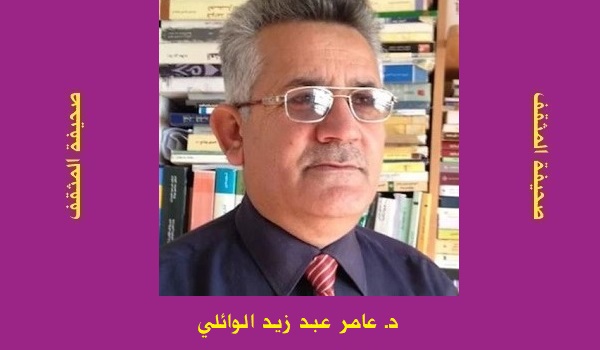آراء
عبد الحسين الطائي: مجزرة سُمَيَّل المؤلمة

قراءة تاريخية في ذاكرة الآشوريين
شهد العراق في 11 آب 1933 واحدة من أكثر الحوادث دموية في تاريخه المعاصر، حيث ارتكبت القوات العراقية مجزرة بحق الأقلية الآشورية في قرية سُمَيَّل والمناطق المجاورة لها. لم تكن المجزرة مجرد حدث عابر، بل كانت نموذجاً لممارسات قمعية تكررت في تاريخ العراق المعاصر، من جراء التنظير الايديولوجي العقائدي المغلق. المجزرة تعتبر الحدث المأساوي الأخطر، الذي رسّخ مبدأ استخدام العنف كأداة سياسية، وأسس لسابقة تاريخية في كيفية تعامل الدولة مع الأقليات، مما انعكس لاحقاً بمختلف المراحل الزمنية في العهدين الملكي والجمهوري في ممارسات مشابهة ضد المجموعات المتعايشة في مجتمعنا العراقي.
لم تأخذ مجزرة سُمَيَّل حقها من الدراسة والتقييم لاعراقياً ولاعالمياً، ويمكن اختصار أبعادها بالحديث عن طعنتين عميقتين لهذه المذبحة؛ الأولى سياسية، كانت أول إبادة جماعية حظيت بتأييد رسمي وشعبي، وعُدّ مرتكبوها أبطالاً، حيث تم إدارة السياسة على حساب القيم الإنسانية. والثانية كانت طعنة قوية في ظهر الآشوريين، لما فيها من أبعاد اجتماعية ونفسية مؤلمة ما زالت آثارها عميقة. ولهذا فإن استذكارها وتوثيق أحداثها من قِبل الجهات الرسمية والشعبية ومن النخب الواعية هو بمثابة رسالة اعتراف بأن هذه المجزرة جريمة ضد الإنسانية، ودعوة بعدم تكرارها مستقبلاً من خلال تبني قيم التعايش السلمي وحماية حقوق الجميع في إطار المواطنة المتساوية.
الآشوريون جزء من مسيحيي العراق، يمتد وجودهم إلى ما قبل انهيار الدولة العثمانية، وأكثر الآراء المحايدة تؤكد بأن الآشوريين اليوم في العراق هم الأحفاد الناجين من الحضارة الآشورية القديمة، وهناك الكثير من الدلائل الأثرية التي تدل على وجودهم في شمال العراق.
يرى الباحث سليم مطر في كتابه "الذات الجريحة" بأن قضية السريان مرتبطة إلى حدّ كبير بالقضية الكردية بسبب التداخل الجغرافي والتاريخي بين مناطق تواجد السريان وتواجد الأكراد. وبعد الفتح الإسلامي أخذ بعض السريان يتخلون بالتدريج عن مسيحيتهم ويعتنقون الإسلام، كانت عملية الأسلمة والتعريب تحدث أولاً في المدن والحواضر بينما بقيت الكثير من الأرياف على مسيحيتها، لا سيما المناطق المرتفعة وشبه الجبلية التي تحولت إلى ملجأ للسريان وغيرهم حتى العصر العثماني. وإن بقاء السريان على مسيحيتهم جعلهم عرضة سهلة لاكتساحات القبائل التركية والكردية المنحدرة من آسيا والجبال المجاورة.
الأحداث التي حصلت قبل الحرب العالمية الأولى مهدت لحصول المجزرة، بعد أن كون السلطان عبد الحميد في أواخر القرن التاسع عشر فرقاً حربية من الأكراد سميت بالفرق "الحميدية"، قامت هذه الفرق ومعها الأغوات بدور كبير في طرد السريان من مناطقهم في الجزيرة (كذلك الأرمن في ارمينيا) وارتكاب مذابح كثيرة ضدهم وإجبارهم على الرحيل أو التحول إلى مسلمين أكراد. وفي سنة 1895م، بدأ الاستهداف العثماني للآشوريين فيما عُرف باسم "المجازر الحميدية" نسبة إلى السلطان عبدالحميد الثاني، تعرض المسيحيون في ديار بكر وحكاري وغيرها من المناطق إلى مجازر دموية في فترات مختلفة بتحريض من بعض رجالات الإمبراطورية العثمانية.
وخلال الحرب العالمية الأولى، تحالف الآشوريون مع القوات الروسية ضد الدولة العثمانية، وتعرضوا إلى مذابح شبيهة بما عرف بـ"الإبادة الأرمنية" التي طالت أكثر من مليون أرمني وعشرات الآلاف من الآشوريين. ولما سيطرت بريطانيا خلال فترة الاحتلال على العراق، أدركت معاناة الآشوريين، طلبوا منهم التعاون معهم، وعرضوا عليهم مغريات كثيرة ووعود بأن يكون لهم كياناً مستقلاً.
وجد الآشوريون الفرصة متاحة أمامهم للتحالف مع السلطة البريطانية، اسست بريطانيا قوات "الليفي" عام 1919، من الآشوريين وبعض العرب والأكراد والتركمان، ولكن بعد تأسيس الجيش العراقي تم ضم العرب والأكراد فيه وأبقوا على الآشوريين في قوات "الليفي". هذا التصرف كان مقصوداً من السلطة البريطانية التي أرادت خلق حالة من التباعد يصب في خدمة مصالحها.
كانت أول صدمة للآشوريين في عام 1923 عندما تم عقد اتفاقية "لوزان" التي رسمت الحدود بين تركيا والعراق، حيث تبدد الحلم الآشوري بضم اقليم "حيكاري" إلى العراق، حيث بقي الاقليم ضمن الحدود التركية. ومع المعاهدة الإنكليزية- العراقية الثانية عام 1930، التي منحت العراق الاستقلال في 1932، باتت المجموعات الآشورية تشعر بأن الخطر قد بلغ الذروة، وأعلنت صراحة أن الإنكليز خالفوا الاتفاق بينهم بحماية الأقليات المسيحية أو على الأقل منحهم حقوق الإدارة الذاتية.
وبعد انتهاء عهد الانتداب البريطاني على العراق عام 1932، أصبح العراق مكبلاً ببنود اتفاقية 1930 لمدة (25) سنة، وحصلت بريطانيا في اطار المعاهدة على موقعين جويين هما الحبانية والشعيبة. كان رشيد عالي الكيلاني وحكومته تعاني من مواجهة شديدة مع المعارضة الشعبية الواسعة، فأراد تغطية مشاكله مع المعارضة بايجاد موضوع لتوجيه الرأي العام نحوه، فاستغل الاعلام العراقي الرسمي في التمهيد لتنفيذ أبشع مذبحة وإبادة جماعية. فبدلاً من أن تحترم حكومته حقوق الآشوريين العراقيين في (المواطنة الكاملة)، أوهمت العراقيين بأن الآشوريين، أعداء العراق والعراقيين ويجب إبادتهم والتخلص منهم، صورتهم على إنهم (أقلية وافدة وانفصالية) تعمل لصالح (الإنكليز).
أدرك الآشوريون بأن وضعهم بائس ومهمش وبريطانيا قد تخلت عنهم كلياً، وإن حلم الوطن قد تبدد، والتوترات مع الكرد ومع الحكومة العراقية في تصاعد، وإن الحكومة الملكية تنتهز الفرصة للإنقضاض عليهم. لذلك قرروا في اجتماع لهم في 16/06/1932، التخلي عن مطالبهم بالوطن المستقل والانخراط مع الحكومة العراقية في برنامج حكم ذاتي، وأصدروا "الميثاق القومي الآشوري" المتكون من تسعة مطالب التي تم تقديمها للحكومة العراقية.
المفاجأة جاءت برفض تلك المطالب من قبل الحكومة العراقية وبريطانيا، لوأد "القضية الآشورية" التي برزت بقوة على المشهد السياسي العراقي وطُرحت على طاولة "عصبة الأمم" بين عامي1931 و1932. ولنجاح مخطط ضرب الآشوريين، استدعت الحكومة البطريرك (مار شمعون) الى بغداد بحجة التفاوض معه بشان حقوق ومطالب الآشوريين، لكن التفاوض كان مجرد خدعة لاعتقاله ووضعه تحت الاقامة الجبرية، بهدف إثارة غضب الآشوريين ودفعهم للعصيان والتمرد، لتبرير الحملة العسكرية عليهم وسحقهم.
تناول الباحث كاظم حبيب في كتابه "مسيحيو العراق" أحداث مجزرة سُمَيَّل بحيادية مؤكداً بأن ما حصل في قرية سُمَيَّل كان مجزرة مدبرة ومعدة سلفاً من جانب الحكومة الملكية ممثلة برئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني، ووزير الداخلية حكمت سليمان، ووزير الدفاع جلال بابان، ووزير الخارجية نوري السعيد ورئيس أركان الجيش العراقي ياسين الهاشمي، ومدير عام الشرطة صبيح نجيب العزي ومتصرف الموصل تحسين علي ونائبه خليل عزمي، وقائد الحملة العسكرية ضد الآشوريين الفريق بكر صدقي. وقد تم تنفيذ الجريمة على مرحلتين، الأولى على نزع سلاح الرجال الآشوريين وتسليمه لمركز الشرطة بحجة حمايتهم من أي اعتداء، بواسطة قائمقام قضاء زاخو، والثانية تنفيذ العملية باستخدام العشائر العربية والجيش والشرطة الملكية بقيادة الضابط إسماعيل عباوي.
لقد فضلت بريطانيا الحفاظ على علاقاتها مع الحكومة العراقية على حساب التزاماتها الأخلاقية تجاه حلفائها السابقين، هذا الموقف المتخاذل زعزع ثقة الآشوريين ببريطانيا، التي كانوا يعتبرونها حامية لهم، وأدى إلى كارثة إنسانية. وكان بامكان السلطة الملكية إيقاف المجزرة ولكن وسائل العنف والتطرف بالاجرام كانت هي السائدة.
ستبقى هذه المجزرة راسخة في ضمير الانسانية كذاكرة مؤلمة والتوثيق التاريخي سيساعد في حفظ الذاكرة الجماعية لشعب عانى من الإبادة والتهجير، ويضمن للأجيال القادمة معرفة ما حدث. وهذا التوثيق يعزز من المطالبة بالاعتراف الرسمي بالمجزرة وتسليط الضوء على ضرورة حماية حقوق كل الأقليات من كل أشكال العنف المتطرف والتمييز، ويأخذ القانون الدولي المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية في انصاف حق الآشوريين في وطنهم العراق.
***
د. عبد الحسين الطائي
أكاديمي عراقي مقيم في بريطانيا