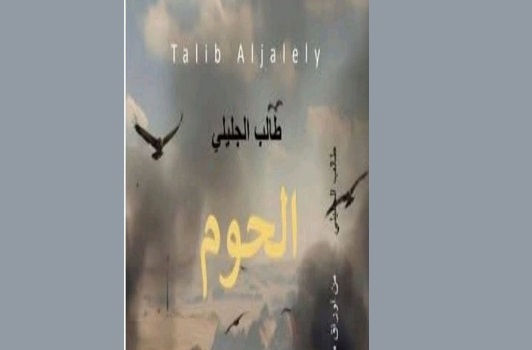قضايا
سجاد مصطفى: ما وراء الإنسان.. نهاية الأنا وبداية الوجود

مقدمة: في زحمة الكلام الفلسفي المتكرر، وتراكم الكلمات التي تكرر نفسها عبر العصور، تبرز الحاجة إلى صوت جديد، لا يكتفي بتكرار الأفكار المعتادة، ولا يستسلم للسقوط في فخ الخطابات السطحية التي تلهث خلف المثالية الوهمية.
هذا المقال ليس مجرد نص يُضاف إلى رصيد الكلام عن الإنسان، بل هو صرخة فلسفية عميقة، ترفض التسامح مع الوهم الذي زرعناه في صميم وجودنا، وتسعى لكشف الوجه الحقيقي لهذا الكائن الذي يُدعى الإنسان. الإنسان الذي طالما اعتُبر محور الكون وغاية الخلق، لا يليق به هذا التكريم، فهو في جوهره مأسور في شباك وعيه المفكك، وحامل لعنة التطور الذي شوه أصالته الوجودية.
في هذا النص، لن نبحث عن حلول نصفية أو نظريات إصلاحية، بل سنخوض رحلة متطرفة نحو جوهر الأزمة: كيف يُمكن لنا، فلسفيًا، أن نُعيد قراءة الإنسان، ليس كقمة التطور وحصان الفلسفة، بل ككائن يحتاج إلى إعادة تأسيس أو حتى إلى تجاوزه.
هذا المقال هو إعلان تمرد على الذات الإنسانية، نداء للفكر لأن يحرر الوجود من أسر الإنسان، وللوعي كي ينظر إلى نفسه بمرآة لا ترحم، تسقط الأقنعة، وتكشف الحقيقة المُرّة. في زمن تُغتال فيه الحقيقة داخل غرف الأنا، هذا النص يدعو إلى لحظة صراحة مطلقة، تقلب الموازين، وتطرح سؤالًا لم يجرؤ أحد على طرحه: هل الإنسان حقيقة يستحق الحياة، أم أنه مجرد خطأ وجودي يجب تجاوزه؟ هل أنت مستعد للغوص في هذه الرحلة الفلسفية التي لا تُحبّذ المهادنة ولا التراجع؟
1. الإنسان ككائن فاسد بنيويًا: تفكيك البناء الوجودي للذات
الذئب، بنظامه الحيوي البسيط، لا يخون نفسه ولا يخرج عن صيغته الطبيعية. النار، في تألقها المهيب، لا تتنكر لجوهرها، ولا تصطنع حرارةً زائفة. أما الإنسان، ذاك الكائن الذي تنوعت أسماؤه وأسطورته، فهو الوحيد الذي ينسج من وجوده شبكة معقدة من الأوهام، يقيم عليها مجتمعات كاملة، ويعبدها في معابد فارغة من الصدق.
تشريح الفساد البنيوي: الإنسان ليس كائنًا محايدًا أو مجرد متلقٍ لقدرٍ بيولوجي أو كوني، بل هو كائن ملوث أصلاً. ليس خطيئته في أفعاله وحسب، بل في طريقة وجوده ذاتها. إنه طبيعة تمردت على جوهرها، ووعي أدمن الخديعة الذاتية. الوعي، الذي يُفترض أنه مرآة الحقيقة، هو في جوهره أداة تفكيك الذات، فهو لا يكشف الحقيقة بقدر ما يخلط بين الحقيقة والوهم، وينتج تعدد ذوات متصارعة داخل نفس الواحد.
الوعي كآلية انقسام داخلي: حين ندرك "أنا"، تبدأ الحكاية المعقدة. فـالأنا ليست وحدة متماسكة، بل مجموعة من الصراعات: صراع بين الرغبة والخوف، بين الحقيقة والزيف، بين الحرية والعبودية. الإنسان يبتدع لنفسه أدوارًا متضاربة: هو الجلاد والضحية، الضمير والإنكار، الباحث عن الحقيقة والرافض لها في الوقت نفسه. هكذا يصبح الإنسان مصنعًا للأوهام الوجودية، ومصدرًا لانقسام الذات التي لا تهدأ.
مفاهيم صنعها الإنسان لشرعنة وجوده: منذ وعي الإنسان لذاته، ابتدأ في تشييد أبراج من المفاهيم التي تمنح وجوده شرعية، لكن هذه المفاهيم ليست أكثر من ستائر تخفي اللاوعي والعبث الكامن في أعماقه: الخير الذي يُقدم كقيمة مطلقة هو في الأصل رغبة في السيطرة ورفض للاختلاف.
الشر ليس سوى انعكاس لنظام قيمي يحدد من هو خارج دائرة الإنسانية. الحرية تتحول في أرض الواقع إلى قانون قمعٍ لا يُعلن عن نفسه. المعنى هو تسوية اضطرارية بين اللاوعي والخوف من العدم. بهذه الطريقة، يصبح الإنسان حكّامًا على ذاته بسلاسل من الأوهام التي تؤجج نزعات التسلط والقهر، ويُنتج عالمًا يفقد فيه كل شيء أصالته، ليصبح مجرد مسرحية مستمرة من الازدواجية.
الخيانة الأزلية: الإنسان ضد الوجود: الإنسان ليس صديقًا للطبيعة، بل هو خائنها الأبدي. يخونها حين يعبث بتوازنها، ويحكم عليها بالموت حين يستغل مواردها بلا هوادة. يخون الزمن حين يسرق من ذاكرتنا الجماعية الحقائق ويعيد تشكيلها وفق مصلحته. ويخون الحقيقة حين يلوّح بالأوهام والرموز بدلًا من المواجهة الصريحة.
هذه الخيانة ليست خطأ عرضيًا، بل هي في صميم طبيعته، فهو كائن أُلقي في العالم يحمل بذور تحلله الداخلي، وسرعان ما تُفجّر هذا التحلل في أشكال من التدمير الذاتي والكوني.
الإنسان ليس كائنًا يعاني من شرور خارجية أو ظروف قاهرة، بل هو كائن يختار بوعي أن يعيش في الازدواجية، وأن يحتضن الانقسام الداخلي، ويصنع من ذاته ما هو أشبه بـمسرحية متقنة لتمثيل الخيانة الوجودية.
2. الوعي: العقوبة التطورية التي شوهت الأصل
لقد اعتُبر الوعي الإنجاز الأسمى في تطور الإنسان، وذروة العقل التي تميزه عن باقي الكائنات. لكن ما لم يُفكر فيه أحد بعمق كافٍ هو أن هذا الوعي قد لا يكون سوى عبء ثقيل على الكائن الحي، بل وربما عقوبة تطورية أثقلت وجود الإنسان بدلاً من تحريره. الوعي ليس مجرد قدرة على إدراك العالم، بل هو حالة من التمزق الدائم بين الذات والواقع، ينتج عنها فجوة لا يمكن جسْرها بين ما هو حقيقي وما هو مفترض، بين الذات التي تتطلع إلى الثبات، والعالم المتحرك المتغير الذي يرفع الاستقرار. في اللحظة التي وُجد فيها وعي الإنسان بنفسه، بدأ رحلة من الاضطراب الوجودي المزمن. ليس وعيًا يُضيء الطريق، بل وعيًا يُعمّق الظلال، ويفتح باب الشك والشكوك، ويغذّي خوف العدم المطلق. كل الأساطير والفنون والفلسفات التي صنعها الإنسان هي محاولات يائسة لملء هذه الفجوة، لإيجاد معنى يثبت الذات في مواجهة هذا العدم الرهيب. لكن، في الحقيقة، هي ليست أكثر من أقنعة رمزية تحجب عن الذات حقيقتها المؤلمة: أنها ليست سوى بؤرة اضطراب، وأن الوعي ليس براءة، بل لعنة على الوجود.
3. النزعة الإنسانوية: الوهم الأكبر وغطاء الانحراف
الفلسفة الغربية، ومن خلالها الفكر الحديث، كرست الإنسان في مركز الكون، وجعلته معيارًا لكل شيء. لقد تم تشييد "الإنسانوية" كإيديولوجيا متكاملة، تغطي كل انحراف وتفسر كل خطأ، وتنطلق من فرضية أن الإنسان جوهر الخير والحق والحكمة. لكن هذه المركزية ليست إلا ستارًا فلسفيًا محكمًا يغطي أعمق الجروح: إن الإنسان هو كائن مريض، يتوسل بفكرة تفوقه ليستمر في تأكيد وجوده المزعوم. وأن الإنسانوية ليست إنقاذًا بل تحايل للتغطية على فساد بنيته.
أفلاطون بنا مدينة العدالة، لكن المدينة لم تكن سوى محاولة لصياغة نظام يحافظ على سيطرة فئة على أخرى. ديكارت أسس الأنا المفكر، لكن هذا الأنا هو بداية انقسام الذات، وفتح الباب أمام أزمة الهوية والذاتية المتنافرة. نيتشه نادى بالإنسان الأعلى، لكنه لم يخرج من دائرة الإنسان، بل استبدل قيدًا بقيْد آخر.
النقطة الأهم أن الفلسفة، حتى في نقدها، لم تجرؤ على رفض الإنسان كمرجعية، بل كانت تدور حوله وكأنه محور لا يمكن تحريكه. وهذا يجعل الإنسانوية أكثر الخطايا فداحة: إنها تحافظ على الإنسان، لا لأنه قيمة، بل لأنه مركز الأزمة الوجودية ذاتها. إذا كان الإنسان هو المشكلة، فكيف لنا أن نُصلح المشكلة ونحن نُعلي من شأنها؟. هذا هو التناقض الذي يثقل كل محاولات الإصلاح والتمرد.
4. ما بعد الإنسان: ضرورة فلسفية لتحرير الوجود من أسر الذات
إنهاء مركزية الإنسان لا يعني مجرد رفض أو إلغاء هذا الكائن، بل هو دعوة لإعادة تفكير جذري في ماهية الوجود وعلاقته مع الذات والعالم. إنه رفض لاستمرار وضع الإنسان كمصدر المعنى والمرجعية المطلقة، ودعوة للعودة إلى حالة ما قبل الإنسان، حيث يظل الكون حراً، والوجود أصيلاً، بلا تداخل الوعي الممزق والأنانية الوجودية. إن ما بعد الإنسان ليس عبثًا أو رفضًا للعقل، بل هو تجاوز نقدي للإنسانوية التي عجزت عن تحرير الفكر والوجود من سطوة الذات. فكما أننا نتجاوز الأنظمة الفاسدة، والسلطات المستبدة، يجب أن نتجاوز الفكرة التي جعلت من الإنسان أداة قمع على الطبيعة، والمجتمع، والعالم.
ما يعنيه ما بعد الإنسان فلسفيًا:
تفكيك فكرة النوع: لا وجود للنوع البشري ككيان مقدس أو مركز الكون. النوع هو مجرد تركيب بيولوجي واجتماعي، وليس الجوهر النهائي للوجود.
تفكيك الهوية المركزية: تجاوز فكرة الأنا كوحدة متماسكة ومطلقة، والانفتاح على مفاهيم الوجود المتعدد، اللاواعي، واللا-ذاتي.
تحرير الوجود: السماح للوجود بأن يكون حرًا من أسره للوعي الذاتي الانعكاسي الذي غالبًا ما يكون سببًا في الاغتراب والخراب.
إعادة النظر بالعلاقات بين الإنسان والطبيعة: إن الإنسان هو جزء من شبكة الحياة، وليس سيدها أو مالكها، ويجب أن تُعاد صياغة هذه العلاقة على أساس الاحترام المتبادل والتكافل.
لماذا هذا التجاوز ضروري؟ الاستمرار في اعتبار الإنسان مركزًا هو استمرار في إنتاج أنظمة القهر، والأوهام، والفساد البنيوي.
كما أن هذا المركز يخلق وهم السيطرة، الذي بدوره يدمر الطبيعة، ويغتال الوجود نفسه.
التاريخ، كما نعرفه، ليس إلا مرآة لتدمير الإنسان الذاتي، فكل حروبنا، أيدولوجياتنا، معاناتنا، ما هي إلا محاولات متكررة لتأكيد بقاء هذا الكائن في قمة الهرم الوجودي، رغم أنه في الواقع، هو مصدر الفساد والدمار.
خاتمة: ما هو المطلوب الآن؟
نحن بحاجة إلى فلسفة ما بعد الإنسان، التي لا تخاف من قطع الروابط، وطرح الأسئلة التي تبدو في الظاهر مستحيلة: هل يمكن للوجود أن يتنفس بحرية بدون الإنسان؟ هل يمكن أن يكون للكون معنى بلا وعيه التفكيكي؟ هل يمكن أن نستعيد التواصل مع الطبيعة والعالم بلا وهم السيطرة الذاتية؟
إن الإنسان، بكل تناقضاته وأوهامه، ليس بطل هذه الحكاية، بل هو الكائن الذي اختلق دروب الخراب والاغتراب لنفسه وللوجود كله. لن نكون حمقى كي نُعيد تدوير الكلام عن الحرية والمعنى كأنهما حلًّا، بينما هما في جوهرهما سجنان للنفس التي لم تجد طريقها للخلاص. كما قلتُ ذات مرة: عقولنا ليست ملكنا.. فهل نملك الجرأة للاعتراف؟
الفيلسوف سارتر، الذي غاص في عتمات الوجود، وصف الإنسان بدقة: الإنسان محكوم عليه بالحرية، لكنه أيضًا محكوم عليه بالخيانة لذاته. وهذا ما نراه بوضوح في طغيان الأنا، في غياب الصدق، وفي الهيمنة التي لا تنتهي لذات لا تهدأ.
نيتشه، المتمرد الذي لم يهادن الإنسان، قال: الإنسان هو جسر، وليس غاية؛ ما بعد الإنسان هو الهدف. كلام يعكس جوهر ما نحتاجه: ولادة جديدة تتجاوز الأنانية والذاتية الضيقة، نحو أفق أرحب للوجود. وأنا أؤكد هنا أن: الوعي ليس براءة، بل لعنة على الوجود.
وفي هذا السقوط المدوي للذات، تكمن الثورة الحقيقية، وفي تحرير الوجود من هيمنة الإنسان، يكمن الخلاص الحقيقي. لذلك، إن كان هناك ما يستحق أن يُكتب ويُقال في عصرنا، فهو هذا الاعتراف الصريح: الإنسان، كما نعرفه، عائق على الوجود لا رائدًا له. والخلاص يبدأ حين نجرؤ على تجاوزه، فلسفيًا وإنسانيًا.
وفي نهاية هذا المقال، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر العميق إلى أستاذي الدكتور حيدر عبد السادة جوده، لا على اختياره الموفق للعنوان فحسب، بل على بصيرته النقدية التي ساعدتني على تعميق نظرتي لهذا التمرّد الفلسفي، وفتح أفق الكتابة أمامي لتجاوز الإنسان بوصفه مركزًا لا يجب أن يُلامس. هذا النص لا يُهدي نفسه سوى إلى أولئك الذين يجرؤون على التفكير خارج قفص النوع، وهو ثمرة فكر يتتلمذ على يد مَن يؤمن أن الفلسفة فعل تحرّر لا تكرار.
***
الكاتب: سجاد مصطفى حمود