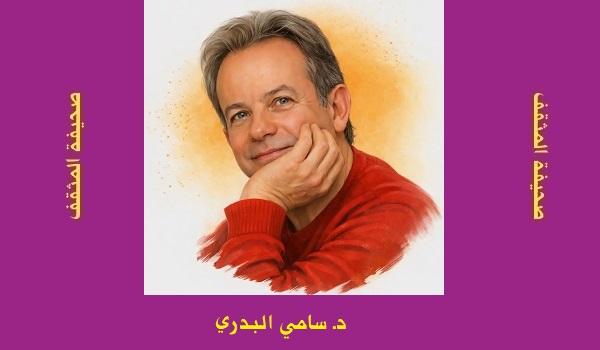قضايا
نورالدين حنيف: الْجسدُ العِلمانيّ

1- الشاهد: ذاتَ حوارٍ، قالت صديقتي العلمانية: أنا حرّةٌ في جسدي ولا أطيق أن أسجنه في طقوس دينية تُملِي عليّ شروطَ اسْتِعماله. قلتُ: هي ليست شروطاً بالمعنى الذي يُضيِّق الخناقَ على حريّة الإنسان. إنها تعاليم ربّانية تشذبُ في العلاقات الجسدية ما يخرج عن الفطرة والقيم والأخلاق والمواضعات الاجتماعية. قالت: هذه كلّها قيود لا معنى لها، وأنا أحبّ أن أتحرك بجسدي دون قيد وأن أستعمله كيفما شئت دون رقابة خارجية. بل إنني أذهب إلى أجرأ من ذلك وأكبر... قلتُ: كيف؟ قالتْ: حتى ابني الرضيع، أنا حرة في أن أمسكَ عنه جسدي بحرمانه من الرضاعة لأنه ليس حتماً عليّ أن أظل رهينة قيدٍ زمنيٍّ يفرض عليّ أن أمدّه بالغذاء لمدّة حوليْن كامليْنِ، حتى يترهّل صدري وأفقد رشاقتي. قلتُ: في هذه أنتم معشر العلمانيين تذهبون مذهب التطرف وتنسون أنه بين الأم ورضيعها عقدٌ ضمني يُلزِمها بواجب الرّضاعة قالتْ: أي عقد؟ قلتُ: تأسّس العقد ضمنياً عندما فكّرتِ في الإنجاب، وقد كان حريّاً بكِ ألّا تنجبي أصلاً... لأنّك إن تذرّعتِ بالحق في الأمومة، فإن هذا يستتبع آلياً الواجب في الرعاية. وهو الواجب الذي يتحول إلى حقٍّ يُمتِّع الرضيعَ بالحضن والرضاع وما شابَه... انتهى .
2 - سؤال الجسد:
فضّلتُ أن تكون هذه الأقصوصة مدخلا لقراءة الجسد الإنساني قراءة تتساءل أكثر مما تقرّر وتفتح الإشكال على مصراعيْه أكثر مما تُعرِّف، حتّى لا تدّعي في تداعياتها البحثية امتلاكها للمعرفة ولسلطة هذه المعرفة. وفضّلتُ أيضاً هذه الأقصوصة البينية على أيّ مدخل آخر لأنها تطرح الإشكال بين تصوريْن، واحد بمرجعية دينية والآخر بمرجعية وضعية.
إذن هي مقولة الحرية والجسد تطرح ذاتها هنا بإلحاح، في سياق حضاري لاحظَ على نفسه تغوّلَ المدّ العلماني القائل بتسييب العلاقة بين الفرد وجسده، في غير رقابة ميتافيزيقية بالمفهوم الفلسفي، وفي غير رقابة عُلوية وغيبية بالمفهوم الديني. وهو السياق ذاتُه الذي لاحظتْ فيه الحضارة الإنسانية صحوة الدين والرجوع إلى الله والوحي وإلى خطاب النبوة.
إن الحديث عن الجسد وعن حريته في التصرّف هو الحديث عن البدايات الممكنة. وهي البدايات الثاويةُ في هوية هذا الجسد، الفارضة أكثر من سؤال:
هل هي هوية تدل على الإنسان في فردانيته الصارخة بحيث تنتصر حدود الذات على الدوائر الجمعية؟ وهل هذه الهوية نازحة من عمليات عقلِ الذات لِذاتِها الفردانية المعبّرة عن نفسها في فلسفة قائمة ومستقلّة؟ أم هي هوية الفرد المتجاوزة لتمثيلِ (الأنا) الهووية المتشرنقة داخل المفهوم الفردي... أم هي الهوية الواسعة الدّالّة على رمزية هذه (الأنا) والذّاهبة إلى التعبير عن الإنسان بمفهومه الجمعي وغير الكامن في أنتروبولوجيا المحلّي حيث الإنسان الأوربي هو غير الإنسان الافريقي وهما غير الإنسان الأمريكي اللاتيني وهكذا؟ وهل هي هوية الجسد في تمثلاته الضيّقة والبسيطة والمرتبطة بالشخصنة أم هي هوية الكائن الأنتربولوجي الكوني المعبّر عن مفاهيم الجسد الواحد على الرغم من اختلاف البنيات الفيزيولوجية واللونية والعرقية؟
3- سؤال الجوهر:
لا تتحدد هوية الإنسان في ملامحه الجسدية إلا في الإطار الضيّق الذي يميز هذا عن ذاك في محفل لا يقوم على أحكام القيمة. إذ سرعان ما تتلاشى الحدود البيضاء والسمراء والسوداء عندما تحضر الهوية الإنسانية في مفهومها الكلياني الموسوم بالغاية في التوحيد. من هنا نفهم عميقاً قوله تعالى (الحمدلله ربّ العالمين) القاضي باحتواء الكون كلّه في دوائر المحبّة الإلهية. وبالتالي فلا موجب للحديث عن العَرَضِ في ماهية الإنسان، إلا في العمليات الإجرائية التفكيكية والتحليلية التي تتغيّى فهم خصوصيات الثقافات وتعبيراتها المحلية عن طبائع الناس داخل حقولٍ معيشية أكثر حميمية ومحليّة. وما تبقّى من الصوغِ الإنساني، هو الدفع بالكليانية إلى أقصى حدودها لكسب جوهر الإنسان .
إن جوهر الإنسان هو رهان الإنسانية، وهو المرجعية القوية في تحديد الهوية ومعالمها وامتداداتها الممكنة. من هنا نسبية الطرح القائل بهوية الجسد الواحد والفردي، ومن ثمّة حريّة هذا الجسد الواحد والفردي. إن المسألة مترابطة أشدّ الترابط في ذهن العلمانية الراغبة في تبرير الحرية الجسدية والجسدانية في أفق يتغيّى أكثر من التكريس لقيم الحرية الفردية. إنها تبتغي من وراء ذلك فتح بوّابات الحريات على مصاريعِها فتحا بدون قيود وبدون شروط وبدون رقابات، وخاصّة الرقابات الدينية، وبالأخص الرقابة الإسلامية الشاذبَة لفعل الجسد تشذيبا قويما مبنيا على رؤية ربّانية فريدة في تاريخ القيم.
هكذا، نتحدّث عن الجوهر والعرض في علاقة الإنسان بجسده، من حيث التعبير الفعلي عن حرية الفرد في التصرّف فيما يملك. إن هذه الملكية التي هي صميم وصمّام أمان التصرّف، ملكية شائكةٌ وإشكالية. فمن قالَ إن الإنسانَ مالكٌ حقيقيّ لجسده؟
دعْنا نناقش الأمر في هدوءِ وحكمة وفي رزانة... حتّى نحولَ بيننا وبين التأويلات الاندفاعية الفاتكة بالحوار وبأهداف الحوار. إن هذا الجسد الذي يدّعي العلماني أنه حرّ في استعماله وفق إرادته ورغبته بحجة أنه يمتلكه هو طرحٌ يحمل الفكرة ونقيضها الهادمَ لها. ودعنا لا نقول ما قال التصور الإسلامي بأن الله يرث الأرض ومن عليها وبالتالي حتى الأجساد يرثها. من منطلق أن العلماني الذي يحاورنا لايأبه بالنقول والنصوص الماتحة من مرجعيات الوحي. نقول له وفي برهنة منطقية لا خلفية غيبية فيها: هبْ أيها العلماني أنّك تملك هذا الجسد، وتملك قرار التصرف فيه، إذن فامنع عنه المرض والخلل والعِلل والشيخوخة والموت. إن ملكية الشيء لا تقف عند حدود حق التصرف فيه بل تذهب بعيدا إلى حق التحكّم فيه، وبالتالي فلا تقلْ لي أيها المستمع لهذا الحوار (بهتَ الذي كفر)1... فحتّى هذا المنطق لا نرومه، لأننا لا نريد تكفير أحد بقدر ما نريد التصحيح إن أمكن أو على أقلّ تقدير نريد البيانَ، من وجهة نظرنا التي نظنّها مبنية داخل نسق فكري واضح المعالم، وبمرجعية معرفية أوضح، تقوم أساسا على منهج (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)2.
إنّ اختزال العلمانية لمشهد الجسد في حرية العرَض بدل حرية الجوهر، أو بدل حريتهما معاً في تكامل نسقي هو لعمري الخروج بالجسد من منظور الوجود الإنساني إلى منظور الواجهة. وحيث إن الواجهة بحكم تسميتها تبقى مجرّد تقليعة عابرة، فإن عمليات تحليل مقولة الجسد ستسقط آلياً في التركيز على تيمات الإثارة. ومن ثمّة سيختزل التحليل ذاته في فكرة الجسد \ الحيز، وستتقلّص إمكانيات قراءته في المنظور الواسع الذي يربطه بعوالم أخرى تكون به ويكون بها، ونقصد بذلك أقنوم الروح، حتّى ولو دأبت الدراسات البحوث على اعتبارها هيولى غير قابلة للقياس والقبض والأجرأة .
3- مقاربة منقوصة:
إذن، كيف نطلبُ من منطق التحليل أن يُقارِب حرية الشيء في منقوصهِ لا في كماله أو تكامله؟ بمعنى أن القراءة العلمانية للجسد هي قراءة آثمة بالمفهوم النقدي والأخلاقي. هي قراءة تختزل الجسد في مناطق (جمع منطِق) غير سليمة على مستوى النظر:
الأول هو النظر الجسماني والبدني لمفهوم الجسد، على اعتبار أنه مجرّد كتلة، تقبل فكرة الحيّز ولا يُراعَى بُعدُها الروحي الممتد خارج الكتلة.
والثاني هو النظر القيمي الذي يختزل الحرية في الرغبة الدانية القاضية بشقّ عصا الطاعة التاريخية للدين، حتّى ليبدو للقارئ أن المستهدف بهذا التخريج ليس حرية الجسد وإنما نقد الدين، ويُفهم ذلك من أن أغلب التحاليل العلمانية تستعمل لغة نقدية مستفزة وغير علمية، تقوم على تصيّد الممكن من ثغرات الدين في رؤيته للجسد، وخاصّة إذا تعلّق الأمر بدين الإسلام.
والثالث هو النظر اللاثقافي الهادف إلى إخراج الجسد من ثقافته الصانعة لهويته، إلى اللاثقافة، وإلى اللاجسد... وبالتالي نكون أمام نظر لا يؤسس لكونية الجسد وإنما يروم علمنة الجسد في إطار ثقافة أخرى هي ثقافة التبضيع والتسليع خارج إطار القيم ومرجعياتها البانية.
هذه الصيحات المتلونة بألوان الحداثة لا تروم الحرية في ذاتها ولذاتها في مقارباتها لهذا الجسد الإنساني. إنها ترغب في تعرية هذا الجسد وتحويله من حالة الثقافة إلى حالة الطبيعة. أي من حالة الهوية الممتلكة لمقولة الأسماء التي علّمها الله آدمَ، إلى حالة اللاهوية البدئية القاطعة من الحداثةِ ذاتها في مفارقة عجيبة تتناقض في صميم بنياتها مع مُدخلاتِها ومخرَجاتها قبل أن تتناقض مع الأطروحات الفكرية المُغايِرة. وهي في هذا المسار صيحاتٌ تستفيد من سياقٍ حضاري وهمي يقول بقيم التحرر والحرية والحرية الشخصية. في مقابل الترويج من قبلِ هذا السياق ذاتهِ لخطل وخطأ الدعوات والصيحات المقابلة، ونقصد بها كل صيحة تراثية دينية تحمل مشروع حداثتها في رحم عتاقتها.
4 – خاتمة مفتوحة:
لا تكون الحياةُ في الجسد بما هو جسدٌ متحيّزٌ في الكتلة، وإنما تكون حياتهُ رهينةً باحتضانها لمقولة الروح التي أشرنا سابقا إلى زئبقيتها في التحليل. إلا أن حضورها لا ينكره أحد البتّة. وهي جوهر الوجود وسديمه الغائر في قيم هذا الوجود. إن استحضار الروح في مقامات الجسد ليس انثيالاً لثنائية المحتوى والوعاء فحسب، وإنما وأساساً هو انثيالٌ لحقيقة العلاقة بينهما، وهي القائمة على جدل الحضور والغياب، أي المعنى واللامعنى. ففي تجاورهما يكون الجسد ثقافةً وهويةً، وفي تغييب أحد الطرفين يكون اللاجسد. وحيث إنّ اللاجسدَ مقولةٌ عائمة فإن الغرض من هذا الصوغ الفكري العلماني هو إطلاق الإنسان في علاقات بشرية بغير ضابط قيمي يتشيّؤ في سياقه هذا الإنسان ويفقد إنسانيته التي بها يكون إنسانا.
***
نورالدين حنيف أبوشامة\المغرب
...................
1 - الآية 258 من سورة البقرة
2 - الآية 111 من سورة البقرة