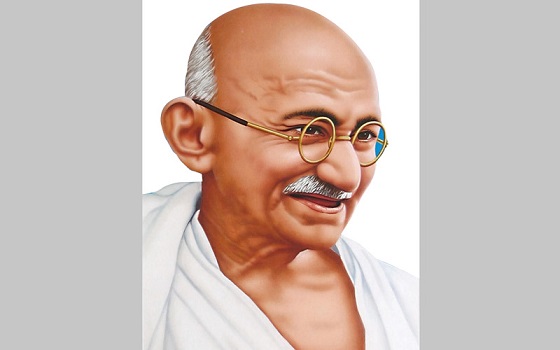قضايا
بدر الفيومي: نحن وثروة المعلومات (2)

إذا ما رجعنا إلى الحقبة التي بزغ فيها نور النبوة، نجد أن العلم ارتبط في الثقافة الإسلامية بنظرة تتجاوز نفع الفرد إلى نفع الإنسانية جمعاء. حيث لم يُقدَّم الإسلام بوصفه قطيعة معرفية مع العالم، ولا مشروعًا حضاريًا مغلقًا على أتباعه، بل جاء في سياق إنساني أوسع يعترف بتعدّد الأمم واختلاف المِلَل، ويُقيم التمييز الواضح بين الخلاف العقدي من جهة، والتعاون الإنساني وتلاقح الأفكار وتبادل الخبرات من جهة أخرى.
وقد تجلّى هذا المعنى عمليًا في عهد النبوة، حين تعامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين تعامل الثقة العملية، حيث استعان بعبد الله بن أريقط، رغم أنه مشرك، دليلًا في أخطر لحظات الدعوة أثناء الهجرة (622م). ولم يمنع اختلاف العقيدة من الاعتماد على خبرته وأمانته، الأمر الذي يظهر وعيًا مبكرًا بأن بناء المجتمع لا يقوم إلا على الثقة المتبادلة وتبادل المنافع. كما نظّم النبي-صلى الله عليه وسلم-العلاقة بين المسلمين واليهود والمشركين في وثيقة المدينة (622م)، التي أرست مفهوم الجماعة السياسية القائمة على التعايش والمسؤولية المشتركة، وليس على التطابق الديني، وهو ما يعكس وعيًا مبكرًا بأن بناء المجتمع لا يقوم إلا على الثقة المتبادلة وتبادل المنافع.
وإذا ما انتقلنا إلى عهد الخلفاء الراشدين ثم الأمويين، نجد أن هذا المنطق ظل حاضرًا؛ فالإدارة والطب والدواوين لم تُحصر في المسلمين وحدهم، بل شارك فيها نصارى ومجوس وصابئة، خاصة في الشام والعراق وفارس. وقد عمل أطباء نصارى في علاج الخلفاء والأمراء دون حرج، وكان المعيار هو الكفاءة لا الانتماء العقدي، الأمر الذي ساعد على تناكح الأفكار بين الثقافات المختلفة. وفي هذا السياق بدأ الاحتكاك المنظم بتراث الأمم السابقة، حيث انتقلت المعارف اليونانية والسريانية والفارسية إلى البيئة الإسلامية، لا بوصفها علوم غريبة، بل باعتبارها خبرة إنسانية قابلة للتطوير والتمحيص.
ومع قيام الدولة العباسية (750م)، بلغ هذا التلاقح الحضاري ذروته، خاصة في بغداد التي تحولت إلى مركز عالمي للعلم. حيث أُنشئ بيت الحكمة في عهد الخليفة المأمون (ت 833م)، ليكون مؤسسة جامعة للترجمة والبحث، وشارك فيه علماء من أديان مختلفة. ومن أبرز هؤلاء حنين بن إسحاق (808 873م)، طبيب ومترجم نصراني، نقل مؤلفات جالينوس وأبقراط من اليونانية والسريانية إلى العربية بدقة علمية عالية، وكذلك ثابت بن قرة (826 901م)، صابئي من حرّان، أسهم في الرياضيات والفلك والطب. ولم يكن هؤلاء استثناءات، بل جزءًا من مناخ عام يرى أن العلم لا يُسأل عن عقيدة حامله، بل عن صدقه ومنهجه، الأمر الذي يعكس إدراكًا مبكرًا لأهمية الزمن المعيش في الانتفاع بالمعرفة والخبرات العملية.
ومن داخل هذا المناخ المتسامح والمنفتح، نشأ كبار علماء الإسلام الذين لم يكن علمهم حكرًا على المسلمين، بل صار تراثًا إنسانيًا مشتركًا. فابن سينا (980 1037م)، المولود في بخارى، ألّف كتابه الشهير القانون في الطب، الذي تُرجم إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر، وظل يُدرَّس في جامعات أوروبا حتى القرن السابع عشر، واستفاد منه الأطباء المسلمون والمسيحيون واليهود على السواء. وكذلك الزهراوي (936 1013م)، طبيب الأندلس الكبير، الذي وضع أسس الجراحة الحديثة في كتابه التصريف، حيث انتقل أثره إلى أوروبا وأصبح مرجعًا أساسيًا للجراحين قرونًا طويلة.
وفي السياق نفسه، يأتي ابن النفيس (1213 1288م)، الطبيب الدمشقي، الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى، وهو إنجاز علمي بالغ الأهمية، ظل مجهولًا في أوروبا حتى أُعيد اكتشافه لاحقًا، ما يؤكد أن المعرفة الطبية في الحضارة الإسلامية كانت جزءًا من السلسلة العالمية لتطور العلم، لا حلقة منقطعة عنها. ولم تكن المستشفيات الإسلامية، حكرًا على أطباء المسلمين، بل عمل فيها مسلمون ونصارى وغيرهم، وكان المريض يُعالج بوصفه إنسانًا لا تابعًا لعقيدة بعينها.
أما في مجال الفلسفة والعلوم العقلية، فنجد أن ابن رشد (1126 1198م)، قاضي قرطبة وفيلسوفها، مثّل نموذجًا صارخًا لتلاقح الأفكار بين الحضارات، حيث كتب شروحه الشهيرة على أرسطو، التي انتقلت إلى أوروبا عبر الترجمات اللاتينية، وأسهمت في تشكيل العقلانية الأوروبية فيما عُرف بالرشدية اللاتينية. وقد قرأه فلاسفة مسيحيون ويهود، وتأثروا به في بناء الفلسفة المدرسية، ما يدل على أن نتاجه الفكري تجاوز الإطار الديني والثقافي الذي نشأ فيه.
ولذلك لم يكن علم ابن سينا أو ابن رشد أو الزهراوي علمًا إسلاميًا بالمعنى الضيق، بل علمًا إنسانيًا ساهم في بنائه المسلم والمسيحي والمجوسي، وانتفعت به سائر الأمم، في سلسلة تاريخية طويلة من الثقة المتبادلة والتلاقح الخلّاق.
وقد كانت الأندلس (711 1492م) نموذجًا حيًا لهذا التعايش، حيث عاش المسلمون والمسيحيون واليهود في فضاء ثقافي واحد، وتبادلت فيه اللغات والمعارف. ففي طليطلة، نشأت مدارس للترجمة نقلت العلوم العربية إلى اللاتينية، وأسهم فيها علماء من مختلف الديانات. ويكفي أن نذكر موسى بن ميمون (1135 1204م)، الفيلسوف والطبيب اليهودي، الذي نشأ في بيئة أندلسية إسلامية، وكتب مؤلفاته متأثرًا بالفلسفة الإسلامية، خاصة ابن رشد وابن سينا، ثم انتقل أثره إلى الفكر اليهودي والمسيحي معًا.
وإذا ما نظرنا إلى البنية الغربية الحديثة، نرى تحولًا جذريًا في التعامل مع المعرفة. ففي أوروبا الحديثة، كان الاحتفاظ بالأرشيفات، والسيطرة على الطباعة، والتحكم في الجامعات، جزءًا من أدوات السلطة، ومع صعود الرأسمالية الصناعية أصبحت المعرفة رأس مال استراتيجي. ومع ظهور الشركات متعددة الجنسيات، تحولت المعلومة إلى مورد يُستخرج ويُخزَّن ويُباع. حيث أصبحت المعلومة تُدار بآليات سياسية واقتصادية معقدة، وتخضع أحيانًا لتوجيهات مؤسسية تحدد ما يُنشر وما يُخفى وما يُضخ في الإعلام وما يُدفن في الأرشيف.
ففي مجال الطب تحديدًا، أصبح التطوير العلمي مرتبطًا بالربحية، فحين تتولى شركات عملاقة إدارة الأبحاث والاختبارات والتوزيع، يصبح الوصول إلى العلاج متوقفًا على القدرة الاقتصادية لا الضرورة الإنسانية. ولا يعني ذلك أن الدواء الغربي رديء، بل يعني أن الدواء الذي يصل إلى العالم لا يعكس دائمًا أفضل ما توصل إليه العلم، بل ما يتناسب مع حسابات السوق. فالأولوية تُعطى للأدوية ذات العائد الكبير، أما العلاجات التي تُحدث فارقًا جذريًا لكنها لا تحقق أرباحًا مناسبة، فتُؤجَّل أو تُحجَب أو تُطرح بحدود جغرافية واقتصادية ضيقة.
وليس المقصود هنا إلصاق المسؤولية بدين أو عرق معين، بل الإشارة إلى شبكات نفوذ ثقافية واقتصادية لعبت دورًا في توجيه المعرفة بما يخدم مصالحها. وقد أشار لذلك محمد عابد الجابري، بأنه في بدايات أوروبا الحديثة، كان الاحتفاظ بالأرشيفات، والسيطرة على الطباعة، والتحكم في الجامعات، جزءًا من أدوات السلطة ومع صعود الرأسمالية الصناعية، أصبحت المعرفة رأس مال استراتيجي، ومع ظهور الشركات متعددة الجنسيات تحولت المعلومة إلى مورد يُستخرج ويُخزَّن ويُباع. حيث أصبحت المعلومة تُدار بآليات سياسية واقتصادية معقدة، وتخضع أحيانًا لتوجيهات مؤسسية تحدد ما يُنشر وما يُخفى وما يُضخّ في الإعلام وما يُدفن في الأرشيف.
ومع دخولنا عصر الرقمنة، ارتفعت درجة التوجيه إلى مستوى غير مسبوق. فخوارزميات المنصات الكبرى لا تعمل بصورة حيادية كما يتصور البعض، بل تُبرمج لتوجيه السلوك والمواقف والرغبات بما يتماشى مع مصالح من صمموها. معرفة مرشّحة، ومختارة ضمن مسار معين يرسّخ نمطًا ذهنيًا دون آخر، وحين تُضخ مليارات من الصفحات والمقالات والفيديوهات في شبكة تُديرها حفنة من الشركات، يصبح من السهل تشكيل وعي عالمي يتجه إلى ما تريده تلك المنصات، لا ما يريده الفرد.
تحت هذه السحابة الكثيفة من البيانات المتناقضة معلومات صحيحة وأخرى زائفة، علم رصين وآخر موجه، معرفة نقية وأخرى محمّلة بالتحيز يصعب على الإنسان العادي الوصول إلى الحقيقة. ليس لأن الحقيقة غير موجودة، بل لأن الوصول إليها محاط بطبقات من التوجيه والتشويش والانتقاء. وهكذا تُبنى أنماط الوعي الحديثة من خيوط خفية من السياسات المعلوماتية توجه ما نراه، وما نفكر فيه، وما نميل إليه، حتى تتحول خياراتنا إلى نتائج هندسة ذكية، لا نتائج إرادة حرة تمامًا.
ومن هنا يمكن القول بأن ما نشهده ليس عفوية معلوماتية، بل هندسة معرفية ممنهجة تُعيد صياغة العقل الجمعي بما يتماشى مع مصالح القوى الكبرى. فالخوارزميات، والأرشيفات المغلقة، ومراكز البيانات، وقواعد البحث العلمي، والإعلام الرقمي، كلها تعمل ضمن نسق واحد لتشكيل وعي الإنسان بما يوافق ما يطمحون إليه له، لا ما يطمح هو إليه لنفسه.
للحديث بقية...
***
بقلم: د. بدر الفيومي