قراءة في كتاب
إحسان الحيدري: كتاب "التربية الأخلاقيّة في الفلسفة الكانطيّة" للدكتور علي أسعد وطفة

دراسة تحليليّة
أولًا: التعريف بالفيلسوف الألماني كانط وبفلسفته
يُعدُّ إيمانويل كانط (1724-1804) أحد أعظم فلاسفة العصر الحديث، وشخصيّة محوريّة في عصر التنوير الأوروبي. لقد ترك إرثاً فكريّاً هائلاً لا يزال يؤثر في مسارات الفكر العالمي حتى يومنا هذا، وتتجلّى عبقريّته بشكل خاص في ثلاثيّته النّقديّة الشهيرة: "نقد العقل المحض" (1781)، و"نقد العقل العملي" (1788)، و"نقد ملكة الحكم" (1790). وكما يوضّح مؤلف الكتاب- الدكتور علي أسعد وطفة- فإن كانط قد شيّد مملكته الفكريّة على أربع ركائز فلسفيّة متكاملة هي: المثاليّة، والنّقديّة، والأخلاقيّة، والعقلانيّة، واستطاع أن يمزج بينها في نسيج فلسفي فريد ومتماسك.
يكمن جوهر إسهام كانط في "الثورة الكوبرنيكيّة" التي أحدثها في الفلسفة. فكما أنّ كوبرنيكوس قلب مركزيّة الكون من الأرض إلى الشمس، قلب كانط مركزيّة المعرفة من الموضوع (العالم الخارجي) إلى الذات (العقل الإنساني). فبدلاً من أن يكون العقل مجرد مرآة سلبيّة تعكس الواقع، أصبح مساهماً فعاّلاً في بناء وتنظيم خبراتنا المعرفيّة. لقد تحول محور البحث الفلسفيّ من طبيعة الواقع في ذاته (الميتافيزيقا التقليديّة) إلى البحث في طبيعة العقل وحدوده وإمكانيات الإنسان نفسه.
ولعل الإنجاز التاريخي الأبرز لكانط هو المصالحة التي عقدها بين المذهب العقليّ (الذي يمثّله ديكارت وليبنتز) والمذهب التجريبيّ (الذي يمثله هيوم ولوك). فبعد قرن من الصراع بين من يرون أنّ المعرفة تنبع من العقل وحده، ومن يرون أنها تنبع من الحواس وحدها، جاء كانط ليثبت أنّ المعرفة هي نتاج تفاعل خلّاق بينهما. وتتلخص هذه الرؤيّة التوفيقيّة في مقولته الشهيرة: " الحُدوسُ الحسّيّةُ بدونِ مفاهيمَ تظلّ عمياءَ، والمفاهيمُ بدونِ حُدوسٍ حسّيّةُ تبقى جوفاء". فالحواس تزودنا بالمعطيات الخام، والعقل يمنحها الشكل والنظام والمعنى.
ومع ذلك، يبرز توترٌ أساسي في قلب الفلسفة الكانطيّة، وهو التوتر بين كانط الفيلسوف النظريّ صاحب الأنظمة شديدة التجريد، وكانط المربي الذي يسعى لتقديم إرشادات عمليّة. إنّ الفجوة بين عالم "النومينون" (الشيء في ذاته) وعالم "الفينومينون" (الظواهر)، وبين صرامة "الأمر القطعي" وتعقيدات الواقع الإنساني، تطرح إشكاليّة منهجيّة عميقة أمام أي محاولة لتأسيس "تربية كانطيّة". ويشكل كتاب الدكتور وطفة محاولة جادّة للتوسط في هذا التوتر، واستكشاف كيف يمكن ترجمة هذه الفلسفة المتعاليّة إلى ممارسة تربويّة عمليّة .
ثانيًا: التعريف بمؤلف الكتاب الدكتور علي أسعد وطفة
إن مؤلف هذا العمل، الأستاذ الدكتور علي أسعد وطفة، هو باحث وأكاديمي سوري يشغل منصب أستاذ علم الاجتماع التربوي في جامعتي دمشق والكويت، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع التربوي من جامعة كان بفرنسا. وتكمن أهميّة خلفيّته الأكاديميّة في أنها تجمع بين تخصصين متكاملين: الفلسفة وعلم الاجتماع. وهذا التكوين المزدوج يمنح تحليلاته عمقاً فلسفياً وقدرة على الربط بالسياق الاجتماعي؛ مما يجعله قادراً على تجاوز الشرح التقليدي للفلسفة الكانطيّة.
يتبنّى الدكتور وطفة منهجاً نقديّاً وسوسيولوجيّاً واضحاً في أعماله. فهو لا يتعامل مع كانط كنص تاريخي مغلق، بل يوظفه كعدسة تحليليّة لفهم وتشخيص أزمات الواقع العربي المعاصر. وتتضح هذه النَّزعةُ النقديّةُ في مؤلفاته الأخرى التي تناولت قضايا محوريّة مثل "بنيّة السلطة وإشكاليّة التسلط التربوي في الوطن العربي" و"الجمود والتجديد في العقليّة العربيّة "، بالإضافة إلى اهتمامه بقضايا التنوير وحقوق الإنسان.
من هنا، يمكن فهم مشروع المؤلف كمشروع "مثقف عضوي" يسعى إلى التأثير في واقعه. فهدفه، كما يصرّح في مقدمة كتابه، ليس مجرد التحليل الأكاديمي، بل هو إطلاق "صرخة كانطيّة جديدة في عالمنا العربي تدعو إلى استعمال العقل والبرهان؛ لكشف كل أشكال السقوط الأخلاقي والممارسات العبثيّة في التربية ". هذا الطموح يضع الكتاب في مصاف المشاريع الفكريّة الإصلاحيّة التي تستخدم التراث الفلسفي كأداة للتشخيص والعلاج. ومن ثمَّ، فإن تقييم هذا العمل لا يقتصر على مدى دقته في عرض الفكر الكانطي، بل يمتد ليشمل مدى نجاحه في توظيف هذه الفلسفة، بكل تعقيداتها وتناقضاتها التاريخيّة، كأداة فعاّلة للإصلاح التربوي في السياق العربي الراهن.
ثالثًا: المقدمة
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم قراءة تحليليّة ونقديّة شاملة لكتاب " التربية الأخلاقيّة في الفلسفة الكانطيّة: مكاشفات نقديّة معاصرة" للأستاذ الدكتور علي أسعد وطفة. وسيتم تناول كل فصل من فصول الكتاب السبعةَ عَشَرَ بشكلٍ مستقلٍّ، مع إبراز موضوعاته الرئيسة وتحليلها في ضوء الفلسفة الكانطيّة الكليّة والرؤيّة النّقديّة للمؤلف.
تعتمد هذه الدراسة منهجاً تحليلياً يهدف إلى الربط بين مستويات ثلاثة:
أولًا، المحتوى التفصيلي لكل فصل كما يقدمه الدكتور وطفة؛
ثانيًا، السياق العام للفلسفة الكانطيّة الذي تنتمي إليه هذه الأفكار التربويّة؛
وثالثًا، المشروع النقدي للمؤلف الذي يسعى من خلاله إلى توظيف الفكر الكانطي لمواجهة تحديات الواقع العربي المعاصر.
تكمن الأهميّة الكبرى لهذا الكتاب في كونه عملاً رائداً في المكتبة العربيّة، يسد فجوة معرفيّة في مجال دراسة الفكر التربويّ الكانطيّ من منظور نقدي معاصر. فهو لا يكتفي بعرض أفكار كانط، بل يشتبك معها ويضعها في حوار مع أزمات التربية والأخلاق في مجتمعاتنا؛ مما يجعله عملاً حيويّاً يجمع بين الأصالة الفلسفيّة والراهنيّة الاجتماعيّة .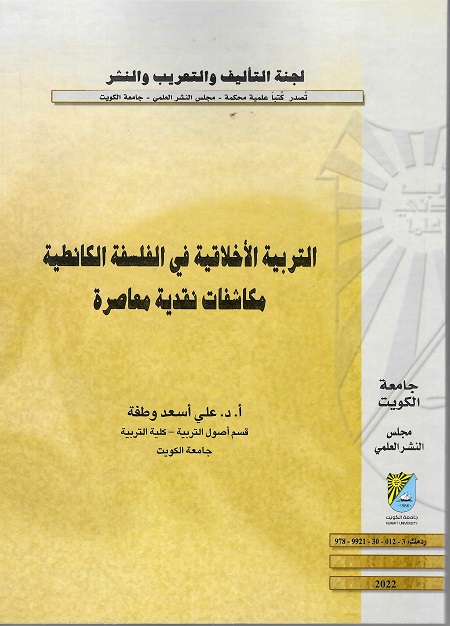
رابعًا: دراسة للفصل الأول: كانط: نشأته ومؤثراته الفكريّة
يقدم الفصل الأول مدخلاً ضرورياً لفهم الفلسفة الكانطيّة، إذ يربط بشكل منهجي بين سيرة الفيلسوف الذاتيّة، وبين تكوين نظامه الفكري. يركّز الدكتور وطفة على محورين أساسيين: البيئة التربويّة والمؤثرات الفكريّة :
أولًا، يحلل الفصل تأثير نشأة كانط في بيئة دينيّة "تقوّيّة " صارمة، ودور والدته المتدينة في غرس قيم الواجب والصدق والصرامة الأخلاقيّة في نفسه منذ الصغر. هذه التربية الطهوريّة، على الرغم من تمرد كانط لاحقاً على طقوسها الشكليّة، تركت بصمة لا تُمحى في شخصيته وفلسفته.
ثانيًا، يحلل الفصل المؤثرات الفكريّة التي شكّلت عقل كانط، ويحددها في مثلث فكري متفاعل: الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم، الذي "أيقظه من سباته الدوغمائي" وشكك في قدرة العقل على إثبات السببيّة؛ والعالم الإنجليزي إسحاق نيوتن، الذي منحه ثقة هائلة في قدرة العقل العلمي على اكتشاف قوانين الكون؛ والمفكر السويسري جان جاك روسو، الذي ألهمه أخلاقياً ودفعه إلى وضع الكرامة الإنسانيّة فوق المعرفة والعلم.
يطرح الدكتور وطفة هنا رؤيّة سببيّة تربط بين السيرة الذاتيّة والنظام الفلسفي، وهو ما يمثل بصيرة تحليليّة عميقة. ففلسفة كانط، وفقاً لهذا الطرح، ليست مجرد بناء عقلي مجرد، بل هي نتاج مباشر لتجاربه الحياتيّة. الصرامة والدقة اللتان ميزتا حياته اليوميّة، لدرجة أنّ جيرانه كانوا يضبطون ساعاتهم على موعد نزهته، هي انعكاس مباشر للصرامة التي تلقاها في تربيته الدينيّة، وهذه الصرامة بدورها تجلّت في الصرامة المطلقة لقانونه الأخلاقي. هذا التحليل "السيكولوجي - الاجتماعي" يضع تحدياً ضمنياً أمام ادعاء كانط بالكونيّة المطلقة لفكره. فإذا كانت فلسفته الأخلاقيّة متجذرة بعمق في تجربة بروسيّة لوثريّة محددة في القرن الثامن عشر، فإلى أي مدى يمكن عد مبادئها "كونيّة " و"ضروريّة " وصالحة لكل زمان ومكان؟ هذا التوتر بين الخصوصيّة التاريخيّة والادعاء الكوني سيظل خيطاً ناظماً في تحليلنا للكتاب.
خامسًا: دراسة للفصل الثاني: الملامح الأساسيّة للفلسفة الكانطيّة
يقدم الفصل الثاني الأدوات المفاهيميّة الأساسيّة والضروريّة لفهم المنظومة الكانطيّة، والتي ستشكل الإطار المرجعي لتحليل التربية الأخلاقيّة في الفصول اللاحقة. يستعرض الدكتور وطفة المفاهيم المحوريّة مثل الثورة الكوبرنيكيّة، والتمييز بين عالم "النومينون" (الأشياء في ذاتها)، وعالم "الفينومينون" (الأشياء كما تظهر لنا)، والمصالحة التاريخيّة بين العقل والتجربة. كما يركّز على الأسئلة الأربعة الكبرى التي لخص كانط فيها مشروعه الفلسفي برمته: ماذا يمكنني أن أعرف؟ (الميتافيزيقا)، ماذا يجب أن أفعل؟ (الأخلاق)، ماذا يحق لي أن آمل؟ (الدين)، وما هو الإنسان؟ (الأنثروبولوجيا).
إن استراتيجيّة المؤلف في هذا الفصل ليست مجرد تلخيص للفلسفة الكانطيّة، بل هي عمليّة بناء واعيّة لإطار مفاهيمي كانطي يمكن تطبيقه على التربية. يختار الدكتور وطفة بذكاء تلك المفاهيم التي لها صدى تربويّ مباشر وعميق. على سبيل المثال، التمييز بين "النومينون" و"الفينومينون" ليس مجرد تمييز ميتافيزيقيّ، بل له آثار تربويّة هائلة؛ فهو يضع حدوداً للمعرفة اليقينيّة (ما يمكن تدريسه بشكل قطعي)، ويفتح في الوقت نفسه فضاءً مشروعاً للإيمان (ما يمكن تربيّة الفرد على الأمل به). وبالمثل، فإن الأسئلة الأربعة الكبرى لا تشكل فقط خريطة للفلسفة الكانطيّة، بل يمكن قراءتها كمنهج تربوي متكامل يهدف إلى تكوين إنسان يمتلك المعرفة (العقل النظري)، والبوصلة الأخلاقيّة (العقل العملي)، والغايّة الوجوديّة، والوعي بماهيته. وبهذا، يتحول هذا الفصل من مجرد عرض للمفاهيم إلى عمليّة تأسيس منهجي لفلسفة تربويّة متكاملة.
سادسًا: دراسة للفصل الثالث: المشروع التربويّ الكانطيّ
يستعرض هذا الفصل الخطوط العريضة للمشروع التربوي عند كانط، منطلقاً من الفكرة الأساسيّة التي ترى أنّ الإنسان هو "الكائن الوحيد الذي يحتاج إلى التربية " ليحقق إنسانيته. يقدم الفصل المراحل الأربع المتتاليّة التي تشكّل بنيّة هذا المشروع، وهي عمليّة غائيّة تهدف إلى نقل الإنسان من حالته الطبيعيّة إلى حالته الأخلاقيّة :
1- الضّبط (Discipline): وهي مرحلة سلبيّة تهدف إلى قهر "توحش" الطبيعة الحيوانيّة في الطفل ومنعه من الانحراف عن غايته الإنسانيّة .
2- التثقيف (Culture): وهي مرحلة إيجابيّة تهدف إلى تزويد الطفل بالمعارف والمهارات اللازمة للحياة.
3- التمدن (Civilization): وهي مرحلة تهدف إلى تعليم الطفل كيفيّة التكيّف مع المجتمع وقوانينه، وأن يكون محبوباً ومؤثراً .
4- التّهذيب الأخلاقي (Moralization): وهي الغاية النهائيّة للتربيّة، حيث يتعلم الفرد أن يتصرف ليس فقط لتحقيق أهداف خارجيّة، بل وفقاً لمبادئ أخلاقيّة داخليّة نابعة من العقل.
يطرح هذا الفصل إشكاليّة جوهريّة في قلب التربية الكانطيّة، وهي ما يمكن تسميته بـ "المفارقة الأخلاقيّة ". كيف يمكن لمرحلة "الضبط" التي تقوم على القسر والإكراه والطاعة للسلطة الخارجيّة، أن تؤدي في النهايّة إلى مرحلة "التهذيب الأخلاقيّ" التي تقوم على الحريّة والاستقلال الذاتي (Autonomy)، والتصرف وفقاً لقانون يشرعه الفرد لذاته؟ إذا تمّ تعويد الطفل على الطاعة العمياء والخضوع للقوة، فكيف سيتعلم لاحقاً أن يفكر بنفسه ويتحمل مسؤوليّة أفعاله؟ هذا التوتر العميق بين السلطة والحريّة، وبين الإكراه والاستقلال، يمثل نقطة ضعفٌ أساسيٌّ في النظامِ التربويّ الكانطيّ، وهي إشكاليّةٌ لم يُقدّم لها كانطُ حلاً فلسفيًّا مُقنعًا تمامًا، وستظلّ نقطةَ نقدٍ محوريّةٍ في الفصولِ اللاحقةِ
سابعًا: دراسة للفصل الرابع: في مفهوم الطبيعة الإنسانيّة عند كانط
يحلل هذا الفصل موقف كانط المعقد من الطبيعة الإنسانيّة، والذي يشكّل الأساس الذي تقوم عليه نظريّته التربويّة. يرفض كانط الرؤيتين المتطرفتين: رؤيّة توماس هوبز التي ترى أنّ الإنسان شرير بالطبع، ورؤيّة جان جاك روسو التي ترى أنه خيّر بالطبع. بدلاً من ذلك، يقدم كانط موقفاً وسطياً ودقيقًا. يرى أنّ الإنسان يمتلك "استعدادات للخير"، وهي بذور كامنة في طبيعته العقلانيّة، ولكنه في الوقت نفسه يمتلك "ميلاً جذرياً للشر"، وهو نزوع إلى تفضيل الميول الحسيّة على القانون الأخلاقي.
هذه الرؤيّة تجعل من الطبيعة الإنسانيّة مشروعاً تربوياً بامتياز. فالتربية عند كانط ليست مجرد صقل لطبيعة خيّرة (كما عند روسو)، وليست مجرد قمع لطبيعة شريرة (كما عند هوبز). بل هي عمليّة أكثر تعقيداً وضرورة: إنها عمليّة تنميّة للاستعدادات الخيّرة الكامنة، وفي الوقت نفسه، هي صراع مستمر ضد الميل إلى الشر. لو كان الإنسان خيّراً بالطبع، لما احتاج إلى التربية. ولو كان شريراً بالطبع، لما نفعت فيه التربية. ولأن الإنسان، في نظر كانط، كائن "غير مكتمل" بطبيعته، وموجود في حالة توتر دائم بين عقله وميوله، فإن التربية تصبح هي العمليّة الوجوديّة التي من خلالها "يصنع الإنسان إنسانيته"، ويحقق غايته الأخلاقيّة. هذا يعطي للتربية مكانة مركزيّة ليس فقط في بناء المجتمع، بل في تعريف ماهيّة الإنسان نفسه.
ثامنًا: دراسة للفصل الخامس: التربية الأخلاقيّة والطبيعة الإنسانيّة: إشكاليّة التجاوز
يفصّل هذا الفصل الآليات العمليّة التي يقترحها كانط لتجاوز "الحالة الحيوانيّة " في الإنسان والوصول إلى "الحالة الأخلاقيّة ". يركّز الفصل على مرحلتين أساسيتين: المرحلة الأولى هي "الضبط والترويض"، والتي تقوم على القسر والإكراه بهدف "قهر التوحش" وكبح الميول الطبيعيّة الجامحة. والمرحلة الثانيّة هي "التنوير واليقظة الأخلاقيّة "، والتي تهدف إلى تكوين شخصيّة تتصرف بحريّة وكرامة وفقاً للقانون الأخلاقي. يدافع كانط عن فكرة أنّ الإكراه في البدايّة ضروري لتمكين الحريّة لاحقًا.
إن لغة كانط في هذا السياق، كما ينقلها الدكتور وطفة، تبدو صادمة للمعايير التربويّة الحديثة، إذ يستخدم مصطلحات مثل "قهر التوحش" و"الترويض" و"تجرید الإنسان من حيوانيته". هذا يكشف عن الهوّة التاريخيّة العميقة بين فكر كانط في القرن الثامن عشر، وبين علم نفس الطفل و التربية الحديثة التي تؤكد على أهميّة اللعب والفضول والعاطفة كأسس للنمو السليم. إنّ هذا الفصل يوضح بجلاء أنّ أي محاولة لتطبيق التربية الكانطيّة بشكل حرفي اليوم ستكون إشكاليّة للغايّة، إن لم تكن ضارة نفسيّاً وتربويًا. فالقيمة المعاصرة لأفكار كانط لا تكمن في وصفاته العمليّة، بل في غاياته الأخلاقيّة العليا.
تاسعًا: دراسة للفصل السادس: التجلّيات الأخلاقيّة في الفلسفة الكانطيّة
يعود هذا الفصل إلى قلب المفاعل النوويّ للفلسفة الكانطيّة، أي نظريته الأخلاقيّة. يستعرض الدكتور وطفة المفاهيم الأساسيّة التي تشكّل جوهر هذه النظريّة: مفهوم "الواجب" كأساس مطلق للفعل الأخلاقيّ، والذي يجب أداؤه لذاته وليس لأيّ غاية خارجيّة؛ ومفهوم "الإرادة الخيّرة" بوصفها الشيء الوحيد في العالم الذي يمكن عدّه خيراً دون قيد أو شرط؛ وصيغة "الأمر القطعي" كقانون كلي للأخلاق، وأشهر تجلياته: "اعمل فقط وفقاً لذلك المبدأ الذي يمكنك في الوقت نفسه أن تريد له أن يصبح قانوناً كليًا".
إن أخلاق كانط هي أخلاق صوريّة (Formalistic) بامتياز، أي أنها تهتم بشكل القاعدة الأخلاقيّة (كونيّتها وضرورتها) وليس بمحتواها المحدد أو بنتائجها. وهذا ما يجعلها نظاماً فلسفيّاً قويّاً ومتماسكًا، ولكنه يطرح تحديّاً تربويّاً هائلًا. إذ كيف يمكن تعليم طفل أن يتصرف ليس بدافع التعاطف مع الآخر (وهو شعور يعدّه كانط ميلاً حسياً لا قيمة أخلاقيّة له)، ولا بدافع الخوف من العقاب أو الطمع في الثواب، بل فقط من منطلق "احترام القانون الأخلاقي" المجرد؟ هذا الفصل يوضح الصعوبة الكبرى في ترجمة هذه الأخلاق الصوريّة إلى محتوى تربوي عملي. فكيف يمكن أن نزرع في نفس الطفل دافعاً مجرداً ونقياً للفعل الأخلاقيّ، بعيداً عن المشاعر الإنسانيّة الطبيعيّة التي تشكّل عادةً أساس التربية الأخلاقيّة؟
عاشرًا: دراسة للفصل السابع: الممارسة النقديّة للتربيّة عند كانط
يُظهر هذا الفصل الجانب العملي والإصلاحي في فكر كانط، إذ يطبق منهجه النقدي على الممارسات التربويّة التي كانت سائدة في عصره. ينتقد كانط بشدة العقاب الجسدي والنفسي، وأساليب التلقين والحفظ الآلي، والدلال المفرط الذي يفسد طباع الأطفال، والمناهج التعليميّة التي لا تراعي مراحل نموهم العقلي. كما يهاجم عادات محددة مثل تقميط الرضع وهدهدتهم، ويرى فيها تعديّاً على حريّتهم الجسديّة ونموهم الطبيعي.
هذا الجانب من فكر كانط يوازن صورته كفيلسوف مجرد ومنعزل. فهو يظهر هنا ليس فقط كمنظّر في برج عاجي، بل كمراقب ناقد لمجتمعه، يهتم بالتفاصيل العمليّة للتربيّة ويسعى إلى إصلاحها. إنّ نقده للممارسات التربويّة القائمة يثبت أنّ فلسفته لم تكن مجرد تمرين عقلي، بل كانت جزءاً لا يتجزأ من مشروع التنوير الأوسع، الذي يهدف إلى تحسين الحالة الإنسانيّة من خلال إعمال العقل في جميع مجالات الحياة.
أحد عشر: دراسة للفصل الثامن: ملامح الفكر التربوي عند كانط
بعد استعراض الجانب النقدي، يركّز هذا الفصل على الملامح الإيجابيّة والبنّاءة في بيداغوجيا كانط. المحور الأساسي هنا هو "المنهج الحواري" المستلهم من سقراط، والذي يمثل قمة الممارسة التربويّة عند كانط. يهدف هذا المنهج إلى جعل التلميذ يفكر بنفسه، ويستخرج المعرفة من عقله، بدلاً من أن يحفظ آراء الآخرين بشكل سلبي. يميز كانط بين مرحلتين: مرحلة السؤال والجواب البسيطة، ومرحلة الحوار السقراطي المتقدمة التي تتطلب نضجاً عقلياً أكبر.
إذا كان الفصل الخامس قد أبرز "المفارقة الأخلاقيّة " المتمثلة في كيفيّة الانتقال من الإكراه إلى الحريّة، فإن هذا الفصل يقدم الحل الكانطي المحتمل لهذه الإشكاليّة. الحوار هو الجسر الذي يربط بين المرحلتين؛ فمن خلال الحوار السقراطي، ينتقل المربي من دوره كسلطة خارجيّة تفرض القواعد (مرحلة الضبط) إلى دوره كمرشد يساعد التلميذ على اكتشاف المبادئ العقلانيّة بنفسه. فالحوار هو الأداة التربويّة التي تمكّن من الانتقال من الطاعة القسريّة إلى الاستقلال الذاتي القائم على الاقتناع العقلي، وبالتالي يمثل حلًا، ولو جزئيًا، للتناقض الجوهري في نظامه التربوي.
اثنا عشر: دراسة للفصل التاسع: من التربية العامة إلى التربية الأخلاقيّة
يفصل هذا الفصل المراحل التربويّة بشكل أكثر دقة، موضحاً كيف أنّ كل مرحلة هي تمهيد ضروري للمرحلة التي تليها، وصولاً إلى الغاية النهائيّة وهي التهذيب الأخلاقي. التربية الجسديّة، و التربية الثقافيّة (تنميّة المهارات)، و التربية المدنيّة (التكيّف الاجتماعي)، كلها مراحل لا غنى عنها، ولكنها تظل وسائل لهدف أسمى، وهو تكوين الشخصيّة الأخلاقيّة التي تتصرف وفقاً للواجب.
يكشف هذا التحليل عن البنيّة الهرميّة والغائيّة (Teleological) للتربية الكانطيّة. فالتربية عند كانط ليست مجموعة من الممارسات المتفرقة، بل هي نظام متكامل ومتصاعد. في القاعدة يوجد الضبط الجسدي، ثم يأتي التثقيف العقلي، وفي القمة يتربع التهذيب الأخلاقي. كل مرحلة سابقة هي شرط ضروري للمرحلة اللاحقة، ولا يمكن القفز فوق المراحل. هذه البنيّة الهرميّة تعكس رؤيّة كانط للإنسان ككائن متعدد الأبعاد (جسد، عقل، وروح أخلاقيّة )، ويجب تربيّة كل هذه الأبعاد بترتيب محدد ومنهجي للوصول إلى الإنسان الكامل الذي يحقق غايته الأخلاقيّة .
ثلاثة عشر: دراسة للفصل العاشر: التربية الأخلاقيّة من منظور ديني
يطرح هذا الفصل أحد أكثر جوانب فكر كانط ثوريّة وتأثيراً في الحداثة، وهو رؤيته للعلاقة بين الدين والأخلاق. يقلب كانط العلاقة التقليديّة رأساً على عقب؛ فالأخلاق عنده لا تستمد شرعيتها من الدين، بل على العكس، الدين هو الذي يجب أن يُفهم ويُقوّم في "حدود العقل وحده" وفي ضوء المبادئ الأخلاقيّة. إنّ وجود الله وخلود النفس ليسا عقائد يجب الإيمان بها أولاً لتأسيس الأخلاق، بل هما "مسلّمات العقل العملي"، أي أنهما افتراضات ضروريّة لجعل الحياة الأخلاقيّة ممكنة وذات معنى نهائي.
هذا التحليل يمثّل جوهر علمنة الأخلاق وتأسيسها على العقل وحده. بفصل الأخلاق عن الوحي الإلهي، يؤسس كانط للأخلاق على أساس مستقل، عقلاني، وكوني. هذا يجعل الأخلاق ممكنة للجميع، بغض النظر عن معتقداتهم الدينيّة، ويجعلها شأناً إنسانياً مشتركًا. من الناحيّة التربويّة، يترتب على ذلك أنّ التربية الأخلاقيّة يجب أن تركّز بالدرجة الأولى على تنميّة العقل النقدي والضمير المستقل، وليس على التلقين الديني العقائدي الذي قد يعتمد على الخوف أو الطمع بدلاً من احترام الواجب لذاته.
أربعة عشر: دراسة للفصل الحادي عشر: الأسس الأخلاقيّة للتربيّة الجنسيّة
يبحث هذا الفصل في مبادئ كانط الأخلاقيّة الصارمة التي أراد تطبقها في مجال التربية الجنسيّة؛ وهو الأمر الذي يكشف عن حدود فلسفته وتزمتها. انطلاقاً من الأمر القطعي الذي ينهى عن استخدام الإنسان كمجرد وسيلة، يدين كانط أي علاقة جنسيّة لا تكون ضمن إطار الزواج وهدفها الأساسي هو الإنجاب، لأن أي علاقة أخرى تقوم على اللذة تحول الطرف الآخر إلى أداة لإشباع الرغبة. كما يدين بشدة العادة السريّة بوصفها انتهاكاً للكرامة الإنسانيّة.
يمثل هذا الفصل المثال الأوضح على كيف يمكن لتطبيق مبدأ مجرد بشكل صارم ومتعسف أن يؤدي إلى نتائج متزمتة وغير واقعيّة. إنّ رفض كانط للعاطفة واللذة كجزء مشروع من الحياة الإنسانيّة السويّة يكشف عن جانب "لا-إنساني" أو "عدائي للحياة" في فلسفته الأخلاقيّة. وهذا يمثل نقطة نقد قويّة ضد كانط، ويظهر أنّ الأخلاق لا يمكن أن تكون مجرد مجموعة من القواعد الصوريّة المجردة، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار تعقيدات الطبيعة البشريّة وعواطفها وحاجاتها الجسديّة والنفسيّة.
خمسة عشر: دراسة للفصل الثاني عشر: التربية على الفضائل الأخلاقيّة
بعد التركيز على المبادئ العامة، ينتقل كانط في هذا الجزء إلى الحديث عن فضائل أخلاقيّة محددة مثل الصدق، الشجاعة، تقدير الذات، والعدالة. يربط كانط كل فضيلة بمبدأ الواجب، فالشجاعة ليست مجرد غريزة، بل هي قوة الإرادة في الالتزام بالواجب على الرغم من الخوف.
يمثل هذا الجزء محاولة من كانط لـ "تجسيد" نظامه الأخلاقي المجرّد ومنحه محتوى عملياً يمكن تربيّة الأفراد عليه. ومع ذلك، تظل فضيلة كانط مختلفة جوهرياً عن فضيلة أرسطو. عند أرسطو، الفضيلة هي طبع أو عادة حسنة تتكون عبر الممارسة. أما عند كانط، فالفضيلة هي حالة صراع دائم، هي الالتزام الواعي بمبدأ الواجب في مواجهة الميول الطبيعيّة المعارضة. هذا يعني أنّ التربية على الفضيلة عند كانط ليست مجرد تدريب على عادات حسنة، بل هي بالأساس تدريب على قوة الإرادة والالتزام العقلي بالمبادئ، حتى لو كانت مخالفة للطبيعة والمشاعر.
ستة عشر: دراسة للفصل الثالث عشر: من التنوير إلى التربية على التنوير
يحلل هذا الفصل مقالة كانط التأسيسيّة "ما هو التنوير؟"، والتي تُعد من أهم نصوص الحداثة. يعرّف كانط التنوير بأنه "خروج الإنسان من حالة القصور التي هو مسؤول عنها"، أي عجزه عن استخدام عقله دون إرشاد من سلطة خارجيّة. شعار التنوير هو الكلمة اللاتينيّة "Sapere Aude!" والتي تعني "تجرأ على المعرفة!" أو "امتلك الشجاعة لاستخدام عقلك الخاص!". ويرى كانط أنّ التربية هي الأداة الرئيسيّة لتحقيق هذا التنوير على المستويين الفردي والاجتماعي.
هنا، تتجاوز التربية عند كانط حدود تكوين الفرد لتصبح مشروعاً سياسياً تحرريًا. الهدف النهائي ليس فقط خلق فرد أخلاقي، بل خلق مجتمع من المواطنين المستقلين الذين يفكرون بأنفسهم، ولا يخضعون لوصاية السلطات التقليديّة (سواء كانت دينيّة أو سياسيّة). هذا يربط فكر كانط التربوي مباشرة بالتقاليد الليبراليّة والديمقراطيّة، ويجعل من التربية أداة للتحرر السياسي والفكري، وليس مجرد أداة للتكيّف الاجتماعي.
سبعة عشر: دراسة للفصل الرابع عشر: "السلام الدائم" كمنهج للتربيّة الأخلاقيّة
يستعرض هذا الفصل مشروع كانط الطموح للسلام العالمي، كما طرحه في كتابه "نحو السلام الدائم". يقوم هذا المشروع على فكرة تأسيس "اتحاد فيدرالي لجمهوريات حرة" تتعهد بحل نزاعاتها بالطرق السلميّة. يرى كانط أنّ السلام ليس مجرد حالة طبيعيّة (غياب للحرب)، بل هو واجب أخلاقي يجب على البشريّة أن تسعى لبنائه بشكل واعٍ ومنظم.
يرفع هذا الفصل غاية التربية إلى أقصى مدى ممكن، ليكشف عن الأفق الكوني للتربيّة الكانطيّة. فالهدف النهائي للتربيّة الأخلاقيّة ليس فقط خلق فرد صالح أو مواطن صالح في دولة معينة، بل هو تكوين "مواطن عالمي" (cosmopolitan) يرى نفسه جزءاً من الإنسانيّة جمعاء، ويعمل من أجل بناء نظام عالمي يسوده السلام والعدل. هذا يعطي للتربيّة بعداً كونياً وإنسانياً يتجاوز كل الحدود القوميّة والثقافيّة، ويمثل ذروة المثاليّة الأخلاقيّة في فكر كانط.
ثمانيّة عشر: دراسة للفصل الخامس عشر: العنصريّة العرقيّة في الفلسفة الكانطيّة
يكشف هذا الفصل، الذي أفرده الدكتور وطفة بجرأة نقديّة، عن الجانب المظلم والمهمل في فكر كانط. يستعرض الفصل بشكل مفصل آراء كانط العنصريّة الصريحة، وتصنيفه الهرمي للأعراق البشريّة، حيث يضع العرق الأبيض الأوروبي في قمّة الهرم من حيث القدرات العقليّة والأخلاقيّة، بينما يضع الأعراق الأخرى (الأصفر، الأسود، والأحمر) في مراتب أدنى، وينسب إليها صفات سلبيّة مثل الكسل والغباء والخمول.
هذا التناقض يمثل التحدي الأكبر والمدمر لفلسفة كانط. كيف يمكن لفيلسوف "الواجب الكوني" و"الكرامة الإنسانيّة " أن يحمل مثل هذه الآراء العنصريّة البغيضة؟ هذا التناقض ليس مجرد هفوة شخصيّة، بل يضرب في صميم ادعاء الكونيّة في فلسفته. فإذا كان "الإنسان" الذي يجب أن يُعامل كغايّة في ذاته هو في الحقيقة الرجل الأوروبي الأبيض فقط، فإن النظام الأخلاقي الكانطي برمته ينهار ويفقد مصداقيته. يمثل هذا الفصل "نقد النقد"، حيث يستخدم الدكتور وطفة الأدوات النقديّة التي علمنا إياها كانط لكشف حدود "تنوير" كانط نفسه، وإظهار أنه لم يستطع التحرر بالكامل من الأحكام المسبقة لعصره.
تسعة عشر: دراسة للفصل السادس عشر: تأثير كانط في الفكر الحديث
يتتبع هذا الفصل التأثير الهائل الذي تركته فلسفة كانط على كل التيارات الفكريّة التي جاءت بعده. لقد شكّلت فلسفته نقطة انطلاق للمثاليّة الألمانيّة (هيغل، فيشته، شيلنغ)، وأثرت بعمق في فلسفات شوبنهاور ونيتشه، وصولاً إلى الظاهراتيّة (الفينومينولوجيا)، والوجوديّة، والبنيويّة، وما بعد الحداثة.
الفكرة المحوريّة هنا ليست مجرد سرد تاريخي، بل هي التأكيد على أنّ كانط يمثل نقطة تحوّل لا يمكن تجاوزها في تاريخ الفكر. لقد أعاد صياغة الأسئلة الأساسيّة للفلسفة حول المعرفة والأخلاق والواقع. بعد كانط، لم يعد بإمكان أي فيلسوف أن يفكر في هذه القضايا بالطريقة نفسها التي كانت سائدة قبله؛ بل أصبح مجبراً على تحديد موقفه من الإرث الكانطي، سواء بالقبول أو النقد أو التعديل. إذن، تأثير كانط ليس مجرد تأثير واحد من بين تأثيرات أخرى، بل هو تأثير تأسيسي أعاد تشكيل الحقل الفلسفي بأكمله.
عشرون: دراسة للفصل السابع عشر: نقد التربية الكانطيّة
يجمع هذا الفصل الخيوط النقديّة التي ظهرت بشكل متفرق في فصول الكتاب، ليقدم تقييماً نقدياً شاملاً للمشروع التربوي الكانطي. يلخص الدكتور وطفة الانتقادات الرئيسة: المثاليّة المفرطة التي تجعل أهدافه طوباويّة، والتزمت الأخلاقي الذي يتجاهل العواطف الإنسانيّة، والتناقض مع معطيات التربية الحديثة وعلم نفس الطفل، وإشكاليّة التوازن غير المكتمل بين عمقه الفلسفي وسطحيّة بعض أفكاره التربويّة العمليّة .
يمثل هذا الفصل خلاصة الرؤيّة النقديّة للمؤلف. والاستنتاج الضمني الذي يمكن الخروج به هو أنّ قيمة التربية الكانطيّة اليوم لا تكمن في إمكانيّة تطبيق وصفاتها بشكل حرفي (وهو أمر قد يكون مستحيلاً وضارًا)، بل في استلهام "روحها" النقديّة والتنويريّة. ما يجب أن نأخذه من كانط هو إصراره على العقلانيّة، والحريّة كاستقلال ذاتي، والواجب كالتزام أخلاقي، والكونيّة كأفق إنساني. ومهمتنا هي إعادة صياغة هذه المبادئ الساميّة في قوالب تربويّة معاصرة تتجاوز تزمته وتناقضاته وعنصريته التاريخيّة .
واحد وعشرون: الخاتمة
في ختام هذه الدراسة التحليليّة، يتضح أنّ كتاب الدكتور علي وطفة يقدم مساهمة فكريّة غنيّة ومعقدة. فهو لا يكتفي بعرض الفكر التربوي الكانطي، بل يخوض في حوار نقدي معه، كاشفاً عن جوانب قوته وضعفه، ومستلهماً من روحه التنويريّة ما يمكن أن يضيء دروب الإصلاح التربوي في العالم العربي. لقد تتبعنا كيف بنى المؤلف تحليله عبر سبعة عشر فصلًا، منتقلاً من سيرة كانط الشخصيّة إلى أعماق نظامه الفلسفي، ثم إلى تطبيقاته التربويّة، وصولاً إلى نقده وتأثيره التاريخي.
وفي إجابة عن السؤال الذي يطرحه الدكتور وطفة في نهاية كتابه: "ما الذي يبقى من كانط؟"، يمكن القول إنّ ما يبقى ليس تفاصيل نظامه التربوي، بل مشروعه النقدي ككل. ما يبقى هو فكرة التنوير كواجب مستمر على كل فرد ومجتمع، وشعار "تجرأ على المعرفة" كصرخة دائمة ضد الوصاية والتقليد الأعمى. وما يبقى هو التأسيس الأخلاقي القائم على فكرة الكرامة الإنسانيّة المطلقة، التي تجعل من كل إنسان غايّة في ذاته، على الرغم من السقوط المأساوي لكانط نفسه في فخ العنصريّة، والذي يجب أن يظل درساً لنا في ضرورة النقد الذاتي المستمر حتى لأعظم العقول.
اثنان وعشرون: رؤيّة نقديّة عن أهميّة الكتاب وتأثير موضوعاته في الواقع المعيش
يكتسب كتاب الدكتور علي وطفة أهميّة خاصة في سياقه العربي المعاصر. فهو عمل أكاديمي رصين يثري المكتبة العربيّة بدراسة معمّقة لأحد أهم فلاسفة الحداثة، ويتميز بمنهجه النقدي المزدوج: فهو ينقد الواقع العربي من خلال منظور كانطي، وفي الوقت نفسه، لا يتردد في نقد كانط نفسه وكشف تناقضاته.
من حيث التأثير في الواقع المعيش، يمكن القول إنّ دعوة كانط إلى استخدام العقل والنقد، والتمسك بالواجب الأخلاقي الكوني، واحترام الكرامة الإنسانيّة، تمثل علاجاً فكرياً فعّالاً لكثير من الأمراض التي تعاني منها مجتمعاتنا، مثل الفساد المستشري، والتعصب الطائفي، والتفكير الخرافي، والاستبداد السياسي. إنّ استلهام روح التنوير الكانطي يمكن أن يساهم في بناء ثقافة المواطنة والمسؤوليّة والحريّة .
ومع ذلك، يواجه تطبيق الفكر الكانطي في الواقع العربي تحديات كبيرة. فهل يمكن لفلسفة فردانيّة صارمة، نشأت في سياق بروتستانتي أوروبي، أن تعالج مشاكل مجتمعات ذات بنى تقليديّة وجماعيّة؟ وكيف يمكن التوفيق بين كونيّة كانط المطلقة وبين ضرورة احترام الخصوصيات الثقافيّة والدينيّة؟ والأهم من ذلك، كيف يمكننا أن ندعو إلى قيمه الإنسانيّة الساميّة بينما نتجاهل إرثه العنصري المقيت؟
في النهايّة، إنّ القيمة الحقيقيّة لكتاب الدكتور وطفة لا تكمن في تقديمه حلولاً جاهزة، بل في تحفيزه للتفكير النقدي وطرحه للأسئلة الصعبة. إنه ليس مجرد كتاب عن كانط، بل هو دعوة للقارئ العربي للاشتباك مع أحد أعظم عقول الحداثة، ليس بهدف تقليده أو استنساخ تجربته، بل لاستلهام روحه النقديّة من أجل بناء مشروع تنويري وتربوي أصيل، ينبع من واقعنا ويجيب عن تحدياتنا الخاصة.
***
أ. د. إحسان علي الحيدري - أستاذ فلسفة الدين والأخلاق
كلية الآداب / جامعة بغداد، رئيس تحرير مجلة (أخلاق) الصادرة عن مركز تجديد للفكر والثقافة . ومدير تحرير مجلة "علم المبدأ" الصادرة عن الأكاديمية الدولية للتصوف والعرفان.







