قراءة في كتاب
عبد السلام فاروق: الهوية والمواطنة
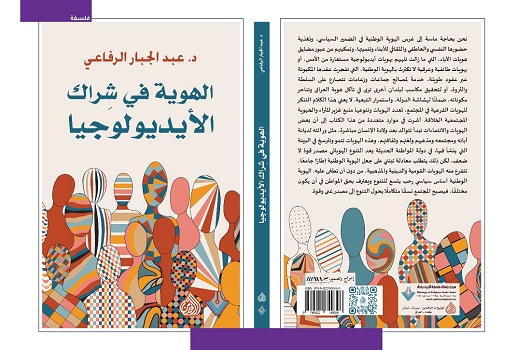
لا يفتأ الجدل حول الهوية يشتد في عالمنا العربي، حتى ليخيل إلينا أننا أمام معضلة وجودية تهدد كياناتنا الوطنية الناشئة. وفي كتابه "الهوية في شِراك الأيديولوجيا"، الصادر مؤخرا، يقدم الدكتور عبد الجبار الرفاعي رؤية نقدية عميقة لهذه الإشكالية، منطلقاً من واقع العراق بوصفه نموذجاً لحالة مجتمعية زاخرة بالتنوع والتحديات.
يبدأ الرفاعي من مسلمة أساسية: الانتماء إلى العراق شرف وطني. لكنه لا يقتصر على هذه العبارة الإنشائية، إنما يغوص في أعماق التاريخ ليستخرج جذور هذه الهوية المتشابكة. إنه يذكرنا بأن أرض الرافدين لم تكن فقط مهداً للحضارات السومرية والبابلية والآشورية، بل كانت أيضاً منارة للحضارة الإسلامية في عصورها الزاهية. وهذا التراكم الحضاري ليس تراثاً من الماضي فحسب، إنه كائن حي ينبض في حاضرنا.
وهنا تكمن عبقرية الرفاعي في تجاوزه للرؤية الأحادية للهوية. فهو لا ينكر الهويات الفرعية، لكنه يراها منبعاً للثراء والحيوية المجتمعية. فالهويات المتعددة – الدينية والمذهبية واللغوية - تبدأ بالتكون مع ولادة الإنسان، وتنمو في البيئة التي ينشأ فيها. لكن الخطر يبدأ عندما تتحول هذه الهويات من عناصر إثراء إلى أدوات صراع.
معادلة المواطنة
يطرح الرفاعي معادلة دقيقة: الهوية الوطنية يجب أن تكون الإطار الجامع، تتفرع منه الهويات القومية والدينية والمذهبية، دون أن تطغى عليه. وهنا نجد أنفسنا أمام سؤال محوري: كيف نوفق بين الانتماءات المتعددة دون أن نفقد الإحساس بالانتماء الوطني الجامع؟
إن انقلاب هذه المعادلة - بتقديم المذهب أو الديانة أو القومية على الوطن - هو الذي يجهض الوحدة المجتمعية، ويمنع إقامة الدولة الحديثة. فالدولة الوطنية هي فضاء سياسي وقانوني وأخلاقي يتسع للتنوع ويعترف بحق المواطن في أن يكون مختلفاً.
المواطنة بين الحقوق والمسئوليات
يذهب الرفاعي إلى جوهر المشكلة حين يؤكد أن معنى المواطنة لا يتحقق إلا بتحقيق معنى المواطن. والمواطن الحقيقي هو الذي يتمتع بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها غيره، ويطالب بالمسئوليات ذاتها. أما عندما تفرض عليه المسئوليات دون أن يمنح الحقوق الكاملة، لأن انتماءه الديني أو المذهبي أو القومي يعتبر "أدنى" من غيره، فإن معنى المواطنة ينهار.
هنا نجد أنفسنا أمام مفارقة خطيرة: كيف يمكن بناء دولة المواطنة في مجتمعات تتنازعها هويات متصارعة؟ الجواب يكمن في أن الهوية الوطنية يجب أن تكون هي النصاب، لا الهوية العرقية أو المذهبية أو الدينية. فحين تكون الهوية الوطنية هي الأساس، تصبح ضامناً للعيش المشترك وشرطاً للتعايش السلمي.
يقدم الرفاعي تحليلاً دقيقاً لواقع العراق عندما يحذر من تحول الوطن إلى "غنيمة يتقاسمها المنتصرون". هذه العبارة تختزل مأساة العديد من المجتمعات العربية، حيث تتحول الدولة إلى غنيمة للجماعة الغالبة، ويستبعد منها من لا يشاركها انتماءها.
إن تحويل الوطن من غنيمة إلى ملك مشترك يتطلب ثورة في التفكير والوعي. فالدولة الحديثة ليست ملكاً للغالبية، هي بيت للجميع. والمواطنة لا تعني الانصهار في بوتقة واحدة، بل الاعتراف بالتنوع واحترام الاختلاف.
إن تحديات بناء الهوية الوطنية في مجتمعاتنا العربية لا تحل بالإنكار أو بالقمع، بل بالاعتراف الواعي بالتنوع، وبناء مؤسسات تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين. كما يقول الرفاعي، فتنوع الهويات مصدر قوة لا ضعف، لكن هذه القوة لا تتحقق إلا في ظل دولة المواطنة التي تحترم حقوق الإنسان وتضمن المساواة بين جميع أبنائها.
الهوية الوطنية كائن حي يتطور ويتجدد. وهي ليست نقيضاً للهويات الأخرى، إنها الإطار الذي يحتضنها جميعاً. وبناء هذه الهوية يتطلب جهداً فكرياً وأخلاقياً وسياسياً، يبدأ بالاعتراف بإنسانيتنا المشتركة، وينتهي ببناء وطن للجميع. فهل نستطيع أن نتحول من ثقافة الغنيمة إلى ثقافة الوطن المشترك؟ هذا هو التحدي الحقيقي الذي تواجهه مجتمعاتنا العربية في راهنها ومستقبلها.
الأيديولوجيا وسياسات الهيمنة
تمثل الهوية في عالمنا العربي حقل ألغام، لا تكمن خطورته فقط في تناقضاتها الداخلية، إنما في كيفية توظيفها سياسيًا وأيديولوجيًا. فالهوية لم تعد مجرد انتماء طبيعي، فقد باتت أداة في صراع القوى وتنافس النخب.
في هذا السياق، يبرز ما يمكن تسميته "صناعة الهوية" - وهي عملية تحويل الانتماءات العفوية إلى مشاريع سياسية. فالنخب الحاكمة تارة، والمعارضة تارة أخرى، تستخدم ورقة الهوية كأداة للاستقطاب والحشد. وهنا تتحول الهوية من كونها تعبيرًا عن الذات إلى أداة للهيمنة.
المواطنة المشروطة
أحد أخطر إشكالياتنا العربية هي تحول المواطنة من حق مكفول إلى امتياز مشروط. ففي العديد من مجتمعاتنا، تمنح المواطنة الكاملة فقط لمن ينتمون للجماعة المسيطرة - سواء كانت عرقية أو مذهبية أو قبلية. أما الآخرون، فيتحولون إلى مواطنين من الدرجة الثانية، يحملون كل الواجبات ولا يتمتعون بكل الحقوق.
هذه "المواطنة المشروطة" تخلق نظامًا طبقياً سياسياً، حيث يتحدد مركز الفرد في الدولة ليس بناء على كفاءته أو إنسانيته، بل بناء على انتمائه العرقي . وهذا بدوره يخلق دوامة من الاستياء والاحتقان، تنتظر فقط شرارة صغيرة لتنفجر.
الدولة الوطنية بين الماضي والمستقبل
تواجه الدولة الوطنية العربية تحدياً وجودياً من اتجاهين: من فوقها بواسطة العولمة والتدخلات الخارجية، ومن تحتها بواسطة الهويات ما دون الوطنية. وفي مواجهة هذه التحديات، تظهر استجابات مختلفة:
- نموذج القمع: محاولة كبت الهويات الفرعية بالقوة
- نموذج الاستيعاب: محاولة إذابة الهويات الفرعية في بوتقة واحدة
- نموذج التعددية: الاعتراف بالتنوع في إطار المواطنة المتساوية
والتجربة التاريخية تثبت أن النموذجين الأولين طريق للفشل، بينما النموذج الثالث - رغم صعوبته – هو الوحيد القادر على بناء سلام اجتماعي دائم.
الثنائية المنسية
قلما يناقش العلاقة بين إشكالية الهوية ومشاريع التنمية. فالمجتمعات المنقسمة عرقيا لا تنجح في بناء اقتصاد قوي. والسبب بسيط: الطاقة التي يجب أن توجه للبناء والإنتاج، تستهلك في الصراع وتنافس الهويات.
كما أن غياب المساواة يخلق بيئة طاردة للكفاءات، ومعيقة للإبداع، ومضيعة للطاقات. فكيف يمكن لمجتمع أن ينهض، وهو يستثني أجزاء مهمة من طاقاته البشرية فقط بسبب انتماءاتها؟
من منطق الغنيمة إلى منطق الشراكة
إن تحول الوطن من "غنيمة" للجماعة الغالبة إلى "شركة" بين جميع مواطنيه، هو التحدي الأكبر الذي نواجهه. وهذا التحول يتطلب ثورة في الوعي، وإصلاحاً في المؤسسات، وتجديداً في الخطاب.
فالهوية هي خيار نصنعه يومياً. وبناء وطن للجميع ليس حلماً، إنه ضرورة وجودية لمستقبل أفضل. والسؤال الذي يظل معلقاً: هل نملك الشجاعة الكافية لاختيار المستقبل على الماضي، والوطن على القبيلة، والإنسان على الانتماء الضيق؟
***
د. عبد السلام فاروق







