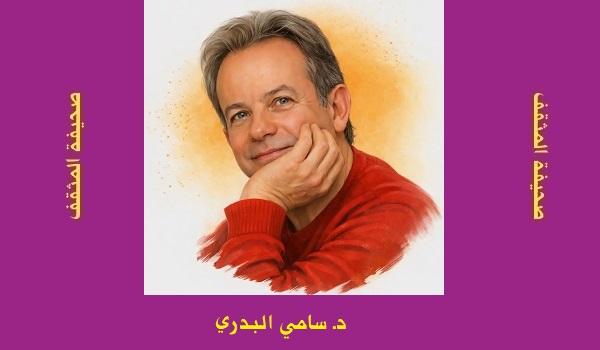قراءات نقدية
كريم الوائلي: البنية العميقة لقصيدة المدح عند البحتري

الفرار من الطلل إلى القصر
ليست هنالك حداثة واحدة، وإنما هناك حداثات بحسب اختلاف المكان والزمان والإنسان، فحداثة باريس غير حداثة موسكو، وهناك حداثة معاصرة نعيشها، وهناك حداثات في أزمان سابقة، وفي القرنين الثاني والثالث الهجريين كانت هناك حداثة، وشعراء محدثون ونقاد كذلك، فكر ومؤسسات اجتماعية، ويعارضها اللاحداثيون.. سلطة وطبقات اجتماعية وفكر وشعراء.
ونلتقي بمرجعيتين معرفيتين في القرون الثلاثة الأولى؛ المرجعية المعرفية العقلية والمرجعية المعرفية النقلية، ولكل مرجعية أدواتها وأنصارها، ولم يكن البحتري من أهل الحداثة، ولكنه من خصومها، وجاء مع الزمن المعارض للحداثة مع مجيء جعفر المتوكل " الخليفة العباسي " الذي أحدث تغيرًا على المستوى الفكري بإقصاء لاعتزال وأهل العقل والمنطق، وإحلال أهل الأثر محلهم، وعلى المستوى الفني تبنى مصطلح " الطبع " الذي يعبر عن اللاحداثة ! في معارضة لمصطلح " الصنعة " المعبر عن الحداثة.
إن المتوكل ـــ في تصوري ـــ لا يزال يحكم العالم الإسلامي وهو في قبره؛ إذ لا تزال الرؤى والأفكار والمناهج التي أرساها سائدة في المجتمع حتى الآن!.
ولقد شغلتني حقيقة بنية القصيدة في كلا الاتجاهين، وعلى الرغم من انحيازي للحداثة في التراث وانحيازي لمنجزاتها كان لا بد لي أن أتأمل منهجيًّا، فالبنية العميقة التي تحكم بنية القصيدة عند اللاحداثيين، وهي عادة تتكون من وحدتين، أو ثلاث وحدات، يكون الغزل أو التشبيب أولها، ثم يكون المدح الهدف الذي تسعى إليه.
ولم أكن مقتنعًا بالتفسيرات الكثيرة التي قدمها النقاد، قدامى كابن قتيبة، ومعاصرون غربيون، مثل: فالتر براونه ومعاصرون عرب، مثل: عز الدين إسماعيل ـــ مثلا ــــ وكان لابد من الكشف عن البنية العميقة.
ويتبدى إمكان دراسة قصائد البحتري في ضوء محورين، أحدهما يحاول الكشف عن التجليات المتعددة التي تشتمل عليها قصيدة المدح، ويحاول الآخر إرجاع تلك التجليات المتعددة إلى بنية عميقة تحكمها، ولما كانت الأغلبية الساحقة من قصائد المدح عند البحتري تنقسم إلى مقطعين: مقطع المحبوبة، ومقطع الممدوح، فإن البحث سيركز على هذا المنحى بشكل عام، والتطبيق على بعض نماذجه.
إن البنية العميقة التي تحكم تجليات قصيدة المدح تتمثل في التعارض بين السلب والإيجاب بين مقطعي المحبوبة والممدوح، ويمثل هذا التعارض إطارًا عامًّا تقع تحت شموليته أنماط متعددة من تجليات متعارضة عديدة
إن مقطع المحبوبة يمثل الموجة السالبة في القصيدة، في حين يمثل مقطع الممدوح الموجة الموجبة، فإذا كانت المحبوبة تبعث على السقم والهزال والجدب، وأنها حسناء سيئة الصنيع، فإن الخليفة يتميز بحسن المحيا من ناحية، وحسن الفعل من ناحية أخرى، ولذلك جعل الشمس والقمر دالَيْن على جماله وبهائه،ويرتبط هذا في أغلب الأحوال بملامح دينية ترجع إلى الرسول صلى الله عليه و آله وسلم؛ لأن الممدوح ـــ الخليفة ـــ هو امتداد للنبي، كما أن أفعاله تحيي الإسلام، وتدافع عن الرعية.
وإن هنا تعارضًا من نوع آخر بين المحبوبة والممدوح؛ إذ تمثل المحبوبة مفردًا مؤنثًا تحدث عنه الشاعر بصيغة المذكر، وأن فعلها لا يتجاوزها ولا يتجاوز الشاعر، أمَا الممدوح فإنه يمثل المفرد المذكر الخارق، الذي يتميز بخصائص تقترب من الملامح القدسية بفعل الصفات الدينية التي خلعها عليه الشاعر وتقابله الجماعة، ويتجلى في فعل الممدوح تعارض من نوع آخر؛ حيث يكون الممدوح سببًا في بعث الخصب في الحياة والحيوية في الجماعة المناصرة له، والموت الدمار في الجماعة المعارضة له، فعلى مستوى الجماعة المناصرة له.
دلالات التعارض المكاني والزماني:
المحبوبة:
امرأة: أنوثة؛ ضعف ولين.
امرأة: ظاهرها جميل، وباطنها قبيح.
امرأة: محدودة الخصائص، لا علاقة لها بالمطلق.
امرأة: تتسم بالعقم.
امرأة: تبعث السقم والهزال في الشاعر.
امرأة: لا تحقق التواصل.
امرأة: عالمها تخيلي متوهم.
الممدوح " الخليفة غالبًا "
رجل: ذكورة؛ قوة وخصب.
رجل: ظاهره حسن، وباطنه حسن.
رجل: جزء من حركة المطلق، هو امتداد للنبي، ومن ثم مرتبط بالمطلق.
رجل: ولود.
رجل: يبعث الخصب والنماء في الشاعر.
عالم الممدوح: حقيقي واقعي.
مكان المحبوبة وزمانها:
المكان: مكان مجدب لا حياة فيه « طلل »
الزمن: زمن ماض وحركته بطيئة.
الحالة: التلاشي والهشاشة.
المستوى الحضاري: البداوة.
مكان الممدوح وزمانه:
المكان: مكان خصب، قصور وحدائق ومياه.
الزمن: زمن الحاضر والمستقبل، وحركته متسارعة.
الحالة: الخصب والنماء.
المستوى الحضاري: المدينة.
ويسعى البحتري إلى التنقل والتحرك من الطلل إلى القصر، والحركة هذه تعني نفيًا للمكان وخصوصيته الثبوتية، ورمزا لانعتاق الإنسان وتحرره، ولذلك فإنه يفر من الأولى إلى الثانية، فلا يعطي المقطع الأول مساحة أكبر، ثم ينتقل إلى المقطع الثاني الذي يتوقف عنده طويلًا، مساحة وحضورا، بمعنى: إلغاء للطلل، وتثبيت للقصر، وانحراف عن البداوة وانحياز إلى المدنية.
***
د. كريم الوائلي