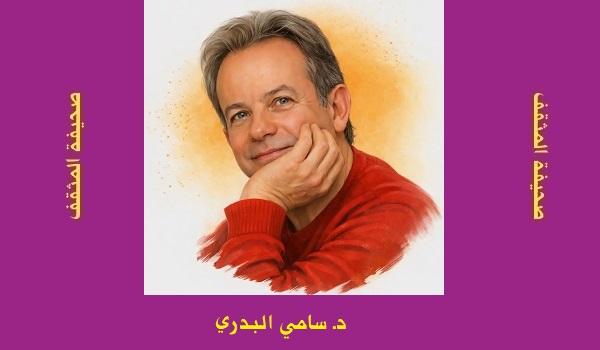قراءات نقدية
سعد غلام: وقفة تفكيكية - ثقافية لقصيدة "أنثى الرمّان في رؤيا آلهة الطوفان"

للشاعرة د. بشرى البستاني
العتبة الكبرى: (لعبة العنوان)
العنوان هنا ليس مجرد عتبة شكلية في مثل هذه القصائد، بل بنية ميتا-نصية تحمل مفاتيح القراءة كما يتفق كبار النقاد والكتاب في العالم.
أنثى الرمّان:
تتجاوز الرمانة رمزيتها التقليدية لتصير جسدًا مجروحًا،وخصبًا حيًّا في آن واحد.كائن هش يمكن فرطه ليتوزع على امتداد المكان ويكون من المستحيل اعادته إلى حاله السابق. إن حضورها كأنثى يضع القارئ مباشرة أمام ثنائية الجسد/المعنى. وكما يرى عز الدين إسماعيل": الرمز الشعري حين ينفتح على طاقته الأسطورية، يغدو قادرًا على تمثيل نقيضين في وقت واحد: الموت والولادة، الفناء والبقاء1.
آلهة الطوفان:
استدعاء الطوفان بصفته فعلاً كونيًّا غامرًا يربط النص بموروث أسطوري متشعّب (السومري، التوراتي، القرآني...). لكن جمع آلهة يُفكك السلطة الأحادية. صلاح فضل" يوضح أن "التفكيك يشتغل على تفتيت الأحادية وإظهار التناقض الكامن في البنى، بحيث يُردّ المطلق إلى نسبي، والمفرد إلى تعدّد2.
التوتر التفكيكي: مقابلة أنثى الرمّان/ آلهة الطوفان
تعلن مفارقة: الهشاشة أمام المتانة، الجسد أمام الروح الأسطورة أمام الواقع. غير أنّ النص يخلخل هذه الثنائية؛ فالأنثى، رغم جراحها، قادرة على تحويل الخيانة إلى وعي، والخراب إلى ولادة جديدة والصمت إلى ضجيج والغياب إلى حضور والخيال الى حقيقة. رولان بارت "يذكّرنا أن "العنوان هو العلامة الأولى لانفتاح النص على تعددية الدلالات3.
الدلالة الثقافية: الجمع بين المحلي (الرمانة، دجلة) والكوني (الطوفان) يشي بوعي ما بعد استعماري / كونوليالي :
الهُوية العراقية الممزقة تصارع قوى الطمس الكونية عبر أحتلال غاشم طوفاني. وكما يرى إدوارد سعيد": "الهُوية ليست جوهرًا ثابتًا، بل بناء مقاوم يتجدد مع كل مواجهة للآخر المهيمن4.
أولًا/ ترجيعات التفكيك:
تفجير الثنائيات وتشظيتها فالمنهج التفكيكي يجد على هدم الثنائيات التقليدية وكشف التناقضات الداخلية *. في القصيدة لتنهار ثنائيات: الوجود/العدم، الذكر/الأنثى، الحرب/السلام. الأنثى/ المرأة و هنا ليست ضحية، بل كيان مشتعل بوعي ذاتي ("أنا مريم السر")، بينما يُصوَّر الذكر معتديًا لكنه ضعيف ("بلا ساعدين"). التشظي اللغوي يظهر في تحويل دجلة "من نهر إلى /خيمة، قنديل، جمرة، نخيل ثم /هاوية، ما يُفكك أي معنى ثابت للهوية أو المكان فتشيؤ النهر وبث الروح فيه لأنسنته ينقله من مجرى مائي الى كائن أسطوري ومن جسد ملموس إلى صورة حسية.
ثانيًا / قراءة ثقافية: التاريخ والهوية والاستعمار:
الرمزية العراقية:
دجلة سجلّ دم وهوية؛ زِنّار بغدادي وربيع الموصل تربطان النص بالتراث، ربطًا عضويًا أواصره الأيقونية لا مناص من تبين شخوصها القائم بينما "الطيار الأ.مريكي" يرمز للغزو والجبروت والمعتدي الطاغوتي.
الأسئلة الوجودية:
هل بقي للعرب شطٌّ؟ تُعبّر عن قلق الهوية الممزقة.الهوية التي جرى تهشيم مقوماتها وتشظيتها وضياع ملامحها بل تهديم أركان وجودها الكيانية والماهوية لتمسي وهمًا هيولي.. إدوارد سعيد" يرى أن "الخطاب الثقافي يصبح ساحة لاستعادة الذات حين يُمارَس ضد السرديات الاستعمارية4.
التناص الفني والفكري:
دمج ابن الفارض" وماتيس" ودريدا" يُظهر صراع الأصالة والحداثة، مع سخرية من الإقصاء الغربي (حوار مقطوع يكسره دريدا). كمال أبو ديب" يبين أن "التناص جدلٌ يُحوّل النصوص إلى فضاء صراع بين ثقافات متجاورة5.
الأنثى كمقاومة:
الرمانة/المرأة جرح وخصب، خيانة ووعي؛ الخيانة تمنحنا الوعي فالألم معرفة. والألم محاض والألم ولادة..
ثالثًا/ الانزياحات الجمالية والفلسفية:
الزمن ليس خطيًا بل دائري من العذاب:
لا زمنٌ يحتوي / عري الجوع. الكلمة تصير "شجرة الكينونة أو تُقتل بالاختلاف، والجسد الأنثوي يُختزل إلى جراح تُوشِّه الذاكرة، بينما الطبيعة مسرح عنف دائم: يقتلع شجر الحلم ويحول السكينة إلى فوبيا. بول ريكور "يقول: "الانزياح يمنح اللغة طاقتها على إعادة تشكيل الواقع في صور رمزية جديدة6.
رابعًا/ التناقض كاستراتيجية شعرية:
(الخلاص لا يخلص)
الخلاص يُسقط الوعود الدينية والسياسية.
الكلمة "شجرة" و"جثة" معًا، فهي إنشاء ودمار. خلق وفناء بلسم وداء..
"الخيانة تمنحنا الوعي" فالندوب هوية جديدة يحملها المجروح وجديًا بين حناياه أيقونة شخصية وبصيص نور يقود في العتمة للخلاص. ميخائيل باختين يرى أن "تعدد الأصوات في النص يكشف الصراع الداخلي الذي يتقاسمه الفرد والجماعة7.
خامسًا/ شعرية الانهيار والانبعاث:
النص ينتهي برمانة تنبت من حطام دجلة، تأكيدًا أن الفن وحده يخلّص الهوية: "حيث لا إخلاص إلا بالشعر". فالشعر قرآن الطارق درب الوجود متحديًا كائنات الظلام بآيات الجمال وبكائنات اللغة الفردية. أدونيس يؤكد: "الشعر هو مقاومة الموت بخلق زمن آخر للكينونة8 القيامية الجديدة بعد بعث عنقاوي من الرماد.
وقفة نقدية ثقافية:
سنقرأ القصيدة بوصفها وثيقة ثقافية تُنتج وتُعيد إنتاج قيم الهوية والصراع والتحدي الجندري المتأصل اجتماعيًا وثقافيًا.
أولًا / تمثيلات الهوية:
الأنثى-الوطن تجسد الهوية المجروحة؛ الطيار-الغازي يمثل الآخر المُدمّر. العلاقة بينهما ليست ثنائية بسيطة، بل شبكة قوى متداخلة معقدة.
ثانيًا / ديناميات القوة:
القصيدة تُعرّي العنف الاستعماري وتكشف قوى داخلية خائنة ("رسل تخون")، ما يُعقّد صورة الجلاد والضحية. الشاعر والسياف شهرزداد ومسرور..
ثالثًا / الأيديولوجيا والقيم:
تُفكك الوعود الدينية والسياسية، وتُعيد للشعر قدرة الخلق والمقاومة.فالشعر طريق الخلاص حيث لا هيمنة لسلطان عليه غير اللغة والخيال..
رابعًا / التاريخ والذاكرة:
دجلة و"زِنّار بغدادي" يستدعيان تاريخًا مكتوبًا بالدم، في حين تُطفئ الأسماء الغربية (ماتيس، كاندينسكي) وهج الحداثة الذي لم يمنع الدمار،وهو تضارب صارخ بوجه الهمجية التي تطلقها الحضارة، والأبق بوجه العبودية، والحرية بوجه النير.
خامسًا / الجندر والجسد:
الجسد الأنثوي مسرح حروب؛ الجراح وشوم تُثبت الذاكرة، و"عري الجوع" يُفضح سياسات الإفقار التي تمليها الهيمنات وتفضحها البشاعة لتقف بوجه سرديات التاريخ القاسية التي كتبها الزيف والذكورة والقيود.
سادسًا / الفضاء والمكان:
دجلة يتحول من خيمة إلى هاوية، والسؤال "هل بقي للعرب شطٌّ؟" يُعلن انكسار الجغرافيا قبل الانكسار البشري ذلك الذي حدث بفعل قوى الظلام. العرب هنا ليست هوية لشطّ ولا كناية عن علامة مميزة في هوية وطنية وحسب بل كيان يتعرض للتأكل والتأمر والخيانة، والشطّ هنا ليس شق في الأرض ولا مجرى مائي بل جرح تاريخي مستلب ومتنفس مكتوم..
مع الثقافة:
تأثير البعد الثقافي والفني:
تداخل المحلي والعالمي: إشارات "تشايكوفسكي" و"دريدا" إلى جانب "دجلة" و"الرمان" تفتح النص على حوار ثقافي عابر للحدود في طباق فكري وتزاحم الاطروحات والمقدمات.
تمازج الفنون:
الموسيقى والتشكيل تُستعاد كإيقاع بصري داخل اللغة يخرج الفونيم من سلمه الصوتي الى طيفه اللوني بتراسل يتناسل داخل النص.
التراث الفلسفي:
دريدا وباختين يُذكّران بأن المعنى انزياحي، بينما السهروردي وابن الفارض يُعيدان الروح إلى المكان وهو امتداد لصراع الزمان والمكان في وحدتهما الكرونتوبية Chronotope¹.
الأسطورة وسؤال الوجود: الطوفان وعشبة الخلود يُحوّلان الكارثة العراقية إلى مسألة كونية ليكون كلكامش وطنًا يبحث عن خلوده متحديًا الصعاب.
الشعر كجسر:
الكلمة تصير موطنًا أخيرًا يُجمّع بين الشرق والغرب دون إلغاء أحدهما الأخر وهو قنطرة الحاضر التي تربط الأمس بالغد.
العلاقة بين الرمز والأسطورة
الطوفان:
يُستدعى كحدث كوني يُعيد ترتيب العالم وبناءه بعد لملمة شظايا بعثرها القدر واخذ سيل التيار الكثير منها إلى حيث لا ضفاف، فيُصبح الدمار العراقي جزءًا من دورة أزلية من الكارثة والتجدد،تلك الصورة القدرية ترسم سردية وجود العراق التاريخي وقرون طويلة من تعاقب الغزاة عليه.
دجلة:
ينتقل من نهر إلى حضارة ثم إلى هاوية، فيُجسّد انهيار المكان الذي كان مصدر الحياة. النهر الشيء والكائن الرحيم والقاسي جالب الخير وموجد الدمار..
أنثى الرمان:
تحمل ثنائية الخصب والدم، فتكون تموزًا وعشتار معًا: تموت لتُعيد الحياة بعد رحلة في العالم الأخر والتعرض لأوجاع والخيبات بين شتاء العتمة وربيع النور.بين الأفراح والاتراح.
اللغة:
"كُن" و"شجرة الكينونة" تُعيد للكلمة طابعها الإلهي القرآني والإنجيلي، فالشعر يُنشئ عالمًا جديدًا من رماد القديم.
إحياء الأساطير في شعر ما بعد الحداثة:
نصوص ما بعد الحداثة لا تُعيد سرد الملحمة، بل تستخرج رموزها وتُغرقها في السياق المعاصر:
جلجامش يُطرح كإنسان يواجه حتمية الفناء، فتصبح رحلته مرآة للبحث عن معنى وسط الخراب.
موت إنكيدو" يُختصر في لحظة انكسار: فقدان الصديق يُفجّر السؤال الوجودي ويُطلق رحلة البحث عن الخلود وبلوغ الحكمة من الخلق والمصاعب ومحنة الوجود.
سيدوري ":صاحبة الحانة" تلوح من بعيد بنصيحة الواقعية: تقبّل حياتك واستمتع بالحاضر، فالخلود الحقيقي في اللحظة الحية وليس العيش بالماضي ولا القلق من الغد المعبأ بالغيب.
العشبة المسروقة غيابها يُعلن أن الخلود مستحيل وهو قدر الإنسان وعليه تقبله، وأن ما يبقى هو الأثر الذي نتركه لا تجاوزنا للموت عبر تناسلنا وما يخلفه من عاديات تبقى ماكثة تشير إلينا رغم ما سيحدث حتما من اندثار واندراس للوجود المادي.
خاتمة سيموثقافية
القصيدة، باستدعاء جلجامش وإنكيدو وسيدوري دون تسميتهم ولكن حضورهم السيمو ثقافي تشربته العلامات وحملته الدلالات، تُشغل الذاكرة الأسطورية كطبقة مضمرة ( وربما مسكوت عنها) تُفسّر الحاضر ليس من خارجه بل من داخله. أنثى الرمان هي العراق الجريح وما اعتراه إبان واعقاب الاحتلال، وهي أيضًا الإنسان الذي يُعيد اكتشاف محدوديته بعد كل طوفان هادر وقدري وحتمي. فلا خلود في العشبة طالما هناك غفوة وثمة أفعى تتربص، ولا نجاة من الطوفان مادم هناك نهر وفصول وغضب سماوي وأدران تلفظها ارتكابات الإنسان، لكنّ الشعر يبقى شطًّا" يُمكن للعرب أن يلتفّوا حوله ليعيدوا اختراع هويتهم، مرة تلو أخرى ويمكن أن يكون سرابًا مخادعًا يقود للضياع. الشعر هو روح الجمال والأمر الذي لا تصيبه عوامل القدر والتعرية.
***
د. سعد محمد مهدي غلام
.......................
المراجع
1. عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد الأدبي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992.
2. صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، القاهرة: دار الشروق، 1992.
3. رولان بارت، لذة النص، ترجمة: منذر عياشي، دمشق: وزارة الثقافة، 1996.
4. إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ترجمة: كمال أبو ديب، بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1997.
5. كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، بيروت: دار العلم للملايين، 1981.
6. بول ريكور، الاستعارة الحيّة، ترجمة: جورج زيناتي، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2006.
7. ميخائيل باختين، خطاب الرواية، ترجمة: محمد برادة، الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 1987.
8. أدونيس، الزمن الشعري، بيروت: دار العودة، 1981.
الهوامش
1. الكرونتوب (Chronotope): مصطلح باختيني يشير إلى وحدة الزمان/المكان في النصوص الأدبية، حيث يتقاطع الحدث مع الإطار الزمكاني ليُنتج دلالة مركّبة.
2. الاستعارة الحيّة: عند بول ريكور هي الاستعارة التي تحتفظ بطاقة إبداعية وتأويلية، بخلاف الاستعارة الميتة المستهلكة.
3. التناص: في رؤية كمال أبو ديب هو جدل وصراع بين النصوص، وليس مجرد حضور شكلي، يخلق فضاءً دلاليًّا جديدًا [5].
4. التفكيك (Deconstruction): مفهوم أسسه جاك دريدا، يهدف إلى تقويض الثنائيات الميتافيزيقية وكشف تناقضاتها الداخلية، ليُظهر أن المعنى غير مستقر، وأن النص فضاء مفتوح لاحتمالات متعددة.
5. المهيمنات (Hegemony): مفهوم عند أنطونيو غرامشي، يشير إلى أشكال السيطرة التي تمارسها الطبقة المهيمنة عبر الثقافة والمعرفة، وليس فقط عبر العنف المباشر. ميشيل فوكو أعاد صياغة الفكرة عبر مفهوم "خطابات السلطة"، مبينًا أن المعرفة نفسها أداة للهيمنة والانضباط الاجتماعي.
6. النقد الثقافي: مقاربة حديثة في الدراسات الأدبية، ترى النصوص بوصفها خطابات أيديولوجية تُنتج وتعيد إنتاج قيم السلطة والمجتمع. أسسه منظّرون مثل ريموند ويليامز، ستيوارت هول، وفينسنت ليتش، وامتد في السياق العربي مع دراسات عبد الله الغذامي وآخرين.
7. التفكيك والنقد الثقافي: يلتقيان في كشف البنى المضمرة للخطاب، غير أن التفكيك (دريدا) يركز على اللغة وانفلات الدلالة، بينما النقد الثقافي يركز على تفاعل النصوص مع أنساق السلطة والهوية والمجتمع.