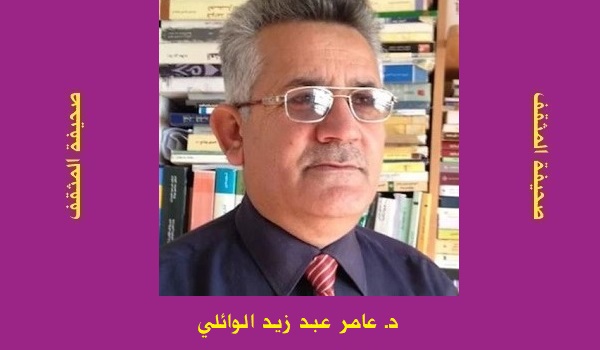قراءات نقدية
عماد خالد رحمة: قراءة نقدية تحليلية لنص الشاعر خلدون رحمة

بعنوان: "هناك.. جنوب الياسمين".. قراءة نقدية تحليلية عميقة تعتمد على المنهج الهيرمينوطيقي التأويلي والأسلوبي والرمزي والسيميائي
يُعدّ النص الذي نحن بصدد دراسته للشاعر والناثر خلدون رحمة نموذجاً بالغ الكثافة والتعقيد في آنٍ واحد؛ نصٌّ تتقاطع فيه الأزمنة والرموز، وتتداخل فيه الأبعاد الوجودية مع الجمالية، فيتجاوز حدود الشعر إلى فضاءٍ تأويليّ رحب، يجعل القارئ شريكاً في إنتاج المعنى لا مجرد متلقٍ له. إنّه نصّ يتّخذ من جنوب الياسمين — بوصفه استعارةً عن الجرح الجمعي والهوية الممزقة — فضاءً للتوتر بين الحرب والحب، بين الموت والحياة، وبين الخراب والرغبة في الخلاص.
تتجلّى في هذا العمل بنية هيرمينوطيقية مفتوحة تستدعي القراءة التأويلية العميقة، حيث تتشابك العلامات وتُعيد اللغة بناء العالم من رماده. فالقصيدة ليست مجرّد سردٍ للمأساة، بل هي مجازٌ للوعي الإنساني حين يُمتحن بأقصى درجات القسوة. ولعلّ ما يميّز النص هو توازي خطّين أساسيين في بنائه: خطّ الأسى الوجودي الممتد من “نكبة” الماضي إلى حاضرٍ متجدّد بالنكبات، وخطّ العشق الذي يتعالى على الحرب ليمنح الذات معنى البقاء.
من هنا، تأتي هذه الدراسة لتغوص في الطبقات العميقة للنص، معتمدةً على المنهج الهيرمينوطيقي التأويلي في تفكيك رموزه وانفتاح معانيه، وعلى المنهج الأسلوبي في تحليل لغته وإيقاعه، وعلى المنهج الرمزي والسيميائي في قراءة إشاراته ودلالاته البصرية والوجدانية، بالإضافة إلى البعد الجمالي والوطني والديني الذي ينسج خلفية التجربة الشعرية. كما تُعنى الدراسة بالكشف عن البنية النفسية الكامنة وراء الصورة، وعن توتّر الذات في مواجهة الحرب والحب، الحلم والفقد، الروح والجسد.
بهذا المنظور، يسعى هذا البحث إلى كشف ما تحت الجلد الشعري من نبضٍ وتوتّرٍ ورمز، وإلى إعادة بناء المعنى بوصفه رحلة تأويلٍ مستمرة بين الذات والوجود، بين الكلمة والكينونة.
النص المعنون: " هناك..جنوب الياسمين"، يحمل كثافة شعرية عالية، وتوتراً دلالياً غنياً بالتعدد القرائي، ما يجعله مناسباً تماماً للغوص في ثناياه.
لذا جاءت هذه الدراسة النقدية موسعة ومنهجية مرتكزة على هذه المحاور:
أولًا: المدخل الهيرمينوطيقي – التأويل وانفتاح المعنى:
النص ينهض على بنية مفتوحة تُتيح تعدد التأويلات وتُبقي القارئ في حالة تأمل ودهشة. فـ “هناك.. جنوب الياسمين” ليست مجرد إشارة مكانية، بل مفتاح تأويلي يفتح الباب على حمولة رمزية ووطنية مكثفة؛ إذ يحيل هذا الجنوب إلى فلسطين/بلاد الشام، وإلى ذاكرة الجمال والخراب معاً.
-الجملة الأولى:
«داخل مثلّثٍ كُسِّرت أضلاعه بمطارق القادمين من الجحيم»
هي جملة مشبعة بالصور المأساوية؛ إذ يتحول المثلث — وهو رمز الاستقرار والتوازن — إلى بنية مكسورة بفعل الغزاة (القادمين من الجحيم)، وهي صورة تأويلية يمكن قراءتها كـ سرد شعري للتاريخ الفلسطيني: انكسار البيت الأول، الوطن، واليقين.
يشتغل الشاعر خلدون رحمة هنا على تأويل مزدوج: فهو لا يصف فقط مأساة خارجية، بل أيضاً انكسارًاً داخلياً في الذات التي تعيش صدمة التهجير والاقتلاع. إن “الهواﺀ” الذي “غصّ بفجيعة ماجنة” ليس عنصراً طبيعياً، بل كيان يشهد ويختنق. هذه الانزياحات اللغوية تخلق نصاً تأويلياً لا يخاطب العقل فحسب، بل الوجدان الجمعي.
ثانيًا: المنهج الأسلوبي – توتر الصورة وثراء الجملة الشعرية:
الأسلوب في هذا النص يقوم على إيقاع مزدوج:
١- إيقاع تفجيري: عبر التراكيب الصادمة (“مطارق القادمين من الجحيم”، “القذيفة أخطأت لحمه لكنها أصابت حلمه”).
٢- وإيقاع احتوائي حميمي: عبر لغة الحب والاحتضان (“زنّرته بغزالات روحها”، “غسلت بكوثرها الأمومي”).
هذا التضاد الأسلوبي يعكس بنية الازدواج في التجربة الإنسانية زمن الحرب: بين العنف المطلق والرغبة في الحياة، بين الخراب والعشق، بين صوت الانفجار وصوت الأنثى.
٣- اللغة مشحونة بـ صور مجازية معقدة، تنقل الإحساس بالاختناق والرجاء في آنٍ معاً، لتخلق شبكة أسلوبية محكمة تتناوب فيها القسوة والرهافة.
ثالثاً: القراءة الرمزية والسيميائية:
١- “جنوب الياسمين”: رمزٌ للهوية الفلسطينية والسورية (الياسمين الدمشقي)، لكن الجنوب هنا ليس جغرافيا فقط، بل منفى داخلي ومكان جريح.
٢- “المثلث”: إشارة سيميائية إلى المكان/الوطن/البيت، وانكساره دلالة على سقوط الحماية وتفتت البنية الجماعية.
٣- “القذيفة”: رمز للحرب/الدمار المادي والنفسي.
٤- “الحلم الممتد من عطش المنفى إلى بحر كنعان”: تمثيل شعري للرحلة الفلسطينية بين التيه والحنين والعودة المؤجلة.
٥- “المرأة/المخلّصة”: تظهر كرمز مزدوج:
أمومي/خلاصي: “زنّرته بغزالات روحها” – تحميه وتعيده إلى رحم الأمان.
عشقي/جسدي/ميتافيزيقي: “صفعته بعطر نهديها” – تعيد له الحياة عبر الجسد والرمز.
- السيميائية في النص لا تنحصر في الرمز الواحد، بل تعمل في سلسلة ترابطية تُحيل القارئ إلى معجم ثقافي وتاريخي وديني.
رابعاً: البنية النفسية – ما تحت الجلد الشعري:
النص ينطق من منطقة الجرح العميق، حيث يلتقي الخوف بالعشق، والقلق بالحنين، والموت بالحياة.
البطل يعاني انشطاراً داخلياً بين الواقع المدمّر والحلم المستحيل.
القذيفة التي “أخطأت لحمَه” لكنها “أصابت حلمه” تعبّر عن صدمة وجودية؛ فالأجساد قد تنجو، لكن الروح تصاب إصابة لا شفاء منها.
اللقاء مع الأنثى ليس لقاء جسدياً بل طقساً نفسياً للخلاص من وحشة الحرب، وخلق مساحة تطهّر ذاتي.
“القبلة الثالثة” في نهاية النص تشير إلى توقٍ للاتحاد النهائي، ربما مع الوطن، أو مع الحياة نفسها، أو مع السلام الغائب.
خامساً: البعد الديني والميتافيزيقي:
توظيف مفردات مثل “كوثر”، “ملاك”، “جلجلة”، “كنعان” يمنح النص بعداً روحياً عميقاً، يوظف اللغة الدينية كحاضنة للرمز لا كعقيدة مباشرة.
“جلجلة الخوف” تحيل إلى صليب المعاناة (جلجلة المسيح)، لتجعل من الألم الفلسطيني أيقونة كونية.
الأنثى هنا ليست فقط معشوقة، بل قدّيسة/مخلّصة تعيد للذات تماسها بالزمن المقدس.
سادساً: المستوى الجمالي والوطني:
الجمال في هذا النص ينهض على مفارقة مأساوية:
١- الجمال الأنثوي مقابل دمار الحرب.
٢- رهافة الصورة مقابل خشونة الواقع.
٣- الحنين الوطني مقابل الاغتراب الوجودي.
اللغة الوطنية ليست شعاراتية، بل مضمّنة في الصور، في “جنوب الياسمين”، “بحر كنعان”، “النكبة القديمة (المتجددة)”.
هذا الاشتغال الجمالي على الذاكرة الوطنية يعيد صياغة المأساة بلغة شعرية كونية لا تخاطب الفلسطيني وحده، بل الإنسان عامة.
سابعاً: تأويلات ختامية – بين الحب والحرب:
البيت الأخير:
«داخل مثلّثٍ يحلم بالحياة وينتظر القُبلة الثالثة»
هو ذروة النص التأويلية: فـ “القبلة الثالثة” ليست مجرد فعلٍ حسي، بل رمز لولادة جديدة بعد الحرب. إنها الحلم الذي يؤجل الحرب ويمنح الروح سببًا للبقاء.
القبلة الأولى نجاة، والثانية مقاومة، والثالثة تحقّق الخلاص.
هكذا يزاوج الشاعر بين الأنوثة/الوطن والحب/التحرر في خطاب واحدٍ متماسك دلالياً وجمالياً.
خاتمة نقدية:
هذا النص ليس سرداً شعرياً تقليدياً، بل نسيج لغوي رمزي تتداخل فيه الأسطورة، التاريخ، الدين، والسياسة مع البنية النفسية للفرد الفلسطيني/الإنساني.
المنهج التأويلي يكشف أن المعنى لا يكمن على السطح، بل في الطبقات العميقة للرمز.
المنهج الأسلوبي يُظهر الصراع بين صوت الحرب وصوت الحياة.
المنهج السيميائي يضيء شبكة رمزية معقدة تتجاوز اللحظة المباشرة إلى أفق كوني.
- إن خلدون رحمة في هذا النص يكتب بالدمع لا بالحبر، ويجعل من الحب معادلاً موضوعيًا للحياة في وجه موتٍ يتربص بكل شيء.
***
بقلم: عماد خالد رحمة - برلين
....................
هناك.. جنوب الياسمين،
داخل مثلّثٍ كُسِّرت أضلاعه بمطارق القادمين من الجحيم.
هناك تماماً، حيثُ غصّ الهواﺀ بفجيعة ماجنة: احتضنتْ جسده المحشوّ بالعتمة والخوف، كان بعضُهُ يفتّش عن بعضِهِ بين أنين الركام ونُتَفِ اللحم البشريّ.
لم يصعد إلى جلجلة الخوف المطلق فيما سبَقْ، القذيفة أخطأت لحمَهُ المزهوّ بالصبا والذكريات، لكنها نجحت في إصابة حلمه الممتدّ من عطش المنفى إلى بحر كنعان. كانت روحه معفّرة بغبار القلق الوجوديّ، المكان اهتزّ في أعماقه حتى أقاصي المخيّلة ورائحة البرتقال، أمّا زمانه فقدْ فقَدَ وعيه منذ النكبة القديمة (المتجددة).
- أين أنا؟
- لا تخف، أنتَ هنا حبيبي.
أنقَذَتْهُ بجمالها الفائض عن حاجة الكون، زنّرَتهُ بغزالات روحها الهيفاﺀ ثمّ غسلتْ بكوثرها الأموميّ اختلاج طفل ينزف في عينيه.
كانت خائفةً عليهِ ومنهُ، انهمر دمعها الماسيّ على نحرها، أدرك ذاته في ذاتها، قبّلها بشراسةٍ ناعمةٍ فصفعته بعطر نهديها لتذكّره بأنه مازال حيّاً.
تلألأت بين يديه كمعجزة كما يتلألأ ملاك في قبّة السماﺀ، قبّلها ثانية لينتقم من وداع قادم تبكيه دروب الرحيل.
فكّرَ بالحبّ وهمس لها: للحبّ في الحرب اتساع الوصف، اشتداد الحنين وتشعّب التأويل.
كَفَرَ بالحرب وصرخ في داخله: للحرب في الحبّ انكسار الوردة، انطفاﺀ القلب وانتحار المعنى.
هناك..
جنوب الياسمين
داخل مثلّثٍ يحلم بالحياة وينتظر القُبلة الثالثة..