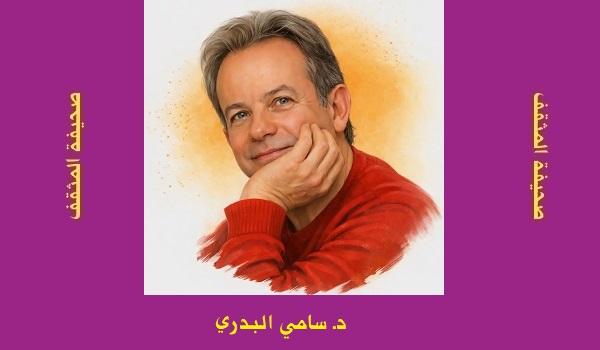قراءات نقدية
عماد خالد رحمة: دراسة نقدية تحليلية لقصيدة «صَمْتُ المَرَايَا» لبهيجة البعطوط

مقدمة الدراسة: تنهض قصيدة «صمتُ المرايا» للشاعرة التونسية بهيجة البعطوط بوصفها نصّاً يتجاوز حدود البوح العاطفي إلى فضاءٍ تأمليٍّ تتقاطع فيه المجازات الوجدانية مع الأسئلة الوجودية. فهي ليست مجرّد اعترافٍ شعريٍّ عن فَقْدٍ أو لوعة، بل هي تجلٍّ تأويليٌّ لمعنى الذات حين تنكسر في مواجهة غياب الآخر، وحين يتحوّل الحبّ من وعدٍ بالخلاص إلى جرحٍ يفتح على المطلق. في هذا النص، يصبح الصمت لغةً، والمرآة كياناً وجوديّاً يعكس ما وراء الصورة — إنها محاولةٌ للقبض على ما يتفلّت من الإدراك، وتدوين ما لا يُقال.
من هنا تأتي أهمية مقاربة هذا النص من خلال المنهج الهيرمينوطيقي التأويلي الذي يُعنى بقراءة ما تخفيه العلامة أكثر مما تصرّح به، إلى جانب المنهج الأسلوبي الذي يضيء البنية اللغوية والإيقاع الداخلي، والمنهج الرمزي والسيميائي الذي يُعنى بتفكيك شبكة العلامات والدوالّ ضمن النص وفق مقاربة غريماس لمربّع الأدوار السيميائية (الفاعل/ المفعول/ المرسل/ المتلقي...). كما تنفتح الدراسة على البعد النفسي والديني والجمالي، بوصف الشعر هنا مرآةً لانكسارات الذات الباحثة عن يقينٍ في عالمٍ ملبّدٍ بالضياع، ووسيلةً لالتقاط لحظة الإدهاش بين الصمت والكشف، بين الغياب والحضور.
تسعى هذه القراءة النقدية إلى الغوص في ما تحت الجلد الشعري من توتّرٍ ونبضٍ ورمز، واستنطاق الأنساق المعرفية والانفعالية التي تحكم النص على مستوياتٍ عدّة: التخييلي، العضوي، اللغوي، الجمالي، والوطني. فقصيدة "صمت المرايا" لا تُقرأ على سطحها الغنائيّ فقط، بل تُفكّك كنصٍّ وجوديٍّ يُعيد مساءلة العلاقة بين الذات والمرآة، بين الصمت والقول، بين العشق والوعي.
نقودُ قراءتنا بثلاث دعامات منهجية متكاملة:
1. الهيرمينوطيقا التأويلية: قراءة المقاصد والآفاق الدلالية للنص، تتبع الأفق التأويلي بين ما يجيزه الخطاب الشعري وما يطلبه القارئ من فهم.
2. الأسلوبية والرمزية: فحص الوسائل الأسلوبية (الصورة، الموسيقى، الإيقاع، التراكيب) وكشف رموز النص الدلالية المتكرّرة.
3. السيميائيات (غريماس): تفكيك العلاقات الفاعلية داخل النص عبر "مخطط الأدوار" (الفاعل/ المفعول/ المرسل/ المتلقي/ المرشد/ المعارِض) لبيان البناء السردي الإنساني داخل الصوت الشعري.
نضيف طبقات: تحليل نفسي (الذات، الجرح، آليات الترميم) وقراءة دينية/ تصوفية (مجازات الغياب، الوجد، النبض). النص سيُقرأ على مستويين: ما يقوله لفظاً (الظاهر) وما يقال تحت الجلد الشعري (الباطن).
1. البنية السطحية: عناصر النص وملامحه الأسلوبية
القصيدة مقسَّمة إلى مقاطعٍ قصيرة واضحة، نبرة المتكلِّم–الأنا الأناشيدية تخاطب غائباً (أنتَ)، وتوظف موسيقى داخلية عبر تكرار الحركات، الصور الحسية، وتناوب بين جُمَلٍ إخبارية وإِناجيّة. من أبرز السمات الأسلوبية:
١- الصيغة الخطابية: مخاطبة مباشرة "تُنَاجِيكَ" — تضع القارئ في موقع شهود الحزن والود.
٢-الصور المركبة: "طَيْفُك"، "خَرَائِطُ العَالَمِ"، "زُجَاجًا مَكْسُورًا" — مزج بين الخرائط والمرايا والزجاج والخريف، مشهد بصري حادّ.
٣-الاستعارة المجازية الموسيقية: "سمنفونية عشق"، "لحنُ الجَوَى" — الموسيقى رمز للتماهي والاستمرارية.
٤- التضادّات/ المفارقات: حبٌّ لكنه "ألم"، غياب لكن "تَغْفُو بين نبضي" — ثنائية الحضور/ الغياب تُحرك النص.
٥-اللغة متوسطة المستوى بين الفصاحة والعامية الخفيفة: كلمات قوية ذات وقع فصيح ("مَثْقَلَةُ الوَجْدِ"، "أُرَمِّمُ شَظَايَا") مع صور قريبة من الوجدان اليومي.
هذه السمات تعطي القصيدة نبرة تأمّلية حيوية، توازن بين الحضور الغنائي والصرامة التأملية.
2. الحقول الدلالية ومفردات المفصل (تفسير مفردات محورية):
نُعرّف الحقول المفرداتية الرئيسة: الغياب/ الوجود (طيف، غياب، ألا أرانِي)، الموسيقى/ اللفظ (أوتار، لحن، قوافل القصيدة، حروف الرَّوي)، الخراب/ الترميم (زجاج مكسور، شظايا، أرمم)، الجسد/ النفس (نبض، قلب، روح)، الخريفي/ الزمني (خريف، أيام)، الحسية/ الشمّ (رذاذ العطر المنثور).
تفسير بعض المفردات:
١- طيفك: لا يعني وجوداً مادياً بل انعكاس حضوره في الذاكرة — علامة لوجود خيالي أو أثر.
٢- خرائط العالم حين أشتاق: الخريطة هنا مجاز للتمثيل المعرفي؛ الحضور يتحول إلى شبكة معانٍ تنظم العالم الداخلي للشاعرة.
٣- قوافل القصيدة: القصيدة كعملية حمل واحتفاء بالحبيب: اللغة تتحرك كقافلة، تنتقل من لحن إلى لحن.
٤- زجاج مكسر: رمزية تقليدية للذات المجروحة، حالة الانكسار والشفافية المفقودة؛ كذلك تشير إلى رؤية مشوّهة للواقِع.
٥- رذاذ عطرك المنثور بين السطور: الحضور الحسي/ الشمّي الذي يواصل وجوده عبر النص المكتوب؛ علامة على ديمومة الذاكرة.
3. القراءة الهيرمينوطيقية / مستويات التأويل
نحو تأويلات ممكنة للنص بوضع فرضيات متعددة مدعومة بالأدلة اللفظية:
أ. التأويل العاطفي/ الوجداني:
القصيدة سرد لوجدان يعاني انفصالاً لكنه يُعيد صياغة الغياب باعتباره نمط معرفة: الفقد لم يحلّ؛ بل أعطى فهماً جديداً (ـ"لم يُطفئني الفقد بل أنار بصيرتي" — هذه العبارة ضمنية في قطعة أخرى لكن هنا نفس المنطق موجود: الترميم عبر الألم). الوجدان يتحرك بين شوق واستسلام وترميم.
ب. التأويل النفسي:
الزجاج المكسور، الشظايا، عدم القدرة على الرؤية أمام المرايا، تدلّ على اضطراب في الهوية أو انقسام الذات. الفعل الشعري هنا يقوم بدور العلاج: "أُرَمِّمُ شَظَايَا الأَيَّامِ" → الشعر كفعل سُدْوِي/ شفائي يعيد ترتيب شظايا الذاكرة.
ج. التأويل الديني/ الصوفي:
مخاطبة الروح والمآل نحو "مَلاذي" و"الرجاء" و"تغفو بين نبضي" يستحضر لغة دعائية/ مناجاة أقرب إلى خطاب العاشق في التصوف: الحبيب كمبدأ غيبي/ إلهي أو رمز للمعرفة العليا؛ الغياب لا يبطله بل يجعل الحبيب حاضراً في القلب كحضور خفي (حضور القلب/ الباطن). كذلك "الروح تناجيك" تقترب من صيغة الابتهال.
د. التأويل المعرفي/ الأنساق المعرفية:
النص يقيم أنساقاً معرفية: الذاكرة كخريطة، القصيدة كقافلة، الجسد كمرآة زجاجية، والعطر كعلامة حسية محفوظة بين السطور. هذه الأنساق تُظهِر كيف ينظّم الشاعر العالم داخلياً: عبر خرائط، مخطوطات، مرايا، وأنغام. قراءة هيرمينوطيقية تتتبّع الانتقال من صورة إلى أخرى كعملية تفسيرية داخل النص نفسه.
4. سيميائيات غريماس — مخطط الأدوار
نطبق هنا مخطط غريماس البسيط: (المرسل ـ الموضوع/ الموضوع ـ المستقبل/ المتلقي ـ الفاعل ـ المعاون ـ المعارض). نحاول استخلاص "الأدوار" داخل النص الشعري:
١- الفاعل: «أنا الشاعرة»/ الضمير المتكلم (أنا المتكلمة) — الذي يسعى/ يشتاق.
٢- المرسل: الذاكرة/ الحنين/ القصد الذاتي للشعر — الدافع الذي يرسله إلى الفاعل. أحياناً يمكن اعتبار "الماضي" أو "الذكرى" مرسلاً لأنه يوجّه الفاعل نحو البحث عن المعنى.
٣- المرسَل إليه/ المتلقي: الحبيب «أنتَ»/ أو الذات الممثلة بالحضور — الذي سيستقبل فعل الحنين أو القصيدة.
٤- الموضوع: الاتحاد/ إدراك الحضور/ الرؤية الذاتية؛ أو استرجاع الحب بكيانٍ ثابت. أحياناً الموضوع هو «الهوية المكتملة» أو «الراحة/ الملاذ».
٥- المعاون: القصيدة، الذاكرة، الألق، الحواس (العطر، اللحن) — أدوات الفاعل في السعي.
٦- المعارض: الغياب، الضياع، الشظايا، الزوابع النفسية — عناصر تعيّق الوصول.
نرسم منها محورين رئيسين: محور سعي (أنا —> موضوع: لقاء/ إدراك) ومحور عائق (غياب/ شظايا) يَحُولان دون الوصول بينما القصيدة/ الذاكرة تعملان كمساعدة. هذا المخطط يبيّن بنية الصراع الشعري: حركة مستمرة بين السعي والعتبة.
5. التحليل الأسلوبي المفصل (تفكيك الآليات):
أ. التواصيف البلاغية؛
١- التشخيص: النجوم "تبتسم خجلاً" تشخيص للطبيعة تردّ على حالة الشاعرة.
٢- التشبيه: "كأنك سمفونية عشق" — تنصيص على تداخل الموسيقى مع العاطفة.
٣- الاستعارة: "قوافل القصيدة" — تحويل القصيدة لفعالية اجتماعية/ حركية.
٤- التكرار: تكرار الحقول (الحنين، الخسارة) يقوّي الإيقاع العاطفي.
ب. النحو والصياغة:
التناوب بين الجمل الخبرية والإناجية يعطي النص ديناميكية: الأخبار تُثبت الحالة، والإنابة (يا، أنت) تُشعل اللهفة.
الاستعانة بأزمنة حالية ومستمرة ("تُعانقُ طيفك"، "تتساقط دموعي") تُبقي الحدث حاضراً ومتحركاً داخلياً.
ج. الإيقاع الداخلي والموسيقى:
رغم عدم اتّباع القصيدة لوزن تقليدي صارم، إلا أن هناك إيقاعات داخلية تعتمد على تكرار الأصوات (موسيقى حروفية) وتراكيب لعبارات موسيقية: "لحنِ الحبِّ... لحنُ الجَوَى". هذه «موسيقى معنوية» تعزز الانفعال.
6. البنى النفسية: الانكسار، الترميم، الذات المجروحة
الذات الشاعرة في النص تبدو مُنزوية ومقسّمة:
١- الانكسار: "أشبه زجاجًا مكسورًا" — دلالة على فقدان السلام الداخلي، انقسام في الإدراك.
٢- الترميم: "أُرَمِّمُ شَظَايَا الأَيَّامِ" — الشعر كفعل إصلاح، إرادة بصرية لترتيب العالم.
٣- الاستبقاء الحسي: العطر المنثور، النبض، الأوتار → علامات تجعل الذات مرتبطة بالجسم والحواس، لا تختزل في مجرد فكرة.
نستطيع أن نقرأ النص كـ"عملٌ من الذاكرة المتألمة" يقوم على تجميع الذات، وفيه الشعر عملية علاجية.
7. البعد الديني/ الصوفي:
الخطاب الحواري مع الحبيب يشابه مناجاة العاشق للمعشوق في التصوف:
"روحِي تُنَاجِيكَ" — اللغة الدينية للدعاء.
"مَلاذِي وَكُلَّ الرَّجَاءِ" — وصف الحبيب كمأوى ومرجع إيماني نفسي.
"تَغْفُو بين نَبضي" — فكرة الحضور المستور: أن الحبيب ليس غائباً كلياً بل حاضر في شكل غيبوي حاضر في الباطن.
هذا لا يعني بالضرورة أن الحبيب إلهي، لكن النص يشبّه حالة الحبّ بالابتهال، ويستعمل مفردات تعبّدية للتأكيد على قُدسية التجربة العاطفية.
8. المقارنة بين مستويات: انفعالي، تخييلي، عضوي، لغوي/ جمالي.
أ. المستوى الانفعالي:
النص مشحون بالشوق والوجع والحنين. المشاعر مركّزة ومكثفة، تترجم في صور مباشرة (دموع، نبض) وفي صور استعادية (خرائط، شظايا). انفعال الشاعرة يتجه نحو الاحتفاظ بالمحبوب داخلياً لا لتحطيمه أو نسبته للخارج.
ب. المستوى التخييلي (الخيالي):
الخيال شعري وغزير — يجمع بين الصور الممكنة (العطر، الزجاج) والرمزيات الكبرى (القافلة، الخريطة). الخيال يبني عالماً داخلياً ذا ترابط ايقوني: الذاكرة كخريطة والقصيدة كقافلة. هذا المستوى يُنتج حسّاً بطوليّاً صغيراً للصراع الداخلي.
ج. المستوى العضوي:
الصور الجسدية (نبض، قلب، روح) تجعل المشاعر متجسّدة — لا مجرد فكرة بل حالة عضوية تتألم وتستعيد. استخدام فعل الشرب/ الارتشاف "أرتشف صمتي ولوعتي" يحوّل الصمت إلى مادة تُشرب، أي ملموسة.
د. المستوى اللغوي والجمالي (الأعراف):
اللغة تميل إلى الفصاحة والرصانة، تضع النص في سُلّم جمالي عربي معاصر يمزج تقاليد الغزل العربي مع الحرية الشكلية للقصيدة الحديثة. الاعراف: مخاطبة مباشرة، ازدواج بين البساطة التصويرية وعمق الاستعارة، احترام للحدة الشعرية دون تطريب زائد.
9. لحظة الإدهاش (المفاجأة الجمالية):
في هذا النص، لحظة الإدهاش مركّزة في المقطع الذي يربط بين الخرائط والحنين، تقول:
"فأنتَ خَرَائِطُ العَالَمِ حِينَ أَشْتَاقُ،
وحِينَ يُدْرِكُنِي الضَّيَاعُ."
هنا يتحوّل الحبيب إلى «خريطة» — لا يكون مجرد فرد بل نظام يُنظِّم الوجود. الإدهاش في تحويل الدال من شخصٍ إلى هيكل معرفي منطقي (خريطة) يخلخل القارئ ويكشف عن قدرة النص على خلق معنى مركب: الحبيب ليس فقط موضوع عشق بل مركز معرفي يعيد ترتيب العالم. كذلك إدهاش قوي في "أحتضنك بمفردات الهوى" — مفردات تصبح أجساداً تُعانق.
10. قراءة سيميائية أكثر تفصيلاً (علامات، رموز، أكواد):
١- المرآة: في عنوان النص "صمت المرايا" وداخل النص "أقف أمام المرايا فلا أرانِي" — المرايا هنا علامة الهوية والاختلاف: المرايا تصمت أو تكذب أو تُخفي؛ وعنوان القصيدة يضع الصمت كآلية انعكاس مقلوبة: لا انعكاس بل مفارقة. المرايا بوصفها رمزاً للذات المفقودة، أو للهوية التي لا تجيب.
٢- الخريطة: رمز للمعرفة، النظام، الاتجاه. الشعور بالحنين يصبح نشاطًا معرفيًا.
٣- الزجاج المكسور: رمز للانقسام، الشفافية المشتتة، رؤية محطمة للواقع.
٤- العطر: علامة ذاكرة حسية تدل على استمرار الحضور رغم الغياب.
الأكواد هنا: الحسي (شمّ، صوت، بصر) يقابلها الكود النفسي (حنين، ألم). النص يستخدم الأكواد الحسية لإيصال الأكواد النفسية.
11. الأنساق المعرفية داخل النص:
النص يبني شبكة من المعارف، أي مفاهيم مبنيّة داخلياً:
1. الذاكرة الخريطة (الذاكرة كنسق معرفي تنظيمي).
2. اللغة القافلة (اللغة كجماعة وكمسيرة).
3. الحضور الطيف (الحضور كتمظهر غير مادي).
4. الذات، المرآة، الزجاج (هوية متكسّرة/ لامرئية).
قراءة هذه الأنساق تكشف أن الشاعرة لا تكتب فقط عن فقدان؛ بل عن طريقةٍ للمعرفة: كيف تُنظَّم الذكريات، كيف تكتب الذات نفسها على هيئة خريطة أو قافلة.
12. المقارنة مع أنماط شعرية (سياق وطني/ أدبي):
شعريّاً، النص ينتمِي إلى تقاليد الغزل المعاصر العربي الذي يمزج بين الحسية والرمزية والتأمل، لكن بصبغة انشائية معاصرة.
على المستوى الوطني (التونسي/ المنطقة المغاربية) — دون الدخول في سِيَر شخصية للكاتبة — يمكن القول أن النص ينسجم مع تيارات حديثة تهتم بالذات والذاكرة والوجود بعد الحريات الاجتماعية والتحولات السياسية: الشعراء المغاربيون غالباً ما يوظّفون رموز الغياب / الذاكرة لتجربة فردية تتماهى مع التاريخ. (ملاحظة منهجية: هذا ربط عام ثقافي لا يفترض نية سياسية صريحة في النص).
13. اقتراحات لقراءات بديلة ونقاط بحث لاحقة:
١- قراءة نسوية: كيف تُصوِّر المرأة الذاتية (أنا الشاعرة) داخل فضاء الذكر/ الغياب؟ هل هناك طابع تحرري في "أحتضنك بمفردات الهوى"؟
٢- قراءة بينية: ربط النص بنصوص غزلية/ تصوفية عربية كلاسيكية (ابن الفارض، جلال الدين الرومي) أو الحداثيين (نزار قباني، أدونيس) لبيان التوارث.
٣- تحليل سيميائي معمّق: بنية العلامات داخل كل مقطع، وكيف تتفاعل نظم العلامات عبر القصيدة.
٤- تحليل صوتي/ موسيقي: إخراج وزن داخلي، دراسة التكرارات الصوتية وتأثيرها على الإيقاع الدلالي.
14. خاتمة موجزة: خلاصات وتلخيص التحليل
1. الذات المتكلّمة في القصيدة هي فاعل مُجروح لكنه فعال: يحوّل الألم إلى فعل شعري (الترميم/ الكتابة).
2. الغياب ليس فراغاً بل مجالاً مُكتنزاً بعلامات: طيف، خريطة، عطر — الحبيب حاضر كشبكة من الإشارات.
3. الشعر هنا يتخذ دور المعاون العلاجي، واللغة قافلة تنقل التجربة وتبني الهوية.
4. المفردات المركزية (مرآة، زجاج، خريطة، لحن، عطر) تعمل كـ"نظام علامات" متكامل يحمل الدلالات النفسية والروحية.
5. لحظة الإدهاش تتجلّى حين يتحوّل الحبيب إلى "خريطة العالم" — أي حين يتعدّى النص حدود الغزل إلى بناء معرفي يغيّر تصور القارئ عن العلاقة بين الحبيب والعالم.
15. مادة ملحقة: مخطط غريماس مختصر (نصّياً).
١- الفاعل: «الـأنا الشاعرة» — تسعى للوصول/ للاتحاد.
٢- المرسل: الذاكرة/ الحنين/ الماضي — تحفّز السعي.
٣- المرسل إليه/ المتلقي: «أنتَ» (الحبيب) أو الذات المندمجة.
٤- الموضوع: إدراك الحضور/ الهوية/ الترميم.
٥-المعاون: القصيدة، الذاكرة، العطر، اللحن.
٦- المعارض: الغياب، الضياع، الشظايا.
***
بقلم: عماد خالد رحمة - برلين
..........................
صَمْتُ المَرَايَا
كُلُّ شَيْءٍ هُنَا صَامِتٌ،
إلَّا رُوحِي تُنَاجِيكَ...
تَتَسَلَّلُ الكَلِمَاتُ،
تُعَانِقُ طَيْفَكَ،
فَتَبْتَسِمُ النُّجُومُ خَجَلًا.
*
أَرْتَشِفُ صَمْتِي وَلَوْعَتِي،
أَبْحَثُ عَنْكَ فِي لَحْنِ الحُبِّ...
فَأَنْتَ خَرَائِطُ العَالَمِ حِينَ أَشْتَاقُ،
وحِينَ يُدْرِكُنِي الضَّيَاعُ.
*
سَأَكْتُبُكَ قَوَافِلَ القَصِيدَةِ،
مَلاَمِحُكَ حُرُوفُ الرَّوِيِّ،
وَصَوْتُكَ لَحْنُ الجَوَى.
*
يَا مَلاذِي وَكُلَّ الرَّجَاءِ،
أَلْتَقِيكَ بَيْنَ حُرُوفِي،
أَتَنَفَّسُ رَذَاذَ عِطْرِكَ
المَنْثُورَ بَيْنَ السُّطُورِ،
فَأَحْتَضِنُكَ بِمُفْرَدَاتِ الهَوَى.
*
لَمْ يَكُنْ حُبًّا، بَلْ أَلَمًا،
كَانَ سَرَابًا وَأَضْغَاثَ أَحْلَامٍ،
غَدَوْتُ مَثْقَلَةَ الوَجْدِ،
أُرَمِّمُ شَظَايَا الأَيَّامِ،
أَقِفُ أَمَامَ المَرَايَا،
فَلَا أَرَانِي.
*
أُشْبِهُ زُجَاجًا مَكْسُورًا،
يَرَى اليَقِينَ غَرِيبًا،
وَالأَقْدَارَ مُشَتَّتَةً.
*
وفي حَضْرَةِ الغِيَابِ،
مَا زِلْتَ تَغْفُو بَيْنَ نَبْضِي،
بَيْنَ ارْتِجَافِ قَلْبِي المُتَيَّمِ.
***
بهيجة البعطوط – تونس