قراءات نقدية
ليلى تبّاني: كيف ينجو الإنسان من نفسه؟
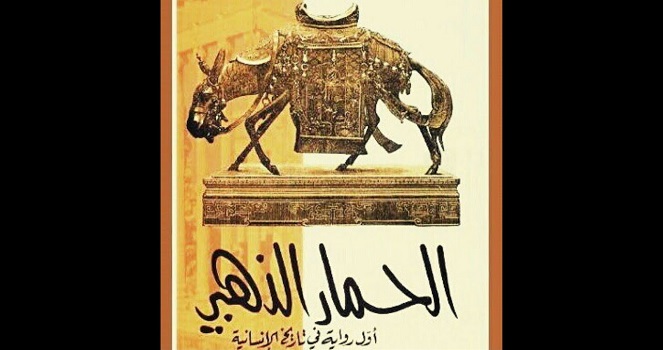
في مداوروش أرض الأمازيغ كُتب القلق الإنساني بريشة من ذهب
"الحمار الذهبي". كيف أُعيد تدوير القلق الإنساني؟
حنين هو لا تعصّب... تعالوا نقرأ التاريخ بعين أمازيغية جزائرية، عين عارفة باحثة تدرك أن هذه الأرض لم تكن صامتة في يوم من الأيام، بل ناطقة بالفلسفة، والجدل، والسؤال. فمن هذه الربوع خرج أبوليوس المداوري، الأمازيغي الجزائري، ليكتب أول رواية فلسفية في تاريخ الإنسانية، قبل أن يُعاد توزيع المجد على غير أهله. إن قراءة التاريخ بعين أمازيغية جزائرية ليست دعوة لإقصاء أحد، بل محاولة لاستعادة موقعنا الطبيعي في مسار الفكر الإنساني، بعد قرون من التهميش والاختزال .
قد لا يعرف كثيرون أن سؤال الهوية والاغتراب، لم يولد في أثينا ولا في روما، بل تَشكّل باكرا في أرض الشاوية الأمازيغ، في مادور، مداوروش الحالية، بسوق أهراس، حيث كتب أبوليوس وأوغسطين قلق الإنسان الأول.
تُعد رواية "الحمار الذهبي" لأبوليوس واحدة من أكثر النصوص إغراء وإرباكا في تاريخ الأدب القديم، فهي أوّل رواية مكتملة وصلت إلينا، لكنها ليست نصّا بريئا ولا حكاية وعظية بسيطة، بل بناء سردي مركّب تتجاور فيه المغامرة مع السخرية، والأسطورة مع الفلسفة، والخلاص الروحي مع ظلال كثيفة من العنف والخوف والشك. وفي هذا التوتر العميق تكمن عظمتها الحقيقية.
تدور الرواية حول لوكيوس، الشاب المفتون بالسحر والمعرفة المحرّمة، الذي يدفعه فضوله إلى تجربة تعويذة تحولٍ تنقلب عليه فيتحول إلى حمار، محتفظًا بعقله الإنساني داخل جسد حيواني. غير أن هذا التحول لا يمكن فصله عن المكان الرمزي الذي خرج منه المؤلف نفسه، أي مادور، أو مداوروش، المدينة الأمازيغية العريقة التي كانت إحدى أمهات الفكر في شمال إفريقيا الرومانية، حيث لم تكن المعرفة ترفا بل قلقا، ولم يكن السؤال الفلسفي زينة ثقافية بل ضرورة وجودية. منذ هذه اللحظة تبدأ رحلة طويلة من الإذلال والتنقل القسري بين طبقات المجتمع الدنيا، حيث يُستعمل جسده بلا رحمة، ويُجلد ويُجوّع ويُستغل، فيغدو شاهدا صامتا على انحطاط البشر وقسوتهم ونفاقهم. الحمار هنا ليس قناعا هزليا فحسب، بل موضعا للعقاب، وكأنّ الجسد حين يخرج عن النظام الاجتماعي يُجرّد من كرامته ويُسلَّم للعنف بلا حدود.
خلال هذه الرحلة القاسية تتخلّل الرواية حكايات فرعية كثيرة، أهمّها وأجملها قصة "حب ونفس" أو قصة كيوبيد وبسيخه، التي تشكّل قلبا رمزيا نابضا داخل العمل. بسيخه فتاة بشرية بلغ جمالها حدّا أغضب فينوس إلهة الجمال، فأمرت ابنها كيوبيد أن يعاقبها، لكنه خلافا لأمر أمه، يقع في حبّ بسيخة ويتزوجها سرّا، مشترطا عليها ألاّ تحاول رؤيته. تعيش بسيخه في نعيم حتى يخونها الفضول فتضيء وجه حبيبها النائم، فيغادرها، وتسقط في درب من الألم والاختبارات القاسية التي تفرضها عليها فينوس. لا تنجو بسيخه إلا بعد أن تتألّم، وتخضع، وتقترب من الموت نفسه، قبل أن يمنحها زيوس الخلود فتتحد بالحب اتحادا أبديا.
هذه القصة التي تُقرأ غالبا بوصفها ترنيمة للحب، تكشف في عمقها عن منطق الرواية كله، لا اكتمال دون ألم، ولا استحقاق دون امتحان قاس، ولا خلاص دون خضوع. فبسيخه، مثل لوكيوس، لا تُكافأ إلا بعد أن تُكسَر وتُختَبَر حتى النهاية، وكأنّ المعرفة والحب لا يُمنحان إلا لمن يمر عبر العذاب.
عند العودة إلى المسار العام للرواية، نلاحظ أن العنف ليس مجرد أداة نقد اجتماعي، بل عنصر بنيوي في السرد . أبوليوس لا يكتفي بالإشارة إلى القسوة، بل يُطيل الوقوف عندها، ويصف الإذلال بتفاصيل حسية تجعل القارئ شريكا صامتا في التلقي. السخرية التي تغلف كثيرا من هذه المشاهد لا تُخفِّف الألم، بل تُطَبّعه، وتجعل القسوة مألوفة، وكأنّ الضحك يُستخدم هنا قناعا لإسكات الحس الأخلاقي.
كما أن الرواية تؤسس لنظرة قلقة إلى الجسد، إذ يُقدَّم الجسد الحيواني بوصفه موضعا للإثم والعقوبة، بينما لا يتحقق الخلاص إلا بالتخلّص منه والعودة إلى الجسد الإنساني المنضبط. هذه الثنائية بين الجسد والروح تعكس خوفا عميقا من الغريزة واللذّة، وتمهّد لفكرة أن الألم تطهير، وأن الكرامة لا تُستعاد إلا عبر المعاناة.
أما صورة المرأة في الرواية، فرغم إشراق قصة بسيخه، فإنّها في مجملها صورة ملتبسة ومظلمة. النساء غالبا سبب السقوط أو الفتنة أو الخيانة، حتى فينوس نفسها تُصوَّر إلهة غيورة سادية. وكأن النص يعكس تمييزا جندريا وقلقا ذكوريا من المرأة بوصفها قوة لا يمكن ضبطها إلا عبر الألم والخضوع، فلا تُقبل أنوثتها إلا حين تُفرغ من تهديدها.
في خاتمة الرواية، يجد لوكيوس خلاصه عبر عبادة إيزيس، فتُعاد له إنسانيته في طقس ديني صارم، يُبنى على الطاعة والانضباط والانتماء إلى نظام مغلق. هنا يبدو الخلاص الروحي ملتبسا، إذ لا يتحقق بالحرية أو المعرفة العقلية، بل بالاستسلام الكامل. وكأنّ الرواية تستبدل عبودية الجسد بعبودية مقدّسة، أكثر نعومة لكنها لا تقل صرامة.
نخلص للقول أن "الحمار الذهبي" ليست رحلة خلاص صاف، بل اعترافا أدبيا عميقا بخوف الإنسان القديم من ذاته، من جسده، ومن حريته، ومن المرأة، ومن العقل حين ينفلت من الضبط. إنّها رواية عظيمة لأنها لا تُطمئن القارئ، بل تضعه أمام سؤال قاس، هل الإنسان لا يتعلم إلا إذا كُسر؟ وهل الخلاص ممكن دون أن يمر عبر الظل؟ في هذا السؤال المفتوح، لا في الإجابة، يكمن خلود هذه الرواية.
وإذا أُعيدت الرواية إلى سياقها المنسي، فإن هذا العمق القاتم يكتسب معنى إضافيا. فأبوليوس ليس كاتبا لاتينيا خالصا كما درجت الدراسات الكلاسيكية على تقديمه، بل هو أفولاي الأمازيغي، ابن مادور، المدينة التي تُعرف اليوم بمداوروش في ولاية سوق أهراس الجزائرية. تلك المدينة لم تكن هامشا ثقافيا، بل مركزا تعليميا وفكريا مهمّا في شمال إفريقيا الرومانية، وهي نفسها الفضاء الذي تشكّل فيه وعي القديس أوغسطين، المولود في تاغست المجاورة، والذي درس في مادور قبل أن يشقّ طريقه اللاهوتي.
هذا المعطى ليس تفصيلا تاريخيا، بل مفتاح قراءة. فأبوليوس يكتب من موقع ذات أمازيغية تعيش التوتر بين ثقافتها المحلية والهيمنة الرومانية، بين الجسد المنتمي إلى الأرض والروح المشدودة إلى أنظمة الخلاص الوافدة. ظلمة الرواية، هوسها بالعقاب، خوفها من الجسد، وارتيابها من الحرية، يمكن قراءتها بوصفها تعبيرا عن قلق هوية تعيش تحت سلطة ثقافية كبرى، فتبحث عن الخلاص لا بالتمرّد، بل بالانخراط المشروط في منظومات روحية قاهرة.
وإذا كان أوغسطين قد عبّر لاحقا عن القلق نفسه بلغة الخطيئة والنعمة، فإن أبوليوس عبّر عنه بلغة السخرية والتحوّل والإذلال. الاثنان ينتميان إلى تربة واحدة، لكنّهما سلكا طريقين مختلفين للإجابة عن السؤال ذاته، كيف ينجو الإنسان من نفسه؟ هكذا تصبح رواية "الحمار الذهبي" نصا أمازيغيّ الجذر، عالميّ الأفق، يكتب الهشاشة الإنسانية من أرضٍ عرفت التعدد والاحتكاك والاغتراب قبل أن يُسمّى ذلك فلسفة.
***
ليلى تبّاني - الجزائر







