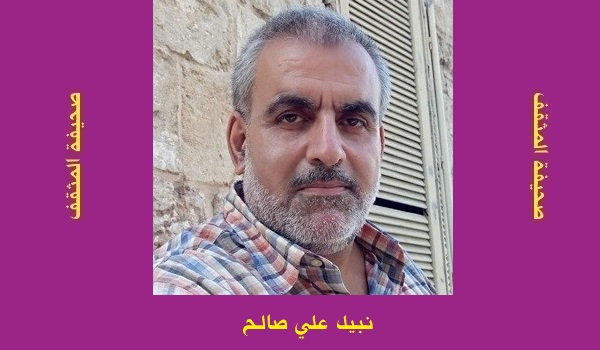دراسات وبحوث
جواد بشارة: مقاربة لفهم الصراع بين العقل العلمي والعقل الخرافي- اللاهوتي

إن ثيمة الصراع بين العقل العلمي والعقل الخرافي، أو بشكل أدق الصراع بين الدين والعلم، هو جوهر وأساس وسبب السعي المعرفي الذي كرسّت له أغلب سنوات عمري للبحث عن الحقيقة، إن وُجدت. والتعبير عن ذلك موجود في كتبي، منذ كتابي الأول عن الكون وكان بعنوان "الكون أصله ومصيره وآخرها كتاب "من الكون المرئي إلى الكون اللانهائي". ومن بينها كتاب بعنوان " إله الأديان وإله الأكوان". و" سفر التكوين العلمي" و" الكون الإله" و" كون مرئي وأكوان خفية" و" الكون الجسيم والكون المتسامي" والثالوث المُحيّر: الله-الدين-العلم" و" الكون الحي" و" الكون المطلق" الخ... وكلها ناقشت معضلة الصراع بين العقل العلمي والعقل الخرافي.
وهذا الصراع موجود في كل زمان وكل مكان منذ آلاف السنين إلى يوم الناس هذا، وليس فقط في العالمين العربي والإسلامي. وما تركيزي على هذا الأخير إلاّ لأنه ما يزال مستمراً وبحدة ويتخذ أشكالاً أكثر خطورة بعد عودة الدين وهيمنته على الحياة الاجتماعية والتربوية والثقافية والفكرية منذ نهاية ستينات القرن الماضي. ففي عام 1969 صدر كتاب نقد الفكر الديني للدكتور صادق جلال العظم وتم منعه في العديد من الدول العربية ومحاكمة مؤلفه وناشره في بيروت، لأنه تجرأ على مناقشة العقلية الخرافية التي تصدق الخرافات ونحن نعيش في عصر العلم.
بدأ الصراع أولاً بين الدين والفلسفة قبل أن يدخل العلم حلبة الصراع بقوة منذ القرن السابع عشر وشراسة الهجمة الكنسية على الفلاسفة والعلماء إبّان فترة محاكم التفتيش واضطهاد المفكرين وحرق جيوردانو برونو حياً في الساحة العامة في روما سنة 1600 بتهمة الهرطقة والزندقة والإلحاد لجرأته في طرح أفكاره الفلسفية والعلمية نوعاً ما آنذاك والمخالفة لأطروحة الكنيسة الكاثوليكية. ولو أردنا الحديث باستفاضة عن الموضوع لاحتجنا إلى أسابيع بل وربما أشهر لتغطيته من جميع جوانبه.
لنبدأ بتعريف أولاً بما نقصده بالعقل الخرافي والعقل العلمي. العقل الخرافي هو الذي يتقبل ويصدق ويؤمن بالأساطير والخرافات والشعوذات والخزعبلات حيال كل شيء في الحياة والواقع والموت والآخرة والقيامة والجنة والنار والعقاب والثواب وعملية الخلق الرباني بطريقة كن فيكون وبما جاء في النصوص الدينية التي يعتبرها مقدسة، من أساطير وخرافات وغيبيات وماورائيات أما العقل العلمي فالمراد به هنا هو ذلك العقل الذي يستند للعلم فقط في إيجاد الأجوبة على التساؤلات الوجودية وتفسير الظواهر الطبيعية المتعلقة بالحياة والكون والوعي والتطور الخ ولا يقبل أو يرفض التصديق بما جاء في الكتب التي يقال أنها سماوية منزّلة ومقدسة.
لا بد من التنويه في البدء أنني لا أقصد هنا بالعقل الخرافي حصراً هو ذلك العقل الذي يعتقد ويصدق بالخرافات الدينية فقط، بل اقصد به كل ما ينافي العقل والوعي العلمي سواء أكان ذلك موجوداً في الأيديولوجيات والنظريات والأفكار الوضعية والدنيوية أو في النصوص والروايات الدينية، على السواء، وليس المقصود هنا بدين بعينه، بل إن الدين المطروح هنا هو مجرد فكرة وممارسة واعتقاد وإيمان سواء أكان هذا الدين وضعي دنيوي كالبوذية وغيرها، أو سماوي منزل كالدين اليهودي أو الدين المسيحي أو الدين الإسلامي، حيث تغطي هذه الفكرة الدينية مساحة زمنية تمتد لملايين السنين وليس فقط الفترة المرتبطة بتاريخ ظهور الأديان على الأرض، وكذلك فإن المقصود بالعقل العلمي هنا هو طريقة التفكير والتأمل، والشك والتساؤل، والبحث والتجريب، والطعن بالمسلمات الأسطورية أو الخرافية، وذلك منذ أن نشأ الوعي عند الإنسان قبل ملايين السنين ولو بشكله البدائي أو الجنيني إلى يوم الناس هذا.
إن الصراع بين العقل العلمي والعقل اللاهوتي الخرافي هو موضوع متكرر في تاريخ الفكر الإنساني. ويتجلى هذا الصراع في التوترات بين النهج العقلاني والتجريبي والمنهجي للمعرفة والمعتقدات القائمة على التقاليد والعقائد الدينية والخرافات. تتناول هذه المقاربة أصول هذا الصراع ومظاهره وآثاره عبر العصور التاريخية المختلفة، مع تسليط الضوء على القضايا المعرفية والاجتماعية والثقافية والفلسفية.
هناك الأصول التاريخية للصراع، والتي لايمكن الخوض فيها بالتفصيل ولكن يمكننا القول أن العصور القديمة والمفاهيم الأولى للعالم في الحضارات المبكرة قد تشكّلت، عندما كانت معرفة العالم غالبًا ما ترتبط بالمعتقدات الدينية والخرافية حيث تم تفسير الظواهر الطبيعية على أنها مظاهر للإرادة الإلهية أو الأرواح. المحاولات المبكرة للفهم العقلاني، بدأت هي الأخرى منذ وقت بعيد وبالتوازي تقريباً، مثل تلك التي قام بها فلاسفة ما قبل سقراط في اليونان، والتي كانت تتعارض أحيانًا مع التفسيرات الأسطورية. وبظهور الفلسفة العقلانية مع مفكرون مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو، وضعت الفلسفة اليونانية الأسس لنهج عقلاني ومنتظم للمعرفة. لقد طور أرسطو، على وجه الخصوص، أساليب المراقبة والتصنيف التي تصور العقل العلمي. ومع ذلك، غالبًا ما تعايشت هذه الأفكار مع المعتقدات الخرافية والدينية. سيطر اللاهوت المسيحي خلال العصور الوسطى في أوروبا على العقول، وهيمن على النهج الفكري. وكانت المعرفة تابعة إلى حد كبير للعقائد الدينية، وكان أي شكل من أشكال المعرفة يجب أن يكون متوافقًا مع الكتب المقدسة. وغالبًا ما تم قمع محاولات التشكيك في هذه العقائد. خاصة عند إعادة تقديم الفلسفة الأرسطية ومع إعادة اكتشاف نصوص أرسطو في القرن الثاني عشر، حيث ظهرت محاولة للتوفيق بين العقل والإيمان. حاول مفكرون مثل توما الأكويني إظهار إمكانية انسجام الفلسفة الأرسطية مع اللاهوت المسيحي. ومع ذلك، ظلت التوترات قائمة بين التفسيرات العقلانية والمعتقدات الدينية، ثم جاء عصر النهضة والثورة العلمية، وهي حقبة يمكن أن نعنونها بعودة الإنسان والعقل. كان عصر النهضة بمثابة تجديد الاهتمام بالمعرفة القديمة وتثمين العقل البشري. بدأت الاكتشافات في علم الفلك والطب والعلوم الأخرى في تحدي المعتقدات اللاهوتية والخرافية الراسخة ثم جاءت الثورة العلمية حيث شهد القرنان السادس عشر والسابع عشر ظهور الثورة العلمية مع شخصيات مثل كوبرنيكوس وغاليليو وكبلر ونيوتن. طرح هؤلاء العلماء أساليب تجريبية ورياضياتية لفهم العالم. إن نموذج كوبرنيكوس لمركزية الشمس، والذي أثبته غاليليو، يتحدى بشكل مباشر مذاهب الكنيسة، ويوضح بجلاء الصراع بين العلم واللاهوت. واستمر الوضع على حاله إبّان عصر التنوير وتطور العلوم الحديثة، وكما ذكرنا شهد القرن الثامن عشر، وعصر التنوير، تعزيزًا للعقل والتجريبية والشك تجاه المعتقدات الخرافية واللاهوتية. انتقد فلاسفة التنوير، مثل فولتير وديدرو وهيوم، الخرافات والدوغمائية الدينية، بينما دافعوا عن النهج العلمي والعقلاني الذي قاد إلى ولادة العلم الحديث وإنشاء المنهج العلمي وتخصص العلوم مما عزز الروح العلمية. وقد عززت المؤسسات والمنشورات العلمية النهج القائم على الملاحظة والتجريب والتحقق من صحة الأقران، في مواجهة العقائد الدينية والخرافات. ومن هنا ظهرت الصراعات الحديثة بين العلم والدين والخرافة وتمثلت بانتشار الداروينية والجدل الذي أثارته نظرية التطور لتشارلز داروين، التي عرضت في كتاب "أصل الأنواع" (1859)، وكان جدلا كبيرا من خلال تحدي قصص الخلق الموجودة في العديد من الأديان. لاسيما قصة الخلق في سفر التكوين التوراتي. لقد بلورت الداروينية الصراع بين التفسير العلمي لأصول الحياة والإنسان في المنظور العلمي مقابل المعتقدات الدينية التقليدية والأطروحة الدينية الخرافية والأسطورية، لحكاية الخلق الأسطورية التي وردت في النصوص الدينية عن خلق آدم وحواء والجنة والنار. العلم والدين في القرنين العشرين والحادي والعشرين مايزلان يواجهان مقاومة عنيفة من قبل المؤسسات الدينية الرسمية لاسيما الإسلامية. ففي القرن العشرين، استمر التقدم العلمي في علم الكونيات والأحياء والفيزياء بكل فروعها لاسيما علم الأكوان الكوسمولوجيا والفيزياء النظرية والفيزياء الفلكية في تحدي المذاهب الدينية. غالبًا ما كانت المناقشات حول موضوعات مثل نظرية الانفجار الكبير، وعلم الوراثة، ونظرية النشوء والارتقاء في علم الأحياء، وفي علم الأعصاب، تضع الروح العلمية في مواجهة الروح اللاهوتية. ولكن استمرت الخرافات على الرغم من التقدم العلمي، ولا تزال الخرافات تزدهر في العديد من الثقافات. وتظهر المعتقدات في السحر والأبراج ونظريات المؤامرة لذلك تبقى الذهنية الخرافية مؤثرة. ويظهر التوتر بين العلم والخرافة بشكل خاص في مجالات مثل الطب، حيث يمكن أن تتعارض الممارسات غير العلمية مع العلاجات القائمة على الأدلة في القضايا المعرفية والفلسفية. إن الصراع بين العقلية العلمية والعقلية اللاهوتية يثير أسئلة أساسية حول طبيعة المعرفة. يعتمد العلم على التجريبية والملاحظة والتحقق، في حين يعتمد اللاهوت والخرافات غالبًا على الإيمان والاعتقاد الساذج والتقاليد. تسلط هذه الأساليب المختلفة الضوء على مفاهيم متباينة لما يشكل ما نسميه عموماً جوهر وماهية "الحقيقة" . يعتمد المنهج العلمي على قابلية التشكيك والتكذيب والتجريب والتكرار. لأنه لايدّعي امتلاك الحقيقة المطلقة وهذا يتناقض بشكل صارخ مع العقائد الدينية والخرافات، التي لا تخضع لنفس معايير التحقق، والتي تدّعي امتلاك الحقيقة المطلقة لأنها متصلة بالسماء وبالله وبالتالي فإن دور المنهج العلمي في اكتساب المعرفة الموثوقة والقابلة للتكرار هو نقطة مركزية في هذا الصراع. إن الصراع بين الروح العلمية والروح الخرافية واللاهوتية هو أمر ثابت في تاريخ البشرية وما يزال مستمراً إنه يعكس التوترات العميقة بين الطرق المختلفة لفهم العالم وإيجاد المعنى. على الرغم من أن العلم قد حقق تقدمًا مذهلاً في تقديم تفسيرات عقلانية وتجريبية، إلا أن المعتقدات الدينية والخرافية لا تزال تلعب دورًا مهمًا في العديد من الثقافات. إن فهم هذا الصراع يسمح لنا بفهم أفضل لديناميكيات المعرفة الإنسانية والتحديات التي تواجهها.
لذا يمثل الصراع بين العقل العلمي والعقل الخرافي واللاهوتي كما قلنا، ثنائية تاريخية وفلسفية مهمة شكلت تطور المعرفة البشرية والمعايير المجتمعية. تطورت هذه العلاقة المعقدة من عصر النهضة العلمية وعصر التنوير، حيث بدأت الاكتشافات الرائدة والمنهجيات التجريبية في تحدي وجهات النظر الدينية والخرافية الراسخة، إلى المناقشات المعاصرة حول مواضيع مثل التطور والخلق وسياسات الصحة العامة. كانت الثورة العلمية بمثابة انحراف عن الفلسفة السكولائية المدرسية في العصور الوسطى والفيزياء الأرسطية، مع التركيز على الملاحظة المنهجية والاستقصاء العقلاني وشكلت بديلاً عن التفسيرات الإلهية والخارقة للطبيعة للظواهر الطبيعية. ومن الجدير بالذكر أن الأحداث والشخصيات التاريخية الرئيسية، مثل محاكمة غاليليو غاليليه بتهمة الهرطقة وحرق جيوردانو برونو وهو حياً في عام 1600، وترويج "أطروحة الصراع" من قبل جون ويليام درابر وأندرو ديكسون وايت، تؤكد على التوترات التي نشأت بين التقدم العلمي والعقائد الدينية. إن دفاع غاليليو عن مركزية الشمس واضطهاده اللاحق من قبل محاكم التفتيش الكنسية يوضح وحشية القمع الفكري الذي مارسته السلطات الدينية على التقدم العلمي. وعلى الرغم من فضح المؤرخين المعاصرين على نطاق واسع لـ "أطروحة الصراع"، إلا أنها أوضحت بشكل أكبر التوتر التاريخي الملحوظ بين العلم والدين. في العصر الحديث، يستمر النقاش في مجالات مثل علم الأحياء التطوري مقابل الخلقية أو نظرية الخلق الربانية كما جاءت في سفر التكوين التوراتي، واستجابة الجمهور للمبادئ التوجيهية العلمية، مما يسلط الضوء على الاحتكاك المستمر بين الأدلة التجريبية والمعتقدات الشخصية أو المجتمعية. وقد ساهم فلاسفة مثل فرانسيس بيكون ورينيه ديكارت في هذا الخطاب، حيث ميزوا بين النهج التجريبي والعقلاني للمعرفة. إن هذا التوتر الفلسفي يمتد إلى المناقشات اللاهوتية، حيث سعت شخصيات مثل توما الأكويني إلى التوفيق بين الإيمان والعقل. إن التأثير الاجتماعي والثقافي لهذا الصراع واضح عبر سياقات تاريخية مختلفة، بما في ذلك العصر الذهبي الإسلامي والتحديات التعليمية المعاصرة. وقد ساهمت شخصيات بارزة مثل تشارلز داروين وتوماس هنري هكسلي في تشكيل المناقشة بشكل أكبر، من خلال الدعوة إلى دمج التفكير العلمي في مناهج التعليم في فهمنا للأصول البشرية. كما توفر وجهات النظر النفسية حول الخرافات والمعتقدات الخارقة للطبيعة رؤى حول العمليات المعرفية والعاطفية الكامنة وراء هذه المعتقدات، مما يوضح التفاعل المعقد بين الشخصية والتأثيرات الثقافية وأنظمة المعتقدات. بشكل عام، يستمر الحوار المستمر بين الاستقصاء العلمي والمنظورات الخرافية أو اللاهوتية في التأثير على فهمنا الجماعي للعالم، مما يدفع إلى الصراع دائماً ونادراً ما يدفع نحو المصالحة وعلى نحو مؤقت ويؤكد هذا التفاعل الديناميكي على أهمية ربط المعرفة العلمية مع السياقات الثقافية والدينية لتعزيز رؤية أكثر دقة وشمولية للمعرفة البشرية والتنمية.
المنظورات التاريخية: ركز عصر النهضة العلمية بشكل كبير على استعادة المعرفة القديمة، وبلغت ذروتها في نشر إسحاق نيوتن كتاب "المبادئ" عام 1687، والذي صاغ قوانين الحركة والجاذبية الكونية، وبالتالي بدأ تشييد علم الكونيات الجدي. مهدت هذه الفترة الطريق لعصر التنوير اللاحق، حيث تم التعبير عن مفهوم الثورة العلمية من قبل مفكرين في القرن الثامن عشر مثل جان سيلفان بيلي، الذي وصفها بأنها عملية من مرحلتين لتفكيك القديم وتأسيس الجديد. غالبًا ما يُنظر إلى الثورة العلمية على أنها تتفوق على الأحداث التاريخية الأخرى مثل عصر النهضة والإصلاح بسبب تأثيرها العميق على العالم الحديث والعقلية الجمعية، مما يجعل الفترات التقليدية للتاريخ الأوروبي عتيقة إلى حد ما. الباحث بيتر هاريسون في كتابه يُشيد بدور المسيحية المهم في ظهور الثورة العلمية، مسلطًا الضوء على العلاقة المتشابكة بين التطورات الدينية والعلمية خلال هذه الفترة. يتميز هذا التحول النموذجي بالابتعاد عن الفلسفة السكولائية المدرسية في العصور الوسطى والفيزياء الأرسطية، مما يمثل تحولًا كبيرًا في فهم الظواهر الطبيعية وإدارتها. نشأ تفسيران رئيسيان فيما يتعلق بأسلوب حكم العالم: أحدهما يدعو إلى التدخلات الإلهية المستمرة والآخر لتشغيل القوانين الطبيعية غير المتغيرة. استفادت السلطات الكهنوتية من دورها الوسيط بين الأفعال الإلهية والصلوات البشرية، ومالت بشكل طبيعي نحو التفسير الأول. بمرور الوقت، ومع بدء الأساليب العلمية والاستقصاء العقلاني في تحدي واستبدال التفسيرات الخرافية واللاهوتية، أصبحت النصوص والأدلة التجريبية ذات أهمية قصوى. يؤكد هذا التحول على الصراع الأوسع بين العقل العلمي، الذي يعتمد على الملاحظة المنهجية والعقلانية، والعقل الخرافي واللاهوتي، الذي يعتمد غالبًا على التفسيرات الإلهية والخارقة للطبيعة للظواهر الطبيعية. لم تكن التغييرات الجذرية التي جلبتها الثورة العلمية فكرية فحسب، بل كانت لها أيضًا آثار اجتماعية وسياسية عميقة. لقد شهدت مؤسسات مثل الكنيسة الرومانية، التي مارست سابقًا نفوذًا كبيرًا على جوانب مختلفة من الحياة، تحديًا لقوتها وسلطتها من خلال النماذج العلمية الجديدة والتحول المصاحب نحو نظرة عالمية أكثر علمانية وعقلانية.
نظرية التطور والخلقية أو نظرية الخلق الإلهي:
استمرت الصراعات بين العلم والدين حتى العصر الحديث، وخاصة حول موضوعي التطور والخلقية. أو الخلق الرباني. تشير الدراسات الاستقصائية التي أجريت في عامي 2009 و2014 إلى أن جزءًا كبيرًا من الجمهور الأمريكي يدرك وجود صراع بين التفسيرات العلمية لأصول الحياة والمعتقدات الدينية حول الخل. لا يزال التوتر بين نظرية التطور، التي تدعمها مجموعة قوية من الأدلة العلمية، ووجهات نظر الخلقية، التي تتجذر في العقيدة الدينية، قضية مثيرة للجدال في المناقشات التعليمية والسياسية العامة. سلطت جائحة كوفيد-19 الأخيرة الضوء على الاحتكاك المستمر بين المبادئ التوجيهية العلمية والالتزام العام المتأثر بالمعتقدات والمواقف المتنوعة. أثناء الوباء، قوبلت تدابير الصحة العامة مثل عمليات الإغلاق، وفرض ارتداء الكمامات، ومتطلبات اللقاح بمقاومة من شرائح من السكان، مما يوضح كيف يمكن أن تتعارض التوصيات العلمية مع المعتقدات الشخصية والمعايير المجتمعية. تعكس هذه الخلافات أسئلة فلسفية أعمق حول الطبيعة البشرية، ومكاننا في الكون، ومسؤولياتنا تجاه بعضنا البعض كأعضاء في مجتمع مشترك. إن فهم هذه الصراعات والمناقشات الرئيسية يساعد في توضيح التعقيدات التي تحيط بالعالم. والعلاقة المتطورة بين البحث العلمي وأنظمة المعتقدات الأخرى، سواء كانت متجذرة في الدين أو الخرافة أو أطر أخرى.
الأسس الفلسفية:
مع بداية الثورة العلمية، أصبحت التجريبية بالفعل مكونًا مهمًا من العلوم والفلسفة الطبيعية. بدأ المفكرون السابقون، بما في ذلك الفيلسوف الاسمي ويليام أوكام في أوائل القرن الرابع عشر، الحركة الفكرية نحو التجريبية. دخل مصطلح "التجريبية البريطانية" حيز الاستخدام لوصف الاختلافات الفلسفية الملحوظة بين اثنين من مؤسسيها: فرانسيس بيكون، الذي وُصف بأنه تجريبي، ورينيه ديكارت، الذي وُصف بأنه عقلاني. كان توماس هوبز وجورج بيركلي وديفيد هيوم من أبرز رواد الفلسفة الذين طوروا تقليدًا تجريبيًا متطورًا كأساس للمعرفة البشرية. من أجل الحصول على المعرفة والسيطرة على الطبيعة، حدد بيكون في عمله نظامًا جديدًا للمنطق اعتقد أنه متفوق على الطرق القديمة للقياس المنطقي، وطور منهجه العلمي. تتألف هذه الطريقة من إجراءات لعزل السبب الرسمي لظاهرة ما (الحرارة، على سبيل المثال) من خلال الاستقراء الإقصائي. أكد بيكون على أنه يجب على الفيلسوف أن ينتقل من خلال الاستدلال الاستقرائي من الحقيقة إلى البديهية إلى القانون الفيزيائي. ومع ذلك، فقد لاحظ أيضًا أنه قبل البدء في هذا الاستقراء، يجب على السائل أن يحرر عقله من بعض المفاهيم أو الاتجاهات الخاطئة التي تشوه الحقيقة. على وجه التحديد، انتقد حقيقة أن الفلسفة كانت مشغولة جدًا بالكلمات والنقاش بدلاً من الملاحظة الفعلية للعالم المادي . استمر التباين بين الفلسفات التجريبية والعقلانية في التطور. أبرز ديكارت والمفكرون اللاحقون مثل كارل بوبر وتوماس ناغل أن الفكر العقلاني هو مسعى معياري لا يمكن تفسيره بالكامل بمصطلحات علمية بحتة . يعكس هذا توترا فلسفيا أوسع: فبينما يهدف العلم الطبيعي إلى وصف ما هو موجود، يتعامل الفكر العقلاني مع الحقائق المعيارية حول ما ينبغي أن يكون. وتؤكد هذه الثنائية على العلاقة المعقدة بين الملاحظة التجريبية والاستدلال العقلاني. يمتد هذا التناقض الفلسفي إلى المناقشات اللاهوتية. على سبيل المثال، وصف البابا يوحنا بولس الثاني في رسالته العامة "الإيمان والعقل" الإيمان والعقل كجناحين متكاملين يرفعان الروح البشرية نحو التأمل في الحقيقة. هذه الفكرة لها جذور تاريخية، حيث دمج آباء الكنيسة الأوائل الفلسفة اليونانية للدفاع عن الإيمان، وهو التوليف الذي بلغ ذروته مع كتابات توما الأكويني في القرن الثالث عشر. لقد أثر دمج توما الأكويني للإيمان والعقل بشكل عميق على الفكر الكاثوليكي، وربطه بشكل وثيق بالأسس الفكرية للعلم الحديث.
التأثير الاجتماعي والثقافي:
أدى تقاطع التقدم العلمي والمعايير المجتمعية إلى تغييرات عميقة في كيفية إدراك الأفراد والمجتمعات لأنفسهم وعلاقاتهم مع الآخرين. إن هذه الظاهرة واضحة بشكل خاص في سياق ثورة تكنولوجيا المعلومات، والواقع الافتراضي، والاتصالات العالمية، والتي غيرت بشكل كبير العلاقات الشخصية، والقوى العاملة، والتعليم، والنسيج المجتمعي الأوسع . تؤثر هذه التحولات حتماً على المجالات الفكرية والعاطفية والعلاقاتية للحياة البشرية، مما يطرح تحديات وفرصًا لدمج الثقافة العلمية في الحياة اليومية. وعلاوة على ذلك، يوضح التقدم التاريخي للحضارات نمطًا في تطوير ونشر المعرفة العلمية. على سبيل المثال، خلال ذروة العصر الذهبي الإسلامي، أدى الاستخدام الواسع النطاق للغة العربية، إلى جانب الأطر الدينية والسياسية المشتركة، إلى تسهيل انتشار الأفكار العلمية في جميع أنحاء العالم الإسلامي. تم نقل المعرفة العلمية من خلال كل من الشبكات غير الرسمية، مثل المراسلات بين العلماء، والمؤسسات الرسمية مثل المستشفيات والمراصد. وعلى الرغم من هذه الفترة المزدهرة، إلا أن تراجع الخلافة العباسية كان بمثابة نقطة تحول، مما أدى إلى ركود التقدم العلمي في السياق الإسلامي . كما أن التأثير الاجتماعي والثقافي للعلم واضح أيضًا في البيئات المعاصرة. إن الدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل الإمارات العربية المتحدة، تظهر مستويات عالية من التحضر والتطور التكنولوجي ولكنها غالبًا ما تكون أقل أداءً في مقاييس الناتج البحثي العلمي، مثل المنشورات والاستشهادات . كما تعمل هذه المناطق كأرض خصبة للاعتقادات الزائفة، بما في ذلك نظرية خلق الأرض القديمة والممارسات الطبية غير التقليدية، مما يسلط الضوء على التوتر بين المنظورات العلمية واللاهوتية في المجتمع الحديث . في السياقات التعليمية، يظل التحدي قائمًا في نقل المعرفة حول طبيعة العلم (NOS) بشكل فعال من الفهم النظري إلى التطبيق العملي. هذه القضية ذات صلة خاصة بالمعلمين قبل الخدمة الذين قد يتفوقون في وصف مفاهيم NOS ولكنهم يكافحون من أجل دمجها في سياقات أخرى. إن تبني المجتمع الأوسع لمحو الأمية العلمية يتطلب بالتالي نهجًا دقيقًا يأخذ في الاعتبار كل من السوابق التاريخية والتحديات المعاصرة في مواءمة المعرفة العلمية مع السياقات الثقافية والدينية. شخصيات بارزة قد شكّلت الصراع بين المنظورين العلمي واللاهوتي من خلال مساهمات العديد من الشخصيات البارزة. كان تشارلز داروين مترددًا في البداية في النشر عن أصول الإنسان ولم يناقش التطور البشري في عمله الرائد، . ومع ذلك، فقد أكد أن "الضوء سيُلقى على أصل الإنسان وتاريخه" (1859: 487). حدد داروين لاحقًا إفريقيا كمكان محتمل لنشأة البشر واستخدم التشريح المقارن لإظهار أن الشمبانزي والغوريلا كانت وثيقة الصلة بالبشر في عمله 1871 .كان توماس هنري هكسلي، الذي يُشار إليه غالبًا باسم "تابع داروين" لدفاعه القوي عن نظرية داروين في التطور، فعّالاً في جلب المناقشة حول التطور البشري إلى الصدارة. في كتابه الصادر عام 1863، ناقش هكسلي الأدلة الأحفورية مثل حفريات إنسان نياندرتال التي تم اكتشافها مؤخرًا من جبل طارق، حيث قدم إحدى أولى الحجج الشاملة للتطور البشري من منظور داروين. في القرن العشرين، انخرط علماء الأنثروبولوجيا القديمة في مناقشات حول الجدول الزمني للتطور البشري. لقد جادلوا فيما إذا كان البشر قد انفصلوا عن القردة العليا الأخرى منذ حوالي 15 مليون سنة أو منذ حوالي 5 ملايين سنة. وقد تم تسليط الضوء على هذا النقاش في النهاية من خلال التفاعلات الجزيئية - أولاً من خلال الاستجابات المناعية ثم من خلال الأدلة الجينية المباشرة. على سبيل المثال، كان العمل الذي قام به ريو وآخرون (2014) حول معايرة ساعة الميتوكوندريا البشرية باستخدام الجينومات القديمة محوريًا في هذا السياق. إن أصول الإنسان ليست مجرد مسألة بحث علمي بل هي أيضًا موضوع متشابك بعمق مع الاعتبارات الدينية والفلسفية. ففي المسيحية واليهودية وبعض فروع الإسلام، يُعتقد أن البشر قد خُلقوا على صورة الله. وقد تم تفسير هذا المفهوم بطرق مختلفة، بما في ذلك التفسيرات الوظيفية والبنيوية والعلائقية. وجهات النظر النفسية: لطالما كانت الخرافات والمعتقدات الخارقة للطبيعة موضوعات للبحث النفسي، لأنها تقدم رؤى حول العمليات المعرفية والعاطفية التي تكمن وراء السلوك البشري. غالبًا ما تدرس وجهات النظر النفسية حول هذه الموضوعات كيف يُشكّل الأفراد مثل هذه المعتقدات ويحافظون عليها، فضلاً عن الفوائد والأضرار المحتملة المرتبطة بها. الوسطاء المعرفيون والنفسيون القلق والسيطرة المدركة هي عوامل مهمة في تكوين المعتقدات الخرافية والخارقة للطبيعة. وجد وات وواتسون وويلسون أن الأفراد الذين لديهم مستويات عالية من القلق هم أكثر عرضة لاعتناق مثل هذه المعتقدات، ربما كوسيلة لممارسة الشعور بالسيطرة على المواقف غير المؤكدة. على نحو مماثل، أظهر تيرهون وسميث أن الإيحاء وبعض سمات الشخصية الإدراكية المعرفية يمكن أن تحفز تجارب شاذة لدى الأفراد، مما يدعم فكرة أن العمليات المعرفية تلعب دورًا حاسمًا في هذه المعتقدات. التحيزات المعرفية والأساليب الإرشادية توفر نظرية العملية المزدوجة للإدراك، والتي تتضمن عمليات التفكير الترابطية والحدسية (النظام 1) وعمليات التفكير التحليلي والتأملي (النظام 2)، إطارًا لفهم التفكير الخرافي. النظام 1 سريع وتلقائي، مما يجعله عرضة للتحيزات مثل الأسلوب الإرشادي للتوافر، حيث يحكم الناس على احتمالية الأحداث بناءً على مدى سهولة تذكرهم لحالات مماثلة. يمكن أن يؤدي هذا إلى تكوين معتقدات خرافية، حيث تصبح النتائج السلبية التي تلي الأفعال المغرية للقدر أكثر سهولة في الوصول إليها إدراكيًا وبالتالي يُنظر إليها على أنها أكثر احتمالية. وهناك التنظيم العاطفي والتأثير الإيجابي حيث من المثير للاهتمام أن التفكير الخرافي يمكن أن يتأثر بالحالة العاطفية للفرد. لقد ثبت أن التأثير الإيجابي يعزز التفكير الخرافي، في حين يمكن وصف الاكتئاب بأنه "فقدان للأوهام الإيجابية". وهذا يشير إلى أنه في حين أن الخرافات قد تكون غير عقلانية في بعض الأحيان، إلا أنها يمكن أن تؤدي وظيفة علاجية من خلال توفير الراحة وتقليل القلق. قد تحتاج الأبحاث المستقبلية إلى موازنة الجوانب غير العقلانية للخرافات مقابل فوائدها النفسية المحتملة. الارتباطات الشخصية: استكشف البحث أيضًا السمات الشخصية المرتبطة بالمعتقدات الخارقة للطبيعة. وجد غليكسون أن الأفراد الذين يؤمنون بالخوارق غالبًا ما يكون لديهم تعقيد إدراكي أعلى، مما قد يمكنهم من الترفيه عن مجموعة أوسع من الاحتمالات. اكتشف راتيت وبورسيك أن بعض سمات الشخصية، مثل الانفتاح على التجربة والبحث عن الأحاسيس، ترتبط باحتمالية أعلى للاحتفاظ بمعتقدات خارقة للطبيعة. تسلط هذه النتائج الضوء على التفاعل المعقد بين الشخصية وأنظمة المعتقدات. إن تأثيرات العوامل الاجتماعية والثقافية لها أيضًاً دور إذ تلعب المعتقدات الخرافية دورًا مهمًا في تشكيل المعتقدات الخرافية والخارقة للطبيعة. اقترح روزين ونيمروف أن المعتقدات الخرافية حول الصفات المعدية لسوء الحظ يمكن أن تساهم في الوصمة الاجتماعية والاغتراب، كما هو الحال في المخاوف التاريخية المحيطة بأمراض مثل الإيدز . يمكن أن تؤثر هذه المعتقدات على السلوك والمواقف العامة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى عواقب وخيمة. دراسات حالة المبتدئ البسيط: مشاركة تُعرف باسم سالي Sally تتضمن إحدى دراسات الحالة التوضيحية في فحص الصراع بين المنظورات العلمية والخرافية أو اللاهوتية. في تحليل نوعي لأفعالها أثناء المحاكاة، أظهرت محاكاة سالي غلبة للأفعال التحقيقية، مثل توليد فرضيات جديدة وإجراء الاختبارات واستخلاص النتائج. تتوافق هذه الأنشطة مع النماذج الراسخة للنشاط العلمي التي تعطي الأولوية للتجريب وتوليد الفرضيات وتقييم الأدلة . تشير مثل هذه الإجراءات التحقيقية إلى أن معتقدات سالي المعرفية تميل نحو البحث العلمي والفهم بأن المعلومات العلمية يمكن أن تتغير مع وجود أدلة جديدة، على النقيض من النظرة الثابتة المرتبطة غالبًا بالعقليات اللاهوتية أو الخرافية المرتبطة بالمعتقدات الدينية في الأوساط الأكاديمية تاريخيًا كانت متشابكة ومتناقضة، كانت العلاقة بين البحث العلمي والمعتقد الديني معقدة. خلال القرن السابع عشر، رأى العديد من الفلاسفة الطبيعيين، بما في ذلك إسحاق نيوتن، أعمالهم العلمية كدليل على الخلق الإلهي. ومع ذلك، بحلول القرنين التاسع عشر والعشرين، بدأ تديُّن العلماء في الانحدار، وانحرفت مواقفهم بشكل كبير عن عامة السكان. توضح الأمثلة المعاصرة مثل فرانسيس كولينز، الزعيم السابق لمشروع الجينوم البشري، استثناءات لهذا الاتجاه. دعا كولينز بنشاط إلى توافق العلم والمسيحية من خلال كتابه "لغة الله" (2006) ومعهد بيولوغوس . مركزية الشمس والثورة العلمية: إن التحول من مركزية الأرض إلى مركزية الشمس يوفر دراسة حالة أخرى ذات صلة. فقد اقترح أريستارخوس الساموسي لأول مرة نموذج مركزية الشمس، الذي يضع الشمس في مركز الكون بدلاً من الأرض، في القرن الثالث قبل الميلاد. وعلى الرغم من أساسه التجريبي، لم يكتسب النموذج سوى القليل من الجاذبية والاهتمام في أوروبا في العصور الوسطى، حيث كانت الآراء اللاهوتية تهيمن على الفكر العلمي. ولم تبدأ مركزية الشمس في تحدي نموذج مركزية الأرض الراسخ حتى ظهور أعمال كوبرنيكوس وغاليليو وكبلر في عصر النهضة، مما يمثل تحولاً كبيراً نحو التفكير العلمي على حساب العقيدة اللاهوتية.
نظرية الانفجار العظيم:
إن تطور نظرية الانفجار العظيم يؤكد على الصراع والتقارب النهائي بين المنظورين العلمي واللاهوتي. وقد واجهت النظرية، التي اقترحها في البداية عالم الكونيات البلجيكي والقس الكاثوليكي جورج لوميتر في عام 1927، شكوكًا داخل المجتمع العلمي. ومع ذلك، فإن اكتشاف إدوين هابل للمجرات التي تتحرك بعيدًا عن بعضها البعض قدم دليلاً حاسمًا يدعم نموذج الكون المتوسع الذي اقترحه لوميتر. تمثل هذه النظرية، التي تصف الكون الناشئ عن تفرد أو فرادة كونية، تحولًا كبيرًا عن نظريات علم الكونيات السابقة المتأثرة باللاهوت والتي افترضت كونًا ثابتًا. تسلط دراسات الحالة هذه الضوء على العلاقة المتطورة بين الاستقصاء العلمي والمعتقدات الدينية أو الخرافية. في حين توضح الأمثلة التاريخية والمعاصرة التوتر بين هذه النظريات العالمية، فإنها توضح أيضًا كيف اكتسب التفكير العلمي القبول تدريجيًا، وغالبًا ما يدمج المفاهيم اللاهوتية أو يعيد تفسيرها في هذه العملية. الحل والمصالحة التأمل في تحول الفهم تكشف الرحلة التاريخية للعلم والدين عن تطور عميق في علاقتهما، والتي تتميز بفترات من الصراع والتباين والاتصال والتأكيد . أحد التأملات المهمة هو أن العوامل الاجتماعية والسياسية تلعب دورًا حاسمًا في بناء ما يُقبل كمعرفة علمية. يعمل المجتمع العلمي في إطار تاريخي حيث تعد الآليات مثل التدريب الأكاديمي وعمليات مراجعة الأقران ضرورية لأفضل الممارسات وقمع الآراء المنحرفة . سلط العمل الرائد لتوماس كون، "بنية الثورات العلمية"، الضوء على الطابع الجماعي للمشروع العلمي، وهو الوعي الذي كان محوريًا في تحويل الفهم الإرث والتأثير المستمر: لقد شكل الحوار بين العلم والدين بشكل كبير علاقتهما المعاصرة. اقترح وينتزل فان هوستين أن العلم والدين يمكن أن ينخرطا في ثنائي رشيق بناءً على تداخلاتهما المعرفية، مع الحفاظ على مجالاتهما المتميزة ولكن من خلال المحادثة والحوار ومن خلال الأساليب والمفاهيم والافتراضات المشتركة يفتح هذا المنظور مسارات للتفاعل الهادف والإثراء المتبادل، والانتقال من مجرد الصراع إلى مساحة من التعاون من أجل الفهم الإيجابي للطرفين.
تقاطع العلم والدين في السياق العالمي بات ملحوظاً، وكانت العلاقة بين العلم والدين متنوعة. وقد كشفت الأبحاث التي أجراها مركز بيو للأبحاث والتي شملت مسلمين وهندوس وبوذيين في ماليزيا وسنغافورة عن وجهات نظر متنوعة حول كيفية ارتباط العلم بالدين. وتسلط هذه المقابلات الضوء على أن التفاعل بين العلم والدين ليس متجانسًا ولكنه غني بالسياقات ومتعدد الأوجه. بالإضافة إلى ذلك، فإن فكرة أن المؤسسات الدينية والعلمانية يمكن أن تعزز السلوكيات الاجتماعية والمعادية للمجتمع تزيد من تعقيد علاقتهما. المشروع العلمي والكرامة الإنسانية: المشروع العلمي ليس موضوعيًا بحتًا ولكنه متشابك بعمق مع القيم الإنسانية والكرامة. يمثل العلم مجموعة من المعرفة التي لا غنى عنها ليس فقط للتنمية الفكرية ولكن أيضًا للنمو الروحي. إن وحدة المعرفة، التي تربط بين العقل والإيمان، أمر بالغ الأهمية للتنمية الشاملة للأفراد والمجتمعات . يُنظر إلى نشر المعرفة العلمية على أنه حق، وتثقيف الجمهور حول التقدم العلمي واجب، مما يسلط الضوء على دور العلم في تحقيق الصالح العام وتعزيز التنمية البشرية.
وأخيراً وليس آخراً أودّ أن أقول إنها منذ فجر البشرية وإلى يوم الناس هذا، كان هذا " الثالوث المُحيّر " الله، الدين، العلم " وهو عنوان كتابي بثلاثة أجزاء، يثير الخوف والخشية، وفيه طرفان يدعيان امتلاك الحقيقة المطلقة بينما يعمل الثالث على اكتشاف الحقيقة النسبية القابلة للتغيير والتطور كلما تقدمت التكنولوجيا والنظريات العلمية. ولكن هل توجد حقاً " حقيقة مطلقة؟" فالإله يأخذ أشكالاً وتعاريف وماهيات وصفات مختلفة من طرف لآخر، ولا ندري إن كان موجود حقاً أم هو مجرد فرضية أو ضرورة سيكولوجية أوردتها الأديان والمعتقدات البشرية وعزتها لذات متعالية متسامية أسمتها الله، وبكل لغات الأرض، أو اختلقتها البشرية لتراقب نفسها عبرها. أما الدين فقصته أكثر غموضاً وخطورة. فلقد حكم وسيّر سلوك البشر وما يزال منذ آلاف السنين، وأوجد مؤسسات دينية أفرزت كافة أنواع الشرور والعنف والحروب والبطش والقتل الوحشي والتكفير والسيطرة على عقول البشر بإسم الإله أو الرب أو الله، أما الطرف الثالث فهو ما يزال يحبو ويجرب، يفشل هنا وينجح هناك، على نحو نسبي، ويسعى إلى تحسين الوعي البشري والبحث عن أجوبة للأسئلة الكبرى التي تطرحها الإنسانية على نفسها. عن الأصل والمصير، عن المستقبل والمآل الذي ينتظر البشرية، ويبقى صعباً على الإدراك والفهم العام فيما عدا نخبة قليلة من العلماء، ويواجه دوماً جملة من التحديات والظواهر التي يعجز عن فهمها وتفسيرها ومنها أصل الحياة وسرها. ما معنى الحياة؟ أو ما معنى وجودنا بشكلٍ عام؟ من الوهلة الأولى يبدو أنه سؤال ينتمي إلى حقل الفلسفة والدين والفكر المجرد، ولا علاقة له بالعلم. لكن الكثير من موضوعات الفلسفة والدين صارت تقع الآن تحت طائلة العلم، وبالأخص علم الفيزياء. وما هذا الكتاب سوى محاولة متواضعة للغوص في هذه الأقانيم المجهولة لإيقاد شمعة في ظلمة الوجود.
وبهذا الصدد تذكرت طرفتين، الأولى هي عندما سأل أحدهم القديس أوغسطين ماذا كان يفعل الله قبل خلقه للكون والإنسان فرد عليه الفيلسوف القديس : كان يحضّر نار جهنم لمن سيسألون هذا السؤال مثلك. والثاني هي عندما التقى ستيفن هوكينغ بالبابا يوحنا فقال العالم البريطاني للحبر الأعظم ألا تسلّمون أخيراً بصحة نظرية الانفجار العظيم فرد عليه البابا بشرط أن تسلّمون أنتم بصحة أطروحتنا فدعو لنا ماقبل البغ بانغ ونترك لكم يامعشر علماء الفيزياء الكونية ما بعد البغ بانغ.
يُمثّل الصراع بين العقل العلمي والعقل الخرافي واللاهوتي انقسامًا تاريخيًا وفلسفيًا هامًا شكّل تطور المعرفة البشرية والمعايير المجتمعية. تطورت هذه العلاقة المُعقّدة من عصر النهضة العلمية وعصر التنوير، حيث بدأت الاكتشافات الرائدة والمنهجيات التجريبية بتحدي الرؤى العالمية الدينية والخرافية الراسخة، إلى النقاشات المعاصرة حول مواضيع مثل التطور والخلق وسياسات الصحة العامة. مثّلت الثورة العلمية انحرافًا عن الفلسفة المدرسية في العصور الوسطى والفيزياء الأرسطية، مُركّزة على الملاحظة المنهجية والبحث العقلاني على التفسيرات الإلهية والخارقة للطبيعة للظواهر الطبيعية.
من الجدير بالذكر أن أحداثًا وشخصيات تاريخية رئيسية، مثل محاكمة غاليليو غاليلي بتهمة الهرطقة، وترويج "أطروحة الصراع" من قبل جون ويليام درابر وأندرو ديكسون وايت، تُبرز التوترات التي نشأت بين التقدم العلمي والمذاهب الدينية. وتُجسّد مناصرة غاليليو لمركزية الشمس، وما تلاه من اضطهاد من قِبل محاكم التفتيش الرومانية، القمع الفكري الذي مارسته السلطات الدينية على التقدم العلمي. وتُوضح "أطروحة الصراع"، على الرغم من دحضها على نطاق واسع من قِبل المؤرخين المعاصرين، التوتر التاريخي الملحوظ بين العلم والدين. في العصر الحديث، لا يزال الجدل قائمًا في مجالات مثل علم الأحياء التطوري مقابل نظرية الخلق، واستجابة الجمهور للتوجيهات العلمية خلال جائحة كوفيد-19، مما يُسلّط الضوء على الاحتكاك المستمر بين الأدلة التجريبية والمعتقدات الشخصية أو المجتمعية. وقد ساهم فلاسفة مثل فرانسيس بيكون ورينيه ديكارت في هذا الخطاب، حيث فرّقوا بين النهجين التجريبي والعقلاني للمعرفة. يمتد هذا التوتر الفلسفي إلى المناقشات اللاهوتية، حيث سعت شخصيات مثل توما الأكويني إلى التوفيق بين الإيمان والعقل.
يتجلى التأثير الاجتماعي والثقافي لهذا الصراع عبر سياقات تاريخية مختلفة، بما في ذلك العصر الذهبي الإسلامي والتحديات التعليمية المعاصرة. وقد ساهمت شخصيات بارزة مثل تشارلز داروين وتوماس هنري هكسلي في تشكيل النقاش بشكل أكبر، داعيةً إلى دمج التفكير العلمي في فهمنا لأصول الإنسان. كما توفر وجهات النظر النفسية حول الخرافات والمعتقدات الخارقة للطبيعة رؤى ثاقبة حول العمليات المعرفية والعاطفية الكامنة وراء هذه المعتقدات، مما يوضح التفاعل المعقد بين الشخصية والتأثيرات الثقافية وأنظمة المعتقدات.
بشكل عام، لا يزال الحوار المستمر بين البحث العلمي والمنظورات الخرافية أو اللاهوتية يؤثر على فهمنا الجماعي للعالم، مما يدفع إلى الصراع والمصالحة. ويؤكد هذا التفاعل الديناميكي على أهمية دمج المعرفة العلمية مع السياقات الثقافية والدينية لتعزيز رؤية أكثر دقة وشمولاً للمعرفة البشرية والتنمية.
وجهات نظر تاريخية
ركز عصر النهضة العلمية بشكل كبير على استعادة المعارف القديمة، وبلغت ذروتها بنشر إسحاق نيوتن كتابه "المبادئ" عام 1687، الذي صاغ قوانين الحركة والجاذبية الكونية، مُكملًا بذلك توليف علم كونيات جديد. مهدت هذه الفترة الطريق لعصر التنوير اللاحق، حيث صاغ مفكرون من القرن الثامن عشر، مثل جان سيلفان بايلي، مفهوم الثورة العلمية، ووصفها بأنها عملية من مرحلتين لتفكيك القديم وتأسيس الجديد.
غالبًا ما يُنظر إلى الثورة العلمية على أنها تفوقت على أحداث تاريخية أخرى مثل عصر النهضة والإصلاح الديني، نظرًا لتأثيرها العميق على العالم الحديث وعقليته، مما جعل التصنيفات التقليدية للتاريخ الأوروبي قديمة بعض الشيء. يعزو الباحث بيتر هاريسون... لعبت المسيحية دورًا هامًا في صعود الثورة العلمية، مسلطًا الضوء على العلاقة المتشابكة بين التطورات الدينية والعلمية خلال هذه الفترة.
يتميز هذا التحول النموذجي بالابتعاد عن الفلسفة المدرسية في العصور الوسطى والفيزياء الأرسطية، مما يمثل تحولًا كبيرًا في فهم الظواهر الطبيعية وإدارتها. برز تفسيران رئيسيان فيما يتعلق بأسلوب إدارة العالم: أحدهما يدعو إلى التدخلات الإلهية المستمرة والآخر إلى تشغيل القوانين الطبيعية الثابتة. استفادت مؤسسة الكهنوت من دورها الوسيط بين الأفعال الإلهية والصلوات البشرية، مما جعلها تميل بشكل طبيعي نحو التفسير الأول.
بمرور الوقت، ومع بدء الأساليب العلمية والاستقصاء العقلاني في تحدي التفسيرات الخرافية واللاهوتية واستبدالها، أصبحت أهمية النصوص والأدلة التجريبية ذات أهمية قصوى. يُبرز هذا التحول الصراع الأوسع بين العقل العلمي، الذي يعتمد على الملاحظة المنهجية والعقلانية، والعقل الخرافي واللاهوتي، الذي غالبًا ما اعتمد على تفسيرات إلهية وخارقة للطبيعة للظواهر الطبيعية.
لم تكن التغييرات الجذرية التي أحدثتها الثورة العلمية فكرية فحسب، بل كانت لها أيضًا آثار اجتماعية وسياسية عميقة. فقد شهدت مؤسسات مثل الكنيسة الرومانية، التي كانت تمارس سابقًا نفوذًا كبيرًا على جوانب مختلفة من الحياة، تحديًا لسلطتها وسلطتها من خلال النماذج العلمية الجديدة والتحول المصاحب لها نحو رؤية عالمية أكثر علمانية وعقلانية.
كان التفاعل التاريخي بين البحث العلمي والمعتقدات الدينية أو الخرافية محفوفًا بالصراعات والنقاشات، وقد تجسد ذلك في العديد من الأحداث والشخصيات الرئيسية.
محاكمة غاليليو غاليلي
أصبح غاليليو غاليلي، عالم الفلك والفيزياء والمؤلف الإيطالي، رمزًا للصراع بين العقيدة الدينية والبحث العلمي، وذلك بعد محاكمته بتهمة الهرطقة أمام محاكم التفتيش الرومانية عام1633. وكان دعمه لنظرية مركزية الشمس لنيكولاس كوبرنيكوس، التي افترضت أن الأرض تدور حول الشمس، يتناقض تمامًا مع نظرية مركزية الأرض التي تبنتها الكنيسة الكاثوليكية. ورغم إضافة بعض التنازلات في كتابه للإشارة إلى أن نموذج مركزية الشمس كان مجرد فرضية، فقد أُدين غاليليو بـ"الشك الشديد في الهرطقة" وأُجبر على التراجع عن آرائه. وانتهت هذه المحاكمة، التي امتدت لعدة جلسات في أبريل ومايو من عام 1633، بإقامة جبرية على غاليليو طوال حياته، مع أنه واصل عمله العلمي حتى وفاته عام 1642من الجدير بالذكر أن اضطهاد غاليليو يُنظر إليه غالبًا كمثال رئيسي على القمع الفكري الذي مارسته السلطات الدينية على التقدم العلمي.
أطروحة الصراع
شهد أواخر العصر الفيكتوري انتشار "أطروحة الصراع"، وهو مصطلح يصف التوتر التاريخي الملحوظ بين العلم والدين. وقد شاع هذا المفهوم بفضل أعمال مثل كتاب جون ويليام درابر "تاريخ الصراع بين الدين والعلم" وكتاب أندرو ديكسون وايت "تاريخ صراع العلم مع اللاهوت في المسيحية". إلا أن مؤرخي العلوم المعاصرين دحضوا هذه الرواية تمامًا، موضحين أن العديد من ادعاءات درابر ووايت إما كاذبة، أو مُساء فهمها، أو مُحرّفة عمدًا. يُجمع المؤرخون المعاصرون على أن ما يُسمى "الصراع" بين العلم والدين مجرد أسطورة، وقد أُعيد تقييم العديد من الأحداث التاريخية التي يُستشهد بها عادةً كدليل على هذا الصراع لإظهار علاقة أكثر دقة.
التطور والخلق
استمرت الصراعات بين العلم والدين حتى العصر الحديث، لا سيما فيما يتعلق بموضوعي التطور والخلق. تشير استطلاعات الرأي التي أُجريت بين عامي 2009 و2014 إلى أن شريحة كبيرة من الجمهور الأمريكي ترى وجود تعارض بين التفسيرات العلمية لأصول الحياة والمعتقدات الدينية حول الخلق. ولا يزال التوتر بين نظرية التطور، المدعومة بمجموعة قوية من الأدلة العلمية، ووجهات النظر الخلقية، المتجذرة في العقيدة الدينية، قضيةً خلافيةً في نقاشات التعليم والسياسات العامة.
جائحة كوفيد-19
سلطت جائحة كوفيد-19 الأخيرة الضوء على الاحتكاك المستمر بين الإرشادات العلمية والالتزام العام المتأثر بتنوع المعتقدات والمواقف. خلال الجائحة، قوبلت تدابير الصحة العامة، مثل عمليات الإغلاق، وفرض ارتداء الكمامات، ومتطلبات التطعيم، بمقاومة من شرائح من السكان، مما يوضح كيف يمكن أن تتعارض التوصيات العلمية مع المعتقدات الشخصية والأعراف المجتمعية. تعكس هذه الخلافات أسئلة فلسفية أعمق حول الطبيعة البشرية، ومكانتنا في الكون، ومسؤولياتنا تجاه بعضنا البعض كأعضاء في مجتمع مشترك. يساعد فهم هذه الصراعات والنقاشات الرئيسية على توضيح العلاقات المعقدة والمتطورة. الترابط بين البحث العلمي وأنظمة المعتقدات، سواءً كانت متجذرة في الدين أو الخرافات أو غيرها من الأطر.
الأسس الفلسفية
مع بداية الثورة العلمية، أصبحت التجريبية بالفعل مكونًا أساسيًا في العلم والفلسفة الطبيعية. بدأ المفكرون السابقون، بمن فيهم الفيلسوف الاسمي ويليام الأوكامي في أوائل القرن الرابع عشر، الحركة الفكرية نحو التجريبية. استُخدم مصطلح "التجريبية البريطانية" لوصف الاختلافات الفلسفية الملحوظة بين اثنين من مؤسسيها: فرانسيس بيكون، الذي وُصف بالتجريبي، ورينيه ديكارت، الذي وُصف بالعقلاني. كان توماس هوبز وجورج بيركلي وديفيد هيوم أبرز رواد الفلسفة الذين طوروا تقليدًا تجريبيًا متطورًا كأساس للمعرفة البشرية.
لغرض الحصول على المعرفة والسيطرة على الطبيعة، حدد بيكون في عمله نظامًا جديدًا للمنطق اعتقد أنه يتفوق على الطرق القديمة للقياس المنطقي، مطورًا منهجه العلمي. تتكون هذه الطريقة من إجراءات لعزل السبب الرسمي لظاهرة ما (الحرارة، على سبيل المثال) من خلال الاستقراء الإقصائي. أكد بيكون على أن الفيلسوف يجب أن ينتقل من خلال الاستدلال الاستقرائي من الحقيقة إلى البديهية إلى القانون الفيزيائي. ومع ذلك، فقد أشار أيضًا إلى أنه قبل البدء في هذا الاستقراء، يجب على الباحث أن يحرر عقله من بعض المفاهيم أو الاتجاهات الخاطئة التي تشوه الحقيقة. على وجه التحديد، انتقد الفلسفة لأنها كانت مشغولة جدًا بالكلمات والنقاش بدلاً من الملاحظة الفعلية للعالم المادي. استمر التناقض بين الفلسفات التجريبية والعقلانية في التطور. أبرز ديكارت ومفكرون لاحقون مثل كارل بوبر وتوماس ناجل أن الفكر العقلاني هو مسعى معياري لا يمكن تفسيره بالكامل بمصطلحات علمية بحتة. يعكس هذا توترًا فلسفيًا أوسع: فبينما يهدف العلم الطبيعي إلى وصف ما هو موجود، يتعامل الفكر العقلاني مع الحقائق المعيارية حول ما ينبغي أن يكون. تُبرز هذه الثنائية العلاقة المعقدة بين الملاحظة التجريبية والاستدلال العقلاني.
يمتد هذا التناقض الفلسفي إلى المناقشات اللاهوتية. على سبيل المثال، وصف البابا يوحنا بولس الثاني في رسالته العامة "الإيمان والعقل" الإيمان والعقل بأنهما جناحان متكاملان يرتقيان بالروح البشرية نحو تأمل الحقيقة. لهذه الفكرة جذور تاريخية، حيث دمج آباء الكنيسة الأوائل الفلسفة اليونانية للدفاع عن الإيمان، وهو توليفة بلغت ذروتها مع كتابات توما الأكويني في القرن الثالث عشر. وقد أثر دمج توما الأكويني للإيمان والعقل تأثيرًا عميقًا على الفكر الكاثوليكي، وربطه ارتباطًا وثيقًا بالأسس الفكرية للعلم الحديث.
التأثير الاجتماعي والثقافي
أدى تقاطع التقدم العلمي والمعايير المجتمعية إلى تغييرات عميقة في كيفية إدراك الأفراد والمجتمعات لأنفسهم وعلاقاتهم مع الآخرين. تتجلى هذه الظاهرة بشكل خاص في سياق ثورة تكنولوجيا المعلومات والواقع الافتراضي والاتصالات العالمية، والتي غيرت بشكل كبير العلاقات الشخصية والقوى العاملة والتعليم والنسيج المجتمعي الأوسع. تؤثر هذه التحولات حتمًا على المجالات الفكرية والعاطفية والعلائقية للحياة البشرية، مما يطرح تحديات وفرصًا لدمج الثقافة العلمية في الحياة اليومية.
وعلاوة على ذلك، يوضح التقدم التاريخي للحضارات نمطًا في تطوير المعرفة العلمية ونشرها. على سبيل المثال، خلال ذروة العصر الذهبي الإسلامي، سهّل الاستخدام الواسع للغة العربية، إلى جانب الأطر الدينية والسياسية المشتركة، انتشار الأفكار العلمية في جميع أنحاء العالم الإسلامي. تم نقل المعرفة العلمية من خلال كل من الشبكات غير الرسمية، مثل المراسلات بين العلماء، والمؤسسات الرسمية مثل المستشفيات والمراصد. وعلى الرغم من هذه الفترة المزدهرة، إلا أن تراجع الخلافة العباسية كان بمثابة نقطة تحول، مما أدى إلى ركود التقدم العلمي في السياق الإسلامي.
كما أن التأثير الاجتماعي والثقافي للعلم واضح أيضًا في البيئات المعاصرة. تُظهِر الدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل الإمارات العربية المتحدة، مستويات عالية من التحضر والتطور التكنولوجي، إلا أنها غالبًا ما تكون ضعيفة الأداء في مؤشرات مخرجات البحث العلمي، مثل المنشورات والاستشهادات. كما تُشكل هذه المناطق أرضًا خصبة للاعتقادات الزائفة علميًا، بما في ذلك نظرية خلق الأرض القديمة والممارسات الطبية غير التقليدية، مما يُبرز التوتر بين المنظورين العلمي واللاهوتي في المجتمع الحديث.
في السياقات التعليمية، لا يزال التحدي قائمًا في نقل المعرفة حول طبيعة العلم (NOS) بفعالية من الفهم النظري إلى التطبيق العملي. تُعد هذه المسألة ذات صلة خاصة بالمعلمين قبل الخدمة الذين قد يتفوقون في وصف مفاهيم طبيعة العلم، لكنهم يجدون صعوبة في دمجها في الممارسات الصفية. الممارسة. لذا، يتطلب التبني المجتمعي الأوسع للمعرفة العلمية نهجًا دقيقًا يأخذ في الاعتبار السوابق التاريخية والتحديات المعاصرة في مواءمة المعرفة العلمية مع السياقات الثقافية والدينية.
شخصيات بارزة
تشكّل الصراع بين المنظورين العلمي واللاهوتي من خلال مساهمات العديد من الشخصيات البارزة. كان تشارلز داروين مترددًا في البداية في النشر عن أصول الإنسان، ولم يناقش التطور البشري في عمله الرائد. ومع ذلك، فقد أكد أنه "سيتم تسليط الضوء على أصل الإنسان وتاريخه" (1859: 487). حدد داروين لاحقًا إفريقيا كمكان محتمل لنشأة البشر، واستخدم علم التشريح المقارن لإظهار أن الشمبانزي والغوريلا كانتا وثيقتي الصلة بالبشر في عمله (1871).
كان توماس هنري هكسلي، الملقب بتابع أو "بولدوغ داروين" لدفاعه الشرس عن نظرية داروين في التطور، فعالاً في إبراز الجدل الدائر حول التطور البشري. في كتابه الصادر عام 1863، ناقش هكسلي الأدلة الأحفورية، مثل أحافير إنسان نياندرتال التي اكتُشفت مؤخرًا آنذاك في جبل طارق، مقدمًا بذلك إحدى أولى الحجج الشاملة للتطور البشري من منظور دارويني.
في القرن العشرين، انخرط علماء الأنثروبولوجيا القديمة في جدل حول الجدول الزمني للتطور البشري. وجادلوا حول ما إذا كان البشر قد انفصلوا عن القردة العليا الأخرى منذ حوالي ١٥ مليون سنة أم منذ حوالي ٥ ملايين سنة. وقد أضاءت الساعات الجزيئية هذا الجدل في نهاية المطاف - أولًا من خلال الاستجابات المناعية، ثم من خلال الأدلة الجينية المباشرة. على سبيل المثال، كان عمل ريو وآخرون (2014) حول معايرة ساعة الميتوكوندريا البشرية باستخدام الجينومات القديمة محوريًا في هذا السياق. أصول الإنسان ليست مجرد مسألة بحث علمي، بل هي أيضًا موضوع متشابك بعمق مع الاعتبارات الدينية والفلسفية. ففي المسيحية واليهودية وبعض المذاهب الإسلامية، يُعتقد أن الإنسان خُلق على صورة الله (صورة الله). وقد فُسِّر هذا المفهوم بطرق مختلفة، بما في ذلك التفسيرات الوظيفية والبنيوية والعلائقية.
المنظورات النفسية
لطالما كانت الخرافات والمعتقدات الخارقة للطبيعة موضوعات بحث نفسي، إذ تُقدم رؤى ثاقبة في العمليات المعرفية والعاطفية التي تُشكل أساس السلوك البشري. وغالبًا ما تدرس الرؤى النفسية لهذه المواضيع كيفية تكوين الأفراد لهذه المعتقدات والحفاظ عليها، بالإضافة إلى الفوائد والأضرار المحتملة المرتبطة بها.
الوسطاء المعرفيون والنفسيون
يُعد القلق والسيطرة المُتصوَّرة عاملين مهمين في تكوين المعتقدات الخرافية والخارقة للطبيعة. وقد وجد وات وواتسون وويلسون أن الأفراد الذين يعانون من مستويات قلق عالية هم أكثر عرضة لاعتناق مثل هذه المعتقدات، ربما كوسيلة لممارسة الشعور بالسيطرة على المواقف غير المؤكدة. وبالمثل، أثبت تيرهون وسميث أن الإيحاء وبعض سمات الشخصية الإدراكية المعرفية قد تُحفز تجارب شاذة لدى الأفراد، مما يدعم فكرة أن العمليات المعرفية تلعب دورًا حاسمًا في هذه المعتقدات.
التحيزات المعرفية والأساليب الإرشادية
تُوفر نظرية العملية المزدوجة للإدراك، والتي تشمل عمليات التفكير الترابطية والحدسية (النظام 1) وعمليات التفكير التحليلي والتأملي (النظام 2)، إطارًا لفهم التفكير الخرافي. يتميز النظام 1 بالسرعة والتلقائية، مما يجعله عرضة للتحيزات مثل أسلوب التوافر، حيث يُقيّم الناس احتمالية وقوع الأحداث بناءً على مدى سهولة تذكرهم لحالات مماثلة. يمكن أن يؤدي هذا إلى تكوين معتقدات خرافية، حيث تصبح النتائج السلبية التي تلي الأفعال التي تُغري القدر أكثر سهولة من الناحية المعرفية، وبالتالي يُنظر إليها على أنها أكثر احتمالية.
التنظيم العاطفي والتأثير الإيجابي
ومن المثير للاهتمام أن التفكير الخرافي يمكن أن يتأثر بالحالة العاطفية للفرد. لقد ثبت أن التأثير الإيجابي يعزز التفكير الخرافي، بينما يمكن وصف الاكتئاب بأنه "فقدان للأوهام الإيجابية". يشير هذا إلى أنه على الرغم من أن الخرافات قد تكون غير عقلانية في بعض الأحيان، إلا أنها يمكن أن تؤدي وظيفة علاجية من خلال توفير الراحة وتقليل القلق. قد تحتاج الأبحاث المستقبلية إلى موازنة الجوانب غير العقلانية للخرافات مع فوائدها النفسية المحتملة.
ارتباطات الشخصية
استكشفت الأبحاث أيضًا سمات الشخصية المرتبطة بالمعتقدات الخارقة للطبيعة. وجد جليكسون أن الأفراد الذين يؤمنون بالخوارق غالبًا ما يتمتعون بتعقيد معرفي أعلى، مما قد يمكّنهم من الاستمتاع بمجموعة أوسع من الاحتمالات. اكتشف راتيت وبورسيك أن بعض سمات الشخصية، مثل الانفتاح على التجربة والبحث عن الأحاسيس، ترتبط بزيادة احتمالية اعتناق معتقدات خارقة للطبيعة. تُسلط هذه النتائج الضوء على التفاعل المعقد بين الشخصية وأنظمة المعتقدات.
التأثيرات الاجتماعية والثقافية
تلعب العوامل الاجتماعية والثقافية أيضًا دورًا مهمًا في تشكيل الخرافات. المعتقدات الخرافية والخارقة للطبيعة. اقترح روزين ونيمروف أن المعتقدات الخرافية حول الصفات المُعدية للمصائب قد تُسهم في الوصم الاجتماعي والاغتراب، كما يتضح في المخاوف التاريخية المحيطة بأمراض مثل الإيدز. يمكن أن تؤثر هذه المعتقدات على السلوك والمواقف العامة، مما يؤدي أحيانًا إلى عواقب وخيمة.
دراسات الحالة المبتدئة البسيطة: سالي
تتضمن إحدى دراسات الحالة التوضيحية، التي تبحث في التعارض بين المنظورين العلمي والخرافي أو اللاهوتي، مشاركة تُدعى سالي. في تحليل نوعي لأفعالها أثناء المحاكاة، أظهرت سالي غلبة في الأنشطة الاستقصائية، مثل توليد فرضيات جديدة، وإجراء اختبارات، واستخلاص النتائج. تتوافق هذه الأنشطة مع النماذج الراسخة للنشاط العلمي التي تُعطي الأولوية للتجريب، وتوليد الفرضيات، وتقييم الأدلة. تشير هذه الإجراءات الاستقصائية إلى أن معتقدات سالي المعرفية تميل نحو البحث العلمي وفهم أن المعلومات العلمية قابلة للتغيير مع وجود أدلة جديدة، على عكس النظرة الجامدة التي غالبًا ما ترتبط بالعقليات اللاهوتية أو الخرافية.
المعتقدات الدينية في الأوساط الأكاديمية
تاريخيًا، اتسمت العلاقة بين البحث العلمي والمعتقد الديني بالتعقيد. خلال القرن السابع عشر، اعتبر العديد من فلاسفة الطبيعة، بمن فيهم إسحاق نيوتن، أعمالهم العلمية دليلاً على الخلق الإلهي. ومع ذلك، بحلول القرنين التاسع عشر والعشرين، بدأ تدين العلماء في التراجع، مبتعدًا بشكل كبير عن عامة الناس. وتوضح أمثلة معاصرة، مثل فرانسيس كولينز، الرئيس السابق لمشروع الجينوم البشري، استثناءات لهذا الاتجاه. وقد دافع كولينز بنشاط عن توافق العلم والمسيحية من خلال كتابه "لغة الله" (2006) ومعهد بيولوجوس.
مركزية الشمس والثورة العلمية
يُقدم التحول من مركزية الأرض إلى مركزية الشمس دراسة حالة أخرى ذات صلة. اقترح أريستارخوس الساموسي لأول مرة في القرن الثالث قبل الميلاد نموذج مركزية الشمس، الذي يضع الشمس في مركز الكون بدلًا من الأرض. وعلى الرغم من أساسه التجريبي، لم يحظَ هذا النموذج بقبول واسع في أوروبا في العصور الوسطى، حيث هيمنت الآراء اللاهوتية على الفكر العلمي. ولم يبدأ نموذج مركزية الشمس في تحدي نموذج مركزية الأرض الراسخ إلا مع أعمال كوبرنيكوس وغاليليو وكبلر في عصر النهضة، مما شكل تحولًا كبيرًا نحو التفكير العلمي على العقيدة اللاهوتية.
نظرية الانفجار العظيم
يؤكد تطور نظرية الانفجار العظيم على الصراع والتقارب النهائي بين المنظورين العلمي واللاهوتي. طرحها في البداية عالم الكونيات البلجيكي والقس الكاثوليكي جورج لوميتر عام 1927، وواجهت هذه النظرية تشكيكًا داخل المجتمع العلمي. ومع ذلك، قدم اكتشاف إدوين هابل للمجرات وهي تبتعد عن بعضها البعض دليلًا حاسمًا يدعم نموذج الكون المتوسع الذي اقترحه لوميتر. تُمثل هذه النظرية، التي تصف نشأة الكون من نقطة تفرد، تحولاً كبيراً عن نظريات علم الكونيات السابقة المتأثرة باللاهوت والتي افترضت كوناً ثابتاً.
تُسلط دراسات الحالة هذه الضوء على العلاقة المتطورة بين البحث العلمي والمعتقدات الدينية أو الخرافية. وبينما تُظهر الأمثلة التاريخية والمعاصرة التوتر بين هذه الرؤى العالمية، فإنها توضح أيضاً كيف اكتسب التفكير العلمي قبولاً تدريجياً، وغالباً ما دمج أو أعاد تفسير المفاهيم اللاهوتية في هذه العملية.
الحل والمصالحة التأمل في تحول الفهم
تكشف الرحلة التاريخية للعلم والدين عن تطور عميق في علاقتهما، اتسمت بفترات من الصراع والتباين والاتصال والتأكيد. ومن التأملات المهمة أن العوامل الاجتماعية والسياسية تلعب دوراً حاسماً في بناء ما يُقبل كمعرفة علمية. يعمل المجتمع العلمي ضمن إطار تاريخي حيث تُعدّ آليات مثل التدريب الأكاديمي وعمليات مراجعة الأقران أساسية لأفضل الممارسات، وقمع الآراء المنحرفة. سلّط عمل توماس كون الرائد، "بنية الثورات العلمية"، الضوء على الطابع الجماعي للمشروع العلمي، وهو وعيٌ كان محوريًا في تغيير الفهم.
الإرث والأثر المستمر
شكّل الحوار بين العلم والدين علاقتهما المعاصرة بشكل كبير. اقترح وينتزل فان هيوستن أن العلم والدين يمكن أن ينخرطا في ثنائيٍّ أنيق قائم على تداخلاتهما المعرفية، محافظين على مجالاتهما المتميزة، ولكنهما يتحاوران من خلال مناهج ومفاهيم وافتراضات مشتركة. يفتح هذا المنظور آفاقًا للتفاعل الهادف والإثراء المتبادل، متجاوزًا مجرد الصراع إلى فضاء من التفاهم التعاوني.
تقاطع العلم والدين
في هذا السياق العالمي، اتسمت العلاقة بين العلم والدين بالتنوع. وقد كشفت الأبحاث التي أجراها مركز بيو للأبحاث، والتي شملت مسلمين وهندوسًا وبوذيين في ماليزيا وسنغافورة، عن وجهات نظر متباينة حول كيفية ارتباط العلم بالدين. وتُبرز هذه المقابلات أن التفاعل بين العلم والدين ليس متجانسًا، بل هو غني السياق ومتعدد الأوجه. إضافةً إلى ذلك، فإن فكرة أن كلاً من المؤسسات الدينية والعلمانية يمكن أن تعزز السلوكيات الاجتماعية وغير الاجتماعية تزيد من تعقيد علاقتهما
المبادرة العلمية والكرامة الإنسانية
المبادرة العلمية ليست موضوعية بحتة، بل هي متشابكة بعمق مع القيم الإنسانية والكرامة. يُمثل العلم مجموعة من المعارف الأساسية ليس فقط للتطور الفكري، بل أيضًا للنمو الروحي. إن وحدة المعرفة، التي تربط بين العقل والإيمان، أمرٌ بالغ الأهمية للتنمية الشاملة للأفراد والمجتمعات. ويُعتبر نشر المعرفة العلمية حقًا، وتثقيف الجمهور بشأن التقدم العلمي واجبًا، مما يُبرز دور العلم في تحقيق الصالح العام وتعزيز التنمية البشرية.
***
د. جواد بشارة
.....................
المراجع
[1]: الثورة العلمية - ويكيبيديا
[2] تاريخ الصراع بين الدين والعلم - مشروع غوتنبرغ
[3]: حقائق ونظريات في العلم واللاهوت: تداعيات على...
[4]: كيف حارب غاليليو الكنيسة الكاثوليكية وأصبح أول نجم خارق...
[5]: غاليليو - ملخص سريع - مرصد الفاتيكان
[6]: أطروحة الصراع - ويكيبيديا
[7]: تصور الصراع بين العلم والدين - مركز بيو للأبحاث
[8]: ما يكشفه تاريخ العلم والدين عن الانقسامات المعاصرة...
[9]: العلم والكنيسة الكاثوليكية - ويكيبيديا
[10]: العلم ورسالة الكنيسة الكاثوليكية | Inters.org
[11]: الدين والعلم - موسوعة ستانفورد للفلسفة
[12]: الدين والعلم - موسوعة ستانفورد للفلسفة
[13]: تقييم المعتقدات المعرفية للخبراء والمبتدئين ... | SpringerOpen
[14]: تطوير مقياس المعتقدات الخارقة للطبيعة والخارقة للطبيعة باستخدام ...
[15]: حياة الخرافات المتعددة - جمعية العلوم النفسية
[16]: مركزية الشمس - ويكيبيديا
[17]: مركزية الأرض مقابل مركزية الشمس: خلافات قديمة
[18]: 10 اكتشافات علمية غيّرت العالم
[19]: العلاقة بين الدين والعلم - ويكيبيديا
[20]: حول تقاطع العلم والدين - مركز بيو للأبحاث
[21]: عندما يحل العلم محل الدين: العلم كسلطة علمانية