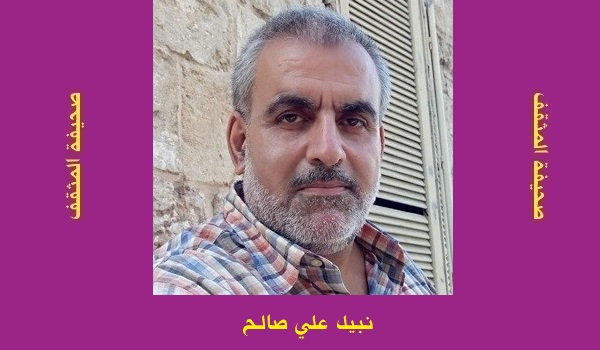دراسات وبحوث
بليغ حمدي: نقض الوصاية التاريخية لتدريس اللغة العربية

ـ استشراف أدوار معلم المستقبل:
أَولَتْ المجتمعات الحديثة المعلم عناية فائقة واهتماما ملحوظا باعتباره عنصرا رئيسا ومؤثرا في العملية التعليمية، وذلك من خلال تعدد وتنوع الصيغ والإحداثيات التعليمية في تأهيله وتكوينه وإعداده، على اعتبار أن فاعلية المؤسسة التعليمية ونجاحها تعتمدان بصورة مباشرة على كفاءة العاملين بها. ولقد صادف عملية إعداد المعلم وتكوينه الكثير من التطوير والتحديث عبر سنوات طويلة، لذا تغيرت طبيعة وماهية استراتيجيات عملية الإعداد، وسلكت المجتمعات المختلفة وفق رؤاها التربوية ودرجة نموها التعليمي وطبيعة مشكلاتها الاجتماعية والثقافية، ودرجة تقدمها الاقتصادي ومستوى نظرة هذه المجتمعات للمعلم وتحديد أهمية دوره في منظومة التعليم مسلكا جديدا مغايرا لما سبق.
ولعل الاهتمام بتكوين المعلم وتأهيله يرتكز على قناعة مفادها أن المعلم وكفاءته يؤثران بشكل واضح ومباشر على نجاح العملية التعليمية؛ باعتباره دعامة أصيلة في المشهد التعليمي، فإن رفع كفاءة إعداده وتكوينه يسهم في تحسين فاعلية النظام التعليمي برمته وتحقيق مخرجات التعلم ونواتجه بصورة جيدة. ولا شك أن مهمة إعداد معلم متميز جدير بمهنة التدريس إحدى أبرز المشكلات المستدامة المرتبطة بمنظومة التعليم الجديدة، كما أن المحافظة على جودة الأدوار التي يقوم بها المعلم في ظل تطورات اجتماعية وثقافية واقتصادية متسارعة ومتصارعة مسألة شائكة ومعقدة.
وفي ضوء التغيرات المتواترة على الصعيد التربوي والتعليمي بشدة فإنه ينبغي على مؤسسات إعداد المعلم بصورة وجوبية تزويده وإكسابه القدرات والمهارات والكفايات اللازمة لا المناسبة فحسب التي تمكنه من مواجهة هذه التغيرات القائمة والمتوقع حدوثها، وهذا يتطلب من كليات التربية إعداد معلم المستقبل اعتمادا على مراجعة مخرجاتها وعملياتها ونواتج التعلم المقصودة والأخرى المرغوبة؛ لتصبح مناسبة ومتوافقة مع متغيرات العصر، بل ومواكبة الإعداد لكل جديد وافد وطارئ على المنظومة التعليمية، من أجل تشكيل معلم قادر على المشاركة والمنافسة والتأثير.
وقضية إعداد المعلم لمهنة التدريس لها أهمية كبرى وخاصة في القرن الواحد والعشرين الذي لم يعد يقتصر دور المعلم فيه على نقل المعلومات والمعارف وتوصيلها بالتلقين المباشر، وإنما يتجاوز ذلك للقيام بمهام من شأنها إعداد نشء قادر على الإبداع وامتلاك مهارات التعلم مدى الحياة، لذا فإن عملية إعداد المعلم لاسيما معلم اللغة العربية عامل رئيس لنجاح منظومة متكاملة تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد في تأهيله وتكوينه .
وإذا كان إعداد المعلم وتأهيله يحظى بأهمية واهتمام رسمي وآخر مجتمعي، فإن إعداد معلم اللغة العربية للمستقبل يحظى وينال مكانة مرموقة في الاهتمام لاسيما في الوطن العربي، والدول الأجنبية التي تهتم بتعلم اللغة العربية وتنشئ معاهد ومراكز متخصصة لتعليمها؛ ليس لكونه معلما فحسب، بل معلما للغة القرآن الذي يعد إتقان حفظه وتلاوته ومعرفة ألفاظه ومعانيه ودلالاته البليغة مُدخلا ضروريا لتعلم كافة العلوم المكتوبة باللغة العربية، مما يفرض عليه ـ المعلم ـ أدوارا ومسئوليات أخرى إلى جانب مهامه الأساسية، فهو مطالب بأداء مهام لغوية تتناسب والعصر الراهن، ومهام استشرافية تتزامن مع تحديات ومتطلبات المستقبل المتجددة.
ولقد أصبح تمكن معلم اللغة العربية للمستقبل من مهارات الأداء التدريسي ضرورة ملحة إذا ما رغب المعلم ـ نفسه ـ في تحقيق الفاعلية من تدريسه، وهذا ما أكدته نتائج دراسات تربوية عديدة من أن تنمية مهارات الأداء التدريسي لمعلم اللغة العربية بخاصة ركنًا أساسيا في جوانب إعداده علميا وعمليا في ظل تحديات متسارعة تواجه ملامح العملية التعليمية، فالمستجدات التعليمية المعاصرة جعلت عملية تأهيل المعلم وإكسابه مهارات تدريسية لازمة ومناسبة يتعاظم دورها وأهميتها لتحقيق التوازن بين الإعداد والمهنة سواء باكتساب المعرفة والفهم، أو بالتطبيق والتحليل، وأخيرًا بتأمل فعل الأداء التدريسي نفسه من أجل تجويده مستقبلا.
وبرز مفهوم الأداء التدريسي التأملي بصورة واضحة منذ مطلع القرن الواحد والعشرين نتيجة فرضية ممارسة المعلمين للتأمل تمكنهم من تحسين ممارساتهم التدريسية، وتمكنهم أيضا من توظيف المعارف والمعلومات والبيانات التي يرصدونها عن أدائهم التدريسي في الحكم عليه وتطويره للأفضل. فضلا عن أن المعلم الذي يفكر في أدائه التدريسي بطريقة تأملية يدرس التحديات التي تواجهه بالفعل والأخرى التي قد تعترض سبيله الصفي فيما بعد، ومن ثم التوصل إلى مداخل وطرائق مناسبة للتفاعل معها بإيجابية، فضلا عن تمكين المعلم من تحسين الأداء التدريسي وتعزيز الاتجاه الإيجابي نحو المهنة وتدعيم المشاعر الأكاديمية لدى تلاميذه.
ولقد ظهرت بوادر الاهتمام بالأداء التأملي للتدريس نتيجة المستويات المتدنية في أداء المعلمين وفكرة البحث عن استراتيجيات تسهم في استمرارية النمو المهني لديهم، والتي أبرزت ضرورة الاستغراق والاندماج في التقويم الذاتي للممارسات التدريسية باعتباره ـ التقويم الذاتي ـ مفتاحا للتنمية المهنية المستدامة لتطوير الوعي بالذات. وركزت التربية المعاصرة على التخلي عن فكرة التدريب الروتيني للطالب المعلم وتلقينه مجموعة من الأساليب التدريسية الجامدة، وتشجيعهم على التفكير التأملي الناقد فيما يقومون به من ممارسات تدريسية ليبتكروا ما يرونه مناسبًا من استراتيجيات تدريس ومواد تعليمية، وأصبحت الممارسة التأملية للأداء التدريسي من المداخل المثالية لإعداد المعلم؛ إذ تتطلب من المعلمين تطوير أنفسهم لأنهم يحللون ممارساتهم التدريسية ويقيمونها ذاتيا.
وتعد الممارسة التأملية للأداء التدريسي ذات أهمية كبيرة للمعلمين؛ لأنها تساعدهم في تحسين واقع أدائهم الصفي، حيث يستطيع المعلم من خلالها دمج المعرفة الحالية بالمعرفة السابقة وتعديلها للوصول إلى معرفة جديدة أكثر رسوخًا، كذلك لا يمكن الوصول إلى تحقيق أهداف التربية والتأكد من إيجابية نواتج التعلم لدى الطلاب إلا أن اكتساب كفايات التدريس في حد ذاتها غير كفيلة بتحقيق الأهداف التعليمية إلا إذا تمكن المعلم من مراقبة أدائه وتأمله سلوكياته الصفية المتعلقة باستخدامه لمهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم.
وتعتبر الممارسة التأملية للتدريس التي يقوم بها الطالب المعلم عبر ملاحظته ومراجعته وتقييمه المستدام لممارساته التدريسية في أثناء تأهيله وتكوينه بمؤسسات إعداد المعلم للعمل على تحسين هذه الممارسات باستخدام آليات تنفيذية معاصرة أكثر أهمية وذات ضرورة، وهذا ما أكدته المعايير العالمية للمعلم (Indiana Department of Education , 2004) من خلال التنبيه على ضرورة الممارسة التأملية للمعلم كمؤشر من مؤشرات التنمية المهنية المستدامة، في حين أن وزارة التربية والتعليم المصرية ضمَّنت في معاييرها القومية للتعليم أهمية ممارسة المعلم للأداء التدريسي التأملي؛ حيث نص المؤشر الأول من مؤشرات معيار التنمية المهنية للمعلمين على أن " يتأمل ويقيم المعلم أفعاله وممارساته للارتقاء بأدائه .
ومما يعزز ضرورة الاهتمام بتنمية الأداء التدريسي التأملي لدى الطلاب المعلمين هو ما أشار إليه كثير من رواد التربية اللغوية المعاصرة حيث إن من أبرز مقتضيات التدريس المعاصر الجيد تغيير السلوكيات وتعديل الاتجاهات لدى المعلمين، ليس فقط من خلال تزويده بمعارف ومعلومات وحقائق عن طبيعة التدريس ونظرياته، بل من خلال تبصيره بالأساليب والطرائق التي تمكِّنه من تحقيق التنمية المهنية المستدامة عن طريق ملاحظة أدائه، ونقده لممارساته التدريسية ومعتقداته عنها، وبقدر أهمية امتلاك الطالب المعلم للمعرفة الدقيقة بمادة تخصصه الأكاديمي وما يتصل بها من معارف أخرى، وكفايات تتعلق بقدرته على التخطيط للدرس وتنفيذه وتقويمه، بقدر أهمية الممارسة التأملية للعناصر السابقة بالإضافة إلى تأمله لإدارته الصفية واتجاهاته نحو المتعلمين داخل الفصل.
ولقد تعددت الدراسات والبحوث التي تناولت متغير الأداء التدريسي التأملي وتنوعت بتنوع غرض التناول من حيث الكشف عن مدى توافر مهاراته لدى المعلمين، أو تقييم مستوى الأداء التأملي لديهم، أو من خلال إعداد برامج تدريسية وتدريبية لتنمية مهاراته، ويمكن تحديد أهمية ممارسة التأمل في الأداء التدريسي في النقاط الآتية:
1 ـ وضع الحلول المناسبة للتحسين المستمر في عمليتي التعليم والتعلم.
2 ـ زيادة الوعي بحاجات الطلاب والإمكانات التعليمية المتاحة.
3 ـ الانفتاح والاطلاع على الأفكار والأساليب التدريسية الجديدة.
4 ـ التنويع في استخدام أساليب التعليم والتعامل مع الطلاب داخل غرفة الفصل.
5 ـ الإحساس الكبير بالقدرة على تصريف الأمور داخل الفصل بكفاءة ومرونة.
6 ـ حث المعلم على التقييم الذاتي لأدائه بعد التطبيق العملي للنظريات المتعلقة بمفاهيم التعليم والتعلم.
وإذا كانت الممارسة التدريسية التأملية ممارسة تلازم المعلم الذي ينبغي أن يتحلى بسعة الأفق والإخلاص وتحمل المسئولية وتتيح له فرص التأمل بصورة منفردة أو من خلال المشاركة مع الأقران، فإن هذه الممارسة تتجلى بوضوح في تسجيل المعلم لملاحظاته ووصفه لأدائه الصفي كتابة؛ لأن الكتابة ومراجعتها تتيح له تعميق التجربة وربطها بخبرات سابقة وأخرى جديدة للوقوف على مستوى أدائه الراهن والمستقبلي مما يساعده على الاحتراف المهني، كما أن الكتابة تعد إحدى تطبيقات الأداء التدريسي التأملي كونها تجسد انطباعات المعلم حول أدائه الصفي ومعالجته للمشكلات وعرضه للتفاصيل التي تحدث في أثناء تفاعله مع الطلاب وتحليلها.
ويرى كثيرون أن إحدى أدوات الممارسة التأملية للتدريس الكتابة التفسيرية المتمثلة في المذكرات اليومية، والسجلات القصصية التي يعدها المعلم لتجاربه مع الطلاب داخل الفصل، وقوائم المراجعة التي تتضمن تفسيرا وتبريرا لأفعال المعلم وسلوكياته، وأخيرًا صحف التأمل التي تعكس مدى رؤية المعلم لمستقبله المهني المرتبط بمهارات التدريس الثلاث التخطيط والتنفيذ والتقويم. وأن ما يقوم به المعلم من كتابة سردية تفسيرية لواقعه التدريسي سينعكس على قراراته المستقبلية بشأن الفعل التدريسي وتغيير سياساته التعليمية مع طلابه على نحو إيجابي تدفعهم للتقدم في الدراسة والتعلم.
ويذكر (Pollard) أن من وسائل تنمية الأداء التدريسي التأملي للمعلم استخدام الكتابة المتمثلة في أكثر من صورة منها التقارير الذاتية Self Reports التي يعدها المعلم بعد الانتهاء من عملية التدريس، وتتضمن انطباعات وأفكار ورؤى المعلم حول مدى جودته في إعداد مخطط التدريس الصفي ومدى مناسبة المحتوى والأنشطة التعليمية التي تم تقديمها للطلاب، وكذلك إعطاء تفسيرات لما قام به من خلق بيئة صفية محفزة لهم، والمشكلات التي تعرض لها في أثناء إدارته للصف، كذلك يوميات المعلم Teacher Diary وهي المذكرات التي يقوم المعلم بكتابتها بشكل يومي عن عمليات التدريس ومواقفه التي مر بها خلال يومه المهني.
وتعد الكتابة التفسيرية من أكثر أنواع الكتابة انتشارا في حياتنا التعليمية المعاصرة تحديدا فيما يتصل بأداء المعلم حيث إنها تعطي له الفرصة في الوصف أو إعطاء معلومات تتعلق بالموقف التدريسي، ومن خلالها يسعى المعلم أن يقدم مجموعة من المعلومات والبيانات والمفاهيم التي تدور حول أدائه التدريسي متضمنة ـ الكتابة ـ رؤيته حول نظريات التدريس المستخدمة وتنبؤاته التدريسية واستنتاجاته، لذلك فهي عملية ذهنية معقدة تتكون من مجموعة من العمليات التي تحدث وتجري في وقت متزامن تستهدف وصف الأفكار والحقائق والأداءات الصفية سعيًا إلى تفسيرها وتحليلها.
ولأهمية الكتابة التفسيرية للمعلم بوصفها منتجًا تحليليا لأدائه التدريسي، فقد أكدت اللجنة الوطنية للكتابة The National Commission on Writing على أهمية إعادة التفكير في مهارات الكتابة المستخدمة والتأكيد على ضرورة طرح مبادرة " ثورة الكتابة في المدارس العامة والكليات " Writing Revolution in Public Schools and Colleges ، ومن ثم اقترحت إطارا لممارسة الكتابة التفسيرية بغرض إنتاج مقال وصفي يمتاز بالتماسك وتقديم أفكار محددة في ضوء الثوابت المنطقية، وهذا يقتضي من جميع المعلمين التدريب بوقت كافٍ على مهارات الكتابة التفسيرية، وتطوير تقنيات جديدة لتحسين آليات تدريس الكتابة وتقييمها. كما أشار المركز القومي للإحصاء التعليمي (NAEP) إلى أهمية زيادة الوقت المخصص لممارسة الكتابة التفسيرية في نطاق مواقف موجهة، وتوظيف الأفكار والحقائق والنظريات في بناء نصوص تفسيرية سردية.
وإذا استعرضنا الدراسات والبحوث التي استهدفت تنمية مهارات الكتابة التفسيرية، فإننا نستقرئ أن جميعها عَضَّد فكرة وعي المعلم بخصائص الكتابة التفسيرية وأهميتها في تجويد الأداء التدريسي وتحسين طبيعته، وأن التدريب عليها يمكِّن المعلمين من تقديم معلومات تفصيلية دقيقة حول ما يتعلمونه أو يؤدونه من مهام، مما يساعد على زيادة الفهم ودعم النظريات والأفكار حول طبيعة التدريس. وأن هذا النمط الكتابي يسهم في تقديم أدلة وشواهد داعمة لأداء المعلم التدريسي التي تعينه فيما بعد في المواقف الصفية على تحسين مستوى أدائه من ناحية، وإكساب المتعلمين المهارات والمعارف بصورة شيقة جذابة متميزة من ناحية أخرى؛ لأنه سيكون دائم المراقبة والتقييم المستدام لأدائه داخل الفصل.
ولقد اجتهد الباحثون في استنتاج مهارات الكتابة التفسيرية، وأسفر هذا الاجتهاد على تحديد مهارات رئيسة للكتابة التفسيرية تضمنت مهارات رئيسة كالأفكار المتمثلة في كتابة الفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية، ومهارة التنظيم المتمثلة في نمط كتابة الفقرات والمقدمة المناسبة والخاتمة المنطقية للنص، ومهارة بناء النص التفسيري التي تتضمن مهارات فرعية مثل توظيف الأدلة والشواهد بما يدعم الموضوع، ومهارة الطلاقة التحريرية التي تشمل صياغة أنواع الجمل المختلفة والسيطرة على الموضوع عن طريق تعزيز المعاني باستخدام المترادفات والتضاد واختيار الكلمات الدالة، ومهارة المراجعة والتنقيح التي تراعي الصحة الإملائية والنحوية، وجودة التوظيف الصحيح لعلامات الترقيم .
ومع تزايد الاهتمام بقضايا التطوير المهني لأداء المعلم، ظهرت في الآونة الأخيرة توجهات ومداخل تدريسية وتدريبية أكثر فاعلية، تهدف إلى إكسابه المعارف والمعلومات والمهارات التي تتناسب مع متطلبات المشهد التعليمي الراهن واحتياجاته بكل متغيراته وضوابطه وتساعده على التخلص والقضاء من التحديات والمشكلات التدريسية، ومن هذه المداخل المعاصرة شديدة الصلة بالأداء التدريسي والكتابة التفسيرية مدخل التعلم القائم على السيناريو Scenario Based Learning. وفي ظل الجهود العالمية في تطوير برامج إعداد المعلمين بكليات التربية وبرامج التطوير المهني المدرسي، ظهر أنموذج التعلم القائم على السيناريو كتجربة تستند إلى مبادئ التطوير المهني القائم على النظرة الشاملة والمتكاملة لواقع الممارسات التدريسية من خلال التأمل في التدريس، وتطوير المعتقدات والكفايات التدريسية بناء على نتائج التحليل النقدي الذاتي وفق أطُر شاملة.
ومدخل التعلم القائم على السيناريو SBL مدخل دينامي غير خطي تحدث فيه عملية التعلم من خلال السياق الذي يتضمن الحصول على المعارف واكتساب المهارات، وهو مدخل يسمح للمشاركين باستنتاج المشكلات التي ربما تواجه الطالب المعلم في حياته المهنية المستقبلية داخل الفصل، وتجريب طرائق التعامل مع هذه المشكلات .
وظهر مفهوم التعلم القائم على السيناريو بسبب عدم الاقتناع بالنظرية السلوكية في التعليم الموجه فقط إلى تمارين الاستجابة للتحفيز والذي نجم عنه وجود انخفاض جودة مخرجات التعلم والتي اتسمت بعدم قدرة معظم المتعلمين على ربط ما تعلموه عن طريق التطبيق في حياتهم، وهذا الأنموذج يعتمد على النظرية البنيوية التي تؤكد على أن معرفة الفرد هي بناء له والمعرفة عي نتيجة لبناء المعرفة للعالم الحقيقي من خلال الأنشطة وهياكل المعلومات اللاز. لذلك جاء التعلم القائم على السيناريو كاستجابة سريعة لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق؛ لأنه يعتمد على توفير مواقف تعليمية تجريبية تتضمن مشكلات العالم الحقيقي بشكل منظم، تسمح للمتعلمين بتطبيق وتوظيف معارفهم ومهاراتهم لحل المشكلات والتحديات التي تواجههم بشكل تعاوني وفي بيئة آمنة، مما يحقق التعلم النشط وإتقان المهارات ذات الصلة وتعميق تعلم الطلاب.
ولقد استخدم مصطلح السيناريو Scenario لأول مرة من قِبَل الروائي وكاتب النصوص السينمائية Leo Rosten عندما وجد مجموعة من الفيزيائيين تفتش عن اسم يصف البدائل للكيفية التي يمكن أن تتصرف بها الأقمار الصناعية، وكلمة سيناريو Scenario كلمة مترجمة من الإيطالية تعني وسيلة للتخطيط الاستراتيجي الذي يستخدمه الفرد أو المجموعة لإعطاء مرونة لخطط طويلة الأمد، وتعني التكيف والتعميم للأساليب التقليدية بربطها بالحاضر والمستقبل.
ويرى الدكتور حسن شحاتة (201٦) أن السيناريو عملية إدراك للمشكلات والقدرة على صياغة فرضيات جديدة والتوصل إلى ارتباطات جديدة باستخدام المعلومات المتوفرة، والبحث عن حلول وتعديل الفرضيات وإعادة صياغتها عند اللزوم ورسم البدائل المقترحة، ثم تقديم النتائج في آخر الآمر. وتتطلب هذه العملية التساؤل والبحث عن الغموض، والتقصي والخيال لتجسيد التفكير في صورة ذهنية أو رسوم أو أفكار، حيث " تتم ملاحظة الماضي واسترجاع آثاره لدراسة الحاضر، واتخاذ ذلك نقطة بدء لدراسة المستقبل ".
ويعتمد التعلم القائم على السيناريو على الفلسفة البنائية التي تؤكد أهمية ميول المتعلمين وخبراتهم السابقة، وعلى أن المتعلم هو محور الموقف التعليمي والتدريبي، وأن عملية التعلم تحدث عندما يقوم المتعلم ببناء معرفته بنفسه، فالتعلم يقوم على ما يصنعه الطالب من روابط بين ما اكتسبه من معارف ومعلومات، وتطبيقاتها الحياتية، ويذكر (Ultay) أنه عند ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة للمتعلم وربط المعرفة بسياقات الحياة اليومية يصبح التعلم ذا معنى ويكتسب المتعلمون المعرفة من خلال الاكتشافات والاستنتاجات من خلال عملية الربط.
وتتمثل فوائد استخدام أنموذج التعلم القائم على السيناريو في قدرته على تحقيق جملة من النتائج الإيجابية بالنسبة للطالب المعلم منها تفعيل المنحى التكاملي من خلال الربط بين المعارف والنظريات والحقائق والسياقات الواقعية، ودعم عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي للأداء في المستقبل واستكشاف النتائج والآثار المحتملة والسياسات التدريسية المستقبلية ، وترقية مهارة المتعلمين على تطوير المهارات والكفايات الاتصالية وممارستها بصورة وظيفية، وتشجيع المعلمين على التطوير المهني الشخصي والأكاديمي والاندماج في بيئة التعلم، وأخيرًا خلق بيئة تعليمية تفاعلية وتعاونية يعمل فيها الطلاب في وضع واقعي تتيح لهم إدارة الوقت بشكل جيد مع زيادة فرص التغذية الراجعة لهم.
ولقد أبرزت نتائج الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت واستهدفت استخدام وتوظيف أنموذج التعلم القائم على السيناريو النتائج الإيجابية التي ارتبطت بالاستخدام في تنمية الأداء التدريسي وكفايات التدريس اللازمة، والتحصيل، وتحسين الكفاءة اللغوية، وتنمية مهارات اللغة والتفكير وحل المشكلات، حيث أبرزت فاعلية استخدام التعلم القائم على السيناريو في رفع الاستعداد الوظيفي للطالب المعلم، وتحسين الكفاءة الذاتية، وزيادة وعي متعلمي اللغة واستخدامهم لاستراتيجيات تعلمهم بكفاءة، والمساهمة في الاستدعاء السريع للمعلومات وذلك من خلال التطبيقات المتعددة للتعلم القائم على السيناريو والتي حددها الباحثون في التعلم القائم على الحالة، والتعلم القائم على السياق، والتعلم القائم على المشكلة، والسيناريوهات القائمة على المهارات، والسيناريوهات التخمينية.
ويمكن عرض هذه التطبيقات كالآتي:
1 ـ التعلم القائم على المشكلة Problem Based Learning: يتم في هذا التطبيق من التعلم توجيه المتعلمين إلى اكتساب المعرفة اللازمة لحل المشكلة، وقد تكون المعرفة الجديدة المكتسبة خلال حل المشكلة أكثر أهمية من المشكلة ذاتها، وهذا النمط يعد فرصة حقيقية مباشرة لاكتساب مهارات التفكير التأملي من خلال البحث عن المعلومات والبدائل والتحقق من الاحتمالات وتقييم النتائج.
2 ـ التعلم القائم على المشروع Project Based Learning: يركز هذا النمط من التعلم على تقديم منتج نهائي، ويتم فيه التركيز على تطبيق واستيعاب المعرفة المكتسبة سابقا.
3 ـ التعلم القائم على الحالة Case Based Learning: يتم في هذا النوع من التعلم تقديم حالات متعددة مرتبطة بموضوع الدرس إلى المتعلمين والتدريب عليها والتعامل معها عن قرب.
4 ـ التعلم القائم على السياق Context Based Learning : يتم في هذا النمط تقديم المعرفة للمتعلمين والتدريب عليها من واقع حياتهم التي يعايشونها وبخبرات حقيقية يمرون بها، والمعرفة التي يتم بناؤها في الوقت الحاضر هي نتاج التفاعل والترابط بين المعلومات والنشاط الفعلي والأدوات المستخدمة والسياق والأسس الثقافية.
5 ـ السيناريوهات القائمة على المهارات Skills Based Scenarios: تتطلب هذه السيناريوهات من المتعلمين إظهار معارفهم عمليا من خلال إنتاج أو تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمهارات النوعية المرتبطة بتخصصاتهم الأكاديمية.
6 ـ السيناريوهات القائمة على التخمين Guessing based Scenarios: وفيها يسمح للمتعلمين بإبداء الرأي وتكوين الفرضيات حول مجموعة من الأحداث الماضية أو الحالية أو المستقبلية من المعلومات المعطاة والتي تم البحث عنها. ويطلق على هذا النمط سيناريوهات التوقع Predictive Scenarios بحيث إتاحة الفرصة للمتعلمين بالتنبؤ للإجابة عن تساؤل (ماذا سيحدث لو ؟).
ـ مشكلات تعليمية مستدامة:
وبالرغم من التأكيد على أهمية إعداد الطالب المعلم المتأمل الذي يخطط لأدائه التدريسي بصورة متميزة ترتكز على المعرفة السابقة والنظريات المعاصرة، ويراقب ويقيِّم أسلوبه في العمليات والإجراءات والخطوات التي يقوم بها لاتخاذ قرار صائب بشأن تحقيق أفضل بيئة ممكنة للتعلم بما يحقق النواتج التعليمية المرغوب فيها، إلا أن الواقع يفي بعدم وعي الطلاب المعلمين بمكانة وأهمية الأداء التدريسي التأملي ومهاراته، فضلا عن عدم وجود مقرر أو برنامج تدريبي بمرحلة الليسانس يستهدف تدريبهم بكليات التربية على التدريس التأملي.
فالطلاب المعلمون يتلقون خلال برامج إعدادهم بكليات التربية دراسة عدد من موضوعات ونظريات التدريس والتعلم، لكن المشكلة التي تواجه هؤلاء الطلاب (معلمي المستقبل) أن بعضا منهم لا يدرك الأهمية العملية لتعلم تلك الموضوعات والنظريات على النحو الصحيح؛ بحيث يستطيعون توظيفها لحل المشكلات التعليمية أو السلوكية التي قد تواجههم في الميدان العملي، ولم يمنحوا فرصا حقيقية لتطبيق أو ترجمة المحتوى النظري الأكاديمي لواقع عملي ملموس. وربما ترجع أسباب ضعف الطلاب المعلمين في امتلاك مهارات الأداء التدريسي التأملي وفق شكوى القائمين على تدريس مقررات طرق التدريس والتدريس المصغر لهم إلى عدم رسوخ مفاهيم الأداء التدريسي التأملي في أذهانهم، وعدم اتخاذهم قرار بشأن اعتماد مجموعة من الاستراتيجيات والإجراءات في تخطيطهم وتنفيذهم للدروس.
ولعل أكثر مظهر من مظاهر ضعف برامج إعداد معلم اللغة العربية بكليات التربية التباعد بين ما يدرسه الطالب في مدرجات الجامعة وما يمارسه بالفعل داخل جدران الفصول، وأشار إلى أنه يستلزم إيجاد هذه العلاقة أن نحدد على وجه الدقة ما ينبغي أن يكتسبه المعلم من مهارات تدريسية في ضوء ما يمارسه داخل الفصل، لذلك تعالت الصيحات في ميدان إعداد معلم اللغة العربية مطالبة بإعادة النظر في برامج هذا الإعداد.
وبرغم أهمية الأداء التدريسي التأملي وضرورة التدريب على مهاراته بالنسبة للطلاب المعلمين لاسيما طلاب شعبة اللغة العربية، إلا أن معظمهم يعتمدون على خبرتهم الشخصية التي تبدو محدودة بحكم سنوات الخبرة والتجارب الواقعية عندما تواجههم مشكلة تدريسية مع طلابهم في أثناء التدريب الميداني، وينأون بأنفسهم عن استشارة أقرانهم من الطلاب أو الأساتذة المتخصصين في طرائق التدريس، ويعتمد كل منهم على طريقته التي اعتاد عليها وألفها دون أن يخضع نفسه لعملية مستمرة من التقويم الذاتي والملاحظة المستدامة للمواقف التدريسية التي يمر بها.
ـ الأداء التدريسي التأملي:
يشير مفهوم الأداء التدريسي إلى أنه مُنجزٌ ناجِمٌ عن ترجمة المعرفة النظرية وتطبيقها إلى مهارات وعمليات وأداءات إجرائية وذلك من خلال الممارسة الإجرائية العملية والتطبيقية لنظريات التدريس، وتتحقق تلك الممارسات من خلال الخبرات الشاملة المكتسبة في مجال تخصص المتدرب، وتتم هذه الممارسة وفق ضوابط ومعايير إجرائية محددة يؤدي توافرها إلى تحقيق الجودة الشاملة في التنمية المهنية المستدامة.
وهذه السلوكيات التدريسية يمكن ملاحظتها وقياسها، ويتوقف مستوى الأداء التدريسي على الخلفية المعرفية والنظرية للمعلم، فضلا عن أن هذه الممارسات جزء أصيل من المكونات الرئيسة للمهارة، ومن ثم لا يمكن قياس المهارة إلا في ضوء هذه المؤشرات والممارسات الجزئية.
ويعد التدريس التأملي استجابة تربوية لمتطلبات معلمي المستقبل كما يوضح (Souto & Dice) من أن أهم مقتضيات التنمية المهنية والأكاديمية الاعتماد على الممارسات التأملية في أثناء التدريب على التدريس قبل الخدمة، والتي تؤدي بدورها إلى المساهمة في تغيير السلوك التدريسي والمواءمة بين النظرية والتطبيق. وهذا ما دفع (Boxley) للتأكيد على أهمية الممارسة التأملية للمعلم وضرورة تدريب معلمي قبل الخدمة عليها؛ حيث إنها تُكسب المسئولية وتحقق الالتزام الذاتي الذي يستهدف تطوير الشخصية التدريسية وتحسينها. لذلك تُمَثِّل الممارسة التأملية للتدريس فرصة يحصل من خلالها الطالب المعلم على تحليل أنشطته التعليمية لتحسين وتجويد أدائه التدريسي في المستقبل، وتمكينه من فهم تصرفاته الصفية التي تحقق ذاته المهنية، وتلك الممارسات بمؤشراتها الإجرائية تسهم في مساعدة الطالب المعلم في تبسيط أنشطة التدريس، وتعتبر الممارسة التأملية عجلة دفع رئيسة للتطوير المهني للتدريس.
ولقد تعددت التعريفات وتنوعت للأداء التدريسي التأملي حسب الاستخدام والتوظيف، فيعرفه (Paul) بأنه " الأعمال التي يقوم بها المعلم قبل وأثناء وبعد عملية التدريس، وتتمثل في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقويم، وبدونها لا يستطيع المعلم أن يحقق أهداف الدروس بشكل فعال". ويعرف على أنه " سلوك المعلم أثناء مواقف التدريس سواء داخل الفصل أو خارجه وهو الترجمة الإجرائية لما يقوم به المعلم من أفعال، واستراتيجيات في التدريس أو في إدارته للفصل أو مساهمته في الأنشطة المدرسية أو غيرها من الأعمال أو الأفعال التي يمكن أن تسهم في تحقيق التقدم تحصيل التلاميذ".
ويرى (Brent) الأداء التدريسي التأملي " القدرة على التأمل والتفكير الناقد الإيجابي الذاتي والمستمر للممارسات والإجراءات التدريسية التي ينفذها المعلم؛ بهدف تحسين وتطوير هذه الممارسات والإجراءات".
ويُقصد بالأداء التدريسي التأملي أنه " ممارسات الاستفسار أو الاستبصار التي يقوم بها المعلم في أثناء تحركاته وأنشطته داخل الموقف التعليمي؛ لتحديد المسارات الخطأ على مستوى البنية المعرفية أو في الممارسات التدريسية ومعالجتها (Carey). ويعرفه (Goker) بأنه "قدرة المعلم على الانخراط في الممارسة التأملية للتدريس في دورة مستمرة من التخطيط والمراقبة والتقييم الذاتي من أجل فهم ممارساته وردود افعال التي تصدر منه أثناء عملية التدريس".
وفي ضوء استقراء التعريفات المتنوعة لمفهوم الأداء التدريسي التأملي، يمكن تحديد بعض الخصائص التي تميز المفهوم عن غيره من المفاهيم المتعلقة بعملية التدريس، منها ما يلي:
1 ـ مجموعة من الآليات والمناشط التي يتم استخدامها وتوظيفها بتتابع محدد وبتوجيه من المعلم لتأمل الموقف الصفي لبناء تصور ذهني صحيح حول المعرفة التدريسية.
2 ـ مجموعة من العمليات العقلية والممارسات الأدائية التي يقوم بها المعلم بغرض التفكير في هذه الممارسات وتأملها وتحليل استجاباته وتفاعلاته مع المتعلمين.
3 ـ ترجمة العمليات والاتجاهات والمعارف إلى سلسلة من الأفعال والإجراءات التطبيقية العملية.
4 ـ مجموعة من الأداءات التدريسية التي ترتكز على مراجعة الخبرات السابقة وتكون قابلة للملاحظة والقياس والتطبيق وفق معايير وضوابط محددة تعكس عملية التأمل التي يقوم بها المعلم.
5 ـ مجموعة من السلوكيات التدريسية المستندة إلى خلفية معرفية ومتطلبات قبلية مهارية ترتبط بعناصر الموقف التدريس التي تعد ضرورية وتعبر عن جودة أداء المعلم وكفاءته.
6 ـ الفحص الناقد للممارسات التدريسية من منظور شخصي (المعلم) ومن منظور الآخرين؛ حيث يتضمن تفكيرا دقيقا وواعيا للاختيارات التدريسية التي يقوم بها المعلم.
7 ـ وعي المعلم بمعتقداته وخبراته ورؤاه حول عملية التدريس والعوامل والدوافع التي تؤثر على أدائه داخل الفصل.
ـ مكونات الأداء التدريسي التأملي:
يتمثل الأداء التدريسي التأملي في ثلاثة مكونات رئيسة؛ المكون المعرفي، والمكون المهاري، والمكون النفسي. والمكون المعرفي يتمثل في محتوى المهارة أو المؤشر الذي يشتمل على مواصفات المهارة التدريسية، وكيفية أدائها النفسي والتربوي، ومدى مناسبتها للمتعلمين، ولأهداف المقرر الدراسي ومحتواه المعرفي، إلى جانب مواضع استخدامها في الموقف التدريسي نفسه. بينما يتمثل المكون المهاري في أسلوب المعلم لأداء مهارة التدريس وتنفيذ الأساليب المناسبة لها خلال الموقف التعليمي، والتي تتناسب مع أهداف المقرر الدراسي، وطبيعته، بما يساعد على تحقيق تلك الأهداف وتشجيع المتعلمين وتحفيزهم على التعلم. بينما يشير المكون النفسي إلى رغبة المعلم في تعلم المعرفة التدريسية المطلوبة والمرغوبة، وإحساسه بأهميتها في تطويره المهني، وفي أدائه الصفي، ومدى اقتناعه بضرورة اكتسابه لتلك المهارات بُغية نموه المهني المستدام.
ـ خصائص الأداء التدريسي التأملي الجيد:
يمتاز الأداء التدريسي التأملي الجيد بجُملةٍ من الخصائص التي يجب أن يكون الطالب المعلم على درجة من الوعي بطبيعتها وخصائصها، ويمكن تحديد بعض هذه الخصائص فيما يلي:
1 ـ العمومية: تمتاز مهارات النشاط والتفاعل داخل حجرة الصف الدراسية بالعمومية ومفاد ذلك أن وظائف المعلم ومهامه التدريسية تكاد تكون واحدة في معظم مراحل التعليم التي يقوم بالتدريس لها وربما في كل المواد الدراسية أيضا؛ لأن طبيعة التدريس متشابهة إلى قدر كبير.
2 ـ عدم الثبات: تبدو مهارات التدريس غير ثابتة بل تتأثر بعوامل التطور التي تدفعها إلى التحسين والتجويد، كذلك تطور المفاهيم التدريسية الخاصة بعمليتي التعليم والتعلم.
3 ـ التداخل: السلوك التدريسي التأملي الذي تعبر عنه المهارات والمؤشرات هو سلوك معقد ومركب وبالتالي من الصعب فصل بعض المهارات التي ترتبط بكل عنصر رئيس من عناصر التدريس عن غيره بسبب التداخل الحاصل بين هذه المهارات، لذا تم تقسيمها إلى مهارات رئيسة (التخطيط ـ التنفيذ ـ إدارة الصف ـ التقويم) ومهارات ومؤشرات فرعية.
4 ـ القابلية للتعلم: مهارات الأداء التدريسي التأملي قابلة للاكتساب والتعلم من خلال النمذجة وتعرف الخبرات السابقة والتدريب المباشر على استخدامها.
5 ـ الفحص الناقد: يتطلب الأداء التدريسي التأملي فحصا ناقدا مستمرا للممارسات التدريسية والإجراءات التي يقوم بها الطالب المعلم في أثناء تدريبه، وتعزيز خطوات التقدم نحو الأهداف التعليمية المرجوة في إطار مستوى معين قائم على الوعي بطبيعة المواقف التدريسية وخصائص المتعلمين.
6 ـ الدائرية: يعد الأداء التدريسي التأملي عملية دائرية مرنة يقوم فيها الطالب المعلم من خلالها بإعداد المخططات التدريسية ومراجعتها في ضوء فلسفة التدريس التأملي، وتنفيذ وتقييم عمليات التدريس ومهامه بشكل تأملي والممارسات التدريسية التي يقوم بها.
7 ـ الوعي المستدام: الممارسة التأملية للتدريس تفترض أن يعي الطالب المعلم ممارسته الحالية للتدريس والمعتقدات التي يقوم عليها، وأن يستبصر الممارسة الجديدة التي يقتضيها التدريس التأملي.
ـ مبادئ الأداء التدريسي التأملي:
1 ـ المعرفة السابقة لدى الطلاب المعلمين يمكن تعوق أو تعزز الأنشطة وعمليات التعلم، لذا يجب دعم الطلاب المعلمين في تأملها وفحصها ومن ثم تصحيحها وفق التصورات الذهنية الصحيحة.
2 ـ تنظيم الطالب المعلم للمعرفة وتحديد أنماط معالجتها بصورة إجرائية قابلة للقياس والملاحظة.
3 ـ بناء الدافعية لدى الطالب المعلم تحدد وتوجه استمراريته في اكتساب واستخدام مهارات الأداء التدريسي التأملي بكفاءة وفاعلية.
4 ـ تجزئة المهارات التدريسية التأملية إلى مهارات فرعية ومحاكاتها وتأملها من جانب الطالب المعلم نفسه ومن جانب أقرانه.
5 ـ التدريبات المتمركزة على الأهداف ونواتج التعلم المقصودة مصحوبة بالتغذية الراجعة تدعم جودة تعلم مهارات الأداء التدريسي التأملي وإتقانها.
هـ ـ مهارات الأداء التدريسي التأملي:
ثمة ملامح رئيسة تحدد مهارات الأداء التدريسي التأملي والتي تتمثل في مراعاة متغيرات التدريس الأساسية مثل الوعي بخصائص المتعلمين، والتمكن من المحتوى اللغوي المعرفي، وإدراك أهداف التعلم ونواتجه بعناية ودقة، كذلك الإحاطة المتميزة باستراتيجيات التدريس المناسبة والمعاصرة والتي يمكن توظيفها في التفاعل مع المتعلمين داخل حجرة الدراسة، فضلا عن مراعاة الطالب المعلم لمراحل التدريس الاستراتيجي التي تتضمن التهيئة للتعلم، وكيفية عرض وتقديم المحتوى ومدى مشاركة المتعلمين وطرائق التفاعل معهم، وصور الاندماج بين الطلاب وأنفسهم وصولا إلى تحقيق التعلم الاستقلالي لهم، وصولا إلى تقويم نتائج التعلم ومتابعتها من أجل التطوير والتحسين.
كما أن مهارات الأداء التدريسي التأملي التي يجب أن تتوافر في الطالب المعلم (تخصص اللغة العربية) ينبغي أن ترتبط ارتباطا وثيقا ببعض كفايات الأداء التدريسي الأساسية والتي تعد من المتطلبات القبلية للتعلم، والتي يمكن تحديدها في التمكن من استثارة دافعية المتعلمين، والقدرة على ربط بين المعارف النظرية والتطبيقية، والقدرة على استخدام أساليب التعزيز والتحفيز، واستخدام واختيار طرائق التدريس واستراتيجياته بما يتوافق مع الموقف الصفي، والقدرة على استخدام وتوظيف تكنولوجيا التعليم في التدريس.
ولقد تعددت الدراسات والبحوث السابقة التي اهتمت بتحديد أبرز مهارات الأداء التدريسي التأملي والتي ينبغي إكسابها للطالب المعلم والعمل على تنميتها، ومعظم هذه الدراسات أكدت أن المقصود بمهارات الأداء التدريسي التأملي المراد تنميتها لدى الطالب المعلم هو شكل من أشكال التعلم الذي يتطلب التأني في التخطيط للتدريس، وملاحظة مواقف التعلم قبل تنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار بالخبرات السابقة للطالب المعلم وربطها بالخبرات والتجارب الراهنة والمستقبلية.
وباستقراء الدراسات والبحوث التي اهتمت بتنمية الأداء التدريسي التأملي، يمكن تحديد بعضها فيما يلي:
1 ـ التخطيط للتدريس:
ويقصد به أنه تصور مسبق لما سيقوم به المعلم من أساليب وأنشطة وإجراءات، واستخدام أدوات أو أجهزة أو وسائل تعليمية؛ من أجل تحقيق الأهداف التربوية المرغوبة ويضم مجموعة من المؤشرات والسلوكيات الأدائية منها ما يلي:
ـ التفكير مسبقا في خطوات عرض الدرس اليومي قبل الشروع في إعداد مخطط التدريس.
ـ إعداد خطة تفصيلية لتدريس المحتوى النظري (تتضمن عناصر تحضير الدرس).
ـ تقييم كل عنصر من عناصر خطة التدريس في ضوء معايير جودة هذه العناصر.
ـ مراجعة خطة الدرس عقب الانتهاء من إعدادها.
ـ مقارنة خطة الدرس مع مخططات بعض الطلاب المعلمين المتميزين.
ـ تقييم مدى جودة عناصر خطة الدرس بعد انتهاء إعدادها في ضوء ظروف التنفيذ الفعلي.
ـ تعرف مدى ملاءمة الوقت المخطط للتنفيذ مع وقت التنفيذ الفعلي.
ـ تدقيق النظر في تحديد احتياجات المتعلمين الفعلية.
ـ التفكير في كافة الاحتمالات الممكنة قبل إصدار أي حكم أو قرار يتعلق بالممارسات التدريسية.
ـ التفكير في وضع حلول مقترحة مسبقا للمشكلات المتوقع حدوثها في الموقف التدريسي.
ـ تحديد الإجراءات التدريسية التصحيحية الممكن اتخاذها في ضوء نتائج مراجعة وتحليل وتقييم الممارسات التدريسية السابقة.
ـ تأمل مدى مناسبة وملاءمة استراتيجيات التدريس المختارة لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.
ـ يصمم أنشطة تعليمية تناسب الفروق الفردية وانماط التعلم بين المتعلمين.
2 ـ التنفيذ:
ـ توظيف أسلوب التهيئة بما يساعد في وضع تصورات المتعلمين وأفكارهم موضع المساءلة.
ـ عرض محتوى الدرس في شكل مشكلات وقضايا تتطلب التأمل لتفسير النتائج في ضوء الأسباب.
ـ مراقبة مدى التقدم نحو تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.
ـ تعرف تصورات المتعلمين حول المشكلات والقضايا المطروحة أثناء عرض الدرس.
ـ تعرف خبرات المتعلمين المختلفة للبناء عليها وتوفير فرص تعليم ذي معنى.
ـ مراقبة مدى النجاح في افتتاح الدرس وجذب انتباه المتعلمين نحوه.
ـ مراجعة جدوى استخدام الوسائل التعليمية التي تم استخدامها.
ـ تعرف مدى ملاءمة أنشطة الدرس للمتعلمين في ظروف التنفيذ الفعلي.
ـ غلق الدرس بربط عناصره وأنشطته وأساليب التقويم المستخدمة لنواتج التعلم المستهدفة.
ـ توظيف التغذية الراجعة في اتخاذ القرار المناسب بشن عمليات التعلم.
3 ـ إدارة الصف والمتابعة:
يقصد بها مجموعة من الأنشطة التي يقوم بها المدرس داخل الصف لتنمية السلوكيات المرغوب فيها، وحذف السلوكيات غير المرغوبة لدى التلاميذ وتكوين علاقات إنسانية صحيحة معهم وفيما بينهم؛ بهدف تحقيق جو اجتماعي إيجابي فعال ومنتج، وتضم مجموعة من المؤشرات والسلوكيات الأدائية منها ما يلي:
ـ تعرف مدى مناسبة تنظيم الفصل لاستراتيجيات وأهداف التدريس.
ـ يستخدم أساليب إدارة الصف التي تشجع التحكم الذاتي وتدعم المسئولية لدى المتعلمين.
ـ تجنب إصدار الأحكام على أداء المتعلمين قبل مراجعتها وتحليلها.
ـ توجيه الطلاب إلى البحث عن مسببات الأشياء والظواهر المدروسة.
ـ مراقبة جدوة التواصل مع المتعلمين في أثناء التدريس.
ـ مراعاة الفروق الفردية وأنماط التعلم المختلفة بين المتعلمين داخل الفصل.
4 ـ التقويم ومتابعة نتائج التعلم:
ويقصد بالتقويم أنه العملية التي ترمي إلى معرفة النجاح أو الفشل في تحقيق الأهداف العامة التي يتضمنها المنهج، وتحديد نقاط القوة والضعف به، حتى يمكن تحقيق المنشودة بأحسن صورة. ويضم مجموعة من المؤشرات والسلوكيات الأدائية منها ما يلي:
ـ تحديد مواطن القوة والممارسات التدريسية في ضوء نواتج التعلم المستهدفة.
ـ تصنيف مواطن القوة في الممارسات التدريسية وفقا لمهارات التدريس الرئيسة.
ـ تحديد مواطن الضعف في الممارسات التدريسية في ضوء نواتج التعلم.
ـ تقييم مدى تطور الأداء التدريسي من خلال عقد المقارنات بين الممارسات التدريسية التي تم تنفيذها.
ـ تحديد مدى الاتساق بين التصورات عن التدريس وبين الممارسات التدريسية الفعلية.
ـ تحديد مدى الاتساق بين التصورات عن التدريس وبين الإجراءات التصحيحية الممكن اتخاذها.
و ـ قياس الأداء التدريسي التأملي وتقويمه:
لا يمكن اعتبار عملية تقويم أداء الطالب المعلم مسألة بسيطة، بل هي بالفعل عملية شاقة كونها لا تقتصر على جمع البيانات والمعلومات والشواهد الخاصة بأدائه فحسب، بل تشمل عملية تقويم المعلم تحليلا عميقا ووصفا شاملا لهذا الأداء في ضوء معايير محددة سلفًا، وهذه العملية تتضمن ثلاثة أبعاد رئيسة؛ الأول تحديد مستويات الأداء التي يجب أن يحققها المعلم عند التنفيذ لدرسه، والثاني تجميع المعلومات حول أدائه الفعلي، بينما يشير المكون الثالث إلى تحليل النتائج التي أسفر عنها الأداء الفعلي له. ولقد رصد بعض التربويين المعاصريين في طرائق تقويم المعلّم وأساليبه، يمكن عرضها فيما يلي:
1 ـ مقابلة المعلم: يستخدم هذا الأسلوب عادة للمعلمين حديثي الخبرة التدريسية،، وتبعًا لهذا الأسلوب يوجِّه المقوِّم عددًا من الأسئلة المتنوّعة للمعلِّم، ثم يحلِّل إجابته عنها، ويعتبر أسلوب مقابلة المعلم غير دقيق في تجميع المعلومات الكافية حول أداء المعلم؛ حيث إنه يعتمد بصورة كبيرة على مهارات وكفايات الخبير الذي يُعهد إليه بالمقابلة، فإذا قام أكثر من خبير تقويم بإجراء مقابلة مع نفس المعلِّم، فإن كلّ واحد منهم يخرج بانطباعات تبدو غير ثابتة ومختلفة تمامًا عن المعلِّم، وهذا التبايُن ينشأ بسبب اختلاف الأسئلة التي توجّه إليه، واختلاف الاهتمامات التي يتبعها كلّ واحد منهم، ويؤكِّد عليها، فضلا عن تنوع خبراتهم وتباينها، وربما وجود حالة من التباين في التقويم أيضا قد ينشأ نتيجة الاختلافات في تفسر الاستجابات وتقيِّمها تلك التي تصدر عن المعلم.
2 ـ اختبار كفاءة المعلم: وفي هذا الأسلوب يجيب المعلِّم عن أسئلة اختبار يقيس كفاءاته الذاتيَّة التي تتضمن الكفاءة الأكاديميَّة، والكفاءة التدريسية، والكفاءة الاجتماعيَّة.
3 ـ الملاحظة الصفيَّة: تُعَدُّ الملاحظة الصفيَّة أكثر أساليب تقويم الأداء التدريسي للمعلِّم شيوعًا، وتشير نتائجُ الدراسات والبحوث التي أُجريت في مجال تقويم أداء المعلم إلى أنَّ الملاحظة المنظَّمة التي تُستخدم فيها بطاقات الملاحَظة المقننة تُعَدّ من أكثر أدوات القياس موضوعيَّة لتقويم الأداء التدريسي للمعلِّم؛ كونها تتيح ملاحظة سلوك المعلم وأدائه مباشرة داخل حجرة الدراسة، مما يسهم في معرفة الجوانب الإيجابيَّة والسلبيةَّ في أدائه، وهذا قد يسُاعِد على تطوير برامج إعداده، وتدريبه. ويوجد نظامان يمكن استخدامها في بناء بطاقات ملاحظة وقياس أداء الطالب المعلم في أثناء التدريب على التدريس، وهما:
أ ـ نظام القوائم سابقة الإعداد: ويُستخدم هذا النظام في ملاحظة أداء المعلِّم في أثناء التدريس عن طريق تحديد أنماط السلوك التدريسيّ مُسبَقًا، أي قبل بَدْء عمليَّة الملاحظة في ضوء تصوُّر الأداء، ثم رصد ما يحدث منها داخل حجرة المدرسة، بحيث تُحدَّد وتُصاغ هذه الأنماط في شكل عبارات سلوكيةَّ تتضمَّن الأفعال التي تصدر عن المعلم في أثناء التدريس، ولذلك تصُمَّم بطاقات خاصة تحتوي على عبارات تصف السلوك المتوقَّع من المعلِّم في أثناء عملية التدريس.
ب ـ نظام التصفيات أو المجموعات: يُستخدم هذا النظام في بناء بطاقات ملاحظة أداء المعلِّم في أثناء التدريس، ففيه يُرصَد تكرار الأداء الذي يصدر عن المعلِّم والطالب في أثناء التدريس، ويعتمد في ذلك على بطاقات خاصَّة يصُنَّف فيها أداء المعلِّم والطلبة إلى أنماط نوعيَّة، بالإضافة إلى رصد السلوك المشرك، ويهدف هذا النظام إلى تحديد نمط الأداء الذي يتميَّز به المعلِّم في التدريس حتى يسهل تعرف إيجابياته وسلبياته قياسًا على معاير محدَّدة.
ج ـ نقد الزملاء: في هذا الأسلوب يقوم الزملاء من المعلمين بملاحظة أداء بعضهم البعض من حيث فحص خطة الدرس، ومتابعة المهارات التدريسيةَّ في أثناء الحصة، وأساليب المعلِّم التدريسيةَّ.
د ـ التقويم الذاتيّ: يُعَدّ هذا الأسلوب أحد أهم المصادر لجمع المعلومات عن أداء المعلِّم، حيث إن المعلم يكون على وعي بآماله وتطلُّعاته واهتماماته وإنجازاته والأمور المتعلِّقة به أكثر من وعي الآخَرين بها، ويتطلَّب التقويم الذاتيّ محاسبة النفس، واكتشاف الأخطاء، وتقدير العواقب والنتائج، والتخطيط لعمل أفضل، كما يتطلَّب هذا الأسلوب من التقويم أيضًا نضجًا عقليًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا.
هـ ـ تحصيل الطلاب: وفيه تُستخدم نتائج اختبارات الطلاب التحصيلية، وهي تلك الاختبارات التي تقيس ما حصّله كل طالب في فترة زمنيَّة معيَّنة كدليلٍ على سلوك المعلِّم التدريسي؛ ما يُساعِد على تقويم أدائه، ويتم ذلك في ضوء ترتيب الطلاب أو الفصول الدراسيَّة طبقًا لمعايير معيَّنة.
ويعتبر مدخل التعلم القائم على السيناريو شكلا من أشكال التعلم الخبراتي Experimental Learning الذي يعتمد على وضع المتعلم في موقف تعليمي حقيقي يؤثر على قراراته المهنية، حتى يتمكن من اكتساب المعرفة اللازمة والمهارات التدريسية كما هو الحال في المواقف الصفية داخل حجرة الدراسة.
ولقد ارتبط مصطلح السيناريو بداية بالعمل الفني بشكل عام سواء كان للسينما أو المسرح، وهو في مفهومه العام الفني يمثل الحبكة الدرامية للقصة أو الرواية بتسلسل أحداثها والتصرفات المصاحبة لكل حدث، والمشاهد التي تبرز الحدث أو المفهوم أو الدرس المطلوب توصيله إلى الجمهور. ولقد ظهر المفهوم في صورته التعليمية في أواخر الثمانينيات على يد Roger Schank أحد خبراء الذكاء الاصطناعي وهندسة المناهج النفسية وبناء بيئات التعلم، وقام بتأسيس شركة متخصصة Socratic Arts قامت بتصميم وتنفيذ مبادئ التعلم القائم على السيناريو والتعلم بالممارسة في بعض المدارس والجامعات التعلم بالممارسة، والسماح للمتعلمين والمعلمين بارتكاب الأخطاء في بيئة تعليمية آمنة مع تصويبهم، وقامت الشركة بالعديد من عمليات المحاكاة للمعلمين مدعومة بالقصص والسيناريوهات التنبؤية التي قد تحدث داخل الفصول.
كما يعني التعلم القائم على السيناريو أنه عرض حالة تمثل نموذجا حقيقيا ويقوم الطالب ومجموعة الفصل بدراستها بعمق وتحليلها من خلال المناقشات وجمع المعلومات عنها، وتأمل التفاصيل ودراستها؛ للحكم عليها واتخاذ القرار بشأنها.وهو يعني خطة لمجموعة من الأحداث والتصرفات المتوقعة أو التي يمكن التنبؤ بها، وهو تسلسل لأحداث المستقبل الذي يتضمن عرضا لأحداث الماضي والحاضر.
والسيناريوهات المستقبلية كمدخل تعليمي يعد عملية توليد الكثير من الأفكار وإثارة التساؤلات حول ما تم رصده وتجميعه من حقائق ومعلومات وخبرات سابقة، واستخدام التأمل والعصف الذهني وإمطار الدماغ بهدف وضع تصور مبدئي عما سيحدث في المستقبل.
ويعد استخدام مدخل التعلم القائم على السيناريو أكثر مناسبة للطلاب المعلمين الذين تتوافر لديهم بعض الخبرة السابقة والمتطلبات القبلية بالموضوعات والمفاهيم والمهارات المطروحة أمامهم بغرض الاكتساب والاستخدام، وهو يختلف عن التعلم التقليدي ليس فقط كونه يعتمد على الأنشطة التعليمية فحسب؛ بل لأنه يهتم بتدريس الموضوعات غير الروتينية التي تتطلب من المتعلمين البحث والتجريب ومراجعة المعتقدات الذهنية المرتبطة بعملية التدريس نفسها في سياقات حقيقية، وعملية المراجعة هذه تتيح لهم إنتاج تصورات جديدة وأفكار قابلة للتطبيق تساعدهم في على المشكلات التي تعترض عملهم المستقبلي.
كما أن التعلم القائم على السيناريو يتيح للطالب المعلم الخبرة الواقعية الاستكشافية من خلال خوضه لتجارب ومواقف وسياقات تعليمية مقصودة وموجهة ومخططة تماما مثلما يتعرض لها في الواقع الصفي ويقوم بتحليلها وجمع الحقائق والمعلومات والبيانات بشأنها، ومن خلال عمليات الجمع والتحليل والربط بينها وبين خبراته السابقة يمكنه اتخاذ قرار تدريسي سليم وصياغته بصورة دقيقة.
مبادئ التعلم القائم على السيناريو:
يستند مدخل التعلم القائم على السيناريو على مجموعة من المبادئ والفرضيات التي تعزز مستوى ممارسته لتحقيق الأهداف التعليمية ونواتج التعلم المقصودة، وهذه المبادئ ـ جميعها ـ تعتمد على النظرية البنائية التي تؤكد على أن معرفة المتعلم هي بناء له وتتكون من خلال المخططات الذهنية وهياكل المعرفة والممارسات التجريبية لبناء عالم حقيقي موازٍ.
ويمكن تحديد مبادئ استخدام مدخل التعلم القائم على السيناريو في تنمية مهارات الأداء التدريسي التأملي فيما يلي:
أ ـ فحص المتغيرات المحتملة في البيئة الطبيعية والمتغيرات الاجتماعية، مع تحليل الوضع التنافسي و إعطاء نتائج محتملة لكل سيناريو.
ب ـ التنبؤ بسلوك المتعلمين داخل الفصل تحت كل سيناريو وتوظيفهم وتحديد أدوارهم من خلال سيناريو تفصيلي، واختيار السيناريو الذي يحقق أفضل النتائج والتوقعات بصورة سهلة وسريعة.
جـ ـ منح الطلاب المعلمين فرصا لممارسة عمليات العلم ومهاراته مثل الربط والتصنيف والمقارنة من خلال مواقف حقيقية وأنشطة تعاونية.
د ـ مساعدة الطلاب المعلمين على وضع مجموعة من الفرضيات والاحتمالات التي تعزز تعلمهم، مع توفير الخيارات والبدائل لمساعدتهم على اتخاذ قرار سليم.
هـ ـ المشاركة الديموقراطية بين الطلاب المعلمين لمناقشة القضايا الجدلية والموضوعات المتضمنة بالسيناريو؛ بهدف الوصول إلى رؤى متوافقة وقرارات جماعية سديدة.
الفعلي.
وتحدد بويل و روثستين أدوار الطالب المعلم في أثناء اكتساب مهارات التدريس التأملي باستخدام التعلم القائم على السيناريو في الأدوار الآتية:
أ ـ تلخيص الحالة: وهو خطوة ضرورية لكي لا تنحرف المناقشة عن المسار بالاتجاه نحو الجدال وترك الأسئلة الواقعية.
ب ـ تعريف المشكلة: لابد من الاتفاق حول ماهية المشكلة والاتفاق على المعضلات الأساسية قبل التعمق فيها بشكل أكبر.
ج ـ تعرف الحلول الممكنة: ويتم هذا من خلال استخدام المعلومات والأفكار المستمدة من المقرر عبر العصف الذهني.
د ـ تقييم الحلول المقترحة: من خلال وضع قائمة بالمزايا والمساوئ أو بالنتائج الإيجابية والسلبية، ثم صياغة قرارات أو الوصول إلى حلول قد تكون الأفضل عند الممارسة الحقيقية داخل حجرات الدراسة.
ـ خطوات استخدام التعلم القائم على السيناريو:
تعددت النماذج التدريسية التي استهدفت استخدام التعلم القائم على السيناريو وتنوعت بتنوع الأهداف المرتبطة بالاستخدام مثل نموذج Schank(1989)، ونموذج Chermmack (2003)، ونموذج Keough&Shanahan(2008)، ونموذج Chermack (2012)، ونموذج Kuhn&Muller (2014) وهذه النماذج الرائدة تبين كيف يستطيع التعلم بالسيناريو مساعدة الطلاب في بناء مجموعة من التصورات المتسقة والتي يمكن في ضوئها اتخاذ قرار بشأن الأداء التدريسي في المستقبل؛ لغرض تغيير التفكير وتحسين صنع القرار، إلا أن مجمل هذه النماذج اتفقت على خطوط عريضة وإجراءات متماثلة ومتشابهة سواء في التخطيط للاستخدام أو عند تنفيذها، وباستقراء هذه النماذج يمكن تحديد أبرز خطوات وإجراءات استخدام مدخل التعلم القائم على السيناريو في الخطوات الآتية:
أ ـ تحديد النطاق: ويعني التساؤل الذاتي للطالب المعلم من خلال طرحه مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالأداء التدريسي مثل: ما المشكلة التدريسية التي ينبغي عليَّ مواجهتها وحلها؟، وماذا أريد أن أعرفه عن مستقبلي المهني؟، والتنبؤ بالتحديات المتوقعة، وهذا يشترط الاتفاق حول المشكلة التدريسية التي يتضمنها السيناريو، كذلك الاتفاق على المعضلات الأساسية قبل التعمق فيها بشكل أكبر. ويشمل تحديد النطاق كإجراء رئيس في التعلم بالسيناريو قرارات المعلم بشأن احتياجات المتعلمين، والأنسب من الأهداف والغايات، كذلك المحتوى الذي سيتم تدريسه.
ب ـ تحليل الاتجاهات: وفي هذا الإجراء يتم رصد وتحليل الاتجاهات المختلفة للمتعلمين واستنتاج مشكلاتهم التي قد تعوق مشاركتهم الصفية، مع استنتاج القيم الصفية السائدة في البيئة التعليمية، ومسح البيئة الصفية الراهنة،وتحليل المعلومات الأساسية المتاحة، والقيام بالعصف الذهني وتوليد أكبر قدر ممكن من الأفكار التي تتعلق برؤى المستقبل، كما يتم في هذه المرحلة توصيف المسارات المستقبلية لخصائص مشكلة تدريسية معينة، ووصف هذه المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى وضع تدريسي مستقبلي.
ج ـ صوغ السيناريوهات: ويتضمن هذا الإجراء إعداد قصص سردية عن المستقبل المهني للطلاب المعلمين، والخطوط العريضة لعدة مسارات محتملة تستخدم لتحدي الافتراضات الأساسية لصانعي القرار. ويراعي عند إعداد السيناريوهات الموجهة الاهتمام بالنماذج الذهنية المسبقة للطلاب المعلمين والتي تكونت من خلال خبراتهم السابقة ضمن برنامج الإعداد والتأهيل بكلية التربية في السنتين السابقتين؛ من أجل أن يتأمل الطلاب المعلمون معتقداتهم التدريسية السابقة وبناء معرفة تدريسية جديدة في ضوئها أو تعديلها أو تغييرها من أجل تحسين الأداء التدريسي التأملي.
د ـ تحديد الخيارات: ويتم ذلك من خلال إنشاء خيارات لكل من السيناريوهات التي تم تحديدها، واقتراح تطبيقات التكنولوجيا الممكنة والمتاحة التي يمكن توظيفها في أثناء الاستخدام، وفي هذا الإجراء يتم تحديد الخيارات المتاحة للمشاركين الرئيسين في السيناريو. والمعلم في هذا الإجراء يقوم بتوفير البدائل ويحدد إذا ما كان تخطيط السيناريو قابلا للتطبيق أو مجديا ومدى مناسبته للمتعلمين من أجل انخراطهم فيه.
هـ ـ خيارات الاختبار: ويقصد بها قيام الطلاب بتحديد ومناقشة الآثار المحتملة والنتائج المتوقعة من السيناريو التعليمي، وفي هذا الإجراء يُطلب من المتعلمين استنساخ المعرفة الواقعية البسيطة. ويشمل هذا الإجراء تحديد السيناريوهات التي يمكنها تحقيق أهداف التعلم (تنمية الأداء التدريسي التأملي والكتابة التفسيرية) ومنها: سيناريو قائم على المهارات / سيناريو قائم على حل المشكلة / سيناريو قائم على القضايا التعليمية / سيناريو قائم على التخمين / سيناريو قائم على الألعاب.
وـ ـ خطة العمل: وفيها يتم تحديد الخطوات اللازمة التي ينبغي القيام بها لنجاح السيناريو، كذلك يتضمن هذا الإجراء تحليل الحالة ودراستها بعناية عن طريق المناقشة الجماعية الموجهة في ضوء المعلومات والبيانات المتوافرة. ويعتبر تحسين الأداء هو النتيجة الأولية لنظام التخطيط
ز ـ إدماج الإبداع: ويقصد به تطبيق عمليات التفكير الإبداعي في عملية السيناريو، وخلق سيناريوهات تستدعي مشاركة المتعلمين بإيجابية باستخدام مزيج من تقنيات القصص والصور.
ح ـ العصف الذهني: وهو يختلف عن ما تم في مرحلة تحليل الاتجاهات؛ حيث إن المتعلمين يقومون بتطوير أفكار السيناريو التعليمي نفسه وتحسينه من خلال استخدام الكتابة. ومن خلال العصف الذهني الذي يعتبر محرك الأداء يتم اكتساب المعرفة التدريسية والمهارة المطلوب استخدامها فيما بعد.
ط ـ تلخيص الحالة: في هذا الإجراء يقوم الطلاب بتلخيص خطوات سير التعلم كتابة؛ لكي لا تنحرف المناقشة عن المسار بالاتجاه نحو الجدال وترك الأسئلة التدريسية الواقعية.
ي ـ التقييم: يتضمن تحديد مستوى تعلم الطلاب أثناء وبعد مرحلة التنفيذ، ويشمل الاختبارات والتكليفات الكتابية والقيام بالمشروعات الصفية وإعداد التقارير. أما بالنسبة للطالب المعلم فهو يقوم بتقييم السيناريوهات وصياغة السياسات المستقبلية التي ترتبط بالأداء التدريسي.
لة وسريعة، كذلك منح الطلاب المعلمين فرصا لممارسة عمليات العلم ومهاراته مثل الربط والتصنيف والمقارنة من خلال مواقف حقيقية وأنشطة تعاونية، والعمل على مساعدة الطلاب المعلمين على وضع مجموعة من الفرضيات والاحتمالات التي تعزز تعلمهم، مع توفير الخيارات والبدائل لمساعدتهم على اتخاذ قرار سليم ـ فضلا عن توفير المشاركة الديموقراطية بين الطلاب المعلمين لمناقشة القضايا الجدلية والموضوعات المتضمنة بالسيناريو؛ بهدف الوصول إلى رؤى متوافقة وقرارات جماعية سديدة. وأيضا تحقيق فرص الانخراط النشط والاندماج التام المصحوب بالتأمل عند ممارسة مهارات التدريس؛ لإنتاج تصورات ذهنية جديدة تتعلق بالمشكلة أو الحالة التي يعرضها السيناريو التعليمي، وتضمين السيناريوهات أسئلة مثيرة للتفكير ومشكلات حقيقية مهمة تتصل بالواقع التدريسي الفعلي.
7 ـ تحديد تطبيقات التعلم القائم على السيناريو: قام الباحث بتحديد النماذج التي سيتم عرض السيناريوهات التعليمية في ضوئها من خلال فحص ودراسة أدبيات التربية الخاصة بالتعلم القائم على السيناريو، وكذلك الدراسات والبحوث التي استخدمت مدخل التعلم بالسيناريو، وتمثلت التطبيقات في النماذج الآتية: التعلم القائم على المشكلة ـ التعلم القائم على المشروع ـ التعلم القائم على الحالة ـ التعلم القائم على السياق السيناريوهات القائمة على المهارات، وحرص الباحث على تنوع أنماط التعلم القائم على السيناريو ضمانا لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وتحقيق الإثارة والتنوع في الموقف التدريبي.
8 ـ الوسائل التعليمية المستخدمة في النموذج التدريسي: واشتملت على السبورة الإلكترونية التفاعلية، وبعض الفيديوهات التعليمية من شبكة الإنترنت الخاصة بالمهارات التدريسية التأملية، وبعض الصور التوضيحية.
9 ـ دليل المحاضر لاستخدام التعلم القائم على السيناريو: قام الباحث بإعداد دليل للمحاضر الذي يقوم بتدريس مقرر " طرق تدريس اللغة العربية 1" لطلاب الفرقة الثالثة بشعبة اللغة العربية، يتضمن خطوات إعداد السيناريو التعليمي المتضمن لنواتج التعلم المقصودة، والمحتوى المعرفي، والمشكلة التدريسية المتضمنة في السيناريو أو الموقف التدريبي، وأدوار المتعلم، ومجموعة من التوجيهات العامة لتحقيق أهداف استخدام النموذج التدريسي المقترح المتمثلة في خطوات تنفيذ التعلم القائم على السيناريو، ومصادر التعلم والوسائل التعليمية التي يمكن للمحاضر الإفادة منها، وكذلك التوصيف الدقيق لعملية سير السيناريو التعليمي وفق النموذج التدريسي والذي يشتمل على المكونات الأربعة (المنفذ ـ المعلومات الأساسية ـ الأهداف ـ الأحداث).
10 ـ خطوات التدريس باستخدام التعلم القائم على السيناريو: تمثلت خطوات النموذج التدريسي القائم على التعلم بالسيناريو في تدريس مقرر " طرق تدريس اللغة العربية 1" في الخطوات الآتية:
أ ـ مرحلة تعرف المتطلبات القبلية: وفيها يتعرف المحاضر الخبرات السابقة للطلاب المعلمين عن موضوع المحاضرة ومدى كفاياتهم التدريسية الأولية في تدريس مهارتي القراءة والكتابة، والوقوف على معتقداتهم الذهنية بشأن المعرفة اللغوية المرتبطة بمهارتي القراءة أو الكتابة، كذلك اتجاهاتهم نحو بعض الأداءات التدريسية.
ب ـ تحديد أهداف التعلم ونواتجه: يقوم المعلم بإعلام الطلاب المعلمين بأهداف موضوع اللقاء (المحاضرة) ويحفزهم لاستنتاج نواتج التعلم المقصودة والتي ينبغي تحقيقها عقب نهاية اللقاء.
ج ـ تقديم المعرفة: وفيها يقوم المحاضر بتقديم المعلومات الأساسية المرتبطة بالموضوع المقرر (تعريف القراءة ـ أهداف تدريس القراءة ـ مستويات القراءة) مستعينا في ذلك باستخدام الأسئلة السابرة والعصف الذهني.
ج ـ التوجيه والإرشاد: وفيها يقوم المحاضر بتوجيه وإرشاد الطلاب المعلمين إلى الأداءات التدريسية النموذجية التي ينبغي أن يقوموا بها في أثناء التدريب الميداني والمتعلقة بتدريس مهارتي القراءة والكتابة، ويمكن للمحاضر أن يطلب من الطلاب المعلمين بنمذجة ما قام به للتحقق من إلمامهم بالمعرفة النظرية للأداء التدريسي.
د ـ غلق المعرفة: يتم في هذه المرحلة غلق المعرفة المرتبطة بالموضوع من خلال تكليف الطلاب المعلمين بتلخيص ما تم تعلمه، ويقوم المحاضر بتقديم التغذية الراجعة وتقديم المعلومات في صورتها النهائية تمهيدا للانتقال إلى المرحلة التالية.
د ـ تقديم السيناريو: وفي هذه المرحلة يقوم المحاضر بتهيئة الطلاب المعلمين لتنفيذ السيناريو التعليمي الذي يتضمن بعض مهارات الأداء التدريسي التأملي في صورة مواقف حقيقية تتصل بالتخطيط للتدريس مثل صياغة الأهداف السلوكية، وقراءة المحتوى وتنظيمه، وكيف يمكن تقديمه بصورة شيقة مثيرة، وكيفية تحديد واختيار استراتيجيات التدريس المناسبة. ويتم في هذه المرحلة استخدام بعض المشاهدات التوضيحية المرئية (فيديوهات تعليمية) التي تساعد في تقديم المهارات بصورة تسهم في اكتسابها. وتشمل هذه المرحلة عمليتين رئيسيتين هما: مرحلة ما قبل التأمل التي تتضمن التهيئة لضمان تفاعل الطلاب المعلمين، ومرحلة التأمل وتتضمن الحوار والمناقشة بين المحاضر والطلاب في المواقف المعروضة. وفي المرحلة ذاتها يتم تكليف الطلاب المعلمين بتسجيل ملحوظاتهم واستفساراتهم عن الموقف التدريسي المتضمن بالسيناريو.
هـ ـ الحوار والمناقشة: يتم في هذه المرحلة تكليف الطلاب المعلمين بتأمل الممارسة التدريسية التي قاموا بها وتسجيل أبرز الملحوظات حول هذه الممارسة، والتعليق عليها من خلال إبراز المزايا والعيوب مع تبرير ذلك.
و ـ تعديل التصورات الذهنية: في هذه المرحلة يتم علاج بعض التصورات الذهنية الخطأ لدى الطلاب المعلمين والمرتبطة ببعض الأداءات التدريسية من خلال تقييم أداء الطالب المعلم ومناقشة الأخطاء التي وقع فيها لبناء صورة ذهنية صحيحة حول المهارة التدريسية.
ز ـ إعادة الممارسة التدريسية: عقب النقد البناء للممارسة التدريسية السابقة، يتم تكليف بعض الطلاب المعلمين بإعادة نفس الممارسة التدريسية المرتبطة بمهارات الأداء التدريسي التأملي؛ وذلك بهدف رفع كفاءة الطلاب المعلمين في إتقان المهارة وتدبر ما يقومون به من مهام تدريسية.
ح ـ التقويم: ويقصد بهذه المرحلة تقويم أداء الطالب المعلم في مهارات التدريس التأملي وتكليفهم بكتابة ملخصات قصيرة تصف وتفسر أدائهم التدريسي ومعتقداتهم الذهنية حول عملية التدريس ومهاراتها.
***
د. بليغ حمدي إسماعيل.
أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة المنيا- مصر