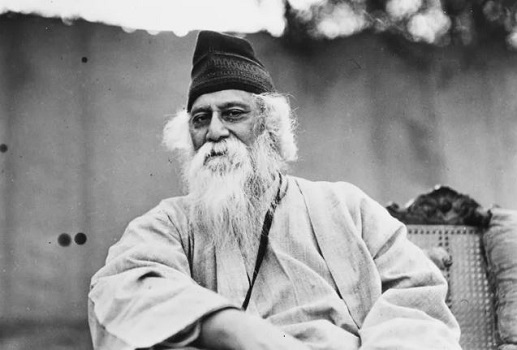أقلام ثقافية
علي الطائي: بلاغة الشتيمة.. تفكيك قداسة الشعر العربي القديم

كثيرٌ مما نُسمّيه اليوم “الشعر العربي الخالد” لا يصمد، إذا نُزع من قدسيته التراثية، أمام السؤال البسيط: ما الشعر؟ أهو اللغة فقط؟ أم الوزن؟ أم القدرة على الشتم المقفّى؟ أم هو — قبل كل شيء — المعنى، والصورة، والروح التي تعبر الزمن واللغة؟
البيت القائل (للأخطل):
قَومٌ إذا استنبح الأضيافُ كلبَهمُ
قالوا لأمِّهِمُ: بُولي على النارِ
*
فتُمسكُ البولَ بُخلاً أن تجودَ بهِ
وما تبولُ لهُم إلا بمِقدارِ!
يُقدَّم في كتب الأدب مثالًا على “الجرأة” و“قوة الهجاء”، لكنه عند التفكيك ليس أكثر من مشهد فجّ، يعتمد على الصدمة اللفظية لا على الصورة الشعرية، وعلى الإهانة الغريزية لا على الدلالة الإنسانية. ولو تُرجم هذا البيت إلى أية لغة أخرى لانكشف عُريُهُ كاملًا: لا صورة جمالية، لا توتر شعوري، لا رمزية، بل سبابٌ مباشر يتكئ على ألفاظ جسدية سوقية. هذا ليس شعرًا بالمعنى العميق، بل بلاغة قبَلية غليظة تؤدي وظيفة اجتماعية آنية: كسر الخصم وإضحاك السامعين.
وهنا تبدأ المشكلة الكبرى في تقديس الشعر القديم بوصفه كتلة فنية متعالية. فالحقيقة أن جانبًا واسعًا منه كان نتاج بيئة شفوية بدائية، تحكمها العصبية، ويُكافأ فيها الشاعر لا بقدر ما يخلق من معنى، بل بقدر ما يُوجِع. فالهجاء لم يكن فنًا، بل سلاحًا، ولم يكن الشاعر في كثير من الأحيان فنانًا، بل "مقاتلًا لغويًا". ولذلك امتلأت دواوين كثيرة بأبيات لو جُرِّدت من الوزن والقافية لانحدرت فورًا إلى مستوى السباب السوقي. الشعر هنا لا يُنقّي اللغة، بل يستعملها أداة إيذاء، ولا يفتح أفقًا إنسانيًا، بل يكرّس أدنى غرائز الجماعة.
إن القول إن الشعر العربي القديم كله في مستوى رفيع هو وهمٌ صنعه التقديس اللاحق، لا النقد. نعم، وُجد شعر عظيم في الجاهلية، وُجدت أبيات تمسّ الوجود، والفقد، والبطولة بمعناها الإنساني، وبلغت بعض المعلقات درجة عالية من التشكيل اللغوي والصورة. لكن إلى جانب هذا القليل النفيس، هناك كثيرٌ غثّ، كثيرٌ لو لم يُنسَب إلى “الجاهلية” لما احتفى به أحد. إن الوزن لا يصنع شعرًا، كما أن الفصاحة وحدها لا تخلق روحًا. الشعر الحقيقي لا يُقاس بسلامة الإعراب، بل بقدرته على أن يُقال اليوم كما قيل أمس، وأن يُترجم دون أن يموت.
وحين نُمعن النظر في هذا اللون من الهجاء الفجّ، ندرك أنه مرتبط بزمنه ارتباط الوظيفة لا الجمال. هو شعر يصلح للسوق، للمفاخرة، للخصومة، لكنه لا يصلح للبقاء. ولذا فإن الدفاع عنه بوصفه قمة فنية هو خلطٌ بين التاريخ الأدبي والقيمة الجمالية. ما كان مؤثرًا اجتماعيًا في زمنه ليس بالضرورة عظيمًا فنيًا في كل زمن. ومن الخطأ أن نرفع كل ما وصلنا من الماضي إلى مقام المثال الأعلى، فالنقد لا يهدم التراث، بل ينقذه من التحنيط.
إن الشعر العربي القديم، في محصلته، ليس فنًا متجانسًا، بل ميدانًا غير مصفّى. فيه العالي وفيه السافل، فيه الحكمة وفيه السفاسف اللفظية، فيه ما يضيء العقل وفيه ما لا يتجاوز وظيفة الشتيمة. والمشكلة ليست في أن هذا الشعر وُجد، بل في أننا أصررنا على التعامل معه بلا ميزان، فساوينا بين القصيدة التي تُنضج المعنى، والبيت الذي لا يعيش إلا على قبحه. الشعر، إن لم يحمل معنى يتجاوز لحظته، وإن لم يكن قابلًا لأن يُفهَم ويُحسّ خارج لغته الأولى، فهو ليس شعرًا خالدًا، بل أثر لغوي عابر — مهما عظّمه الشراح وباركه الرواة.
***
د. علي الطائي