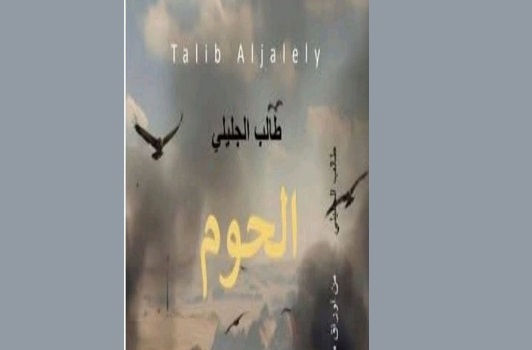أقلام حرة
حميد علي القحطاني: الخوف من الجديد.. متاهة النفس وسجن العادة

إن الجديدَ في دنيا الأفكارِ غالبًا ما يكونُ كالغريبِ في ديارٍ ألفت الهدوء، فحين يطرحُ مفكرٌ أو مصلحٌ فكرته تُقابله المجتمعات أول ما تُقابلُه بريبة وخوفٍ ومقاومة حتى وإن حملت فكرته بين طياتها الخير والحلّ والفلاح ذلك لأن النفسَ بطبعِها تستريحُ لما عرفت، وتخافُ مما تجهل. وتلك ظاهرةٌ مُتشعبةُ الأبعادِ عميقةُ الجذورِ، ترجعُ إلى طبيعة الإنسان نفسًا واجتماعًا ووجودًا، بل وحتى من منطلقِ تطوره التاريخي.
أما الجذورُ النفسية، فهي ضاربةٌ في أعماق النفسِ البشرية تُحركها نوازع شتى منها نفورٌ أصيلٌ من الخسارة، حيثُ يخشى الإنسانُ فقدانَ ما اعتاده من وقتٍ وجهدٍ ومالٍ ومكانةٍ، والخوفُ من الخسارة غالبًا أشد وقعًا في النفس من لذة الربح. وتُضافُ إلى ذلك تحيزاتٌ معرفيةٌ عديدة، منها تفضيلُ الوضعِ الراهنِ، والإحجامُ عن التجديدِ، حتى لو بدا أن الجديد أوفر خيرًا وأجزل نفعًا. كذلك يسعى الإنسان دائمًا لتأكيد معتقداته القائمة فيبحث عما يثبتها ويُغفل كلَّ ما يهددها، ويستريحُ إلى المألوفِ لأنه يمنحه شعورًا بالأمان والراحة. ويزيد من هذا النفور حاجة الإنسان إلى اليقينِ والسيطرةِ على عالمه، والجديد بطبيعته غامضٌ، مُبهمُ النتائج، ما يُثيرُ قلقًا داخليًا عميقًا ويولد خوفًا فطريًا من المجهول.
وعلى الجانبِ الاجتماعيّ، فإن مقاومةَ الجديدِ تزدادُ حدةً وتأثيرا بفعل الضغوط الاجتماعية ورغبة الإنسانِ في الامتثال لمحيطه، خشية أن يلقى النبذ أو النقد أو التهميش. فالإنسانُ بطبيعته يقلد ويقتدي بمن يثقُ بهم ويعتبرهم قدوةً أو مرجعيةً، ويقاومُ الجديدَ خشيةَ أن يتعارض مع هويته الجماعية وتقاليده الراسخة، ما يُهددُ إحساسه بالانتماء والأمان الجماعي.
وإذا ذهبنا أعمقَ قليلًا، وجدنا أن جذورًا وجودية تُحركُ النفوسَ في اتجاه الرفض والمقاومة، فالإنسانُ يخشى التغييرَ لأنه يُذّكرُه بهشاشتهِ أمام العالم، ويثير فيه قلقًا وجوديًا مرتبطًا بانتهاءِ المألوفِ وبدايةِ ما لا يُمكن التنبؤ به. والجديدُ بهذا المعنى، هو تهديدٌ ضمنيٌّ لبقاءِ الذات وإشارةٌ إلى ضرورة تعلمِ مهارات جديدة، قد تبرز نقاط الضعفِ في شخصية الفرد أو المجتمع.
ومن منظورٍ تطوري، يبدو الحذرُ من الجديد استراتيجيةَ بقاءٍ ناجعةً قديمة فقد علّم التاريخ البشر أن المجهولَ قد يكونُ خطرًا وأن التريث والحذر في التعامل مع كل جديد يُمثل آلية دفاعٍ غُرست عميقًا في جينات البشر منذ قديم الزمان.
ومن شواهد التاريخِ ما يؤكد ذلك، فقد قاوم الإنسانُ اختراعاتٍ عظيمةً مثل الطباعة، والسيارات، والتلفزيون؛ ورُفضت نظريات علمية كبرى مثل نظريات كوبرنيكوس وغاليليو، وأُعيقت حركاتُ التغييرِ الكبرى كالحقوق المدنيةِ بسبب مخاوفَ من زعزعةِ البنى الاجتماعية القائمة. وهذا المشهدُ يتكررُ اليوم مع مقاومةِ كثيرٍ من الناس للتقنيات الرقمية الحديثة والأفكار الاجتماعية والسياسية الطموحة.
وليس الدين بمعزلٍ عن هذا؛ فقد رفض أهل مكة في بادئ الأمر دعوة النبي محمد (ص)، تمسكًا بما ألِفوا عليه آباءهم، وخوفًا من فقدان مصالحهم، كما أوضحت آيات القرآن الكريم هذه الحقيقة النفسية والاجتماعية البالغة العمق.
وخلاصةُ القولِ، إن مقاومةَ الجديدِ ظاهرةٌ إنسانيةٌ طبيعيةٌ متجذرةٌ في النفس والاجتماع والوجود والتاريخ التطوري، وفهمُ هذه الجذورِ هو مفتاحُ التعامل الواعي مع التغيير وهو طريقُ التشجيعِ الحكيمِ على قبولِ الجديدِ وعلى تطويعِ المقاومةِ لتكونَ دافعًا للنمو والتطورِ بدلًا من أن تكون حاجزًا وعائقًا.
***
حميد علي القحطاني - أستراليا