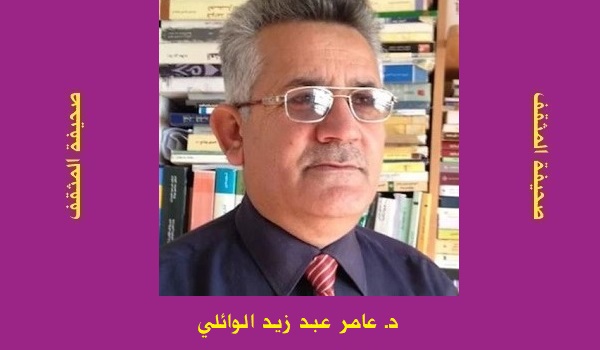اخترنا لكم
محمد البشاري: دعوة للتفكير في حضرة النص

كثيراً ما يُحتفى بالنصوص، وتُحفظ المتون، وتُستعرض الفتاوى، ثم يُسدل الستار على العقل وكأنّه أدى مهمتَه وانصرف. غير أن التدبر الصادق يُلزمنا أن نتوقف مليّاً: هل يمكن لنصٍ أن يؤدي وظيفتَه إذا قُدِّم له عقلٌ لا يسأل، ولا يتأمل، ولا يزن، بل يكتفي بتكرار ما قيل، ولو تغيّر ما كان يُقال فيه؟
وهل يَثبت الدين في الوجدان والفكر، إذا غاب الوعي الذي يمنحه المعنى، ويُجدّد صلتَه بالواقع والإنسان؟ العقل في المنظور الإسلامي ليس جهازاً حياديّاً، بل هو آلة الفهم، ومناط الخطاب، وشريك أصيل في بناء المعرفة. وليس صدفةً أن يُخاطِب القرآنُ الإنسانَ بنداءات متكررة: «أفلا تعقلون»، «أفلا تتفكرون»، «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون».. إلخ. فالدعوة إلى النظر والتعقل ليست مزيّةً إضافيةً، بل ضرورة تكوينيةً في فهم الدين، وفي إنزاله على الوقائع، وفي تحريره من الجمود والتكرار.
وليس في تاريخ الإسلام شاهد أبلغ من المدارس العلمية الكبرى التي لم تفصل بين النص والعقل، بل جعلت مِن العقل أداةَ تفكيك، ومن النص مادةَ بناء، ومن الواقع ميداناً للتنزيل. لقد كان الغزالي، والجويني، وابن رشد، وابن عاشور، وغيرهم، يمارسون التفكيرَ في النص، لا حوله فقط، ويُحاورون الوحيَ بالعقل، لا ضده، ويعتبرون أن فقه الشريعة لا يستقيم دون نظرٍ في المآلات، وفهمٍ للمقاصد، وإدراكٍ لسياقات الإنسان والمجتمع.
لكنّ ما نلاحظه اليوم هو تنامي ظاهرة تقديم الشكل على المعنى، والحرف على المقصد، والجزئي على الكلّي، وكأن التفكير أصبح عبئاً لا فضيلةً، نقيصةً لا فريضةً! فنرى من يحتدّ في مسائل جزئية –كمسألة في هيئة اللباس أو سُنّة ظاهرية– ويغفل عن قضايا العدالة، وكرامة الإنسان، واستقامة المعاملات، وتحصين الأمة من الانهيار القيمي والمعرفي. وقد يتحوّل هذا الميل إلى الجدل الظاهري عن غير وعي، أي إلى عائق أمام نهضة حقيقية تُنير العقولَ وتفتح أفقاً للاجتهاد الخلاق.
الخلل هنا ليس في النصوص، وإنما في غياب التفكير المؤسّس الذي يُعيد ترتيب القضايا، ويحرّر العقلَ المسلمَ مِن التبعية لنمط تدين مشروط بظاهر التقليد لا بروح المقصد. وهذا لا يعني الاستهانةَ بالظاهر، ولكن رفض تحويله إلى معيار جامع مانع يُفصل به بين الإيمان والنفاق، بين الصلاح والفساد.. في مشهد يهيمن عليه التصنيفُ بدل الفهم، والتكفيرُ بدل التقدير.
إن التحدي الحقيقي ليس في كثرة المسائل، ولكن في ندرة المفكرين القادرين على إعادة بناء العلاقة بين النص والعقل. وما لم نستأنف هذا المشروعَ، فسنظل نستهلك الفقه ولا نجتهد فيه، نردّد الأقوال ولا نحرّر مقاصدها، نحفظ النصوص دون أن نسائلها بمنطق الزمان ومتغيراته.
التفكير ليس خصيصة الفلاسفة ولا النخب فقط، بل مطلباً شرعياً، ومقتضى إيمانياً، وعلامة حياة. وكما قال الحسن البصري: «ما زال أهل العلم يَفكرون حتى نطقوا»، والساكت عن التفكير، هو في أحد الوجوه ساكت عن واجب شرعي، وفاعلٌ في ترسيخ التقليد الذي لا ينتج وعياً ولا يُثمر تغييراً. لهذا، فالدعوة اليوم ليست إلى استيراد أفكار جاهزة، ولا إلى تكرار مصطلحات مقطوعة عن واقعها، بل إلى إعادة بناء الفكر من أساسه: عقلٌ يعقل، ونصٌ يُنار به، وواقعٌ يُراعَى في تنزيل الأحكام.
تلك هي أركان النهضة التي لا تقوم على الحفظ وحده، ولا على الانفعال وحده، بل على النظر الموزون، والاجتهاد المقاصدي، والتجديد المنضبط. وبدون ذلك ليس بعيداً أن يتحول الدين إلى صوت باهت في عالم متغير، إن لم نحسن التفكيرَ فيه، لا للدفاع عنه، بل لإظهاره في صورته الجامعة بين الحق والرحمة، بين النص والتاريخ، بين الله والإنسان.
***
د. محمد البشاري
عن جريدة الاتحاد الإماراتية، يوم: 9 يوليو 2025 23:38