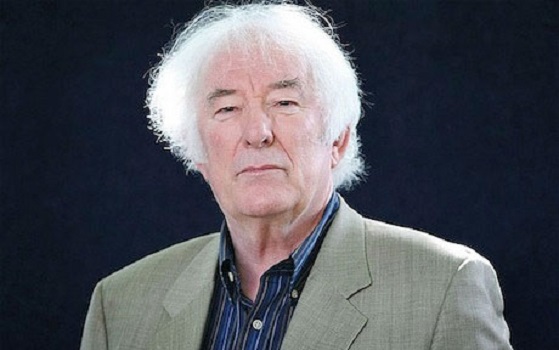نصوص أدبية
جمال العتابي: حزن النارنج

كانت الباب الحديدية لمدخل المنزل الخارجي مواربة، دَفَعتهُ بهدوء وحذر، على يساري تمتد حديقة البيت الصغيرة، كانت عالماً بظلالها الوارفة، يشذّب صاحبها أوراق أشجارها بحنان، ويرويها بيدٍ تعرفُ مواقيتَ العطش، كل نبتة فيها لها حكاية، كل شجرة تعرفُ صوتَه. تنصت إليه حين يتحدث، تعرف خطواته كانت كائناً يتنفس، يشبهه في صمته وإشراقه.
تُذكّرهُ شجرة النارنج في البيت الأول الذي أقامت فيه عائلته بعد عقود من (التّهجْوِل) في البيوت المستأجرة. وبالأمّ التي كانت بدموعها تسقي فيه شجرة النارنج. كانت الحديقة مرآة لروحه، بسيطة، مرتّبة، مسوّرَة بأشجار الآس.
في يوم قائظ استقبلتني الحديقة بصمتها الغريب، لأول مرّة بَدت غريبة، كأنّها تجهلني وتأنف من خطوي، لم يكن الصمت فيها هدوءاً، بل كابوسا يضغط على صدري بقوّة، لا عصافير تحطّ على الأغصان، ولا نسمات تعبث بأوراق الشجر، كل شيء واقف، صامت، مترقب. هالني مشهد شجرة النارنج التي تقوّس جذعها ويبست أوراقها، ومع ذلك بقيت ثمارها معلّقة، كأنها ترفض أن تهبَ الحياة بعد أن غاب من يحنو عليها بعينيه، رأيتها كأمّ مفجوعة تحمل أبناءها على كتفيها. إلى جوارها شجرة الزيتون، ما زالت خضراء يانعة، تتحدى الموت، تصرّ على أن تبقى حيّة.
بَدَت الحديقة كأنّها مرآة لفصول البشر: حياة تستمر، وأخرى تنطفئ، مشهد كأنه صراع بين غياب يحكم قبضته، وحضور يقاوم ليبقى. وبيت يحمل صدى خطوات غابت للأبد، لكن كل شيء في المكان يروي أن (علاء) ما زال حاضراً، وإن الغياب ليس سوى شكل آخر من الحضور. في ذلك المشهد، فهمت أن علاء موجود في الثمار اليابسة التي لا تسقط، في شجرة الزيتون الخضراء التي ترفض الموت، موجود في وداع الجيران لسيارته، كأنها جنازة ثانية، خرجوا جميعاً يودعونها كما ودعوا علاء ليلة التشييع، أحاطوها بنظرات حزينة حين تأكدوا أنها ستغادر المكان إلى حيازة رجل غريب.
تذكرتُ يوم كتبَ ماركيز عن قرية (ماكواندو) في «مئة عام من العزلة»، كيف كانت الأشجار تذبل حين يغيب أحد أحفاد العائلة. «ماكواندو» القرية الوهمية التي أنتجتها مخيلة ماركيز، كانت الطبيعة فيها شاهداً على انقراض العائلة. هنا في حديقة علاء تتكرر الحكاية بلغة حزينة أخرى، كان محمود درويش يقول: نكتب كي لا نموت، لكنه رحل وبقيت الكلمات تدور بين أغصان بيته، مثل أرواح تبحث عن صاحبها. والإنسان ليس خارج الطبيعة، بل ذروتها الواعية، حسب ابن عربي حين يقول: الكون كلّه شجرة، وأنت ثمرتها. هذا التواصل بنظر الصوفيين يسمّونه «أنس الكائنات»، حين تشعر بأن هذا الكائن يفهمك من دون كلام، كما يقول جلال الدين الرومي: أنصتُ إلى الشجر كيف يصلي حين يسقط المطر.
لم تعد شجرة النارنج بحاجة إلى كلام، أدركتُ منذ اللحظة الأولى أنها ليست كائناً صامتاً، بل ذاكرة قائمة بذاتها، إنها تحفظ الزمن في جذورها، وتخزن في جذعها النور، كما نحفظ نحن الوجوه والأصوات في أعماقنا. لقد فهم الأنبياء والعارفون هذه اللغة منذ البدء، وكان الحوار بين الإنسان والشجرة ليس مجازاً شعرياً، بل علاقة حقيقية تقوم على تبادل الصبر والحنين. في الكتب المقدّسة، كانت الشجرة أولى المعارف وآخر الوصايا، في الإسلام شبّه الخالق الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، كأن الجذر هو الإيمان، والفرع هو الأمل. اقتربت إلى الشجرة ببطء، مددت يدي ألمسُ لحاءها، فارتعشت أصابعي، هل الشجرة ارتجفت، أم أنا؟
ـ أين صاحبك؟ ألم يأت هذا الصباح ليسقيك ماءً؟ ألا تفتقدين صوته وهو يناديك: صباح الخير؟
لم تجبني. لكن نسمة خفيفة مرّت بين الأغصان، فسمعت ما يشبه تنهيدة بعيدة. كأنها تتذكر اسمه، أو تردّ عليه بتحية.
قلتُ ثانية: هل مات فيك حين رحل؟ أم ما زال في جذورك؟
الآن، وأنا أقفُ تحت أغصانك اليابسة، أشعر بأنكِ ما زلتِ في انتظاره. رفعتُ رأسي نحو السماء، شعرتُ بأنه يسمعنا، وربّما يبتسم الآن من جهة الشمس.
***
جمال العتابي