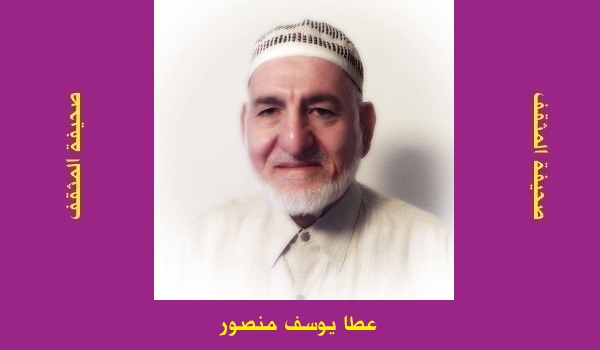نصوص أدبية
سعاد الراعي: لا تستعجلي

في ذلك الصباح الذي أفلت من بين أصابعي كما تفلت الأحلام حين نمدّ لها اليد متأخرين، فتحتُ عينيّ على قلقٍ مكتمل. لم أحتج إلى ساعةٍ لأعرف أنني تأخرت، ولا إلى نافذةٍ لأدرك أن باص الموظفين الخاص بالشركة، ذلك الموعد الصارم الذي لا يعرف التردّد، كان قد مضى. كان الإحساس وحده كافيًا، ثقيلاً وحاسمًا:
الوقت سبقني هذه المرة.
لم تكن المواصلات العامة خيارًا. أجساد متلاصقة، أنفاس متداخلة، ومعركة مقعد لا أملك لها وسعًا ولا مزاجًا.
كنتُ هشّة على غير عادتي، كأن اليوم قرّر أن يختبر تماسك امرأةٍ، امرأةٍ اعتادت أن تُخفي ارتباكها جيدًا، حتى عن نفسها.
أوقفتُ سيارة أجرة. جلستُ في المقعد الخلفي كمن يتمسّك بطوق نجاة لا يثق به تمامًا. الطريق لا يستغرق عادةً أكثر من أربعين دقيقة، لكن الصباح لا يعترف بالعادة، ولا يحترم الحسابات. ملف الحضور يُغلق عند ساعةٍ لا تعرف الأعذار، واسمي ـ إن تأخر ـ سيتحوّل إلى غيابٍ بارد.
انحنيتُ قليلًا إلى الأمام:
ـ لو تسرع قليلًا ان أمكن… سأدفع مضاعفًا.
نظر إليّ عبر المرآة، بابتسامة رجلٍ أنهكته الطرق ولم تكسره، وقال:
ـ الله يسهّل يا ابنتي.
كان في منتصف الخمسينات، بشعرٍ رماديّ يشبه غبار الذاكرة، ولحيةٍ كثيفة تمنحه وقارًا صامتًا. يداه على المقود كانتا تحكيان عن عمرٍ طويل من القيادة والصبر.
بدا كأنه يعرف الطريق أكثر مما يعرف نفسه.
جلستُ أراقب انعكاس وجهي في زجاج النافذة:
عينان مثقلتان، وامرأة تحاول أن تُخفي ارتباكها خلف ترتيبٍ سريع لشعرها وهندامها.
كنتُ أشعر بنظراته من المرآة، لا فضولًا، بل إدراكًا خفيًا؛ كأن التعب يتعرّف إلى التعب.
أخرجتُ كتابًا من حقيبتي. القراءة كانت ملجئي القديم، درعي الصامت حين يقترب العالم أكثر مما أحتمل. لكن السيارة بدأت تبطئ. رفعتُ رأسي، وسبقني صوته:
ـ ازدحام… لا أستطيع الإسراع. ربما حادث.
شعرتُ بضيقٍ داخلي. ليس من التأخير وحده، بل من هذا العجز المفاجئ، من أن تُسلب منك السيطرة في اللحظة التي تحتاجها فيها أكثر من أي وقت.
قال فجأة، بصوتٍ خفيض:
ـ لا تستعجلي يا ابنتي، لا تستعجلي…
كل ما يخصك هنا سيبقى خلفك.. بيت، عمل، دراسة وغيرها …
وستبدئين حياةً أخرى بعيدًا، بعيدًا جدًا.. ستعيشين في الجبال الثلجي وسهولها…
رفعتُ رأسي باندهاشٍ قائلة:
ـ لم أفكر بالرحيل أصلًا. ولا بترك شيء. ومن أين لك كل هذا؟
ابتسم بثقة:
ـ أقرأُ الطالع بالتحليل الشخصي. تعلمته منذ سنوات.
برد الجو فجأة. أغلقتُ الكتاب ببطء:
ـ لا أؤمنُ بالطالع!
لكن إنكاري لم يكن يقينًا بقدر ما كان خوفًا. خوفًا من أن يكون قد لمس شيئًا صحيحًا.
قال، كمن لا يشك:
ـ أنتِ ذكية، واثقة، طموحة وعنيدة بعض الشيء، ستتعبين كثيرًا، لكنك لن تنكسري. وستكتبين، ستكتبين عن نفسك يومًا ما …
وقعت كلماته في داخلي كحجرٍ في ماءٍ ساكن. لم تكن غريبة، ولا مألوفة.
تمسّكتُ بالمنطق:
ـ هذا يمكن ان يُقال لأي شخص.
وأشرتُ إلى الطريق:
ـ الزحام خفّ. أسرِع لو سمحت.
قال مُصرًا وهو يهز راسه بهدوءٍ:
ـ ومع ذلك… كل ما أنتِ عليه الآن سيبقى خلفك.
لم أجادل. نظرتُ إلى ساعتي. الزمن صار خصمًا واضحًا.
حين توقفت السيارة، ناولته الأجرة، وهممتُ بالنزول. قال خلفي:
ـ لا تستعجلي… وتذكّري..
أغلقتُ الباب، لكن صوته لم يُغلق معي. بقي عالقًا في داخلي.
سرتُ بخطواتٍ سريعة نحو باب الشركة، أشعر للمرة الأولى أنني لا أدخل مكانًا فقط، بل أؤجّل خروجًا مؤجّلًا من ذاتي.
كنتُ أعرف نفسي، أو هكذا كنتُ أظن.
أعرف عنادي، وطموحي الذي يتقدّم دائمًا خطوةً على طمأنينتي، وأعرف خوفي الذي أتركه مؤجّلًا كأنه لن يطالبني يومًا بحقه.
لم أكن امرأةً تنتظر نبوءة، ولا امرأةً تصدّق الغرباء، لكن صوته بقي معي، لا كحقيقة، بل كسؤال.
عند العتبة الأخيرة، شعرتُ أنني لا أدخل المكان وحده، بل أؤجّل شيئًا آخر، شيئًا لم تتضح ملامحه بعد.
دخلتُ، نعم.
لا لأنني حسمتُ الطريق،
بل لأن السير أحيانًا هو الشيء الوحيد الذي نعرف كيف نفعله.
أما الأسئلة…
فقد دخلتْ معي.
كنت أعرف نفسي:
عنادي، طموحي، خوفي المؤجَّل. لم أكن امرأة تنتظر نبوءة، لكنني كنت أعرف أن الحياة أحيانًا تهمس بحقائقها عبر أفواهٍ عابرة.
وعند العتبة الأخيرة، أدركتُ أنني، مهما أسرعت، أحمل أسئلتي معي.
وأن الطريق، مهما بدا مستقيمًا، يخفي انعطافاته القاسية بعناية.
ومع ذلك… دخلت. قررتُ أن أواصل السير، وأن أكتب حياتي كما أريد، لا كما يُقال لي.
***
سعاد الراعي/ المانيا