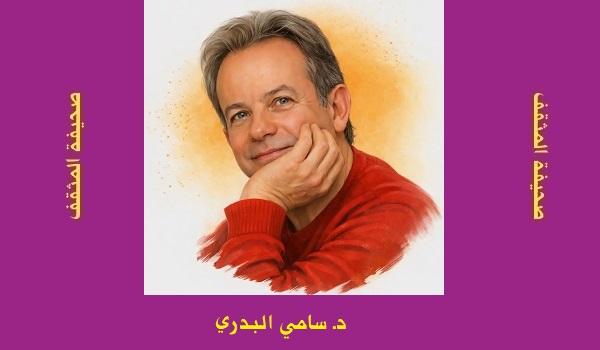قضايا
عبد الحليم لوكيلي: التنشئة الاجتماعية ودورها في تشكيل الإنسان

هل الإنسان في حاجة إلى التنشئة الاجتماعية أم لا؟
إن القارئ لهذا الإشكال الفلسفي سيدرك بعمق أنه يحمل مفارقة إشكالية تاريخية، متصلة بمسألة ما إذا كان الإنسان في حاجة إلى التكوين والتأهيل والتربية، أم أنه يولد مجبولا على بعضها، وبذلك، فهو ليس بحاجة إليها. ولرصد بعض المعطيات التي حاولت النظر في هذه المشكلة، يمكن القول بأن تاريخ الفكر الإنساني النظري منذ اليونان إلى اليوم، قد انشطر في اعتقادنا إلى تصورين. تصور يرى بأن الإنسان يولد حاملا لبعض السمات والخصائص التي تجعله صاحب إمكانية وقدرة على القيام ببعض الوظائف تحقيقا للنظام في الوجود-العالم (أطروحتي أفلاطون وأرسطو في السياسة نموذجا). وتصور آخر، ينظر بمنظار النفي؛ أي يعتبر بأن الإنسان يولد صفحة بيضاء في حاجة إلى النحت والتوضيب والتأهيل، حتى يكون هذا الكائن الفريد قادرا على القيام بجملة وظائف إسهاما في العيش الحتمي المشترك.
يمكن القول، في هذا السياق، بأننا سنركز اهتمامنا في هذه المقالة على التصور الثاني لبيان بعض الأفكار المفيدة في فهم حاجة الإنسان إلى التربية والتنشئة الاجتماعية. ينطلق الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط في مقاله «تأملات في التربية» من قول يلخص بشكل واضح أساس هذا التصور، حيث يقول: «الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يجب تربيته. ونقصد بالتربية الرعاية (التغذية، التعهد) والانضباط والتعليم المقترن بالتكوين (Bilding)»[2]. إذا كان الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يجب تربيته، فذلك معناه أنه الكائن الوحيد الذي يولد دون أن يكون مجبولا على بعض الطباع والسمات، التي لا يكتسبها إلا بواسطة التربية والتأهيل.
واستنادا إلى هذا الفهم الحديث بخصوص الإنسان، يمكن القول بأن الإنسان يولد حيوانا فقط، لا إنسانا بالحد. إذ ما دامت الإنسانية فينا صفات وسمات، فإنها بحسب هذا الفهم لا تولد معنا، بل نصيرها بواسطة التنشئة الاجتماعية، أو لنقل بلغة كانط: «إن الانضباط يحول الحيوانية إلى الإنسانية»[3]. فالانضباط على شكل من القيم والمبادئ الناتجة عن عملية التنشئة الاجتماعية التربوية، هي الوسيلة الكفيلة للانتقال بالكائن البشري من وضعه الطبيعي الحيواني الذي يولد عليه، إلى وضع ثقافي إنساني. لكن، ما دلالة التنشئة الاجتماعية؟
للإجابة عن هذا التساؤل يمكن استحضار تعريف عالم الاجتماع البريطاني أنتوني غيدنر الذي عرف مفهوم التنشئة الاجتماعية في كتابه «علم الاجتماع» بالقول: «يطلق مصطلح التنشئة الاجتماعية على العملية التي يتعلم بها الأطفال أو الأعضاء الجدد أساليب الحياة في مجتمعهم»[4]. وبهذا المعنى، تكاد تكون التنشئة الاجتماعية بمثابة القناة الأساسية التي يتم من خلالها نقل ثقافة الأمة أو الحضارة أو الدولة أو الأسرة إلى الأجيال اللاحقة، بل هي كذلك.
جدير بالذكر، أنه لتبيان كون الإنسان في حاجة إلى التنشئة الاجتماعية، يميز لنا غيدنز بين الحيوانات والإنسان. فالحيوانات بوصفها الكائنات التي توجد في أدنى سلم التطور، تكون فور ولادتها قادرة على حماية نفسها، دون الاستعانة بالحيوانات البالغة، بينما «الحيوانات الأخرى، المتقدمة في سلم التطور فهي في حاجة إلى تعلم طرائق السلوك المناسبة»[5]، الخارجة عن حيوانية الكائن الحي، الحاضنة له ثقافيا وإنسانيا. وبهذا المعنى، فالتنشئة الاجتماعية «هي التي تجعل من هذا الكائن الوليد بصورة تدريجية، إنسانا واعيا بذاته ومدركا لبعض المعارف والمهارات المتعلقة بمسالك الثقافة التي ولد فيها»[6].
وإذا كان الإنسان خاضعا لنوع من التنشئة الاجتماعية، فإن ذلك، لا يفيد أنه يُنحت على منوال لا انفكاك معه، بحيث يصير كائنا مبرمجا ثقافيا، بقدر ما أنها عملية مرنة تزوده كلما تجددت ثقافة الإنسانية بأسس ومبادئ، ترقى به نحو الإنسان الكامل المنفلت باستمرار. وبناء عليه، هل التنشئة الاجتماعية واحدة أم متعددة؟
يمكن القول بأن الإنسان خاضع لنوعين من التنشئة الاجتماعية[7]: تنشئة أولية: تنطوي على مرحلة الرضاعة والطفولة، وهي مرحلة يتم فيها تزويد الطفل بأقصى درجات التعلم الثقافي من قبل الأسرة، بحيث يتعلم فيها الطفل اللغة وطرائق السلوك الأساسية التي تؤهله لكي يتأقلم ويتعايش مع الجماعة البشرية. وتنشئة اجتماعية ثانوية، تنطبق على مرحلة ما بعد الطفولة إلى حدود سن البلوغ، إذ تتداخل في هذه المرحلة عوامل متعددة ومختلفة خارج دائرة الأسرة، كالمدرسة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعية، وغيرها من العوامل التي تتفاعل فيما بينها في تزويد الطفل بمجموعة من المعارف والقيم، ومن ثمة، تأهيله كي يكون إنسانا متحضرا.
وبناء على ما سبق، يتضح أن الإنسان لا يولد إنسانا، بقدر ما أنه يولد كائنا حيا، فتجعله التنشئة الاجتماعية بوصفها آلية تربوية إنسانا حاملا لقيم ومبادئ تتجاوز الحيوانية. فالتنشئة الاجتماعية لا تنزع عن الإنسان ذلك البعد الحيواني الغرائزي، وإنما تعمل على صقله وتأهيله، بل والتحكم فيه عقليا، وبذلك، نكون أمام كائن واع بما يحمله من دوافع غريزية، لكنه قادر على التحكم فيها، وصقلها باستمرار.
***
د. لوكيلي عبد الحليم
باحث في الفلسفة – المغرب
......................
[2] إيمانويل كانط. ثلاث نصوص، تأملات في التربية-ما هي الأنوار؟-ما التوجه في التفكير؟. ترجمة وتعليق محمود بن جماعة. ط.1. (تونس: دار محمد علي للنشر، 2005)، ص.14.
أنتوني غيدنز. علم الاجتماع. ترجمة فايز الصياغ. ط.1. (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2005)
[3] إيمانويل كانط. ثلاث نصوص، مصدر سابق، ص. 14.
[4] أنتوني غيدنز. علم الاجتماع. ترجمة فايز الصياغ. ط.1. (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2005)، ص.87.
[5] المرجع عينه.
[6] المرجع عينه.
[7] المرجع عينه.