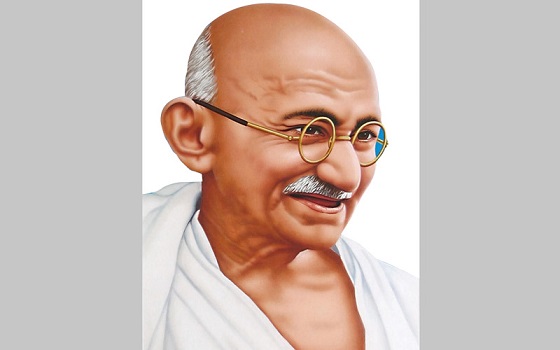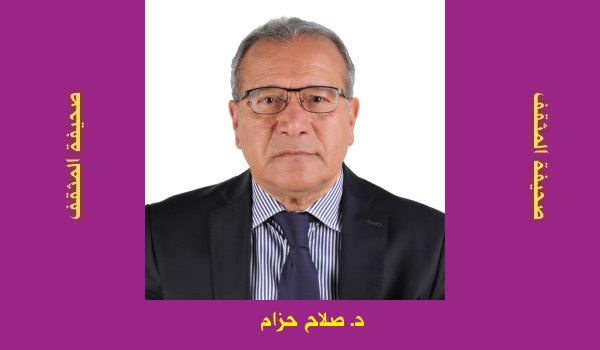قضايا
عصمت نصار: من غيبة آليات المعقول إلى الارتياب في قداسة المنقول

محنة غرابيل الفلاسفة (5)
يعتقد معظم المهتمين بالفلسفة - ولاسيما دراسة مباحثها المعنية بالبنية المعرفية وآلياتها ومناهجها ونظرياتها والأطوار التي مرت بها، وفلسفة العقل، وكذا الدراسات البنية ذات الصلة بهذا المبحث الأخير بداية من مفهوم العقل وطبيعة مدركاته وتنوع نتائجها وأحكامها - في أن الأفكار والتصورات والآراء جميعها ممّا يلفظه ذلك الذي نطلق عليه عقل أو ذهن هي الجديرة - دون غيرها من موضوعات - بالبحث والنظر والتثاقف حول قضاياها ومشكلاتها وأحكامها ومعتقداتها غير أن القليل أو إنْ شئت قل النادر من الأبحاث التي تشكل مبحث فلسفة العلم هو الذي راح يتساءل (كيف نعرف، ولماذا، وما الغاية التي تدفعنا للمعرفة، وما هي الآليات التي تشكل معارفنا وتضع المعايير والحدود لما نطلق عليه المعقول، وغير المعقول، والذي يمكن الشك فيه أو المحتمل)، ومن المسؤول عن تلك الأحكام القطعية التي تنسب لشيء كامن في النواصي وأعلى الجماجم؟ وكيف نتحدّث عن فلسفة عقلية دون أن نتعرف على ماهية ذلك العقل؟ وهل الإنسان هو الموجود الوحيد الذي يمارس وظيفة التعقل والتفكير؟ وهل هناك بدائل حسية وحدسية غير تلك التي ارتبطت بتلك الدائرة التي اطلقنا عليها مقولة المعقولات؟ واعتقدنا عبثاً بأن البرامج التكنولوجية المحاكية للعقل الإنساني هي التي سوف تصل إلى ما عجز العقل البشري عن فهمه؟
وماذا عن فلسفة العقول الموازية التي تعيش في عوالم مُفارقة، وترى وتسمع وتعتقد بطرائق .... بالغنا أحيانًا في تصور قدراتها وسخرنا من التفكير فيها باعتبارها ضربًا من ضروب الخرافة أحيانًا أخرى، وماذا عن فلسفة الأسطورة، والحديث مع الأشباح والتحاور مع كائنات في زمن ماض أو زمن آت.
كل ذلك يجعلنا نعيد النظر في الكثير من أحكامنا على تلك القيم (حقيقة، خيال، صدق، كذب، خير، شر، ذكاء، غباء، آراء تقديمية، أفكار رجعية، كائنات لها أجساد ماديّة، وأخرى تشغل تحيزات غير مرئية) ..
كل ذلك؛ وأكثر منه، طرحته العديد من المؤلفات المعاصرة (نذكر منها) التي جحدت تلك المناهج وهاتيك النهوج التي يعتقد أنها قادرة على الوصول إلى الحقائق القطعية التي عبثًا يستخدمها حتى الان فنضع قيمًا يقينية لأمور لا تستعصي على الشك أن ينفد إلى أصولها وبنيتها ونجحد مفاهيم ونتهكم على تصورات نجهلها أيضًا غير أننا نجهد العقل ونطالبه بإيجاد أدلة على بطلانها.
وخلاصة مقصدي مما سبق هو التأكيد على أن غرابيل الفلاسفة الناقدة التي تسعى للفصل بين الصدق والكذب ليست في منىء عن أن تقع في غرابيل أخرى أكثر دقة منها فتكذب ما صدقته. ومن هذه النافذة نجد فلاسفة العصر الوسيط يتحدثون عن تصوراتهم اللاهوتية ومعتقداتهم الروحية ومفهومهم لشخصية الإله علمًا بأن هؤلاء الفلاسفة لم يخرجوا عن نطاق الممكن الذي تسميه بعض الكتابات أساطير ويطلق عليه البعض الأخر غيبيات ويؤكد البعض الثالث وجود الكائنات الأسطورية والموجودات الغيبية في عالمنا الذي نعيشه موضحين جهل السواد الأعظم من البشر بلغة التواصل وآليات الحوار معها وبالتالي إثبات وجودها ومردود أفعالها والازمة في هذا السياق ليست في الغرابيل ولا في الفلاسفة ولا في المعايير التي تحمل الأفكار وإخضاعها للغربلة بل لقدرتنا على الاعتراف بأن عقولنا أعجز من أن تصل إلى حق اليقين أو جوهر الجواهر في ذاتها وعليه يجب أن نتقبل الآراء التالية التي ساقتها إلينا مصنفات فلاسفة اللاهوت المسيحي.
فترى الأستاذة نانسي مرقص -الباحثة في درجة الدكتوراه في فلسفة العصر الوسيط بكلية الآداب جامعة الإسكندرية-
خلال حديثها عن عقلانية العقيدة المسيحية وكذب المشككين فيها وجنوح منكريها وجهل جاحديها بإسم العقل والمنطق:-
أن القضية ليست أكاذيب وشائعات تلوكها الألسن وتصدقها المسامع والعقول وعلى الجانب الأخر عقائد مقدسة صادقة لم يفلح معتنقوها في الإفصاح عن الإيمان واليقين الذي ادركوه ببصائرهم الحدسية وليس بأبصارهم الحسية بل القضية في عدم تصور-المتلقي- أن للإنسان آليتين للادراك لا ينبغي الخلط بينهما أو أن تحل أحدهما محل الأخرى أو تنكر واحدة ما تراه قرينتها أولها تدرك علم اليقين والأخرى تدرك حق اليقين بلغة الصوفية فالعقول البشرية تدرك المحسوسات بعين اليقين أما التصورات والمجردات فتحتاج لبصيرة تعينها على استيعاب حق اليقين وبذلك التفسير يمكننا فهم ما انتهجه أهم فلاسفة المسيحية في العصر الوسيط لتبرير ما يعتقدونه تبريرًا عقليًا ويمكنني إيجاز من انتهت إليه تلميذتنا الحبيبة فيما يلي:-
فقد ذهب القديس أوغسطين إلى أن للمسيح أقنومين كاملين إلهي وإنساني لا يحل أحدهما في الأخر ولا استقلال بينهما أو انفصال فالتجسيد كان كاملًا فالمسيح إله كامل وإنسان كامل تمامًا متحدان في شخص واحد الذي هو يسوع المسيح الناصري بدون اختلاط أو انفصال الطبيعتين وينكر أوغسطين تلك الأكاذيب التي تعتقد أن الإله أصبح إنسانًا غير أن الحقيقة غير ذلك فخلاص الإنسانية لا يمكن تقبله من العقل الإنساني إلا على يد إنسان فالتجسيد ضروريًا لفدا البشرية بعد الخطيئة الأصلية لأن الإنسان وحده عاجز عن تقديم الكفارة الكاملة لذلك جاء الإله في جسد بشري ليحقق الخلاص ويعيد ويصلح العلاقة المفقودة بين الإله والإنسان وقد ربط أوغسطين بين الإيمان بعقيدة التجسد والفضائل التي نادى بها المخلص ليتم خلاص الإنسان وطهارته التي تؤهله للسعادة الأبدية أما انكار التجسد يؤدي إلى فهم خاطئ لحقيقة المسيحية والتعليم عن جهل لا ينطق به إلا الكذابون فالممكنات لا تستحيل على الإله لأنها لا تخضع لتصورات محدودة وإذا ما اتسع العقل على نحو يستوعب المطلقات وغير المحدود من الممكنات سوف يصل إلى أن ليس هناك تعارض مع الإيمان والعقل.
ويرى القديس أنسلم الكانتربري أن تصور آريوس ونسطوريوس وغيرهما من الهراطقة لا يخلو من الكذب لأن الإنسانية المسيح كاملة لا ينقصها شيء وكذا ألوهيته أما تصورهما في كيان واحد لا ينكره إلا من تشكك في قدرة الإله والشك في القدرة الإلهية ينفي حقيقة إيمانية وعقلية ونفي الحقائق هو بالضرورة كذب أما عن ضرورة وعلة التجسد فكلاهما يرجع لعدم قدرة الإنسان على التكفير عن خطيئة أدم فأراد المسيح أن يكفر عن تلك الخطيئة على نحو يليق بعظمة وكمال الإله ويقنع في الوقت نفسه العقل الإنساني بعظم الفداء فقد ضحى الإله بتجسده في صورة المسيح الإنساني ليتم الخلاص ويقبل القربان أو التكفير مبينًا أن الإله كلي القدرة يستطيع أن يتخذ جسدًا بشريًا بدون أن يفقد طبيعة الإلهية الأصلية كما أن الجسد البشري المادي لا يتناقض مع كمال الإله ومن ثم كان التجسد ضرورة حتمية لخلاص الإنسان وعليه فالعقل الذي يسع كل هذه التصورات لا يتعارض مع الإيمان الصادق وأن من يرى غير ذلك يحرض على الضلال والإضلال دربًا من دروب الكذب.
أن توما الأكويني خير من درس الفلسفة العقلية ولاسيما حديث الفلاسفة في مبحث الألوهية ومن ثم لا يوجد تعارض بين ما ذهبت إليه المسيحية والرؤية العقلية لطبيعة الإله فالكنيسة تعلم بأن الإله واحد غير أنه له ثلاثة أقانيم لا يمكن للعقل تصورها أما صفاته وقدراته اللانهائية فلا خلاف عليها بين المؤمنين فلا سبيل لهم لمعرفة طبيعة الإله ولا صفاته لأنها تفوق العقل وتصوراته المحدودة فإن جوهر الإله الواحد لا يمنع أن تكون له صفات متعددة تحاكي بعضها التصورات العقلية الإنسانية والبعض الأخر لا سبيل للعقل أن يدركها إلا بالحدس الإيماني. وذلك لأنها من الغيبيات وأي انكار لهذه الرؤية وذلك المفهوم يؤدي بنا إلى الانحراف العقلي لأننا نكلفه بما لا يستطيع فإدراك الغيبيات غير عقلي بالضرورة أما إنكارها فيقودنا إلى الالحاد وهو كذب وضلال ويخالف الحقيقة. أما تجسد الإله فلا ينقص من كماله لأن الإله قادرًا على كل شيء لا يحدد بطبيعة المخلوقات فإذا أراد الإله اتخاذ جسدًا فالبطبع هو قادرًا على ذلك وذلك بدون أن يفقد كماله الإلهي على الاطلاق وذلك لأ الشيء الطبيعي لا يمنع القدرة الإلهية من تجاوزه لأنها غير محدودة بالقيود الطبيعية فالهدف من التجسد هو خلاص الإنسان فالتجسد لم يكن حادثًا عشوائيًا وعليه فإن من يشكك في قدرة الإله على التجسد يؤدي إلى انكار كماله وهذا مخالف للحقيقة أيضًا ويؤدي إلى التجديف كما أن اتحاد الطبيعيتين الإنسانية والألوهية في شخص المسيح فإنه يساعد على فهم الإنسان لعقيدة الخلاص التي عايشها الإله مع البشر وذلك لأن هذا الاتحاد بين (الجسد والجوهر الإلهي) لم ينقص من طبيعتهما شيء فليس فيه امتزاج ولا انفصال ومن ثم فرفض الطبيعتين على هذا النحو لا يخلو من الكذب لأنه مخالف لكمال الإله المتفرد القادر على كل شيء كما ذكرنا.
***
والآن سوف نحاول الإفصاح عن طبيعة العلة الحقيقية التي كانت وراء محنة غرابيل الفلاسفة وعجزها عن الفصل بين الأكاذيب والحقائق في ذلك العصر الشاغل بالمثاقفات والمصارعات والمناظرات والمعارك الفكرية التي تسببت في السفع بالنواصي وسجن العقول وخرس الألسنة بل وإراقة الدماء وتربع الاستبداد والجهل والعنف في سماء ذلك الظلام الحالك الذي خيم على أوربا في الفترة الممتدة من القرن الثالث إلى القرن الخامس عشر الميلادي حيث مصابيح النهضة التي حملها ديكارت وبيكون لإزالة ذلك الركام الحضاري الذي عاق تقدم كل القيم الإنسانية آنذاك فقد تبين لنا من دفوع ومزاعم وادعاءات كل الاتجاهات المتصارعة أن جميعهم كان من صانعي الكذب بكل أشكاله في حين أن غرابيل الفلاسفة الحديدية أو الحريرية لم تتمكن من غربلة الوافد الذي تحمله من مزاعم متناقضة وشائعات ذائعة وادعاءات مغرضة وأفاك ملفقة والرؤية الناقدة لا تستطيع أن تقطع بأن هناك مسؤول بعينه عن تلك الكثرة من الأكاذيب التي لفظتها هذه الاتجاهات هل التعصب للموروث أو الخوف من وصف الواقع أو الارتياب في المجهول القادم أم ضياع وفقدان المعيار الذي توضع فيه الأفكار؛ ليصبها العقل في غرابيل النقد لتهذيبها أو النقض لإبعادها؟
وللحديث بقية عن قراءة العقل المحايد لفلسفة عن هذا العصر.
***
بقلم: د. عصمت نصار