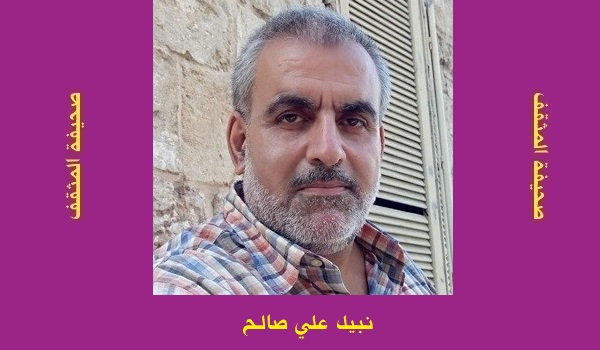قضايا
محمد سيف: الرأي المسحوق تحت الأغلبية

حينما يقترن أمران لا صلة حقيقية بينهما، فيكون أحدهما دالا على الآخر، وقيمة الآخر متوقفة على الأول، فهذا نذير شؤم بنتيجة تتوقع فيها كل شيء إلا الحقيقة، وعلى المستوى الفكري تكون المغبّة أَنْكى؛ لأن الفكر القويم يُبنى على تسلسل منطقي من الأدلة، وليس على جمع اعتباطي، وربطٍ عشوائي كيفما اتفق، وحتى لا تتوه منا الفكرة في ضبابية المدخل العام لموضوع بحثنا، فإني أودّ الإبانة عاجلا عن مقصودي، فأنا هنا أتحدّث عن اقتران صحة الرأي بتبنّي الأغلبية، وإذا كان الفكر الإنساني قد مُنِيَ برزيّة فستكون الأغلبية!
حين نتحدث عن صحة الرأي، فإنه من المفترض أن يدور كلامنا على الدلائل والقرائن والحجج والبراهين والتجارب العملية والعلمية، ونحوها مما يُستند إليه - عن استحقاق - لإثبات المعارف، فيغدو ادّعاؤنا بأن التصوّر الفلاني صحيح استنادا للحجة المبرهن عليها، مقبولا لدى الحسّ الطبيعي، أما إذا كان المصدر الذي ولّد قناعة بصحة رأي ما ليس بذي بال أو فاقدا أيّ قيمة، فهنا تكون نظرتنا لصحة الرأي محل شك ونظر بل وريبة!
وحين نتحدث عن الأغلبية، فإنّ أقصى ما نشير إليه هو نسبة غالبة من مجموعة أناس يجمعهم قاسم مشترك كالرقعة الجغرافية أو اللغة أو الدين أو العِرق…إلخ، فحين نقول أغلبية المقيمين في تلك الدولة من الجنسية كذا، فهذا يعني نسبة 51% فما فوق منهم هم من هذه الجنسية - لا أكثر ولا أقل - ولا يدل على شيء آخر إلا الأكثرية العددية.
المتاهة التي عَلِق فيها الفكر الإنساني هو أنه أوجد رابطة - حيث لا رابطة - بين صحة الرأي التي تفترض حيازتها على أدلة إثباتها، وبين تبنّي الأغلبية إياه بوصفها الدليل الذي يركن الرأي إليه، وإن كان ربطا لا شعوريا وغير صريح، لكن ظلاله ملقاة على واقع تعاطينا الفكري، وخير مثال ما تعجّ به مواقع التواصل الاجتماعي من مناقشات في نطاق (الترندات)، وكيف يتم التعاطي مع رأي الأغلبية بثقل اجتماعي بل ومعرفي للأسف.
كل ما أرغب في زَجّه لبؤرة الضوء هنا هو أن نضع الرأي المُتبنّى من الأغلبية في خانته الطبيعية بلا عملية (Filler) حشو! وعلى قول المتنبّي:
أعيذُها نظراتٍ منك صادقةً أنْ تحسبَ الشحم فيمن شحمُه ورمُ
فهو رأي أخذ به أفراد مجموعة ما بنسبة غالبة، بدون أن نزيد من عنديّاتنا أيّ شيء من قبيل صحة الرأي أو دقته أو وجاهته! فالأغلبية ليست أحد أدلة الصحة، بل نسبة غالبة، وغالبة باعتبار العدد وليس شيئا آخر.
ومن الوارد جدا أن نتساءل إزاء هذا الخلط عن السبب الذي آل بنا إلى فرض هذه العلاقة القسرية بين الأغلبية وصحة الرأي، التي لربّما تكون صادمة للبعض إذْ ينتبه لها لأول مرة وقد كانت ممارسة بديهية فيما مضى، على سبيل النطاق العام للأسباب فطبيعي جدا أن تتعدد وتتداخل، فليس بلازم أن تكون الأسباب خطيّة أو منفصلة بشكل حدّي عن بعضها، وفيما يتصل بمحل بحثنا عن أسباب إقامة اقتران بين الأغلبية وصحة الرأي فإني أود الالتفات إلى سببين، أوّلهما فردي المَنبت، وثانيهما جماعي الدافع.
فيما يخص المستوى الفردي، فأدمغتنا تميل للاسترواح للالتصاق بالأغلبية في تبنّي تصوّر أو توجّه معيّن؛ لتجنّب إعمال العقل؛ لأن العمل الذهني يتطلّب طاقة إضافية، فيجد الدماغ في الأغلبية العزاء، فيستمرئ الميل لمحاكاة رأي الأغلبية على اعتبار أن ذلك إشارة إلى قوة الرأي لدرجة أن الجموع بمختلف أطيافها قد تضافرت عليه، ولكن تلك منهجية غير وجيهة؛ فتبني الرأي هو مسؤولية فردية بالدرجة الأولى، وليست مسؤولية جماعية، والذي يحصل أن هذا الاسترواح يجعل ما يُقدّم من أدلة تبريرات لصحة رأي الأغلبية، ليس لأنها أدلة صحيحة في ذاتها، أو على أقل تقدير ليس لكونها بتلك القوة التي يتم تقديمها على أنها كذلك، وإنما الباعث الأساسي هو تبنّي الأغلبية، فنتراخى في عملية التمحيص والنقد، لا لشيء سوى أننا لا نكاد نولّي وجوهنَا شطر ناحية ما إلا وجدنا من يسبّح بحمد هذا الرأي ويلهج بذكره! فنجد أنفسنا تلقائيا مع الخيل يا شقراء! فإذن الميل لرأي الأغلبية ليس بالضرورة قناعة تُفصِح عن نفسها بل تتسلّل إلى المستوى اللاشعوري مقنَّعة بأدلة لاحقة جوفاء، باطنها محض تبريرات لتمرير رأي الأغلبية على أنه رأي متأسّس على أدلة رصينة تعضده.
وفيما يخص المستوى الجماعي، فعلى مرّ الأزمان تطوّرت الحاجة الجماعية للاحتفاء بخصائصها من الأعراف والأفكار بين أفرادها بفعل الانتقاء الطبيعي للجماعة (Group Selection) للمحافظة على بقاء انتماء أفرادها إليها، فكيف يُتصوَّر وجود للجماعة بدون أفراد يشكّلونها؟ لا شيء قطعا، ومن تفرعات ذلك الاحتفاء هو تقدير رأي الغالبية بما هو تمثيل معتبَر للتيار العام للجماعة، ومن هنا كان تمرّد فرد على التيار العام للجماعة في أعرافها وأفكارها يشكل تهديدا يؤرق مضجع الجماعة؛ فتعمد بدايةً إلى محاولة استمالته مجددا إلى حياضها، فإن لم يُجدِ ذلك نفعا تقوم بتجنيد أدواتها المتاحة المشروعة منها وغير المشروعة، فتغتاله اجتماعيا وتشوه صورته ولا تألُو جهدا في محاربته لجعله عبرة؛ تجنبا للعدوى، والتي إنْ استشرت فذلك إيذانٌ بالقضاء على وجود الجماعة، ولك أن تدرك أنه كلما كانت الجماعة مترامية الأطراف وذات نفوذ واسع وتحكمها أيديولوجيا مستحكمة، امتلكت أدوات أكثر إيغالا في اللاإنسانية، ليس أقلها إطلاق حملات بروبوغاندا ضد المنشقين عنها، على أنّ نطاق الآراء ذات الحظوة لدى غالبية جماعة ما، ينبغي أن يكون محل دراسة حقول علمية كعلم النفس الاجتماعي؛ لبحث الجذور التي شيّدت علاقة متينة بين غالبيةٍ ما وبين هذه الآراء من بين نظيراتها من الآراء.
إذن العقد الذي يُلصق صحة الرأي بالأغلبية هو عقد اجتماعي، يتعزّز بميل أدمغتنا إلى الاتّكاء على استنساخ رأي الغير الجاهز، خصوصا وهو يحظى بسطوة الغالبية، ولسانُ حالها إنْ كان صحيحا فبها ونِعْمَتْ، وإنْ كان خطأً فالخطب يهون مع وقوع غيرنا في الفخ نفسه!
على أنّني أحرص دائما على التحذير من مفهوم الرأي العام، الذي عادة ما يكون مستخرَجا من تفاعلات الجمهور مع (ترند) معين، فيُصدَّر على أنه يمثل الأغلبية، وما يمثل الأغلبية يُنظر إليه بما هو ممثّل لتلك الجماعة بأسرها سواء كانت شعبا أو أصحاب دين أو أتباع تيار فكري…إلخ ولكن عند التفتيش عن حيثيات مفهوم الرأي العام فهو لا يعني إلا صورة مُجْملة شوهاء عن رأي جماعة ما، بعيّنةٍ محدودة وشريحة مُجتزَأة لا تتأهّل لأنْ تقوم بتمثيل الأغلبية فضلا عن الجماعة بأسرها، ففي الوقت الذي نسمع فيه أن الرأي العام في منطقة كذا أو عند مجتمع ما، فهذا لا يعني إلا استطلاعا لوجه واحد من الوجوه، قد يكون استبانة لعيّنة غير منضبطة، أو تفاعلات في (ترند) في منصة (X) وهؤلاء لا يمثلون بالضرورة الصوت الحقيقي لأي مجتمع.
على أنه في الوقت الذي يُنظر فيه إلى الأغلبية مُرجِّحا أو على الأقل باعثا للاطمئنان أو الاستئناس لتماسك رأي ما، فإنه يمكن أن يكون ذلك على النقيض تماما، بما هو لافتة تحذير (Red flag) فقد جرت العادة على أن تكون الآراء السائدة مكانا خصبا لترعرع الأفكار المغلوطة والمدفوعة لخدمة أجندات معينة وليس نشدان الحقيقة.
وهذا يذكرني بمقولة متداولة منسوبة لمارك توين، ولم أقف على مصدرها، ولكن مهما يكن فمضمونها دقيق جدا، وهي: "Whenever you find yourself on the side of the majority, it’s time to pause and reflect." أي: كلما وجدت نفسك في صفّ الأغلبيّة فقد حان الوقت لتتوقّف وتتأمّل، وعموما في الوعي الجمعي ننفر جميعا من سمة الإمّعة رغم سقوطنا ضحايا لها، شعرنا بذلك أم لا، ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ودخول الكوكب في نظام عالمي جديد، نشأت في سياق ثقافة الشعوب الناطقة بالإنجليزية كلمة هجين (Sheeple) وهي نحت لكلمتين (Sheep) بمعنى الخِراف و(People) بمعنى الناس، ليكون معناها الكلّي: الأشخاص سهلو الانقياد كالقطيع، والمعادل الأقرب إليها بالعربية الإمّعة، لكن كلمة (Sheeple) كما هو جليّ تضفي تهكّما لاذعا لهذه الفئة من الناس التي تحشو أدمغتها بآراء جماعتها بغضّ النظر عن صحتها، وقد أُضيفت الكلمة رسميا لقاموس أكسفورد عام 2015 أي قبل عشر سنوات من الآن.
وفي خطوة أولى حتى لا ننجرّ في تيارٍ إمّعيٍ بامتياز، علينا أن نَفْرَق ابتداءً من الرأي السائد الذي يعبّر عن الأغلبية، ونُعمِلُ فيه نقدنا أقسى من غيره؛ لنتأكد قدر المستطاع من أننا لا ننضمّ لقائمة ضحايا تصوّرات تيار الأغلبية، فالرأي إذْ تحتفي به الأغلبية لا يعني إلا أن كثيرا من الناس اعتمدوه، ناظرا إلى العدد ليس إلا، من غير أن يدل على أي معنى زائد آخر كصحته! وكم من رأي صحيح حصيف مسحوق تحت الغالبية؛ لقلة متبنّيه، مبحوح الصوت حتى لا يكاد يُسمع، ومع ذلك إذا كانت نتيجة نظرك في رأي ما قد وافق الأغلبية فلا يعني أنه يتوجّب عليك نبذه وازدراؤه، فحجر الزاوية هو ألا تتبنّاه لأنه رأي الغالبية وحسب.
***
محمـــد سيـــف