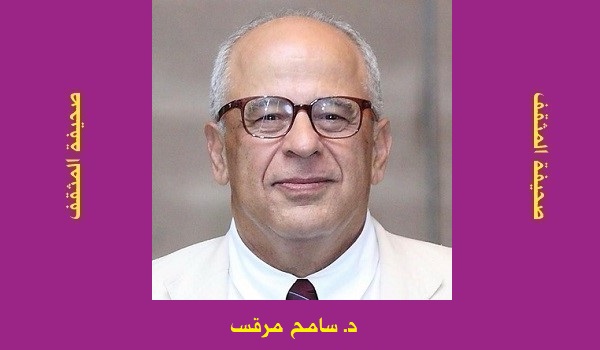قراءات نقدية
عماد خالد رحمة: دراسةٌ نقديّةٌ تحليليةٌ موسّعة في قصيدة: "أُريدُ رَحيلاً لِهذا السَّوادْ!"

للشاعر: أحمد يوسف داود
تقف قصيدة "أُريدُ رَحيلاً لِهذا السَّواد" للشاعر السوري أحمد يوسف داود عند الحدّ الفاصل بين الفاجعة والرجاء، بين انكشاف الروح وخذلان التاريخ، بين عراء الحرف وفضيحة الواقع. إنّها ليست مجرّد قصيدة رثاء للوطن أو للزمن، بل محاولة لالتقاط ما تبقّى من الإنسان في لحظة السقوط، ولتضميد جراح المعنى حين تعجز اللغة عن حمل ثقل الألم. هنا لا ينطق الشاعر بوصفه فرداً، بل بوصفه ذاتاً جَمْعيّة، تتماهى مع رُوح بلادٍ تنهكها الحروب، تتفسّخ في سواد الخيبة، وتظلّ — رغم كل شيء — تبحث عن ضوءٍ غير مُسمّى.
تضع القصيدة القارئ أمام مسرحٍ هيرمينوطيقيّ معقّد، تتداخل فيه الأصوات، وتتقاطع الطبقات الشعورية، ويتحوّل الخطاب من الذاتي إلى الجمعي، ومن الوجداني إلى الرمزي، ومن الرثاء إلى صيغة احتجاج صامت. هي نصّ يطلب تأويلاً، لأنّ كلّ مفردة فيه تعمل كـ"علامة" تتجاوز حدود الكلمات إلى بنى أعمق من اللغة — إلى الجسد، والذاكرة، والذعر، والأسى الوطني الذي يتراكم منذ عقود.
وعلى مستوى البنية، تنتمي القصيدة إلى شعر الأزمة، حيث تتحوّل الوظائف السيميائية للأدوار (الفاعل، المفعول، المرسل، المتلقي…) وفق نموذج غريماس إلى منظومة متشابكة، يتبدّل فيها الفاعل بين الروح والوطن، ويتحوّل الوطن من كيان إلى جرح، ومن جرح إلى "سواد" يبتلع الذات. هذا السواد ليس لوناً، بل نظاماً وجودياً، شبكةً من الرموز التي تُختبر بالتأويل لا عبر القراءة السطحية.
تستدعي القصيدة مقاربات متعدّدة:
١- هرمينوطيقياً: نخوض في لُبس المعاني، وفي طبيعة الصوت الشعري الذي يتردّد بين الانكسار والرجاء.
٢- أسلوبياً: نتتبّع جرس الكلمات، نبرة الخفوت، الموسيقى الداخلية، انسياب الجمل نحو الحزن الكبير.
٣- رمزياً: نقرأ الظلمة والهشيم والرماد بوصفها استعارات لوعيٍ مأزوم ومجتمعٍ محطم.
٤- وجمالياً: نرصد انزلاق اللغة من فضاء التجميل إلى فضاء الشهادة.
٤- نفسيًا ودينيًا: نكشف التحوّلات في خطاب الروح: بين الخذلان، والابتهال، والسؤال الميتافيزيقي لحكمة العدالة والغيب.
٥- سيميائياً: نعيد اكتشاف ماهية "السواد" كفاعلٍ مهيمن قادر على ابتلاع الذات وتوجيه مصائرها.
بهذا المعنى، نحن أمام قصيدةٍ تُطلّ من شرفة الخراب، لا لتبكيه، بل لتسأل: هل ثمّة مخرجٌ من هذا السواد؟
إنّها قصيدةٌ تُستعاد لأنّها لا تُغلق باب التأويل، بل تُضاعف احتمالاته.
1. مقدّمة ومقاربة منهجيّة:
تستدعي هذه القصيدة قراءاتٍ مُتعدِّدة الأفق: هي نصٌّ وجدانيٌّ ووطنيٌّ في آنٍ، يشتغلُ على توترٍ بين الانفعال الفرديّ وجراح الجماعة. ستعتمد هذه الدراسة مقاربةً هيرمينوطيقيّة–تأويليّة للكشف عن نوايا النصّ وظلاله، مع توظيف المنهج الأسلوبي لقراءة الوسائل البلاغيّة والإيقاعيّة، والمنهج الرمزي للكشف عن دلالات الصور، ثم استحضار أداة غريماس السيميائيّة لاستخراج محاور الأدوار الفاعلة في حقل الدلالة. سنغوص أيضاً في البُنى النفسيّة والدينيّة الكامنة «تحت الجلد الشعري» ونقارن النصّ على مستوياتٍ عدّة: انفعاليًّا، تخييليًّا، عضويًّا ولغويًّا وجماليًّا. الهدف: إظهار كيف يصبح الحزن هنا تجربة وجوديّة-وطنيّة مُركّبة تُعيد تشكيل الذات وتؤسِّس خطابًا شعريًّا مقاومًا بالتحنّنِ على حدود اللغة.
2. قراءة هيرمينوطيقيّة - تأويلية: سياق النصّ وأفقه الدلاليّ
القصيدةُ تبدأ بلحظة «هَزيعٍ من الوحشة»؛ أي لحظةٍ فجرية/لحمية لوعيٍ مفجوع. الوقع الوجوديّ واضح: الروح تصرخ بلا صوت، وتخلع معطفها لتضمّد جراح البلاد. هذا الفعل الرمزي (خلع المعطف) يضع الذات في موقف عارٍ متحمّل، مستعدٍّ للمسح والعلاج، لكن في الوقت نفسه مكشوف أمام العنف التاريخيّ. القراءة الهيرمينوطيقيّة تقرأ النصّ كحكاية استدعاء:
الفرد يستدعي تعاطفَ الآخر—أو بالأدقْ يعلن عن استحالة التعاطف الكافي ("الدمع ماعاد يكفي")—وبذلك تُصبح القصيدة شهادةً ونَداءً ومضادًّا للصمت السياسيّ والاجتماعيّ.
نقرأ النصّ كذلك كأرشيف حزن: كلّ وحدة لفظيّة تضيف طبقةً من الألم، من الفردي إلى الجماعي، من الليل إلى القمر، من المطر إلى الرماد. الهيرمينوطيقا هنا تُظهر أن كلّ صورة ليست انعكاسًا فقط، بل عملُ تأويلٍ داخليّ يطلب القارئ أن يُكمل المقطوعة بإحساسه الشخصيّ والتاريخيّ.
3. الأسلوب والبناء البلاغيّ والإيقاعيّ
1. الأسلوب التكثيفيّ: الشاعر يعمل بتكثيفٍ عاطفيّ وبصريّ؛ الجمل قصيرة أحيانًا، تبدو كأنها تنهض من ألمٍ متهرِّئٍ.
2. التكرار والتحوير: تتكرّر صور البكاء، الليل، القمر، والرماد، لكن مع تحويرٍ طفيف يثبّت حركة النصّ: من البكاء كفعلٍ فرديّ إلى البكاء كغريزة اجتماعيّة.
3. الأسلوب التصويريّ/الانفعاليّ: الصور التشخيصيّة (الروح تصرخ، الليل يرسل أقمارَه) تمنح النصّ حيويّةً أسطوريّة، تجعل الموت/الدمع/الفرحُ رموزًا عامّة.
4. الإيقاع الصوتيّ: تناغم الحروف الساكنة والمتحركة، وتوظيف الوقفات (علامات التعجب والاستفهام) يخلق إيقاعًا مُتقطّعًا ينسجم مع حالة الفزع واليقظة.
4. السيمياء (منهج غريماس): أدوارٌ ومحاور داخل الحكاية الشعريّة
نحاول هنا تطبيق مخطط غريماس لتحويل البنية الدلاليّة إلى شبكة أدوار:
١- المرسل: القصيدة/الذات الشاعرة التي تطلب الرحيل وتُعلِن الفاجعة؛ قد يُقرأ المرسل أيضاً كـ«الضمير الوطني» الذي يتوجّه إلى القارئ أو التاريخ.
٢- المرسل إليه/المرسَل إليه: القارئ، الجماعة، أو الضمير الجمعيّ (البلد، المواطن). أيضاً يمكن أن يُنظر إلى «البلاد» كمرسل إليه يحتاج إلى الإنقاذ.
٣- الموضوع/المطلوب: «رحيل هذا السواد»—رحيل الظلمة/الحزن/الاحتلال/اللاعدالة؛ هو الهدف الذي تطمح الذات إلى تحقيقه أو رؤيته.
٤- الفاعل/البطل: الروح الشاعرة، أو الذات المتكلّمة التي تقوم بفعل النداء والعلاج.
٥- المساعدون: صور الليل/القمر/البكاء—كعناصر تُسهم في التعبير وكوسائل إثبات الوجود؛ أو الدموع التي هي "لم تعد تكفي" فيصبح المساعد عاجزًا، لكن مفرداته تساعد على بناء الحزن.
٦- المعارضون/المعوقات: السواد/الخذلان/الخيانة/الظلم—قوى تمنع الرحيل، أو تجعل الرحيل تعبيرًا عن اليأس. كذلك «الصمت» كمُعارض (عدم الاستجابة).
٧- المرسل الحقيقي/النهائي: التاريخ، القدر، أو الذاكرة الجماعية التي تدفع بالذات إلى الصراخ.
بهذا التوزيع، النصّ يكشف وظيفةً حكيّة: هو ملحمةُ نداءٍ لا تنتهي، حيث الذات (الفاعل) تُسعى لإيجاد مخرج (الرحيل عن السواد)، لكن المعوقات تتحوّل إلى قوىً داخليّة تُجمد الفعل وتعيده إلى دائرة التكاثر.
5. البُنى النفسيّة والدينيّة تحت الجلد الشعريّ
البنية النفسيّة:
فعل الخلع (خلع المعطف): فعلُ تعرٍّ أمنيّ ونفسيّ؛ يمثل رغبة في مواجهة الجرح مباشرة دون وسائط. يشير إلى نوع من التضحية الطقسيّة: عرض الجسد/الروح للعلاج على الرأي العام. نفسيةُ الضحية هنا مزيج من الصدمة واليقظة: تصرخ الروح بلا صوت لأنّ اللغة قد هُمشت.
١- الإنهاك والجمود: "الدمع ماعاد يكفي" = نفاد الوسائل التقليدية للشفاء؛ هذا هو مؤشر انكسار جماعيّ/نفسيّ.
٢- الاستسلام الإجرائي: الجزء الأخير "فدعوت البكاء... ولكنه راح يخدعنِي" يشي برؤية نفسيّة عن الخداع: الحزن الذي يتحوّل إلى روتين خدّاع يمتصّ الفعلَ ويترك الروحَ سوداء.
البنية الدينيّة والطقوسيّة:
القصيدة توظّف رموزًا تضرب في العمق الدينيّ: الليل/القمر/المطر/الرماد—كلّها صور ذات نبرة طقوسيّة. المطر هنا ليس رحمة فحسب، بل "مطر من ذهول"؛ رمزيته تتحرّر من دلالتها القرآنيّة/التقليديّة لتصبح حالة وعي. الرماد له دلالة الترميم والتطهير من جهة، ودلالة الهلاك من جهة أخرى.
فعل الدعاء والدخول في حالة "قلقٍ آمل" يُشير إلى توتر دينيّ: ثقة مُعلقة بين استدعاء الفرح وانتظار معجزة أو رحمة إلهيّة لا تأتي. هذا التوتر يطرح الأسئلة الكبرى عن وجود الله/القدرة الإلهية في زمن المصاب.
6. المستوى الرمزي والدلاليّ (تفكيك الصور المفتاحيّة)
الروح تصرخ من غير صوت: الصرخة الصامتة كرمز للمعاناة التي لا تُسمع—سواء بفعل القمع أو بفعل النشاز الكلاميّ.
١- خلع المعطف: إشارة إلى التخلّي عن الحِمى، أو التقدم لشفاء الجراح؛ قد يرمز كذلك إلى فقدان الحماية والكرامة.
٢- الدمع الذي ما عاد يكفي: يرمز إلى استنفاد وسائل الحزن التقليدية، والانتقال إلى حالة من الفراغ العاطفي/الاستسلام.
٣- الليل وأقمارُه: الليل يتصرف كمن يواسي، لكن الأقمار هنا قد تكون أقنعة تواسي أو تدّعي الرفقة؛ "قمرٌ يستحي" يكشف عن مفارقة: حتى عناصر الكون تشعر بالخجل أمام حجم الفوضى.
٤- مطر من ذهول وغيمة من رماد: المزج بين المطر (رمز للحياة) والرماد (رمز للهلاك) يولّد دلالة مركّبة: الحياة تصفرّ، والهلاك يصبح هو ماء الوجود.
٥- السرير الضيّق للبكاءِ: صورة جسمانيّة تُحوّل البكاء إلى فعلٍ عضويّ عيان—والتجمّد من الحَسرة يشير إلى موتٍ داخليّ للأحاسيس.
٦- الخيانة والعمر: مخاطبة "يا صديق الخيانات يا عمر" تُحوّل الزمن إلى مُتآمر؛ العمر ذاته يحمل خياناتٍ لا تُغتفر.
7. شرح بعض المفردات الدلاليّة والعمل اللغوي عليها
١- هَزيعُ الوحشة: "هَزيع" لحظة فجرية أو شُعاع، هنا تربط الوحشة بلحظة تحوّل؛ الوحشة ليست حالة دائمة بل لحظة مُعلنة.
٢- مِعطفُها: ليس مجرد لباس، بل عنوانٌ للحمى والاحتماء، والخلع هنا رمز للشجاعة أو العري.
٣- مَخذولة: صيغة مبالغة للخذلان، تحمل معنى التترك وعدم الإمكان؛ الروح "مخذولة" أي مُترَكة على الحزن وحده.
٤- مباذلُ ما يدّعي: كلمة مركبة؛ "مباذل" جمع مبْذَل؟ تُقرب إلى مَناحي العرض والتباهي—القمر "يستحي" من تظاهر الكون بما ليس فيه.
٥- مطر من ذهول: تركيبٌ جديدٌ ومبتكر، يقوّي البُعد الإبداعيّ في النصّ؛ المطر ليس هنا سببًا للحياة بل نتيجة ذهولٍ جماعيّ.
٦- هَباءٌ يمرّ بلا صخب: الرمز إلى عبثية الدنيا؛ الهباء موت بلا أثر.
8. المقارنة التحليلية على مستويات متعددة
أ. المستوى الانفعالي:
النصّ يعتمد على تصعيدٍ انفعالي: من الصرخة الصامتة إلى استدعاء البكاء إلى استسلامٍ ثقيل. الانفعال هنا متدرّج لكنه متراكم—لا ينفجر في ثورة واحدة، بل يتراكم كما يتراكم الرماد على لهب لم يعد قابلاً للاحتراق.
ب. المستوى التخييلي (الخيالي):
الخيال في القصيدة غنيّ ومباشر: صور الليل/القمر/المطر والرماد تولّد هذا العالم اللامرئيّ الذي يمثل الوطن والذاكرة. التخييُل هنا وسيلةٌ لصياغة الحقيقة القاسية بطريقة تجعلها قابلة للتحمل والشهادة.
ج. المستوى العضوي (الجسدي):
القصيدة توظيفٌ للجسد: المعطف، السرير، دمعُ العين، تجمّدُ الحسرة—كلّها مؤشرات على أن الحزن ليس مجرد حالة ذهنية بل احتلال للجسد. هذا التحويل يجعل من الحزن مرضًا عضويًا، ومن الشعر دواءً أو شهادةً.
د. المستوى اللغوي والأعراف الجمالية
لغويًا، النص يختزل ويكثّف ويبتكر تراكيب تشدّ الانتباه ("مطر من ذهول")، ويتحرّك بين مستوى البيان والمجاز والصورة الأسطورية. من حيث الأعراف الجمالية، القصيدة تنتمي إلى مدرسة حداثيّة متأثرة بالرؤية الرمزيّة/الوجوديّة: قصيدة الشهادة، قصيدة الوطن الممزق، وقصيدة السرد الذاتي–الاجتماعي.
9. لحظة الإدهاش وجوهر النصّ:
لحظةُ الإدهاش في النصّ تتجسّد حين يتقاطعُ المفهومُان المتقابلان: المطرُ (رمز الحياة) و/مع الرماد (رمز الهلاك). هذه المفارقة تُحدث صدمةً معرفيّة تُجبر القارئ على إعادة قراءة العالم: الحياة تصبح مادةً للدهشة والهلاك يصبح ماء الوجود. الإدهاش أيضًا في عبارة "الدمع ماعاد يكفي الفواجع"؛ إدهاشٌ أخلاقيّ: لم يعد العالم قادراً على استيعاب المآسي، وحتى أدوات التعزية تنهار.
جوهر النصّ: هو صرخة توثّق فقدان فعل الراحة/العزاء في زمن الأزمات، وهو رغبة في الرحيل، لكن الرحيل هنا ليس خروجاً جغرافياً محضاً بل هجرة روحيّة عن سطوة السواد. الرحيل رمز لتحوّل، للبحث عن مشهدٍ إنسانيٍ أقلّ تلوّثاً.
10. انساقٌ معرفيّة ونهايةٌ تفسيرية:
النصّ يعمل عبر أنساق معرفيّة متداخلة:
١- أنساقُ الذاكرة والتاريخ: الجراح كذاكرةٍ جماعية.
٢- أنساقُ المعنى الديني/الطقسي: المطر/القمر/الرماد تُستدعى بصفتها إشاراتٍ طقسيّة.
٣- أنساقُ الجسد: الحزن كمرض عضويّ.
٤- أنساقُ البلاغة: التجريد، التكثيف، والابتكار اللغويّ.
٥- التفسير الخاتمي: القصيدة هي شهادةٌ شعريّة تطالب بالرحيل كخيار إنسانيّ أخلاقيّ عند حدود الاستحالة. إنها ليست نزعة انفعاليّة هاربة بل محاولةٌ لإعادة تركيب الذات مقابل الخراب. الشاعر هنا لا يُسقط الخسارة فحسب، بل يحاول جعلها مادة فاعلة للوعي والشعر: تحويل الألم إلى خطاب يطالب بالرحيل—ربما ليس هروبًا، بل ولادةً ممكنة.
11. توصيات بحثيّة ونقديّة لاحقة:
1. تحقيق نصّي: مقارنة مخطوطات/طبعات القصيدة إن وجدت، لتتبّع التبديل اللفظيّ.
2. دراسة علاقية مع نصوصٍ وطنية ومعاصرة حول نفس الثيمات (الحزن، الرحيل، السواد) لمقارنة الأوجه الأسلوبيّة.
3. قراءة نفسية أعمق: تطبيق مناهج التحليل النفسيّة (فرويد/يُونْغ) على الصور (الرماد، المعطف، السرير) لاستنباط آليات التكافل/الانفصال.
4. بحث سيميائي تطبيقيّ أوسع باستخدام غريماس: تحليل شبكيّ يتجاوز الأدوار إلى علاقات الحقول السرديّة.
خاتمة:
قصيدة «أُريدُ رَحيلاً لِهذا السَّوادْ!» هي نصٌّ مركّب—وجوديّ ووطنيّ، جسديٌّ ورمزيّ—يُقدّم تجربةً شعريّةً بليغةً عن استنفاد وسائل العزاء وعن الرغبة في الرحيل كخلاص. بالعمل عبر أدوات الهيرمينوطيقا والأسلوب والتحليل السيميائي لغريماس نكتشف لوحةً شعريّةً تتكوّن من جراحٍ جماعيّةٍ تُحوّل الشاعر إلى شاهدٍ، وإلى مبكيٍ ومُدَوِّنٍ لتاريخٍ لا يريد أن يُنسى. النصّ يدعونا، في النهاية، إلى أن نُسمع صرخته من غير صوت، وأن نُعيد التفكير في الرحيل كعمل مقاومةٍ وجوديّة.
***
بقلم: عماد خالد رحمة - برلين
............................
أُريدُ رَحيلاً لِهذا السَّوادْ!.
بقلم: أحمد يوسف داود
في هَزيعٍ من الوَحشةِ
الرُّوحُ تَصرُخُ من غَيرِ صَوتٍ
وتُلقي بِمِعطفِها جانِباً
كي تُضمِّدَ ـ عارِيَةً ـ ما تَرى
من جِراحِ البلادْ!.
*
أَعوَلَتْ بُرهَةً من فَجيعَتِها
إنّما الدَمعُ ماعادَ يَكفي الفَواجِعَ..
أنّتْ فَضاقَ الأنينُ بِها
فأقامَتْ على الحُزنِ مَخذولةً
في ثِيابِ الحِدادْ!.
*
يُرسِلُ اللّيلُ أقمارَهُ كي تُسامِرَها
فتُفيقُ مَواجِعُها:
كلُّ مافي فَمِ الأرضِ صَوتُ نَشيجٍ
فمَنْ سوف يَمسحُ أجْفانَها
كي تَذوقَ الرُّقادْ؟!.
*
يَستَحي قَمرٌ من مَباذِلِ ما يَدّعي
فيغيبُ على خَجلٍ والبَقيَّةُ تُغمِضُ..
والروحُ مَشغولةٌ بِأساها
يَفيضُ على لَيلِها مَطرٌ من ذُهولٍ
تَغّصُّ بهِ غَيمَةٌ من رَمادْ!.
*
لَمحةٌ من هَباءٍ تَمُرُّ بلا صَخبٍ..
كيف ضاق سَريرُ البُكاءِعلى دَمعِهِ
فتجَمَّدَ من حَسرةٍ؟!..
ياصَديقَ الخِياناتِ ياعُمرُ
هل ظلَّ للرّوحِ من فرحٍ قد يُعادْ؟!.
*
لاتُجِبْني فإني على قَلقٍ آمِلٍ..
(ماتَفتّحَ وَردُكَ يَوماً لأُبصِرَ أَلوانَهُ)
هكذا قالتِ الرُّوحُ لي فدَعَوتُ البَكاءَ..
ولكنّهُ راحَ يخدَعُني فأَلِفْتُ الخَديعَةَ
حتى تَصيَّدَ روحي السَّوادْ!.