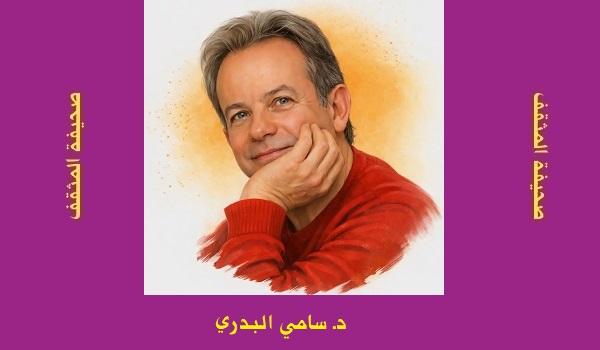قراءات نقدية
عماد خالد رحمة: دراسة نقدية تحليلية موسَّعة لقصيدة "أمشي بلا معناك"

للشاعرة: رجاء نور الدين
في فضاءِ الشعر المعاصر، حيث تتداخلُ الأصواتُ وتتشابكَ الرؤى وتتقاطعُ الأزمنةُ الداخلية والخارجية، تبرزُ قصيدة «أمشي بلا معناك» للشاعرة السورية رجاء نور الدين بوصفها نصّاً يتشكّل من طبقاتٍ عميقةٍ من الغياب والوعي والحنين، ويتأسّس على لغةٍ مشدودة إلى ذاتٍ تبحث عن معنى في ظلالٍ بلا ملامح. إنّها قصيدةٌ تنتمي إلى ذلك النمط من الشعر الذي لا يكتفي بالتعبير، بل يسعى إلى إعادة تشكيل التجربة الإنسانية عبر شبكةٍ من العلامات والرموز والتجليات الروحية، حيث يتحوّل الحب إلى طقسٍ تأويلي، والغياب إلى منهج قراءة، والذات إلى أفقٍ مفتوحٍ على احتمالات التأويل.
تأتي هذه الدراسة في محاولةٍ لتفكيك البنى النصّية والجمالية والرمزية التي تنتظم هذا النصّ، وذلك عبر مقاربة هيرمينوطيقية ـ تأويلية تتقاطع مع المنهج الأسلوبي والسيميائي، وتغوص في الأعماق النفسية والدينية التي تحكم حركة الصورة والخيال. فالنصّ هنا ليس مجرّد خطابٍ عاطفيّ، بل فضاءٌ يتنفّس لغته الخاصة، ويبني معماراَ دلاليّاً تُشارك القارئ في تشييده، ويستدعي في الوقت نفسه إحالاتٍ صوفية، ونداءاتٍ وطنية، وتعابير وجودية تجعل القصيدة أشبه برحلةٍ نحو الداخل، لا نحو الآخر وحده.
إنّ دراسة هذا النصّ ليست بحثاً عن إجابات، بل قراءةٌ لأسباب الأسئلة نفسها، ومحاولةٌ للقبض على تلك اللحظة الشعرية التي يلتقي فيها المعنى بمعناه الغائب، والذات بظلّها، والحلم بغصنه المعلّق في ليلٍ طويلٍ لا يَعدُ بفجرٍ إلا ليؤخِّرَه.
1. مدخلُ الدراسة وإطارها المنهجيّ:
تقع هذه القراءة في تقاطع مناهج: الهيرمينوطيقيا التأويلية التي تُفسِّح المجال لتعدُّد الآفاق التأويلية للنصّ، والمنهج الأسلوبي الذي يُحلّل اللغة والإيقاع والدوال البلاغية، والمنهج السيميائي الذي يحرّك النصّ كشبكة من العلامات والدلالات. كما نُضيف بعداً نفسياً وتحليلاً دينياً لِما تستثيره الصور من مشاهد داخلية، ونقرأ الأفق الجمالي والوطني كنطاقين يمسّان صيرورة المعنى وصدى النصّ في الفضاء الاجتماعي والثقافي.
2. قراءة إجمالية ـ الفكرة المحورية
القصيدة منظومة اشتياق متأمّلة عن الغياب والحضور، عن الجسد والذكرى، وعن السعي في مسارات فراغ لا تُملأُ إلاّ بشِقّ من نورٍ ساطع أو بظلّ يعود ليعيد تشكيل الذات. صوت الشاعرة رجاء نور الدين هنا سائر في عزلةٍ مضمّخة بالحزن الصوفي، يسوق الغياب كفاعلٍ مهيمن، ويحوّل الحلم إلى غصنٍ معلقٍ تنتظره المصادفة. ثيمة الرحيل والانتظار تتماهى مع مشهد دنيويّ/مقدّس: الفجر يُولَدُ من ظلمةٍ، والغياب يحفظ، واللقاء يبقى رهين صدفةٍ مؤجّلة.
3. الهيرمينوطيقا التأويلية: أفق النصّ والقارئ
١- بنية النفي والتأكيد: العنوان «أمشي بلا معناك» يدشّن نفياً يليه حضورٌ قلبيّ («والقلب يمشي وراك»)؛ هذا التناوب يُنتج شرخاً إشكالياً بين جسدٍ يمشي وذاتٍ لا تزال معلّقة بالحضور الداخلي.
٢- أفق التأويل المتعدّد: النصّ يستدعي قراءات شخصية (عاطفية)، صوفية (الغياب كطريق للتطهّر)، ووطنية/اجتماعية (الحنين كوطن داخلي). القارئ يُشارك في تهجّؤ الغياب عبر نصّ يُشركه في أداء لفظيّ ووجداني.
٣- التأويل كعملية فعلية: القصيدة لا توافق على معنى واحد؛ بل تُنشر احتمالاته: الغياب حافظ، الفجر ابن الليل، الحلم على غصن، كلها دعوات لتأويلاتٍ زمنية ومكانية.
4. التحليل الأسلوبي: اللغة، الإيقاع، الصورة
١- اللغة: بسيطة في مفرداتها، مركّبة في تركيبها؛ جملاً اتصالية متتابعة تُشكّل موسيقى داخلية. تُستخدم أفعال الحضور والغور (أمشي، يمشي، تهجِّي، اتعثرت) لتوليد حركة زمنية متواصلة.
٢- الصور البلاغية: استعارات مركبة («الغيب حفظني عن ظهر غيم»، «الابن الشرعي لليل المظلم») واستعارات محمَّلة بدلالات أخلاقية/وجودية. الصور هنا لا تزيّن فقط، بل تبني علائقاً دلالية: الغيب حافظ، الفجر مخلوق من الظلام، الغصن حامل حلم.
٣- الإيقاع والتكرار: تكرار فعل المشي/التحرّك يخلق إيقاعاً سيرياً، وتعاقب الجمل والتراكيب يشي بانسيابية الهمس لا بعنف الخطاب.
٤- التجريد والتشخيص: تحويل الغياب إلى فاعل («الغيب حفظني») وتشخيص الفجر كابن لليل يُمنح نصّاً أسطورياً.
5. العلامات والدوال الرمزية (سيميائية):
١- المشي/المكانة: «أمشي» دال على حركة الوجود وشروطه، لكنه هنا مشوّه بحضور داخلي لصوتٍ وذكرى؛ المشي بلا معناك يعني حركة بلا مشاة معنوي.
٢- القلب: هو دال مركزي للاتجاه الداخلي؛ يمشي وراء المعشوق كظلّ، منطوٍ على حيوية الوجد.
٣- الغيب/الغيم: الغيب هنا حافظ وساتر، و«ظهر غيم» يحيل إلى غطاء يقي من البوح، وفيه إيماءة دينية: الغيب كمصدر حفظ وإخفاء.
٤- الفجر/الليل: ثنائية كلاسيكية لِلانبعاث/الظلمة، لكن الفجر يُعطى هنا صفة «ابن شرعيّ للّيل المظلم»، مما يجعل النور نتيجة علاقة جنسية رمزية بين الظلمات، أي أن الولادة الذاتية للنور من الظلام مشوبة برحم تاريخي وجرح.
٥- الغصن/الندى/الطين/الإيقونة: الغصن موضع تعليق الحلم، الندى رمز رقة الشعر، الطين رمز تشكيل الوجود والوجه، والإيقونة رمز للتقديس الشخصي والذاكرة المحفوظة.
6. البنى النفسية: الاشتياق، الفقد، الهوية
١- الذات المتشقّقة: الشاعرة تقدم ذاتًا ممزقة بين حركة جسدية وصمتٍ داخلي؛ هذه الانقسامية تعكس بنية نفسية قوامها فقدان التكامُل واحتياج لتعويض.
٢- الحنين كهوية: الفعل الشعري هنا محاولات إبداع هوية عبر إعادة تشكيل الحبيب/الوجود داخل مشهد داخلي (تخزين العطر، عناق الشوق، نسيان الذاكرة عند أول محطة).
٣- الندم والذنب: إشارات مثل «المسلوب من كل ثمار الخطيئة» تقود إلى بنية نفسية مذنبة/مُغتصبة، حيث الضياع الجنسي/الأخلاقي يتحوّل إلى فقدان الثمار والوفرة.
7. البعد الديني والطقوسي:
١- مجازات دينية: الغيب والحفظ والليل والفجر، كما وصف «الابن الشرعي للّيل المظلم»، تستحضر لغة توريات/قرآنية في معرضها الرمزي؛ الفجر رمز للقيامة والولادة، والغيب سلطان الحفظ الإلهي.
٢- الطابع الصوفي: «بقلبٍ صوفي حزين» صراحةً تُعلن انزياح النصّ إلى ذوق صوفي حيث الحبّ تجربة تطهيرية؛ الشوق هنا ليس شهوة فقط بل رحلة تزكية.
٣- الإيقونيات والقداسة: تحويل الوجه إلى «أيقونة» يعني تقديس المحبوب وتحويل ذاك الوجه إلى رمز عبادة شخصية داخلية.
8. البعد الوطني والاجتماعي (قراءة استعاريّة)
رغم أن النص شخصي، إلا أن ثيمات الغياب والبحث والفقد يمكن قراءتها تعبيرًا عن فقدان أوسع — وطنٍ أو ذاكرة جماعية. تعليق الحلم على غصن وانتظار مصادفة اللقاء قد يرمز إلى أملٍ وطني يتأرجح بين احتمالات العودة والفرص الضائعة. كذلك «المسؤول من كل ثمار الخطيئة» قد يُقَرأ كشعور مجتمعي بالمسروقات أو الضياع الأخلاقي في سياق تاريخي.
9. القراءة التفصيلية سطرًا سطرًا (مقتطفات محورية):
«أمشي بلا معناك / والقلب يمشي وراك» — افتتاحية تشدّ التنافر بين الفعل والمشاعر؛ الحركة البدنية بلا مرافق روحي
«الغيب حفظني عن ظهر غيم / فكان لي أن أتهجى الغياب» — الغيب يحمي ويغطي؛ الشاعرة تتعلم تهجّي الغياب كحرفٍ لغوي.
«ليدركني الفجر ذاك / الابن الشرعي لليل المظلم» — الفجر يُؤنسَب بعلاقة قرابية للّيل، هنا ولادة النور من رحم الظلمة.
«فلا منديل يجفف دمعه / ولا يد تربت على غصنه» — عزلة كاملة؛ لا عزاء. الغصن الذي يبكي لا يجد مواساة.
«المسلوب من كل ثمار / الخطيئة» — شعور بالاغتصاب الأخلاقي أو الحرمان من الثمار نتيجة فعلٍ ما۔
«ولأني اعرف اسمي / تعثرت بالضوء» — معرفة الاسم ليست قوة كاملة؛ المعرفة تحمل مسؤولية تُعرّض للارتطام بالضوء/الحقيقة.
«من رياح طرقت باب / القلب ولم تستأذن العبور» — العبور العاطفي/القسري؛ الاندفاع العاطفي كشرفٍ للهجوم على المساحة الشخصية.
«رسمت ظلك مدداً / ضمخته بكل عطورك / التي سكنتني» — تشخيص الفقد وتحويله إلى حضورّ محنّط في العطر والظل.
«كمولوي يستجدي الهواء / بين كفيه ولا يمسكه» — صورة متألمة للعدم؛ اليد التي تريد الإمساك بالهواء لا تملك شيء.
«كمرأة باتت تنسج الندى / لترشه على وجه الصباح» — امرأةٌ كائنة من رقة الندى، تقوم بصنع صباحٍ جديد من هباتها.
10. المستوى الجمالي واللغوي: الخلاصة الفنية
القصيدة تعمل بجمالية المعنى المركب: لغة لا تهرول نحو البلاغة المزخرفة، بل تُنقّب عن صرامة الصورة ودفء الإيقاع. استخدام الاستعارة المكدسة (الغيب، الفجر، الغصن، الأيقونة) يمنح النص عمقًا أيقونيًا يجعل كل صورة بوابة لتأويل آخر. الجمالية هنا هي جمالية الحزن المتفرد، التي تجمع ما بين اللغة الكلاسيكية والروح المعاصرة.
11. المقاربة البنيوية والنقدية: نقاط القوة والمواضع الممكن تنميتها
نقاط القوة: صور مكثفة ومترابطة داخليًا.
صوت شاعري ذي طاقة تأملية صوفية وحسيّة في الوقت نفسه.
استثمار ثنائيات (ضوء/ظلام، غياب/حضور) بذكاء دلالي.
ما يمكن تعزيزه:
توسيع مشهد السرد ليوضح بعضاً من السياق (هل الغياب مرتبط بشخص بعينه أم بفكرة/مكان؟) دون فقدان الغموض المنتج.
تقطيع إيقاعي قدّم بعض الانقطاع المفاجئ بين الصور؛ ضبط إيقاعي طفيف قد يثري الوحدة الموسيقية للنص.
12. إمكانات تأويلية ومقارنة نصّية:
١- قراءة صوفية: الحب كطريق تزكية، والغياب كحجاب ثم تمهيد.
٢- قراءة نفسية: الغياب يتصرف كصدمة بطارية تُعيد ترتيب الذاكرة.
٣- قراءة وطنية: الحنين إلى وطن مفقود تُضمره صور التعليق والانتظار.
٤- مقارنة: يمكن وضع النص جنبًا إلى جنب مع شعرية نازك الملائكة أو ماريانا بونيفاسيو في استثمارها لثنائيات الضوء/الظلام وعدّة صور الأيقونة، لبيان خصوصية الأسلوب وعمقه.
13. خاتمة: ما تقدّمه القصيدة لفضاء الشعر المعاصر «أمشي بلا معناك» نصّ يختصر تجربة إنسانية مشتركة: أن يمشي الجسد وتبقى الذاكرةُ جاثية، أن يولد الفجر من ليلٍ شرّ، وأن يبقى الحلم معلقًا على غصن المصادفة. رجاء نور الدين تُقدّم صوتاً شاعرياً حافظاً لمعاجم الرموز الكلاسيكية، لكنّه معاصر في حسّه الوجودي والاجتماعي. القصيدة تمثل نموذجاً لقصيدة ذاتيّة متأنّية، قادرة على فتح آفاق تأويلية واسعة بين الصوفية والسياسة والنفسية.
***
بقلم: عماد خالد رحمة - برلين
...........................
أمشي بلا معناك والقلب يمشي وراك
الغيب حفظني عن ظهر غيم
فكان لي أن اتهجى الغياب
ليدركني الفجر ذاك
الابن الشرعي لليل المظلم
فلا انسى ان أغلق الفجر خلفي
لتبقى حبيس دهر
يبكي غيمه وحيداً
فلا منديل يجفف دمعه
ولا يد تربت على غصنه
المسلوب من كل ثمار
الخطيئة
ولاني اعرف اسمي
تعثرت بالضوء
وتهجيت السكون صدفة
من رياح طرقت باب
القلب ولم تستأذن العبور
دخلت ترسم تفاصيل شوق
يرتل عطر الغياب
ترشقه على عبورك الفضفاض
علَّ الريح تمشط شعرَ اللقاء
وترميه من شرفة معلقة
مابين صدري وراحتيك
ولكنهم أبوا
إلا أن يتركوا المساحة
للصدفة
وبقلبي الصوفي الحزين
رسمت ظلك مدداً
ضمخته بكل عطورك
التي سكنتني
وعانقت الشوق فيك
كمولوي يستجدي الهواء
بين كفيه ولا يمسكه
*
كامرأة باتت تنسج الندى
لترشه على وجه الصباح
وتعجن الطين بريق وجهك
وتخبئه في ايقونة
نسيت ذاكرتها عند أول
محطة عبور
ولأنها سيدة الغياب
علّقت حلمها على غصن
علّه يصادفُ
شوقكَ
يوماً
***
رجاء نور الدين