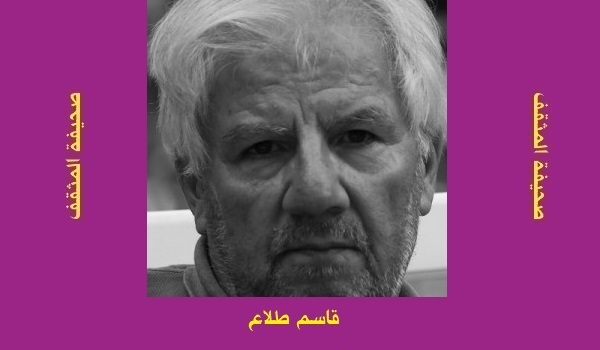شهادات ومذكرات
محمد رضا عباس: هل نحن أمة لا تقرأ؟

تفكيك خطاب جلد الذات في ضوء وفرة المكتبات وتنوع المصادر
منذ صباي وأنا قارئ نهم، تستهويني الكتب وتسحبني مجلات "مجلتي" و"المزمار" إلى المكتبة العامة في بلدتي الصغيرة وأنا عائد من مدرستي الابتدائية، ألتهمها من الغلاف إلى الغلاف. لم أكن أكترث كثيراً للأدب، ولكني كنت أقرؤه رغماً عن ذلك ربما لأن الكتب السائدة آنذاك (وإلى الآن... ربما) هي كتب الأدب والسياسة والتاريخ. ورغم حبي للكتب إلا أنني وجدت نفسي أبتعد عنها حيناً وأقترب حيناً آخر. ربما لانشغالي (وهو أمر أستبعده) أو بسبب النوع المتوفر. وهو ما يسمى في علم الاجتماع بالتنوع البيبليوجرافي Bibliodiversity. فالقراء كالعشاق؛ مذاهب، ولربما كنت (ولم أزل) أميل للعلوم والتكنولوجيا لا للأدب والتاريخ. ومن هنا سأبتدئ رحلة بحثي في مقالي هذا.
فالقراءة في بلادنا نخبوية بامتياز. لم تنجح مكتباتنا (الفقيرة والقليلة) أن تكسر حاجزه نحو الفعل الاجتماعي، لأنها ببساطة لا توفر سوى طيف ضيق من الكتب الفلسفية والدينية والتاريخية ولربما (النمطي) من الكتب اللغوية ناهيك عن الأدب (الكلاسيكي حد النخاع). وحتى في أكثر الكتب تداولاً في مكتباتنا: الأدب، لن تجد على الرفوف سوى الأدب الذي كان يقرأه قراء الخمسينيات من القرن المنصرم. فأنت لن تجد بسهولة كتب هاروكي موراكامي، أو إليف شافاق، أو خوسيه ساراماغو لكنك ستجد بالمقابل كتب دوستويفسكي وغابرييل غارسيا ماركيز وفرانتس كافكا، وأنا هنا لا أنتقص من قدر هؤلاء الكتاب العالميين وإنما أضرب بهم مثالاً لشحة التنوع وهيمنة النمطية حتى أنك تحس أننا نستنسخ القراء لا ننتجهم. فأنت بكل تأكيد لن تجد بسهولة كتباً علمية تتحدث عن آخر استخدامات ميكانيكا الكم في التكنولوجيا أو النظريات الأحدث في القانون أو كتباً في الكيمياء تبني أساساً للنشء المهتم بهذه التخصصات. وحيث أن الأبحاث تؤكد (مثل دراسات ستيفن كراشن وغيره) أن "الوصول الحر" (Free Voluntary Reading) في بيئة غنية بالكتب هو المتنبئ الأقوى بالكفاءة اللغوية والعادة القرائية، أكثر من التعليم المباشر. يرى الكثيرون أن الشحة هي النتيجة وليس السبب فالمكتبة تجلب ما يرغب القراء فيه أو ما يشترونه وهنا لا بد أن أشير إلى أن الأمر يمكن أن يقرأ بالاتجاهين معاً.
خلال رحلتي في الدكتوراه مررت بتجربة جميلة وددتُ أن أحكيها كلما أتيحت لي الفرصة. ففي جامعتي (في ماليزيا) وجدت المكتبات منتشرة بشكل ملفت وكانت إحداها (وهي مكتبة قراءة لا استعارة ولا شراء) مكتبة تفتح لـ ٢٤ ساعة للطلبة داخل الحرم الجامعي، وكان جوها غريباً بحيث تفقد فيها الإحساس بالوقت. كان ذلك الجو مصداقاً لقول أمير المؤمنين (ع): "الكتبُ بساتينُ العلماء"، فكأننا كنا في نزهة عقلية لا تنتهي بمعزل عن ضجيج العالم.
ذهبت مع صديقي إليها لندرس واتفقنا أن يجلس كل منا على منضدة مختلفة وبدأنا بالقراءة وبعد عدة ساعات حاولت التواصل مع صديقي بالإشارة ففشلت، كتبتُ له لكنه لم ينتبه لرسائلي فاضطررت أن أتصل به اتصالاً فانتفض وألغى الاتصال فكتبت له وتحدثت عن ضرورة أن نذهب للغداء فاستهجن قولي كوننا (في الصباح الباكر) فضحكت وقلت له انظر إلى الساعة. ما إن نظر إلى الساعة حتى أتاني مسرعاً. أو ما قاله هو: ما هذا المكان "هل يرشون شيئاً ما؟" طبعا قد يظن القارئ أن صديقي هذا ربما يكون قارئاً نهماً وهو في الحقيقة شخص لا يستطيع الصمود في مكان لساعة واحدة وينظر عادة إلى موبايله كل دقيقة. رجل منهمك اجتماعياً لا يحب الهدوء. لذا فإن أول رد فعل صدر عنه كان ظنه أن المكان فيه شيء مختلف. في الحقيقة أن ما قاله صديقي لم يكن خاطئاً (طبعاً باستثناء رشهم لعقار ما). فالجو الهادئ الذي توفره المكتبة لا يمكن أن يشبهه شيء آخر. وقد أرى ابتسامة على وجه أحد القراء الآن لأن القراء يعرفون بالضبط ما أعني.
مكتبات جامعتي لم تكن عظمة هندسية وإنما بنايات متعددة الطبقات فيها ما لذ وطاب من الكتب في شتى الاختصاصات. الوقت فيها شبه مفتوح، فمن المكاتب التي تفتح من السابعة للسابعة إلى المكتبات التي تفتح ٢٤ ساعة في اليوم في ٣٦٥ يوماً في السنة. مكتبات تقسم إلى درجات بحسب الصمت المطلوب، فهنالك أماكن يمكنك الحديث بها بهدوء وهنالك مجال الصمت (Silent Zone) وفي داخل هذه القاعات المعدة للصمت ترى كابينات مغلقة لشخص أو أكثر تعزل الداخل إليها عن العالم.
هذه المكتبات وفرت جواً لا يمكن أن توفره المنازل الفاخرة، فحتى القارئ الذي يمتلك مساحة ممتازة للقراءة (وأنا منهم والحمد لله) سوف يفتقد ذلك الجو الذي تتقاطع به موجات القراء الدماغية بتناغم عجيب مكونة بيئة تحثك على الاستمرار. بيئة لا يستطيع الملل أن يتخللها. أقول هذا لأنني قضيت فيها مئات الساعات. كنت أحياناً أقرأ فيها لما يزيد على ١٥ ساعة. وهنا أضع تساؤلي الآتي: لماذا لا نمتلك مكتبات شبيهة بهذه المكتبات؟ لماذا يشعر الطالب في جامعاتنا بالرغبة الشديدة في مغادرة كليته أو جامعته؟ لماذا لم تستطع الكافيهات الضخمة المبهرجة أن تفكك ملله؟ ولماذا نهتم بالأساس بالكوفي شوب (أو النادي الطلابي على زماننا) ولا نهتم ببناء المكتبات؟ لماذا كليتنا فيها مكتبة لا تكفي لعشرين طالباً بينما تكفي قاعة المطعم (أو سمه ما شئت) لمئات الطلبة؟ هل هو الاستثمار قصير الرؤية؟ أم هو نزول عند رغبة الطلبة؟ هل لأن طلبتنا أمة لا تقرأ أم لأننا أمة لم توفر المكتبات ولم تهتم بالتنوع الحقيقي للكتب؟ كل هذه التساؤلات تجيبها الظاهرتان الآتيتان:
الظاهرة الأولى: السوشيال ميديا في العراق
يستخدم العراقيون السوشيال ميديا لساعات طويلة يتعلمون ببعضها ويستمتعون ببعضها ويضحكون في البعض الآخر، ولو دققنا لوجدناهم قارئين نهمين لكنهم فضلوا المكتبات التي توفرها الشاشات الصغيرة بأسلوب تفاعلي على القراءة التي خنقتها النمطية التي ترى القراءة حكراً بالكتب الدينية والتاريخية والأدبية والفلسفية الكلاسيكية حصراً. فمكتبات السوشيال ميديا ترضي فضولهم في تخصصات عدة. فالمحب للرياضة سيجد محتوى يراه أو يقرأه وهو محتوى حديث جداً وكذا من يحب العلوم فستراه يركن إلى الدحيح أو حسينولوجي لأنه وببساطة لا توجد في مكتباتنا كتب تغطي هذا التنوع والحداثة. هذا النزوح نحو الرقمية لم يكن ترفاً، بل هو لجوء اضطراري؛ فالعراقي لم يترك الكتاب لأنه يكره الورق، بل لأنه وجد 'المعلومة الحديثة' في اليوتيوب ولم يجدها في المكتبة التقليدية، وإن وجدت محتوىً تحبه فستجده على غرار (تعلم ويندوز XP)، كتباً قديمة لم تعد تستحق الورق الذي طبعت عليه.
الظاهرة الثانية: مكتبات الصين
طورت الصين مكتباتها بحيث أنها أصبحت مكتبات تضم تنوعاً قل نظيره، مكتبات ضخمة إلى الحد الذي احتاجت به إلى أذرع روبوتية ضخمة تجلب الكتب لطوابير القراء الذين ينتظرون دورهم ليحصلوا على ما يشاؤون من كتب. هذه بالطبع ليست كتباً كلاسيكية أو عناوين نمطية فقط إذ طبعت أكثر من ١٨٠ ألف عنوانٍ سنة ٢٠٢٣ وارتفع العدد إلى ١٩٢ ألف عنوانٍ جديداً في سنة ٢٠٢٤. نعم نحن نتحدث هنا عن العناوين الجديدة بين ما تم تأليفه في الصين وما ترجم من لغات أخرى. إنها أشبه بثورة مجنونة لم يشهد العالم مثلها على مر العصور. وهنا تتبادر إلى الذهن أسئلة على غرار: هل هم أمة تقرأ مقابل أمتنا التي لا تقرأ؟ هل هم يفكرون كما نفكر؟ ولماذا لا نفكر مثلهم؟
وبعيداً عن جلد الذات المعهود بحثت عن إجابات لهذه الأسئلة ووفقت للآتي والذي لا أزعم تطابقه الكامل مع الواقع بل أدعي (وبكل ثقة) أن جزءاً كبيراً منه أصاب كبد الحقيقة:
أولاً. النوع الذي يؤدي للوفرة
ما يميز القارئ الصيني ليس الوفرة فحسب (نسبة القراء في الصين بلغت ٨١.٩ بالمئة من البالغين و٨٦.٢ ممن هم دون سن ١٨ عاماً لسنة ٢٠٢٣) وإنما النوع فهذا العدد الكبير من القراء تقابله ملايين العناوين المتاحة بكل المجالات التي يتخيلها العقل. تخيل عزيزي أن مواطناً صينياً قرر أن يعمل في مجال ما فلنقل الطباعة ثلاثية الأبعاد. كل ما عليه هو أن يذهب للمكتبة ويقتني بعض الكتب المتخصصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد وينهمك بقراءتها إلا أن يشبع شغفه بهذا التخصص الجديد عليه. في المقابل يفكر شاب عراقي بالعمل في المجال نفسه، لن يفكر بالذهاب إلى شارع المتنبي ليقتني بعض الكتب حول الطباعة ثلاثة الأبعاد وإنما سيبحث في يوتيوب بين أكوام المعلومات (الغث والسمين) وسيحاول شراء (أو تحميل) كتاب أو اثنين حول الموضوع (هذا إن حالفه الحظ وعلم بأمر هذه الكتب، وبالطبع لن يجدها مترجمة لغته الأم وإنما سيعاني من أجل ترجمتهما. هذا إن حالفه الحظ ولم يصبه الإحباط وهو يحاول.
ولن تقتصر رحلة القارئ الصيني طبعاً على الكتب التي جاء ليستعيرها لأنه قد ترد أمام عينيه كتب في تخصصات مختلفة تقلب تفكيره أو على الأقل تحفزه ليقرأ في مجال آخر وهو ما يطلق عليه التلقيح المتبادل للأفكار (Cross-Pollination of Ideas). وهذا الأمر هو عينه الذي جعل ستيف جوبز (Steve Jobs) يصمم خطوط "الماك" الجميلة إذ لم يكن ليصممها لولا أنه حضر دروساً في "الخط العربي واللاتيني" (Calligraphy) وهي بعيدة عن التكنولوجيا. إذن المكتبة المتنوعة هي التي تخلق هذه الفرص وبالتالي تولد القراء.
ثانياً. جو القراءة ومثال مكتبة الـ ٢٤ ساعة
ومن هنا تصبح الإجابة على سؤالنا الأول واضحة. نحن لم نرغب في الابتعاد عن القراءة وإنما ظروفنا وقلة فرصنا هي التي أبعدتنا. وحتى لو أننا وصلنا بشكل ما كتاب وهممنا بقراءته فسنبحث عن مكان هادئ لنقرأه به وبالطبع لن يكون هذا المكان مكتباتنا العامة ولا مكتبات كلياتنا. ربما سنحاول أن نقرأ باستخدام موبايلنا بضعة سطور في الكوفي شوب قبل أن يخترق صمتنا النادل بأسئلته التجارية المعهودة أو صديق رآنا من بعيد فأحب اقتحام خصوصيتنا، أو حفلة عيد ميلاد أو لعبة لكرة القدم رفعت سماعات التلفزيونات إلى مستوى تصبح القراءة فيه مستحيلة. كما أننا لن نستطيع بأية حال من الأحوال أن نتمشى إلى مكتبة كليتنا بعد انتهاء الدوام الرسمي لنصرف بعض الوقت في القراءة ببساطة لأن مكتباتنا تفتح أوقات الدوام فقط. وأتذكر أنني اقترحت يوماً ما على عميد كليتنا في جامعة بغداد أيام البكالوريوس أن تمدد أو تغير المكتبة أوقات دوامها لأننا ننهي محاضراتنا الساعة الثانية ظهراً والمكتبة تُغلق أبوابها قبل هذا الوقت أصلاً. فما كان منه إلا أنه أبدى إعجابه بالطالب الذي يفكر بالمكتبة لكن هذا الإعجاب لم يترجم بأرض الواقع إلى أي قرار ملموس ولربما كان في قرارة نفسه يضحك على سذاجتي. فنحن أمة تهرع راكضة إلي البيت عند انتهاء الدوام مباشرة (وأحياناً كثيرة قبل ذلك بكثير). والدوام الإضافي أو المسائي كان نكتة آنذاك. ولا أدري لو أن العميد في حينه فكر خارج الصندوق وأتاح المكتبة خارج أوقات الدوام الرسمي، لا أدري لربما كانت الأمور على غير حالنا اليوم.
أخيراً. قد يكون بعضنا يستحق كلمة (أمة لا تقرأ) لكن غالبيتنا كان يمكن أن يقرأ لو أتيحت له فرصة القراءة، لو توفرت له مكتبة بدوام مضاعف، لو وجد كتباً في التخصص الذي يحبه. نحن إذن ضحية أكثر من أن نكون جناة. كان يمكن للحكومات أن تستثمر ببنايات مكتبات على الطراز الحديث، مكتبات ربحية باشتراكات معقولة، مكتبات توفر تنوعاً حقيقياً ومكاناً يجد فيه القراء السلام والجو الملائم للقراءة ولربما جاعوا فأكلوا في مطاعم هذه المكتبات، أو قرروا أن يحتسوا قهوتهم من إحدى أكشاكها لتصبح استثماراً للإنسان وللمال لا للإنسان فقط. حين ذاك فقط ستنطلق حركة التعريب التي سيطالب بها القراء، وحينها فقط - وليس الآن - يحق لنا أن نقرر بإنصاف: هل نحن أمة تقرأ أم لا.
***
محمد رضا عباس يوسف - باحث أكاديمي
كلية الإمام الكاظم