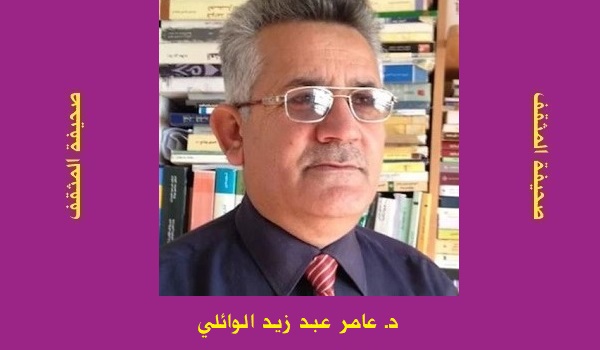قراءات نقدية
عماد خالد رحمة: دراسة نقدية تحليلية موسعة لقصيدة "الظل والقرين"

قصيدة «الظل والقرين» لفاطمة معروفي نصّ غنيّ بالإيحاءات اللونية والرمزية، وتمرّ من صور انفعالية إلى مشاهد أسطورية وفلسفية تبدو فيها الذات المتألمة منقسمة بين قطبين: ظِلٍّ باهتٍ/مكبَّلٍ وقرينٍ ثائرٍ/نارٍ. هدف هذه الدراسة أن تقرأ النص قراءة هيرمينوطيقية-تأويلية متداخلة مع مناهج أسلوبية، رمزية، سيميائية، ونفسية ودينية، للكشف عما «تحت الجلد» من نبضٍ وتوترٍ ورمزٍ، ومن ثَمّ الوصول إلى قراءة متعددة المستويات للمعنى والوظيفة الشعرية.
1. مستوى القراءة الحرفية والهرمينوطيقية: الفهم الأولي والتأويل.
على مستوى السطح، القصيدة تطوى صورة ذاتٍ تواجه حالة صمت ضوضائيّ، وشدّة داخلية تُترجَم بتناوب ألوانٍ وعناصر (زرق، أحمر، نار، زمهرير، غمام أحمر). هرمنوطيقياً، النص يستدعي سؤال القراءة: من يتكلّم؟ ما مرجعية «القرين»؟ هل هو جزءٌ من الذات أم كائن خارجيّ؟ التأويل الأولي يميل إلى قراءة ثنائية: «الظل» رمز للامتلاك/الجمود/الصمت، و«القرين» رمز لقوى الانفعال والغضب والأثر الماضوي الذي يختزن جرحاُ، الحركة داخل القصيدة تبدو رحلة انصهارٍ ومحاولة تحويل الألم إلى فعل (حمل الكأس، الإبحار، الزراعة)، وهو تحويلٍ رمزي يعني رغبة في معالجة الجوع الأخلاقي والروحي بالعطاء/التغذية.
2. البنية اللغوية والنحوية: من اللغة إلى النحو.
التراكيب والأسلوب: تتوالى الجمل بين الجملة الاسمية والمقاطع الجملة الخبرية المختزلة: «ضوضاء الصمت...... / من حولي تكبل نقطي» — استخدام الفعل «تكبل» (نحو مفعولي) يوحّي بالقيْد الجسدي للنَّقطة الصغيرة (النفس). التقطيع النحوي، بالتناوب بين مقاطع قصيرة وطويلة، يخلق إيقاعًا ينفخ في النص توتّراً.
-المفردات والموسيقى الداخلية: المفردات مركّبة بين شفافة ومجازية: «نقطي»، «القدر الموشومة»، «قزح»، «الزرقاء»، «إعصار أحمر»، «زقوم». ثنائية الصوت (الحروف الحلقية والوقفات) تُنتج توقّفًا دراميًا في أماكن محورية (مثلاً بعد «تؤرقني غفوة........تؤرقني ذكريات...»).
-الضمائر والمرجع: المتكلم «أنا» يصبح مرجعًا مركزيًا لكن النص يحتفظ بغموض «القرين» و«الظل»؛ هذا الغموض المنظور يفتح المجال للتأويل النفسي والاجتماعي.
3. الإيقاع، الوزن، والقافية:
القصيدة لا تلتزم بنظام بحري كلاسيكي واضح؛ هي أقرب إلى الشعر الحرّ/التفعيلة المعاصرة حيث يُستغل التقطيع والوقفات لإنشاء إيقاعات داخلية:
- التكرار الصوتي (مثل تتابع حروف «ت-ق-ل» في «تَكْبِل/تَتَمَسَّح/تَتَخَلّل») يعطي إيقاعًا انسداديًا يوازي محنة السارد.
- التكرار الدلالي («تؤرقني...تؤرقني») يعمل كوسيلة عراقية لزيادة شدة الانفعال.
- غياب قافية موحَّدة يُركّز الانتباه على التوحيد اللوني والدلالي بدلاً من الإيقاع القافي.
4. البنية الرمزية واللونية (الألوان والأنماط الرمزية)
- الألوان في النص ليست تلوينًا تجميليًا بل رموز وظيفية:
١- الأزرق (الروح الزرقاء، جوف الروح الزرقاء): أقرب إلى الكآبة، الحزن، الروحانية، أو حالة الامتلاء الداخلي التي تخترقها غيومٌ من غضب.
٢- الأحمر/النار/الإعصار الأحمر/الغمام الأحمر/زقوم: لون العنف، الغضب، الشغف، وربما العنف السياسي/الاجتماعي. استخدام «زقوم» حَمَلَ دلالةً دينية/قرآنية—وهو نبات العذاب في القرآن—وبالتالي يُدخل بعدًا عقائديًا عن العقاب والجوع والعدمية.
٣- الأخضر (كف البساط الأخضر/دروب اليقظة): دلالةُ أملٍ أو حياة أو أرض، لكن هنا يبدو الأخضر كمرجعية للتوازن بعد انفجار الغضب.
- الظل والقرين: الظل كموازة أو قيد، والقرين كمرافقة لا مفر منها — مفهوم القِرِين في التراث يمكن قراءته كالنفس الثانية أو الشيطان المرادي أو النديم — وهذا يثري تعددية الدلالة.
5. البُعد النفسي: صراع الذات والذاكرة والجروح
النص يحتوي على توترات نفسية واضحة: «ذكريات ماض وحاضرسقيم / لا زال حنقه يغزو وشم غائرا» — هذا يشير إلى جرح قديم مستمرّ التفاعل مع الحاضر.
«القرين» هنا يمكن أن يُقرأ من منظور فرويدي/يونغي: كظل يونغي (Shadow) يحمل الاندفاعات المكبوتة، أو كقرينٍ يرمز إلى الجزء اللاواعي/المحرَّم في الذات. الصراع بين الظل والقرين قد يصبح صراعًا داخليًا بين قِيم/ذاكرة مضطربة ورغبة في التطهير/التحرك.
- الفعل الرمزي «أحمل كأسي...وأنطلق لأبحر بسفينة» قد يمثل محاولة للشفاء عبر الفعل أو التضحية أو الرحلة العلاجية.
6. البعد الديني والتراتبي: إشارات قرآنية وأساطير أخلاقية
استخدام «زقوم» مباشرة يفتح النص إلى شبكة من الإشارات الدينية: النبات المعذِّب في الآخرة، مرتبط بالعقاب والجوع الأخلاقي. إدماج هذا المصطلح لدى الشاعرة ليس مصادفة بل استدعاء منظومة قضائية/أخلاقية كبرى تُدِين أو تُحاكم الفعل الاجتماعي.
«موطنها دم يسيل»: هذه العبارة تُحيل إلى مظالم تاريخية أو نكبات تحدث في عالم الحياة، وتربط البُعد الديني بالمأساة الوطنية أو الجماعية.
- التزاوج بين رمزية دينية ولونية (أحمر/نار/زقوم) يجعل النص يتحوّل إلى نص نبوئي/تأملي يحاكم واقعًا أخلاقيًا.
7. البُعد السيميائي: العلامات والرموز كأنظمة دلالة
نستخدم هنا ثلاثة مستويات سيميائية:
1. العلامة الدلالية (المعنى المباشر): كلمات مثل «نقطي»، «كأس»، «سفينة»، «غضب»، «زمهرير» تشير مباشرة إلى عناصر ملموسة ومجازية.
2. الرمز كنظام ثقافي: «زقوم» كرمز ديني، «قرين» كرمز تراثي/أسطوري، و«الظل» كرمز فلسفي (الوجود واللاوجود).
3. الإيقاعات البصرية والصوتية كرموز تصميمية: التقطيعات والوقفات والفواصل (........) تعمل كإشارات للتوقُّف والاختناق والبحث عن نبرة صوت داخلية.
اللغة هنا تعمل كنظام سيميائي متعدد الطبقات؛ لا تُشير إلى حالة واحدة بل تکوّن حقلًا دلاليًا يطال المتلقي لإعادة بناء معنى مركب.
8. البُعد الوطني/الاجتماعي: قراءة سياسية ممكنة.
على الرغم من أن النص لا يذكر أسماءاً سياسية، فإن ثنائية «موطنها دم يسيل / كيسول متدفقة / نحو صراخ السماء» تفتح الباب لقراءةٍ وطنية أو اجتماعية:
يمكن أن تُقرأ الصور الأخيرة كاستنطاق للواقع السياسي/الاجتماعي: شعب جائع/مُدَمَّر، أرض ممتلئة بالدم، و«صراخ السماء» كدعاء أو نداء أخلاقي.
«أطعم بها أفواها وبطون جائعة» يضع السارد في موقع منقذ أو مُعالج، أو على الأقل رؤيا ترتبط بمسؤولية إنسانية/وطنية تجاه الجوع والظلم.
9. الأسلوبية والاشتغال البلاغي: استعارات، تكرارات، وتناصّ
- الاستعارة المركبة: «تنهيدة فضية الحمم» — جمع بين سِلمين متناقضين (الفِضي النقي والحَمَم الملتهبة) لخلق صورة متنافرة تؤكد ازدواجية المشاعر.
- التناصّ: استحضار «زقوم» يخلق تداخلاً مع نصوص دينية/أدبية سابقة، مما يُكسب النص ثقلًا ثقافيًا ودينيًا.
-التكرار: يُستخدم لتعميق الانفعال «تؤرقني...تؤرقني»، ويعمل كرؤية إيقاعية داخلية.
10. الصوت: المتكَلِّم والصوت الشعري والمرجعيات
الصوت الشعري هنا صوت متأمّل ولو أنثوي في شكله الدلالي؛ لكنه لا يغلق الطريق أمام قراءات متعددة، إذ إن «القرين» و«الظل» يمكن أن يكونا شخصين خارجيين أو جوانب من الذات. التناوب بين النبرة الشكوكية والنبرة الفاعلة (حمل الكأس والزرع) يكشف عن وعي شعري يسعى للتغيير عبر الفعل.
11. التوترات الجمالية: بين التجريد والتركّز الاجتماعي
النص يتأرجح بين:
- التجريد الرمزي والفلسفي (الظل، القرين، الروح الزرقاء)،
- والحمولة الاجتماعية/الوجودية (الجوع، الدم، الزقوم). هذا التراكب يجعل النص غنيًا لكنه أيضًا يطرح تحديًا للقراءة: فهل التركيز على القبض النفسي أم على الحكم الاجتماعي؟ الجواب: كلاهما، بطريقة تكاملية تجعل القصيدة عملًا متعدد المعاني.
12. قراءاتٍ بديلة وأسئلة بحثية:
- قراءة يونغية مفصّلة: هل يمثل «القرين» الظلّ الجمعيّ؟ وما علاقة ذلك بالذاكرة الجماعية (الحنق/الوشم الغائر)؟
- قراءة تاريخلية/سياسية: هل «موطنها دم» إشارة إلى حدث تاريخي معيّن؟ كيف يتحول الفرد المؤلم إلى مرآة لوجع الأمة؟
- بحثٌ في الدلالة الدينية: استخدام «زقوم» و«الكأس» والـ«سفينة» — هل هناك استعارات فاضلة من النصوص المقدسة أو التراثية يمكن ربطها بالسرد الشعري الحديث؟
13. الخلاصة: قراءة مُركّبة:
«الظل والقرين» قصيدة تعدُّ فضاءً تأمليًّا مركبًا: هي نصّ صراع داخلي، لكنها في الوقت نفسه مرآة لألم جماعيّ/وطني. الشاعرة توظف مجموعة من الرموز اللونية والدينية واللغوية لبناء سردٍ شعري يحوّل الصراعات النفسية إلى مشاهد أخلاقية وسياسية. فناً، تُظهر القصيدة قدرة على المزج بين العمق العاطفي واستدعاء التراث والرموز، مما يجعلها قابلة لقراءات متعددة وغنية لمختلف المناهج النقدية.
***
بقلم: عماد خالد رحمة - برلين
.......................
الظل والقرين
ضوضاء الصمت......
من حولي تكبل نقطي
تمسح من على الجبين قطرات
القدر الموشومة
بين الظل والقرين
*
تنهيدة فضية الحمم
تشد وثاق الروح
تتملك سلاطين قزح
صلبة الصلب المائي تعبر بالمسير نحو الأسير
تؤرقني غفوة........تؤرقني ذكريات ماض وحاضرسقيم
لازال حنقه يغزو وشم غائرا
بجوف الروح الزرقاء
يتخللها إعصار أحمر
يسقي مارجا من نار
*
لينطفئ الغضب ....
الساطع بكف البساط الاخضر
ودروب اليقظة والحلم
حروفا وأرقام ........
تهوى من الأعالي
مكسورة المشكاة
تصارع قيود الذات الزائلة
تبقى معلقة
بين الشهيق والزفير
بين النار والزمهرير
*
لأحمل كأسي .......
الممتلئ حروفا نارية
وأنطلق لأبحر بسفينة
من الغمام الأحمر
أزرع فيها روضة شجر من زقوم
أطعم بها أفواها وبطون جائعة
*
لا تكتفي بتراب الأرض
بصرها ثاقب جشعها كاسر
موطنها دم يسيل
كيسول متدفقة
نحو صراخ السماء ........
***
فاطمة معروفي