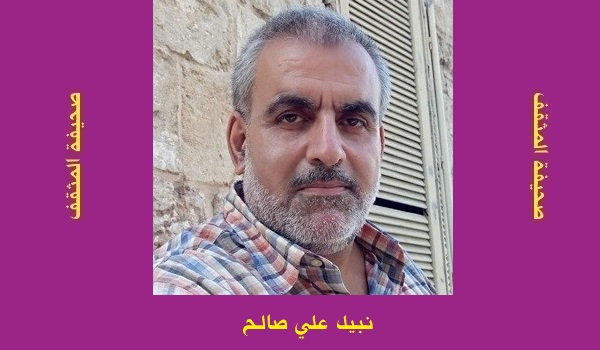دراسات وبحوث
محمد أحمد عبيد: مفهوم الغيب بين الفلسفة الدينية والواقع الافتراضي

الملخص: تسعى هذه الدراسة إلى مقاربة مفهوم الغيب في الفلسفة الدينية في ضوء تحديات الواقع الافتراضي، من خلال تحليل جدلية التفاعل بين الثابت العقدي والمتحوّل التقني. وقد أوضحت الدراسة أن الأديان الكبرى، وعلى رأسها الإسلام، جعلت الغيب مجالاً خاصاً بالوحي، يحدّ من طموحات العقل التجريبية ويمنح الإنسان أفقاً للتسليم واليقين. وقد خلصت إلى أن المستقبل الرقمي سيضاعف من هذه الجدلية، مما يستدعي خطاباً نقدياً وفلسفياً يحافظ على نقاء مفهوم الغيب، ويميز بين الغيب الحقيقي والمحاكاة الرقمية.
وعليه، تقدم الدراسة رؤية نقدية تستشرف مستقبل العلاقة بين الدين والتقنية، مؤكدة ضرورة بناء وعي فلسفي-عقدي معاصر يدمج بين الأصالة الدينية والتحديات الرقمية، بما يحفظ التوازن بين الإيمان بالغيب واستخدام الوسائط الافتراضية.
الكلمات المفتاحيّة: الغيب، الفلسفة، الدين، الواقع الافتراضي.
Abstract:
This study seeks to approach the concept of the unseen in religious philosophy in light of the challenges of virtual reality, by analyzing the dialectic of interaction between doctrinal constants and technological variables. The study demonstrates that major religions, most notably Islam, have made the unseen a domain of revelation, limiting the ambitions of the experimental mind and granting humanity a horizon of submission and certainty. It concludes that the digital future will exacerbate this dialectic, calling for a critical and philosophical discourse that preserves the purity of the concept of the unseen and distinguishes between the real unseen and digital simulations.
Accordingly, the study presents a critical vision that anticipates the future of the relationship between religion and technology, emphasizing the necessity of building a contemporary philosophical-doctrinal awareness that integrates religious authenticity and digital challenges, thus maintaining a balance between belief in the unseen and the use of virtual media.
Keywords: the unseen, philosophy, religion, virtual reality.
المقدّمة
الغيب في التصور الديني يُعَدّ من أهم المرتكزات التي يقوم عليها الوعي الإنساني والإيمان الروحي، فهو الحيّز الذي يتجاوز حدود المحسوس والعقلاني ليؤسّس لمعنى الوجود ويفتح أمام الإنسان آفاق التسليم والبحث عن الحقيقة.
ومع بروز الواقع الافتراضي كأحد أهم إفرازات الثورة الرقمية، أخذت الأسئلة الفلسفية تتضاعف حول طبيعة الغيب وحدوده: هل يظلّ الغيب كما هو في الفلسفة الدينية فضاءً مطلقاً لا تدركه التجربة الإنسانية، أم أنّ العوالم الافتراضية بما تخلقه من صور ومحاكاة أصبحت تُنتج "غيوبيات مزيّفة" تثير ارتباكاً معرفياً جديداً؟
وتتجلّى أهمية الموضوع في كونه يعالج جدلية عميقة بين الثابت والمتحوّل: الثابت المتمثّل في مفهوم الغيب في الأديان والفلسفات الدينية، والمتحوّل المتمثل في الواقع الافتراضي الذي يقدّم خبرات حسّية غير تقليدية تحاكي الماورائيات.
وهذه الجدلية تجعل الموضوع مجالاً خصباً للتفكير الفلسفي والنقدي حول مكانة الغيب في عصر الرقمنة.
أما أسباب اختيار الموضوع، فترجع إلى الحاجة إلى فهم كيف تؤثر التحولات الرقمية على التصورات العقدية والفلسفية للإنسان، خاصةً مع تنامي حضور العوالم الافتراضية التي قد تُضعف أو تُعيد تشكيل إدراك الإنسان للغيب.
وتنحصر إشكالية الدراسة في السؤال المركزي: كيف يتقاطع مفهوم الغيب في الفلسفة الدينية مع معطيات الواقع الافتراضي، وإلى أي حد يمكن أن يؤثر هذا الواقع في الوعي الإنساني بالغيب؟
ومن هذه الإشكالية تتفرع أسئلة الدراسة:
ما طبيعة الغيب في الفلسفات الدينية الكبرى؟
كيف يسهم الواقع الافتراضي في إنتاج خبرات جديدة قد تحاكي الغيب؟
هل يمكن اعتبار المحاكاة الافتراضية بديلاً معرفياً عن مفهوم الغيب؟
ما حدود التمييز بين الغيب الحقيقي والغيب المزيّف في الوعي المعاصر؟
أما أهداف الدراسة فهي:
توضيح مفهوم الغيب في الفلسفة الدينية وبيان مكانته في الوعي الإنساني.
تحليل أثر الواقع الافتراضي على إدراك الغيب وتمثلاته.
الكشف عن أبعاد العلاقة بين الغيب والافتراض الرقمي من منظور نقدي.
استشراف مستقبل مفهوم الغيب في ظل الثورة الرقمية.
وتقتصر حدود الدراسة على دراسة المفهوم في نطاق الفلسفة الدينية والواقع الافتراضي، دون التوسع في الجوانب التقنية البحتة للواقع الافتراضي أو التفاصيل اللاهوتية الدقيقة في كل دين على حدة.
وتعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل المفهوم في الفلسفات الدينية، ومقارنته بما يتيحه الواقع الافتراضي من بدائل إدراكية.
وبالنسبة إلى الدراسات السابقة، فقد انصبّ معظمها على دراسة العلاقة بين الدين والتكنولوجيا، أو على البعد النفسي والاجتماعي للتدين الرقمي، بينما لم يُولَ الاهتمام الكافي لمفهوم الغيب ذاته في تداخله مع العوالم الافتراضية، وهو ما يجعل هذه الدراسة رائدة من حيث الإشكالية والمقاربة.
ويقوم هيكل الدراسة على ثلاثة مباحث رئيسة:
المبحث الأول: الغيب في الفلسفة الدينية – المفاهيم والحدود.
المبحث الثاني: الواقع الافتراضي وإنتاج المحاكاة – قراءة فلسفية.
المبحث الثالث: الغيب بين الفلسفة الدينية والواقع الافتراضي – جدلية التفاعل والاستشراف.
الغيب في الفلسفة الدينية – المفاهيم والحدود
الغيب يشكّل أحد الركائز الكبرى في الفكر الديني والفلسفي على السواء؛ إذ يعبّر عن المجال الذي يتجاوز حدود المحسوس والتجربة المباشرة ليضع الإنسان أمام أفقٍ أوسع من إدراكه الحسي والعقلي.
ويُقصد بالغيب في الأديان السماوية كل ما استتر عن إدراك الإنسان، مما لا يُدرك بالحواس ولا بالعقل المجرد، وإنما يُعرَف بالوحي أو بالإيمان(1).
وقد ارتبط الغيب بالمعنى الوجودي العميق؛ فهو ليس مجرد مجهول، بل هو مجال اليقين الذي يُؤسَّس على الثقة بالمطلق الإلهي، فالإيمان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق"٤. وكما أن الإيمان بالغيب يقوم على أساس متين من الشرع، فهو يقوم كذلك على أساس متين من الفطرة والعقل. طريق الهداية - مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة، محمد يسري، الطبعة: الثانية، 2006م، ص 216.
وفي التصور الإسلامي يحتل الغيب موقعاً مركزياً؛ فالقرآن الكريم يصف المؤمنين بأنهم "الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" (البقرة: 3)، مما يجعل الإيمان بالغيب شرطاً أولياً للانتماء العقدي، ويتسع مفهوم الغيب ليشمل الله سبحانه وتعالى، واليوم الآخر، والملائكة، والقدر، وما وراء الحس(2).
وفي الفكر المسيحي يرتبط الغيب بسرّ الإيمان، فعندهم: "وَلَهُمْ سِرُّ الإِيمَانِ بِضَمِيرٍ طَاهِرٍ"(3)؛ حيث يُنظر إليه باعتباره مجالاً لنعمة الله التي تتجاوز حدود العقل البشري، وتظهر في العقيدة المسيحية مفاهيم مثل سرّ التجسد والفداء كأسرار إيمانية تقع في حيز الغيب.
أما في الفلسفة اليهودية فيبرز الغيب في مفهوم "الإله المتعالي" الذي لا يُدرَك كنهه ولا يُتصوّر تماماً، وإنما يُعرَف عبر أفعاله وإرادته في التاريخ، فــ"يهوه إله اليهود الذي آمن به فيلو هو الإله المفارق للعالم المحسوس، وهو الإله المتعالي اللامتناهي في صفات الكمال... لذلك فهو لا يمكن وصفه إلاَّ بالسلب كقولنا غير المحوي غير المحدود غير المتناهي... غير أنه لفرط علوه عن العالم ولعظم الهوة التي تفصله عنه، لا يؤثر مباشرة في العالم، بل يؤثر عن طريق وسائط أو قوى إلهية... أولها وأهمها هيَ: الكلمة أو اللوغوس"(4).
وعلى الرغم من أن الغيب ارتبط بالوحي، إلا أن الفلسفة الدينية تعاملت معه باعتباره ضرورة وجودية وعقلية معاً، فعند الفلاسفة المسلمين -مثل ابن سينا والفارابي- كان الغيب متجذّراً في مراتب الوجود، حيث يميزون بين العالم المحسوس والعالم المعقول، ويعتبرون الغيب امتداداً لمجال العقول المجردة والفيض الإلهي(5).
يمكن القول أن الغيب في الفلسفة الدينية يتحدد بحدودٍ دقيقة تميّزه عن المجهول أو الوهم، وهي:
الغيب المطلق: وهو ما لا يمكن للإنسان إدراكه بحال من الأحوال، كذات الله أو حقيقة الروح.
الغيب النسبي: وهو ما يمكن أن يُكشف جزئياً عبر الوحي أو التجربة الروحية، مثل حقائق الآخرة أو بعض المعجزات.
المجهول المؤقت: وهو ما يجهله الإنسان في زمن ما، ثم يمكن أن يكشفه العلم أو التجربة، كالقوانين الطبيعية أو أسرار الكون.
وبذلك يصبح الغيب ليس مجرد "مجهول" يثير الحيرة؛ بل أفقاً معرفياً وروحياً يرسم للإنسان حدود قدرته ويذكّره بمقام العبودية، ويمنحه في الوقت ذاته معنى يتجاوز التجربة المادية.
ويشكّل الغيب محوراً أساسياً في تشكيل وعي الإنسان بذاته وبالوجود؛ فهو يرسّخ التواضع المعرفي أمام أسرار الكون، ويغذّي البعد الروحي الذي يربط الإنسان بالمطلق، كما يحدّد المنظور الأخلاقي، إذ إن الإيمان بالغيب يوجّه سلوك الإنسان نحو المسؤولية أمام إله عليم.
وبهذا يتضح أن الغيب في الفلسفة الدينية ليس مفهوماً ثانوياً؛ بل هو أساس الإيمان والوعي بالوجود. غير أن ظهور الواقع الافتراضي أوجد عوالم جديدة من "اللامرئي" قد تداخلت مع هذا المفهوم، وهو ما يستدعي بحثاً مستقلاً في المبحث الثاني حول علاقة المحاكاة الرقمية بالغيب الحقيقي.
الواقع الافتراضي وإنتاج المحاكاة – قراءة فلسفية
يمثل الواقع الافتراضي (Virtual Reality) أحد أبرز التحولات التكنولوجية التي غيّرت إدراك الإنسان للوجود والمعرفة، إذ لم يعد مقتصراً على محاكاة العالم الواقعي؛ بل تجاوز ذلك إلى خلق عوالم جديدة متخيلة، قابلة للتجربة الحسية والمعايشة المباشرة(6).
ويعني ذلك أن الواقع الافتراضي ليس مجرد أداة تقنية، بل هو بنية فكرية ومعرفية تعيد صياغة حدود الممكن والمستحيل، وتثير أسئلة فلسفية عميقة حول معنى الحقيقة والتمثيل، وحول الفاصل بين الوهم والواقع.
وقد ارتبط مفهوم المحاكاة تاريخياً بالفلسفة اليونانية، حيث اعتبر أفلاطون أن الفن محاكاة للمحاكاة، أي صورة ناقصة للوجود الحق(7)، وفي الفلسفة المعاصرة قدم جان بودريار مفهوم "المحاكاة الفائقة" (Hyper-simulation حيث تصبح الرموز والصور أكثر حضوراً من الواقع نفسه، وتكتسب سلطة في تشكيل الوعي والمعنى(8).
ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى الواقع الافتراضي باعتباره امتداداً لهذه الفلسفات، إذ لا يكتفي بإعادة إنتاج العالم الواقعي، بل يؤسس لعوالم بديلة قد تحل محل الواقع في تشكيل إدراك الإنسان لنفسه وللآخر وللإلهي.
ومع اتساع نطاق تطبيقات الواقع الافتراضي في التعليم، والطب، والفن، والطقوس الدينية، يتعرض الإنسان لإعادة تشكيل جذري في تجربته الوجودية، فالتجربة الافتراضية تتيح له إمكانات غير محدودة للانتقال، والتقمص، وإعادة التمثيل، مما يجعل حدود الجسد والمكان والزمان أكثر سيولة.
وتفتح هذه السيولة باباً لإعادة التفكير في ماهية "الواقعي": هل هو ما ندركه مباشرة عبر الحواس، أم ما يقدمه الجهاز الرقمي كبديل أكثر كثافة وثراء؟
ويثير الواقع الافتراضي جدلاً فلسفياً حول العلاقة بين الحقيقة والوهم، فمن منظور واقعي لا يمكن أن تحل الصورة محل الأصل؛ لكن من منظور ما بعد الحداثة، قد لا يكون ثمة فرق جوهري بين الأصل والنسخة، لأن كلاهما يتحدد في فضاء المعنى والتداول.
ومن ثم فإن الواقع الافتراضي يدفعنا إلى التساؤل: هل نحن بصدد توسيع نطاق إدراك الحقيقة، أم أننا أمام طمس تدريجي للفوارق بين الحقيقة والوهم بحيث يصبح الإنسان أسير "عالم المحاكاة"؟
إن المحاكاة التي ينتجها الواقع الافتراضي ليست حيادية؛ بل تحمل آثاراً عقدية وأخلاقية، فهي قد تُعيد صياغة الممارسات الدينية عبر "طقوس افتراضية"، أو تُقدم تمثيلات جديدة للغيب والقداسة، مما يفرض تحدياً على العقيدة الإسلامية التي تؤكد على التمييز بين الغيب المحجوب والشهادة المشهودة. كما تثير قضايا أخلاقية تتعلق بالمسؤولية، حيث قد ينزلق الإنسان إلى تجربة ما هو محرّم واقعياً في فضاء افتراضي دون شعور بالذنب أو المساءلة.
يمكن القول بأن التعامل مع الواقع الافتراضي يقتضي قراءة فلسفية نقدية لا تنبهر بوعوده التقنية ولا ترفضه مطلقاً، فالمسألة تتعلق بكيفية توظيفه في خدمة القيم الإنسانية والدينية، وتجنب تحوله إلى أداة تفكيك للمعنى أو بديل عن التجربة الروحية الأصيلة.
وهنا يظهر دور الفلسفة والعقيدة معاً في وضع معايير توجه هذا الواقع الجديد، بحيث يبقى الإنسان قادراً على التمييز بين الحقيقة والمحاكاة، وبين الوسيلة والغاية.
الغيب بين الفلسفة الدينية والواقع الافتراضي – جدلية التفاعل والاستشراف
الغيب في التصور الديني -لا سيما في العقيدة الإسلامية- يمثل البُعد الذي يتجاوز حدود الحسّ والتجربة المباشرة، وهو مجال محفوظ لله تعالى، يُعرف بالوحي ويُستدل عليه بالعقل، لكنه يظل بمنأى عن المحاكاة والتجسيد البشري، فلا سلطان لأحد على الغيب إلا ما أعلمنا الله إياه(9).
ويُشكل الإيمان بالغيب أحد أركان التصور الإسلامي للوجود، بما يتضمنه من إيمان بالله والملائكة واليوم الآخر وما وراء الحسّ، فهذا المفهوم يطرح إشكاليات فلسفية متجددة حين يُقارن مع أدوات الواقع الافتراضي التي تحاول "محاكاة" أو "إعادة بناء" ما هو غير مُدرَك بالحواس.
وتناولت الفلسفات الدينية عبر العصور الغيب باعتباره منبعاً للمعنى، ومصدراً لتجاوز المحدود إلى اللامحدود، فالفلسفة المسيحية مثلاً نظرت إلى الغيب باعتباره الحقل الذي يتجاوز العقل البشري ويقتضي الإيمان. أما الفلسفة الإسلامية، فقد بلورت رؤية وسطية تؤكد أنّ الغيب لا يُلغى بالعقل ولا يُحاكى بالخيال؛ بل يُصدَّق به بالوحي، ويُفهم بالعقل كأداة لتأكيد إمكانه.
وهذه الرؤية تضبط حدود المعرفة الإنسانية، وتضع فاصلاً بين ما هو متاح إدراكه بالحواس وبين ما لا يُنال إلا بالإيمان.
مع تطور تقنيات الواقع الافتراضي، بدأ الإنسان يبتكر عوالم بديلة تمثل نوعاً من "الغيب المصطنع"، حيث يُتاح له أن يعيش تجارب لم يختبرها في الواقع، أو أن يستحضر صوراً لآخرةٍ متخيلة، أو ملائكة وأرواح رقمية، غير أنّ هذا "الغيب الافتراضي" لا يتجاوز كونه محاكاة من صنع الخيال والتقنية، ما يجعله خطراً فلسفياً وعقدياً إن استُخدم لتقويض الإيمان بالغيب الحقيقي الذي حدده الوحي.
وهنا تبرز إشكالية: هل يمكن اعتبار هذا الغيب المصطنع شكلاً من أشكال الإبداع الإنساني، أم أنه يمثل تشويشاً على العقائد وتلاعباً بالوجدان؟
تقوم الجدلية هنا على مفارقة أساسية؛ فمن جهة الواقع الافتراضي يفتح أفقاً جديداً لفهم قدرة الإنسان على التخيل والتجسيد، بما يعزز وعيه بحدوده أمام الغيب الإلهي. ومن جهة أخرى قد يؤدي التوغل في هذه العوالم إلى طمس الحدود بين الحقيقي والمتخيل، فيتوهم الإنسان أن بمقدوره الإحاطة بالغيب أو تمثيله.
ومن ثم يصبح التفاعل بين الغيب والافتراضي مزدوج الوجه؛ محفزاً على إدراك محدودية الإنسان، ومهدداً في الوقت ذاته لتوازن العقيدة إن لم يُضبط بالمعايير الشرعية والفلسفية.
وتطرح هذه الجدلية سؤالاً استشرافياً مفاده: كيف سيتشكل وعي الإنسان بالغيب في ظل تطور الواقع الافتراضي؟
يمكن القول إن المستقبل سيشهد مزيداً من "التداخل الرمزي" بين الغيب الديني والغيب الرقمي، وهو ما يتطلب بناء وعي نقدي يحفظ التمايز بينهما، ولعل التحدي الأكبر هو أن يستخدم الإنسان هذه التقنيات لتعزيز معاني الإيمان والتأمل في عظمة الخالق، لا أن يجعلها بديلاً عن الوحي أو أداة لمحاكاة الغيب بطرائق قد تفضي إلى الانحراف العقدي.
لا يعني ذلك رفض الواقع الافتراضي جملة وتفصيلاً؛ بل ضرورة ضبطه بمنظور فلسفي-عقدي يُقرّ بمحدودية الإنسان في إدراك الغيب، فالمنهج الإسلامي، في جوهره، لا يُعادي الخيال ولا التقنية، لكنه يضعهما في إطار الوسيلة لا الغاية، وفي حدود ما يخدم الحقيقة الإيمانية.
من هنا تأتي الحاجة إلى مشروع معرفي يعيد قراءة الغيب في ضوء التحولات الرقمية، مستفيداً من التقنيات دون الوقوع في فخ المحاكاة التي تُشوّه قداسة الغيب.
الخاتمة
أولًا: النتائج:
مفهوم الغيب في الفلسفة الدينية يشكل أساساً مركزياً للوعي الإنساني، إذ يضبط العلاقة بين المحسوس واللامحسوس، ويضع حدوداً للمعرفة البشرية. وقد أكدت الفلسفة الإسلامية بشكل خاص أنّ الغيب مجال محفوظ لا يدرك إلا بالوحي، مع إمكان الاستدلال العقلي على إمكانه وضرورته.
الواقع الافتراضي يقدم إمكانات جديدة لمحاكاة التجربة الإنسانية، تصل إلى حدّ صناعة "غيوبيات مزيّفة" تُثير ارتباكاً معرفياً، من خلال قدرتها على محاكاة ما وراء الحسّ، إلا أنّ هذه المحاكاة لا تخرج عن إطار الخيال التقني، ولا يمكن أن تكون بديلاً عن الغيب الديني الحقيقي.
العلاقة بين الغيب والواقع الافتراضي تتسم بالجدلية؛ فهي من جهة قد تساعد على إبراز محدودية الإنسان أمام الغيب الإلهي، ومن جهة أخرى قد تفضي إلى تشويش على الوعي الديني إذا لم تُضبط. كما أظهرت الدراسة أن المستقبل الرقمي سيضاعف من هذه الجدلية، بما يستدعي صياغة وعي نقدي يحمي المفاهيم العقدية من التمييع أو التحريف.
ثانياً: التوصيات:
إدماج البُعد النقدي في دراسة الظواهر الرقمية داخل الحقول الشرعية والفلسفية، بحيث لا يقتصر الاهتمام على الجوانب التقنية أو الاجتماعية.
بناء خطاب ديني وفلسفي معاصر يوضح للمتلقي الفرق بين المحاكاة الافتراضية والغيب الحقيقي، ويبرز قيمة الإيمان بالغيب باعتباره بعداً لا يُنال بالتجربة الحسية ولا بالخيال الرقمي.
تشجيع البحوث البينية (Interdisciplinary Studies) بين الفلسفة، الدراسات الدينية، وعلوم التقنية لفهم انعكاسات الواقع الافتراضي على الوعي العقدي.
توظيف الواقع الافتراضي إيجابياً في خدمة التربية الإيمانية والفلسفة الدينية، كأداة لتقريب المعاني لا لمحاكاة الغيب أو تمثيله.
إعادة قراءة التراث العقدي والفلسفي في ضوء الأسئلة التي يثيرها العالم الرقمي، لإثراء الدراسات المعاصرة بمقاربات رصينة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
***
إعداد: محمد أحمد عبيد - كاتب وباحث في الفلسفة
2025م
..............................
قائمة المصادر والمراجع
ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م.
أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى. زهرة التفاسير. دار الفكر العربي.
إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي. رسالة التوحيد المسمى بـ تقوية الإيمان. نقلها للعربية وقدم لها: أبو الحسن علي الحسني الندوي. دار وحي القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 2003م.
أفلاطون. الجمهورية، د.ت.ط.
بدر الدين مصطفى أحمد محمد. من المحاكاة إلى الواقع الفائق: قراءة في فكر جان بودريار. حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة الكويت – مجلس النشر العلمي، 2016م.
بولس الرسول. الرسالة الأولى إلى تيموثاوس.
تاوضروس، موريس. اللوغوس: مفهوم الكلمة في العهد الجديد.
السيوطي، جلال الدين. جهد القريحة في تجريد النصيحة (مطبوع مع: صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام). تحقيق: علي سامي النشار، سعاد علي عبد الرازق. مجمع البحوث الإسلامية.
الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل. مؤسسة الحلبي.
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. قواعد العقائد. تحقيق: موسى محمد علي. عالم الكتب، لبنان، الطبعة الثانية، 1985م.
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. معارج القدس في مدارج معرفة النفس. دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية، 1975م.
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. معيار العلم في فن المنطق. تحقيق: سليمان دنيا. دار المعارف، مصر، 1961م.
موقع مجرة. الواقع الافتراضي Virtual Reality. hbrarabic.com، تاريخ الدخول: 10/9/2025.
الهلال، محمد. تفسير القرآن الثري الجامع. دار المعراج، ودار جوامع الكلم، دمشق، الطبعة الأولى، 2022م.
الهوامش
(1) قواعد العقائد، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المحقق: موسى محمد علي الناشر: عالم الكتب - لبنان الطبعة: الثانية، 1985م، ص 264. تفسير القرآن الثري الجامع، محمد الهلال، دار المعراج، ودار جوامع الكلم)، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، 2022م، 9/61. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر - تونس، 1984م، 1/229.
(2) زهرة التفاسير، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، دار الفكر العربي، 8/4343.
(3) رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس 3: 9
(4) اللوغوس مفهوم الكلمة في العهد الجديد، أورد د. موريس تاوضروس، 1/72.
(5) الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، مؤسسة الحلبي، 2/147. معيار العلم في فن المنطق، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المحقق: الدكتور سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، 1961م، ص232. معارج القدس في مدراج معرفة النفس، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة: الثانية، 1975، ص 166. جهد القريحة في تجريد النصيحة (مطبوع مع: صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام)، جلال الدين السيوطي، المحقق: الدكتور علي سامي النشار، السيدة سعاد علي عبد الرازق، مجمع البحوث الإسلامية، ص56.
(6) الواقع الافتراضي Virtual Reality، موقع مجرة، hbrarabic.com، تاريخ الدخول: 10/9/2025.
(7) أفلاطون: الجمهورية، ف 598. ،
(8) من المحاكاة إلى الواقع الفائق : قراءة في فكر جان بودريار، بدر الدين مصطفى أحمد محمد، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي، 2016، ص9 - 98.
(9) رسالة التوحيد المسمى بـ تقوية الإيمان، إسماعيل بن عبد الغني بن وَلي الله بن عبد الرحيم العُمري الدهلوي، نقلها للعربية وقدم لها: أبو الحسن علي الحسني الندوي، دار وحي القلم - دمشق، سورية الطبعة: الأولى، 2003م، ص103.