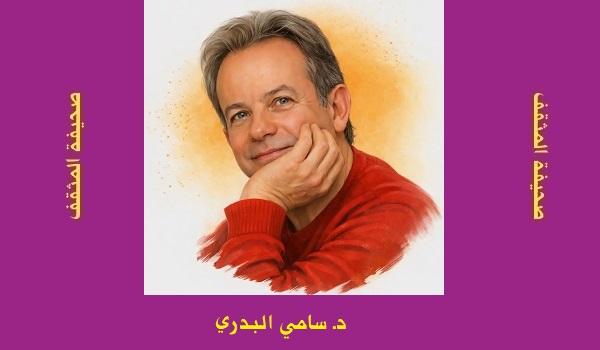آراء
محمد البطاط: مارتن بوبر بين نظرية (أنا-أنت) والموقف من الحركة الصهيونية

مفكرون يهود ضد الصهيونية (6)
يمثل مارت بوبر أحد أبرز الفلاسفة اليهود المعاصرين الذين طغى على إشتغالهم الفكري السعي الى تقديم مقاربة خاصة في العلاقات الانسانية عبر دالة البعد المعنوي، جامعاً في تفكيره الفلسفة واللاهوت والاجتماع والانثروبولوجيا والفكر السياسي، وقد ولد في مدينة فيينا عام 1878م لأسرة يهودية مثقفة، إذ كان جده سالومون بوبر (1827-1906م) من المتخصصين في الفكر التوراتي والتلمودي، الذي سيتربى عنده مارتن في مدينة لوفوف الأوكرانية عقب إنفصال والديه وهو بعمر الثالثة، ويتعلم العبرية مطلعاً في الوقت ذاته على التراث اليهودي والمعتقدات المتعلقة به، وفي عام 1892م يعود مارتن إلى منزل والده في ليمير الألمانية، وهناك سيمر بأزمة دينية تجعله يقطع صلته باليهودية مُبدياً في الوقت عينه ميلاً إلى الفلسفة قارئاً لعمانؤيل كانت (1724-1804م) وفردريك هيغل (1770-1831م) وفردريك نيتشه (1844-1900م) وغيرهم مما سيدفعه الى الرغبة في التخصص في مجال الفلسفة في جامعة فيينا.
وفي عام 1898م قرر مارتن أن ينضم الى الحركة الصهيونية، ليصبح بعد ذلك، كما تنقل الموسوعة البريطانية(1) ، محرراً لصحيفة الصهيونية الإسبوعية The World/العالم، عقب دعوة وجهها له ثيوديور هرتزل (1860-1904م)، إلا العلاقة والوشاجة لن تدوم بين الطرفين جرّاء تباين وجهات نظرهما حول معالجة المسألة اليهودية، فبوبر يميل الى حلول تختلف جذرياً عن حلول هرتزل المتشددة، والساعية الى إقامة الوطن اليهودي عبر إقصاء السكان الأصليين منه، وهو ما رفضه بوبر كما سيأتي لاحقاً.
ونتيجة لميول مارتن بوبر الروحية والمعنوية، وكذلك تأثره ببعض الفلاسفة المعنويين كمؤسس الإتجاه الوجودي سورين كريكَجارد (1813-1855م)، وبعد إطلاعه على فكر تيار الحسيدية اليهودي سيقرر إعتناق هذا الفكر الذي رأى في قرباً كبيراً مع توجهاته وتفكيره عام 1903م، ليستمر في التفكير والكتابة ضمن هذا المناخ الفكري، ليتوّجَه عام 1923م بنشر كتابه الأشهر (الأنا والأنت) الذي يمثل ذروة تفكيره في مجالات الحوار والتفاعل والعلاقات الانسانية، كما سيقوم بوبر بترجمة التوراة من اللغة العبرية الى الالمانية بالتعاون مع أحد أصدقائه، وفي عام 1930م سيصبح أستاذ شرف في جامعة فرانكفورت، إلا أن سيُقدم على الاستقالة عام 1933م إحتجاجاً على وصول النازية الى السلطة في ألمانيا، وستقوم السلطات النازية بمنعه من التدريس في المؤسسات العامة، فقام بتأسيس المكتب اليهودي للتعليم اليهودي للراشدين، والذي سيتم حظره كذلك من قبل النازييين.
وفي العام 1938م يقرر مارتن بوبر الهجرة الى فلسطين، مُقيماً في القدس، عاملاً كأستاذ للأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع في الجامعة العبرية، وزاد خلال إقامته في القدس من مشاركته السياسية واستمرّ في تطوير أفكاره حول الصهيونية ليشارك عام 1942 في تأسيس حزب "إيحود/الوحدة" الذي دعا إلى برنامج حلّ ثنائيّ القومية، مخالفًاً هرتزل في اتجاهه السياسيّ والثقافي وفي تصوّره للصهيونية كقومية يهودية ليست في حاجة إلى الثقافة والدين اليهوديين، في حين كان بوبر يرى أنّ هدف الصهيونية هو إثراء اليهود اجتماعيًا وروحيًا، داعيًا إلى ضرورة إصلاح اليهودية بعد تأسيس "إسرائيل" وقائلًا: (إننا نحتاج إلى من يفعل لليهودية ما فعله البابا يوحنا الثالث والعشرون للكنيسة الكاثوليكية)(3) ، كما كان بوبر أحد زعماء (بريت شالوم) (تحالف السلام)، وهي حركة نادت بالتسامح والتقارب في علاقة اليهود مع الحركة القومية العربية، وقد توفي بوبر في مدينة القدس عام 1965م.
وقبل الولوج الى النقد الذي سيقدمه بوبر الى الحركة الصهيونية نعتقد أن من الأهمية بمكان الإرتكان على تقديم شرح مبسط لنظريته في العلاقات الانسانية والحوار (الأنا-أنت)، إذ يرى بوبر أن الإنسان كائن إجتماعي بذاته، وإذا كان الكوجيتو الديكارتي يقوم على معادلة (أنا أفكر إذن أنا موجود) فإن معادلة بوبر تقوم على (أنا أُقيم علاقات فأنا موجود) لتأكيد محورية أُسية الطابع العلائقي في الذات الانسانية، ويعتقد بوبر أن هناك نوعين من العلاقات، والتي نظّر لها في كتابه (أنا وأنت I and Thou) عام 1923م(4):
النوع الأول: (أنا-هو/ I-It): في هذه العلاقة يُعامل الآخر على أنه شيءٌ من الأشياء، أو كموضوع أو وسيلة، ولذلك تكون العلاقة في هذا النوع مرتسمة برسم النفعية، وللعقل والخيال فيها البعد الأثر الكبير، وبعبارة أخرى، تتأسس العلاقة في هذا النوع على النظرة إلى الآخر من خلال اللحاظ الوسائطي، أو الطريقي، الذي يحقق غاية للإنسان كأداة أو وسيلة، ومن ثم لا يظهر هذا الآخر في العلاقة مع الأنا كحقيقة تفاعلية، وإنما كتعبيرٍ عن موضوع للمعرفة أو الإستخدام، كتعامل الانسان مع سائق التكسي أو من يقدم لك خدمة عابرة، أو عندما تدرس نباتاً أو مادة في المختبر، وهي علاقة لا تحظى بإنعدام الفواصل بين الذات والموظوع، بل تهيمن عليها خاصية التأقيت والإختزال، والعالم، وفقاً لها، يتم إختزاله في أشياء ومفاهيم يمكن قياسها أو تحليلها، وإذا ما تم توسيع علاقة (أنا-هو) لتطغى على كل العلاقات الانسانية فإنها ستحول الآخرين لدى الأنا إلى مجرد موضوعات للدراسة أو التحليل أو الاستخدام النفعي، ومن ثم ستؤول الأمور الى التشيؤ.
النوع الثاني: (أنا-أنت/ I-Thou): على خلاف النوع الأول، تظهر العلاقة في هذا النوع كعلاقة تفاعلية بين الأنا والآخر، ولا يظهر الاخر كغائب أو موضوع دراسة وتحليل و إستخدام، بقدر ما يظهر ككائن حي متكامل متفاعل مع الأنا، وهذه العلاقة تمثل جوهر الوجود الانساني من وجهة نظر مارتن بوبر، وهي لا تقتصر على علاقة الانسان-الانسان، وإنما ترتبط كذلك بعلاقة الإنسان بالله، إذ فيها يظهر الله تعالى لا كموضوع للدراسة، بقدر ما يظهر كــــ(أنت الأزلي) الذي يتحاور الانسان معه، ويعيش معه علاقة روحية تفاعلية، وهنا يظهر التكامل في طريقة التفكير الخاص بمارتن بوبر، وفي إرتباطه الديني بالفكر الحسيدي القائم على النظرة الدينية الروحية.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن بوبر لا يقف على الضد من علاقة (أنا-هو) تماماً، وإنما يضعها في سياقها الطبيعي، إذ أنها علاقة ضرورية في مجالات العلم والتقنية والعمل اليومية، وكذا للعلاقات الطريقية العابرة، بيد أن الخطر الكبير يكمن في أن تهيمن هذه العلاقة على مجمل معالم الحياة الانسانية، وتصبغ بصبغتها كل العلاقات الاجتماعية والروحية، فيفقد الانسان، تبعاً لذلك، البعد الروحي، ويعيش في عالم الأشياء فقط، والإنسان المتوازن، من وجهة نظر بوبر، هو الذي يعيش حالة التوازن والتعادل بين هذين النوعين من العلاقة، فهناك علاقة مع الـــ(هو) الذي نستخدمه وندرسه، وأخرى مع الـــ(أنت) الذي نلتقي فيه ونتفاعل معه في علاقة حضور تفاعلي مع الأنا بخلاف الهو الي يظهر كموضوع دراسة تغيب أناه الخاصة عن التفاعل الحضوري المعنوي مع الأنا.
ونفترض أن فهم طبيعة نظرية بوبر في العلاقات الانسانية مع الآخر ضروري جداً لفهم موقفه النقدي من الحركة الصهيونية، وطبيعة الحل الذي يتبناه للمسألة اليهودية، لأن نقده للصهيونية، وخلافه مع هرتزل وإنسحابه من التعامل معه، لا يعبر عن موقف سياسي بحت، وإنما يعبر كذلك عن تناغم مع فلسفته وفكره الحواري التفاعلي، إذ طالما أن جوهر العلاقة الرابطة للانسان هو النوع الثاني (أنا-أنت)، فلا يمكن إختزال التعامل مع الآخر في (أنا-هو)، وهذا ما تقوم الصهيونية بإتباعه في مشروعها، فالأرض شيء نملكه، والسكان الأصليون الفسطينيون عبارة عن عائق (هو) يقف أمام رغبتنا فعلينا أن نزيحه، والدولة الصهيونية أداة لتحقيق غاية الأمن القومي للصهيونية، والدين/اليهودي وسيلة آيديولوجية تُوّظف من أجل تحقيق غاية سياسية، لذلم أضحت العلاقة مع الاخر علاقة (الانسان وكذلك الله تعالى) علاقة الـــ(هو).
ومن هنا نفهم لماذا سعى بوبر إلى ان تكون العلاقة الرابطة مع العرب علاقة تفاعل وحوار (أنا-أنت)، منطلقاً من فلسفته الحوارية في أن العلاقة بين الشعوب يجب أن تكون علاقة إعتراف متبادل، وليس علاقة سيطرة أو تملك أو إقصاء، ونتاجاً لذلك، رفض بوبر مبدأ الحركة الصهيونية الهادفة إلى إستبعاد الفلسطينيين وتأسيس كيان يهودي فقط، ودعا إلى إقامة دولة ثنائية القومية يعيش فيها اليهود والعرب في علاقة (أنا-أنت)، ولذلك سعى في حزب إيحود إلى أن الحياة في هذه الأرض لن تكون ممكنة ما لم يتم الاعتراف بالاخر الفلسطيني على أنهم الـــ(أنت) بالنسبة لليهود، وقد كتب بوبر في إحدى رسائله (إن القضية ليست أن نُقيم دولة بأي ثمن، بل أن نُقيم مجتمعًا بشريًا في هذه الأرض يكون فيه الإنسان هدفًا، لا وسيلة)(5).
ومن هنا فإننا نتفق مع السيد ولد أباه(6) في تأكيد أن بوبر، وإن كان يتبنى فكرة الهجرة اليهودية إلى فلسطين التي هي أساس المشروع الصهيوني الأصلي، إلا أنه يحرص على أن لا تكون في شكل النزعة القومية السياسية، وألا تكون على حساب العرب من سكان الأرض التي يعيشون فيها، فما يتبناه بوبر هو نمط من النزعة اليهودية الروحية التي تتأقلم مع الفكرة الحديثة للدولة السيادية الوطنية المجسدة لروح الشعب وفق المصطلحات الهيغلية، وإنما تصدر عن العقيدة الأرثوذكسية الحسيدية، وتتبنى رؤية غير سياسية للرابطة الجماعية الروحية، إذ تكون الأولوية للمقتضيات الأخلاقية على محددات السلطة والقوة، وان هدف “إعادة بعث إسرائيل” بالنسبة لبوبر لا يمكن أن يتم عن طريق المقاييس السياسية الحديثة، أي بناء الدولة القومية وفق المبدأ الولسوني الشهير الذي يكرس حق تقرير المصير للأمم ضمن كيان قانوني معترف به دوليًاً، فالانبعاث الذي يتحدث عنه بوبر يتم من خلال الرجوع للتراث اليهودي، ومن هذه المنطلقات يرى بوبر أن الصهيونية السياسية تتعارض في العمق مع التراث اليهودي الأصلي، وتفضي إلى التضحية بجوهر الدين من أجل الدولة التي تحولت إلى صنم معبود، إن رسالة النبي موسى الحقيقية هي أن الأرض لا يملكها إنسان، وأن السيادة ليست لبشر في هذا العالم، وما كرسته الصهيونية السياسية هو بناء أيديولوجيا قومية تنتهك روح ونص هذه الرسالة الدينية اليهودية المقدسة.
***
د. محمد هاشم البطاط
.....................
المصادر:
(1) يُنظر الموقع الرسمي للموسوعة البريطانية، على الانترنت: www.britannica.com
(2) تكشف الحسيدية عن أحد التيارات اليهودية التي تعبر عن التوجه الصوفي الباطني الشعبي، والتي نشات في أوربا الشرقية (بولندا وأوكرانيا) في منتصف القرن الثامن عشر على يد الحاخام إسرائيل بن إليعازر، والمعروف ب"بعل شم طوف"، وتعني كلمة (حسيد) في اللغة العبرية: الورع أو التقي، وقد ظهر هذا التيار داخل اليهودية جرّاء معاناة الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية من الفقر والجوع والاضطهاد والجمود الديني، وعدم التفاعل على الطريقة التقليدية التي يعتمدها الحاخامات اليهود في الجمود على الطريقة الحرفية/النصية للمتن الديني اليهودي، إذ تميل الحسيدية إلى التركيز على الجوانب العواطفية الروحية في التعامل مع الدين، وعلى التفاعل الديني كتجربة روحية لا على الجدل العقلي، وكأنها ثورة من الدفء الروحي ضد البرود العقلي إن جاز التعبير ولاق، ومن أبرز المرتكزات الفكرية التي تقوم عليها الحسيدية:
1- حضور الله في كل شيء، فهو ليس بعيداً في السماء، بل يسكن في كل ذرة من الوجود، كما لا يوجد فصل حقيقي بين “المقدّس” و”الدنيوي”، فحتى العمل اليومي، والطعام، والضحك، يمكن أن تكون وسيلة لعبادة الله إذا قُصِدت بنية صافية.
2- الفرح والنية أهم من المعرفة، إذ يرون العبادة ليست في قراءة التوراة ودراستها فقط، بل في الفرح بالله والإخلاص في النية، كما يرفض الحسيديون الحزن واليأس؛ فالحزن علامة على البُعد عن الله، بينما الفرح علامة على حضوره.
3- القيادة الروحية – شخصية “التسديك” (Tzaddik)(الصالح) وهو الزعيم الروحي للجماعة، بمثابة الوسيط بين الناس والله، ويتميّز هذا القائد بالحكمة والقداسة، ويُنظر إليه بوصفه قناة للنعمة الإلهية، وتكون العلاقة بين الحسيد وأستاذه الصالح هي علاقة حب وثقة مطلقة.
4- التأكيد على الروح الجماعية، وقد رفضت الحسيدية النخبوية الدينية، وفتحت الطريق أمام اليهود البسطاء ليعيشوا تجربة الإيمان بعمق، لذلك كانت حركة اجتماعية–روحية أكثر منها فلسفية أو أكاديمية.
هذه المرتكزات وغيرها قادت الحسيدية الى الصِدام مع التيارات التقليدية اليهودية، وأُتهمت إثر ذلك بالهرطقة والإبتعاد عن التوراة.
للتوسع حول الحسيدية، يُنظر: جعفر هادي حسن، اليهود الحسيديم، نشأتهم، تأريخهم، عقادئهم، تقاليدهم، ط1 1994م، دار القلم، دمشق.
(3) جورج معدي، مارتن بوبر منبهاً الى سقوط الصهيونية الاخلاقي، على الانترنت: www.diffah.alaraby.co.uk
(4) للتوسع حول نوعيّ العلاقة في فكر مارتن بوبر، يُنظر:
Martin Buber, I and Thou, translated by; Walter Kaufmann, 1970, EbookIt,
(5) Martin Buber, “A Letter to Gandhi,” in A Land of Two Peoples: Martin Buber on Jews and Arabs, edited by Paul Mendes-Flohr, University of Chicago Press, 1983, p. 173
(6) السيد ولد أباه، مارتن بوبر والصهيونية الدينية، على الانترنت: www.ardd-jo.org