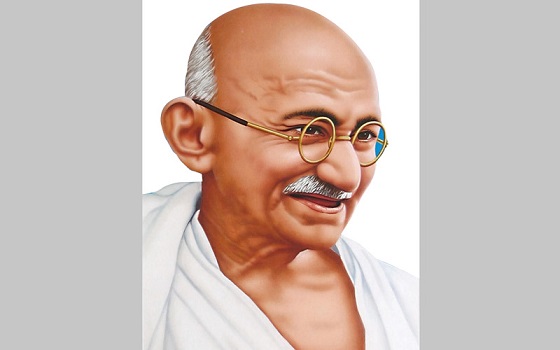قراءات نقدية
طارق الحلفي: عتبات الفقد وأنطولوجيا النسيان..

قراءة نقدية في قصة "ذاكرة في ظلال الغياب" لسعاد الراعي
في عالمٍ تتسارع فيه خطى الزمن وتتلاشى فيه الذاكرة الإنسانية أمام زحف النسيان المرضي والنسيان الاجتماعي معًا، يبرز مرض الزهايمر كأحد أقسى التجليات الوجودية للفناء المتدرج. إنه ليس مجرد مرض عصبي يُفقد الإنسان ذاكرته، بل هو محوٌ تدريجي للهوية، اقتلاعٌ للجذور من تربة الوعي، وتحويل الذات إلى شبح يتجول في متاهات الماضي دون خريطة للعودة. في هذا السياق، تأتي قصة "ذاكرة في ظلال الغياب" للكاتبة سعاد الراعي كشهادة أدبية مؤثرة، تنسج من خيوط الفقد والوفاء نصًا يتجاوز السرد البسيط إلى أعماق المأساة الإنسانية المعاصرة..
تُبحر الكاتبة في أعماق هذا المحيط الوجودي، فتمنح المأساة صوتًا أليفًا، وتجعل القارئ شريكًا في اختبار الغياب لا مجرد مراقب له..
تبدأ القصة بلغة شفافة" أتذكّر تلك المرّة الأخيرة التي حملتني خطواتي إلى بيت استاذتي ماريا بعد رحيل زوجها، وقد ثقلت على صدري مخاوف لم أفلح في تبديدها. كنت كمن يُساق إلى غياب غير مسمّى، يحمل في داخله رجفة لا يفسرها العقل"..
انها ارتعاشة كبيرة تنحنى فيها الذراعان الحانيتان حول الروح الرقيقة.. معلنة أن الهواجس، رغم صمتها المنضبط، تبعثر الأليف واليومي..
البنية النفسية: التوحد مع الفقد
ترصد الكاتبة بدقة موشور تشظي الذات.. فالشخصية المحورية تُحاول ربط اللحظة بالذاكرة لكنها تجد الأسماء الأقرب اليها تفر بعيدًا لحظة استدعاءها.. متعذرة عليها وخاذلة إياها.. هذا الضياع ليس فرديًّا بل جمعي..
الراوية تحاول أن تلملم أشلاء ذاكرة استاذتها ـ وذاكرتها هي أيضًا ـ خشية أن يتحوّل كلاهما إلى أشباح. هناك اختزال نفسي مرهف للعجز صارت الأيام عندها جزرًا غائمة، لا جسر يصل بما فات، ولا قارب للعبور.
ان صياغة الاحداث تؤكد الطابع الحداثي لرؤية الكاتبة.. حيث تثير مشهد ضبابية الزمن في النص.. والذي يذكرنا بقصص مثل "العجوز والبحر" لهمنغواي أو "دكان الحلاق" لجمال الغيطاني، حيث يلتحم الزمن بالدلالة الوجودية..
البعد النفسي الاجتماعي - تفكك شبكة الأمان
تطرح القصة إشكالية اجتماعية حادة تتعلق بمصير المسنين في المجتمعات المعاصرة. ماريا، الأستاذة الجامعية والأم التي قدمت حياتها لأبنائها وللآخرين، تجد نفسها في "بيت العجزة" بعد أن "انقطع عنها أبناؤها، وتركوها وحيدة في مواجهة جسدٍ يخذلها يومًا بعد آخر وذاكرة يلفعها الضباب. هذا الخذلان الأسري يمثل جرحًا اجتماعيًا عميقًا يتجاوز الحالة الفردية ليصبح ظاهرة تستدعي التأمل والمساءلة. القصة تضعنا أمام مرآة قاسية تعكس تفكك الروابط الأسرية وتحول الإنسان إلى عبء في لحظة ضعفه، وإلى امتحان للرحمة والصبر، وتجلى قسوة الخسارة حين يتهشم معنى الانتماء على صخرة النسيان..
الطبقات الاجتماعية هنا تختبر نفسها.. هل تصبح الروابط مجرد واجب روتيني أم فضيلة متجددة تسعى إلى تخفيف وطأة الغياب؟
الكاتبة لا تكتفي بأثر المرض على الضحية، بل ترصد دوائر ارتداده على المحيطين بها: الهواجس، الانكسارات، تفاقم الغربة في الغربة وفي الديار، حتى يصير الجميع ضحايا الغياب بشكل أو آخر..
المقاربة الفكرية والحداثة
النص قائم على مأزق فلسفي.. هل الذاكرة هي الجوهر؟ وهل ينجو المرء من محنة ضياع ذاته في دوامة الزمن..
الكاتبة تشتغل على هذه الرؤية الحداثية عبر اقتصاد لغوي مشدود، وتجسير رمزي بين تفاصيل اليومي وتيارات الفلسفة المعاصرة. كل مرآة في القصة تعكس كسرًا جديدًا في الذات؛ كل ذكرى تصبح ظلًا عاجزًا عن الامتلاء بالنور. النص بذلك يستجيب لطروحات أدباء مثل.. التشيكي الألماني كافكا أو الأمريكي بول أوستر في تمثيل الضياع والهشاشة وتحولات الوجود الفردي.
الذاكرة والهوية: التشظي الوجودي
يشكل مرض الزهايمر في القصة أكثر من مجرد حالة مرضية.. إنه استعارة للفقد الشامل، لانهيار الذات من الداخل. حين تتحدث ماريا عن حفلة حضرها زوجها المتوفى و"البروفيسور كروكوف والرفيق يوري" الراحلين، ندرك أن الزمن قد انطوى على نفسه في عقلها، وأن الموتى والأحياء قد اختلطوا في حاضر مشوش. تصف الراوية هذه اللحظة بقولها: "ذاكرتها لم تعد ملكًا لها، الزمن انسحب من عقلها تاركًا فراغًا مريرًا". هذا التصوير يحمل عمقًا فلسفيًا يتقاطع مع تأملات هايدغر حول الوجود والزمان، إذ تصبح الذات خارج التاريخ، منفية من سياقها الزمني..
التماهي السردي: أنا هي، وهي أنا
من أجمل التقنيات السردية في القصة ذلك التماهي التدريجي بين الراوية/ الراعي وماريا. تبلغ هذه الحالة ذروتها في المقطع المؤثر: "وفي لحظةٍ خاطفة، أحسستُ أنني أنا نفسي ماريا؛ جسدٌ حاضر، وروحٌ تتسرب من بين أصابعه". هنا تتجاوز الكاتبة حدود السرد الخطي لتدخل منطقة التماهي الوجودي، حيث تصبح الراوية والمروي عنها كيانًا واحدًا يتشاركان المصير والألم. هذه التقنية تذكرنا بما فعلته الانكليزية فيرجينيا وولف في "السيدة دالاوي" حين انساب الوعي بين الشخصيات كنهر واحد..
المكان كفضاء للرمز
"بيت العجزة" في القصة ليس مجرد مكان جغرافي، بل هو فضاء رمزي محمل بدلالات العزلة والاغتراب والموت البطيء. تصفه الكاتبة بلغة شعرية كثيفة.. "جدران رمادية عارية من أي حياة، نوافذ مغلقة على أسرار ساكنيها، ستائر باهتة تشبه وجوهًا فقدت لونها مع الأيام". هذا الوصف يحول المكان إلى شخصية مستقلة تشارك في صنع المأساة، تمامًا كما فعل غابرييل غارسيا ماركيز في "مائة عام من العزلة" حين جعل من ماكوندو كائنًا حيًا ينبض بالرمزية..
بلاغة اللغة وإبداع السرد
أسلوب الكاتبة يجمع بين الشفافية والكثافة: " هببت نحوها أحتضنها بنظراتي وبكل ما في شوق، ألقيت عليها تحية تتشبث بالدفء، وحاولت أن أستعيد بشاشتها التي كنت أعرفها، لكنها لم تكن هي نفسها. كان بيننا جدار خفي من الغربة، فصلٌ صامت جعلني أشعر أنني أقف أمام ظلّ ماريا لا ماريا نفسها.". في جملة واحدة تحتشد صور الحنين والوداع والموت. هناك ألفة ساحرة في تصوير اللحظات الإنسانية المربكة والشاردة "صوتها لم يعد يعرف وجهي... عيناها، حين تحدقان بي، كأنهما تبحثان عن صوت قديم".
هذه المفارقة الأسلوبية تخدم بدقة الجانب النفسي، وتمنح النص طاقة تعبيرية عالية، تمرر الكاتبة كل شيء بالصورة والإيماءة، لا التنظير المباشر، فتجعل من الشجن بؤرة تأمل لا مجرد بيان..
اللغة الشعرية والشفافية السردية
تتميز لغة سعاد الراعي بشفافية نادرة تجمع بين الشعرية والوضوح، بين العمق والسلاسة. جملها مشحونة بالصور الاستعارية دون أن تسقط في الزخرفة اللفظية. حين تكتب: " وأن أكون شاهدة على نورها الأخير " أو "صمتٌ كثيف كان يخيّم على المكان، حتى شعرت أن الجدران نفسها تسرد عليّ غيابها بصوت مكتوم"، فإنها تمنح القارئ تجربة جمالية راقية لا تنفصل عن المضمون الإنساني للنص..
الأثر التربوي والإنساني
تكمن أهمية هذه القصة في قدرتها على إثارة الوعي بقضية إنسانية ملحة: مصير المسنين والمرضى في مجتمعاتنا. إنها تدعونا للتفكير في معنى الوفاء، وفي مسؤولياتنا الأخلاقية تجاه من قدموا لنا حياتهم. القصة درس تربوي عميق في القيم الإنسانية، لكنها تقدمه عبر الفن لا عبر الوعظ المباشر، وهذا ما يمنحها قوتها التأثيرية.
البناء السردي وجماليات الانتظار
تبدأ القصة بمشهد الانتظار على عتبة البيت الخالي، وهو مشهد يحمل دلالات رمزية عميقة. الراوية تقف على "الدكّة الحجرية"، صلبة كالحجر في وفائها، مقابل غياب ماريا الذي يتحول من غياب مكاني إلى غياب وجودي. هذا الانتظار ليس مجرد فعل سلبي، بل هو موقف أخلاقي يكشف عن بنية نفسية ترفض الاستسلام للفقد. تكتب الراعي: "كنت أحرس غيابها بقلقٍ يثقل نظراتي"، وفي هذه الجملة تكثيف شعري لافت، إذ يتحول الغياب إلى كيان ملموس يُحرس ويُراقب..
أدب الشهادة والذاكرة
"ذاكرة في ظلال الغياب" نص ينتمي إلى ما يمكن تسميته "أدب الشهادة الإنسانية"، حيث الكاتبة لا تكتفي بتسجيل حدث، بل تحوله إلى تجربة وجودية شاملة. سعاد الراعي تثبت هنا أنها كاتبة ناضجة، تمتلك أدواتها السردية بتمكن، وتملك شجاعة الغوص في الموضوعات الصعبة دون خوف أو تردد. قصتها هذه إضافة نوعية للأدب العربي المعاصر، وصوت يستحق الإصغاء في زمن الضجيج والنسيان..
أهمية النص في الأدب والمجتمع
تذكَر هذه القصة بجدية وجسارة الأدب عند التصدي لموضوعات النسيان والحنين والفقد. النص بمثابة مرآة لتحولات الأسر أمام العلل المزمنة، يضيء مناطق الصمت والإرهاق، ويتيح للأفراد مراجعة علاقتهم بالحب والعطاء والذاكرة. كثيرون يغمضون أعينهم أمام شيخوخة القلب أو انهيار الرموز؛ في نص "ذاكرة في ظلال الغياب" نجد العكس: تفكيك لعقدة الصمت، واحتفاء بالتعاضد الإنساني رغم الفقد..
إنها مأساة إنسانية ومعضلة وجودية لطالما ألهمت الأدب العالمي ـ نجد شبيها له في «لا تزال آليس» لليزا جينوفا، أو في قصة ماركيز «ذاكرة غانياتي الحزينات»، حيث تتحول الذاكرة إلى مسرح للحنين والفقد والانطفاء..
*
قصة "ذاكرة في ظلال الغياب" نص رفيع، خدمه بجدارة أسلوب الكاتبة الشفاف.. واختزالها البليغ للوجع، ونضجُ رؤيتها للذاكرة باعتبارها الجدار الأخير في حرب الإنسان مع النسيان. تضم النصوص الأدبية العربية والعالمية القليل من الأعمال التي سبرت أغوار فقدان الذاكرة بهذا الصفاء والعمق..
انها تطرح العلاقة بين الفرد وذاته وذكرياته بوصفها سؤالاً وجوديًّا ممتدًّا. قصة تستحق أن تُقرأ وتروَّج كوثيقة أدبية وإنسانية واجتماعية عالية القيمة، تُكرس للأدب أدواره الجمالية والعلاجية معًا.
***
طارق الحلفي