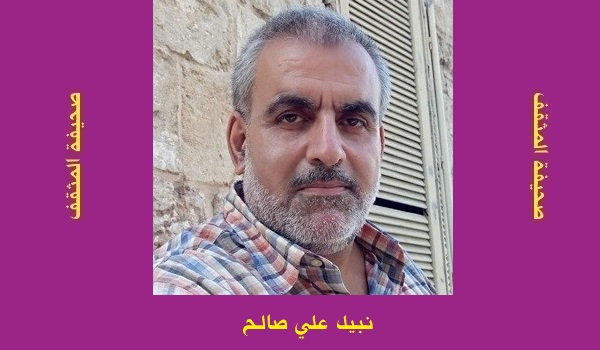دراسات وبحوث
خليل إبراهيم الحمداني: العدالة الانتقالية كأداة للصراع المادي

دراسة في الاقتصاد السياسي للعراق ما بعد 2003
1. تمهيد: وعد العدالة المنقوض
- عندما انهار نظام حزب البعث في العراق في أبريل 2003، ساد شعور عارم بالتفاؤل بأن حقبة مظلمة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد ولّت إلى غير رجعة. بدا أن الطريق قد أصبح ممهداً لبناء دولة جديدة قائمة على أسس الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة المتساوية. وفي قلب هذا المشروع، برز مفهوم "العدالة الانتقالية" كآلية أساسية لمعالجة إرث الماضي الشنيع، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وجبر ضرر الضحايا، وتحقيق مصالحة وطنية تضمن عدم تكرار مآسي الماضي. لقد كانت هذه هي الرواية المعلنة، الوعد الذي قُدم للعراقيين وللعالم.
- لكن بعد مرور أكثر من عقدين، تبدو هذه الصورة المثالية بعيدة كل البعد عن الواقع العراقي المرير. فبدلاً من أن تكون جسراً نحو المصالحة، تحولت آليات العدالة الانتقالية، من اجتثاث البعث إلى المحاكمات والتعويضات، إلى أدوات لتكريس الانقسام، وتصفية الحسابات السياسية، وتغذية دوامات العنف الطائفي. وكما يلاحظ العديد من الباحثين، فإن العملية التي كان من المفترض أن "تعالج الانقسامات المجتمعية انتهى بها الأمر إلى تعميقها" (International Center for Transitional Justice, 2009, p. 5). لقد أصبح واضحاً أن هناك انفصالاً جذرياً بين الأهداف المعلنة للعدالة الانتقالية ونتائجها الفعلية على الأرض.
2. الإشكالية البحثية: ما وراء التفسيرات السياسية
- تُرجع معظم التحليلات هذا الفشل إلى أسباب سياسية مباشرة، مثل "تسييس" العملية من قبل الأحزاب السياسية الجديدة، أو "هيمنة منطق عدالة المنتصر"، أو ببساطة "تفشي الاستقطاب الطائفي". ورغم صحة هذه الملاحظات، إلا أنها تظل في معظمها وصفية، وتعالج أعراض المشكلة لا جذورها. فهي تفشل في الإجابة عن السؤال الأعمق: لماذا كان تسييس العدالة الانتقالية أمراً حتمياً تقريباً في السياق العراقي؟ ولماذا اتخذ هذا الشكل العنيف والمادي تحديداً؟
- إن الاكتفاء بالقول بأن "السياسيين فاسدون" أو أن "الطائفية متجذرة" هو تفسير غير مكتمل، لأنه يتجاهل البنية الاقتصادية التحتية التي تجعل من هذه السلوكيات استراتيجيات عقلانية ومنطقية للفاعلين السياسيين. هذه الدراسة تتجاوز التفسيرات السياسية والأيديولوجية السطحية لتطرح إشكالية بنيوية: كيف أثرت طبيعة الاقتصاد العراقي كـ "دولة ريعية" (Rentier State) على مسار وتوظيف آليات العدالة الانتقالية، وحولتها من مشروع قانوني-أخلاقي إلى ساحة صراع مادي واقتصادي؟
3. الأطروحة المركزية: من العدالة إلى الغنيمة
- تجادل هذه الدراسة بأن تسييس العدالة الانتقالية في العراق لم يكن مجرد فشل سياسي أو انحراف عن مسارها المثالي، بل كان نتيجة حتمية ومنطقية لطبيعة الصراع على الموارد في بنية الدولة الريعية. في دولة يعتمد اقتصادها بشكل شبه كامل على ريع النفط الذي توزعه الدولة، تصبح السيطرة على جهاز الدولة هي الجائزة الكبرى والهدف الأسمى لأي صراع سياسي. في هذا السياق، لم تعد العدالة الانتقالية مجرد آلية لتحقيق العدالة، بل أصبحت "البنية الفوقية" الأيديولوجية والقانونية التي تم من خلالها خوض صراع مادي شرس حول إعادة توزيع الثروة والسلطة.
- لقد كانت العدالة الانتقالية هي الساحة القانونية والأخلاقية التي خيضت فيها معركة اقتصادية لإعادة هيكلة الطبقات الاجتماعية في العراق. كانت الغاية هي تحديد "من يحصل على ماذا" من ثروة النفط الهائلة. وكما يجادل توبي دودج (Toby Dodge)، فإن عملية بناء الدولة بعد 2003 لم تكن حول بناء مؤسسات ديمقراطية بقدر ما كانت "إعادة بناء عنيفة للدولة العراقية" تهدف إلى تمكين نخب جديدة من السيطرة على مواردها (Dodge, 2012, p. 154). لقد تم استخدام خطاب "العدالة للضحايا" و"معاقبة الجلادين" كغطاء أيديولوجي فعال لهذه العملية المادية البحتة التي حولت الدولة من كيان يفترض أنه يخدم المواطنين إلى "غنيمة يتم التنافس عليها" (Isam al-Khafaji, 2004, p. 22).
4. أهمية البحث
- تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها:
أ) تقدم إطاراً تحليلياً جديداً (الاقتصاد السياسي المادي) لفهم فشل العدالة الانتقالية في العراق، يتجاوز التفسيرات الثقافوية أو السياسية السطحية.
ب) تربط بشكل منهجي بين النظرية (الدولة الريعية والمادية التاريخية) والتطبيق (آليات اجتثاث البعث والتعويضات)، مما يوفر فهماً أعمق لجذور الصراع.
ج) تكشف كيف يمكن استخدام الخطاب القانوني والأخلاقي للعدالة كقناع لتبرير الصراعات المادية وإعادة تشكيل علاقات القوة الاقتصادية في المجتمعات التي تمر بمراحل انتقالية، وهو درس مهم يتجاوز الحالة العراقية.
1. هيكلية البحث
- للإجابة على إشكالية البحث وإثبات أطروحته، تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول. يبدأ الفصل الأول بوضع الإطار النظري عبر شرح مفاهيم العدالة الانتقالية، والمادية التاريخية، ونظرية الدولة الريعية. ينتقل الفصل الثاني لتحليل البنية التحتية للاقتصاد السياسي العراقي، مبيناً كيف أن نظام المحاصصة ما هو إلا آلية لتقاسم ريع النفط. أما الفصل الثالث، وهو جوهر الدراسة، فيحلل بالتفصيل كيف تم استخدام أدوات البنية الفوقية (اجتثاث البعث، المحاكمات، التعويضات) كأدوات في الصراع المادي. وأخيراً، يستعرض الفصل الرابع النتائج والآثار المترتبة على هذه العملية، وأهمها تفتيت مفهوم المواطنة وتحويله من علاقة حقوق إلى علاقة غنائم وولاءات.
مصادر
* Dodge, Toby. (2012). Iraq: From War to a New Authoritarianism. Routledge.
* International Center for Transitional Justice (ICTJ). (2009). Truth and Justice in Iraq's Transition: The Case of the Anfal Campaign.
* Al-Khafaji, Isam. (2004). Tormented Births: Passages to Modernity in Europe and the Middle East. I.B. Tauris.
الفصل الأول: الإطار النظري والمفاهيمي: من العدالة المثالية إلى الصراع المادي
مقدمة الفصل:
- يهدف هذا الفصل إلى بناء العدّة النظرية اللازمة لتحليل إشكالية البحث. ففهم تحول العدالة الانتقالية في العراق من مشروع للمصالحة إلى ساحة للصراع يتطلب تجاوز السرديات السياسية اليومية والانتقال إلى مستوى أعمق من التحليل البنيوي. للقيام بذلك، سيقوم هذا الفصل بتعريف وشرح ثلاثة مفاهيم أساسية تشكل مجتمعة الإطار التحليلي لهذه الدراسة: أولاً، مفهوم العدالة الانتقالية كنموذج معياري أو مثالي في "البنية الفوقية" القانونية والأخلاقية. ثانياً، نظرية المادية التاريخية التي تقدم أداة لفهم العلاقة بين "البنية التحتية" الاقتصادية للمجتمع و"بنيته الفوقية" السياسية والقانونية. وثالثاً، نظرية الدولة الريعية التي تشرح الطبيعة المحددة للبنية التحتية الاقتصادية في العراق، وتكشف عن منطق الصراع الدائر فيها. وأخيراً، سيقوم الفصل بتركيب هذه المفاهيم معاً ليقدم إطاراً متكاملاً يفسر حتمية "تسييس" العدالة الانتقالية في سياق ريعي.
المبحث الأول: العدالة الانتقالية - مبادئ "البنية الفوقية" المثالية
- في جوهرها، تُمثل العدالة الانتقالية مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي تهدف إلى معالجة إرث واسع النطاق من انتهاكات حقوق الإنسان في مجتمعات تمر بمرحلة تحول ديمقراطي أو خروج من صراع. لا تهدف هذه الآليات إلى تحقيق العدالة بمعناها الجنائي الصرف فحسب، بل تسعى إلى تحقيق أهداف أسمى تشمل "كشف الحقيقة، وتحقيق المصالحة، وتأكيد هوية الضحايا، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة" (شعبان، عبد الحسين، 2010، ص 55). وقد حددت الأمم المتحدة أربعة أركان أساسية تشكل قوام أي عملية شاملة للعدالة الانتقالية، وهي:
1. الحق في المعرفة (كشف الحقيقة): ويشمل حق الضحايا والمجتمع ككل في معرفة الحقيقة الكاملة حول الانتهاكات التي وقعت، من خلال آليات مثل لجان الحقيقة والتحقيق.
2. الحق في العدالة (المساءلة والمحاسبة): ويتضمن التحقيق في الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها، سواء أمام محاكم وطنية أو دولية، لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
3. الحق في جبر الضرر (التعويضات): ويشمل تقديم تعويضات مادية ومعنوية فردية وجماعية للضحايا، مثل رد الحقوق، والتعويض المالي، وإعادة التأهيل، والاعتذار الرسمي.
4. ضمانات عدم التكرار: وتتضمن إصلاحات مؤسسية واسعة (في قطاع الأمن، والقضاء، والإدارة) تهدف إلى تفكيك الهياكل التي سمحت بوقوع الانتهاكات في المقام الأول (تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، "سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع وما بعد الصراع"، 2004، الفقرة 8).
- هذه الأركان الأربعة تمثل النموذج المثالي أو المعياري للعدالة الانتقالية. إنها تنتمي إلى "البنية الفوقية" للمجتمع، أي عالم القانون والأخلاق والأيديولوجيا، حيث يُفترض أن هذه المبادئ السامية قادرة على إعادة تشكيل المجتمع نحو الأفضل. ولكن لفهم لماذا تم تشويه هذا النموذج المثالي وتفريغه من محتواه في العراق، يجب علينا أن ننتقل من عالم المبادئ إلى عالم المصالح المادية الذي تحكمه، كما توضح المادية التاريخية.
المبحث الثاني: المادية التاريخية - كشف العلاقة بين القاعدة والبناء الفوقي
- تقدم المادية التاريخية، إطاراً تحليلياً يرى أن فهم أي مجتمع (بسياساته وقوانينه وثقافته) يبدأ من فهم أساسه الاقتصادي. الفرضية الجوهرية لهذه النظرية هي أن "أسلوب إنتاج الحياة المادية هو الذي يحدد عملية الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية بصورة عامة" (ماركس، كارل، 1986، "مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي"، ص 9). تقوم النظرية على التمييز بين مفهومين أساسيين:
* البنية التحتية (القاعدة الاقتصادية - Base): وتشمل قوى الإنتاج (الأدوات، التكنولوجيا) وعلاقات الإنتاج (علاقات الملكية، من يملك ومن يعمل، وكيف يتم توزيع ناتج العمل). هذه هي البنية الحقيقية للمجتمع.
* البنية الفوقية (Superstructure): وتشمل كل ما هو غير اقتصادي: الدولة، القانون، السياسة، الأيديولوجيا، الدين، الفن، والأخلاق.
- وفقاً لهذا المنظور، فإن البنية الفوقية لا تنشأ من فراغ، بل هي انعكاس للبنية التحتية الاقتصادية وتعمل على خدمتها وتبريرها وترسيخها. فالقوانين السائدة في مجتمع ما، والمفاهيم السائدة عن "العدالة"، ليست مبادئ مجردة أو أبدية، بل هي نتاج علاقات القوة المادية في ذلك المجتمع. وبالتالي، إذا أردنا أن نفهم لماذا اتخذت "العدالة" شكلاً معيناً في العراق ما بعد 2003، فلا يجب أن ننظر إلى نصوص القوانين فحسب، بل يجب أن نحلل طبيعة القاعدة الاقتصادية التي طُبقت فيها هذه القوانين.
- المبحث الثالث: الدولة الريعية - تشريح البنية التحتية الاقتصادية للعراق
وهنا يأتي دور نظرية الدولة الريعية لتشرح لنا طبيعة هذه القاعدة الاقتصادية. فالعراق لا يمثل اقتصاداً رأسمالياً إنتاجياً بالمعنى الكلاسيكي، بل هو النموذج الأبرز "للدولة الريعية". ويعرّف حازم الببلاوي، أحد أبرز منظري هذا المفهوم، الدولة الريعية بأنها تلك التي "تعتمد بشكل جوهري على ريع خارجي تحصل عليه من التعامل مع بقية دول العالم" (الببلاوي، حازم، 1990، "الدولة الريعية في الوطن العربي"، ص. 67).
- هذه البنية الاقتصادية الفريدة تخلق سلسلة من الخصائص التي تحدد طبيعة السياسة والصراع:
أ) الدولة هي الموزع الأكبر للثروة: على عكس الدولة الإنتاجية التي تجبي الضرائب من المجتمع، فإن الدولة الريعية تحصل على ثروتها من الخارج (النفط) ثم توزعها على المجتمع. هذا يقلب العلاقة رأساً على عقب؛ فبدلاً من أن يدعم المجتمع الدولة، تصبح الدولة هي التي "ترعى" المجتمع أو فئات منه.
ب) السياسة كصراع على التوزيع: يصبح الهدف الرئيسي للنشاط السياسي ليس المشاركة في صنع السياسات العامة، بل "الوصول إلى آلية توزيع الريع والتحكم فيها" (الببلاوي، 1990، ص. 74). الصراع السياسي يتحول إلى صراع مادي مباشر حول من يحصل على حصة أكبر من كعكة النفط.
ج) ضعف الرابط بين المواطن والدولة: في غياب الضرائب، يضعف مبدأ "لا ضرائب دون تمثيل". المواطنة لا تعود قائمة على عقد اجتماعي من الحقوق والواجبات، بل على علاقة زبائنية مع الدولة الموزعة للغنائم.
هذه البنية التحتية الريعية هي "المسرح" الذي طُبقت عليه مبادئ العدالة الانتقالية المثالية.
المبحث الرابع: تركيب الإطار النظري - حتمية تحويل العدالة إلى غنيمة
- الآن، يمكننا تركيب المفاهيم الثلاثة معاً لنبني إطارنا التحليلي:
أ) لدينا بنية فوقية مثالية (العدالة الانتقالية) بأهدافها السامية في تحقيق المصالحة وسيادة القانون.
ب) ولدينا بنية تحتية اقتصادية (الدولة الريعية) حيث المنطق الحاكم هو صراع صفري بين النخب للسيطرة على آلية توزيع الثروة النفطية.
ج) وفقاً للمادية التاريخية، فإن البنية الفوقية ستخضع لمنطق البنية التحتية وتتحول إلى أداة لخدمتها.
- النتيجة الحتمية لهذا التفاعل هي أن العدالة الانتقالية، بكل آلياتها، سيتم تفريغها من محتواها الأخلاقي وتوظيفها كسلاح في الصراع المادي. لن تكون المساءلة والمحاسبة بحثاً عن العدالة، بل أداة لإزاحة الخصوم الاقتصاديين والسياسيين والاستيلاء على مواقعهم. ولن تكون التعويضات جبراً لضرر الضحايا، بل آلية لتوزيع الريع وشراء الولاءات السياسية. وكما يشير المفكر العراقي فالح عبد الجبار، فإن العملية السياسية في العراق بعد 2003 كانت مدفوعة بمنطق "اقتصاد سياسي للمحاصصة الطائفية"، حيث تسعى كل نخبة إلى "تعظيم حصتها من الريع الحكومي" (عبد الجبار، فالح، 2007، "الدولة، الديمقراطية والمسألة الطائفية في العراق"، ص. 112). في هذا السياق، لم تكن العدالة الانتقالية إلا ساحة أخرى، وربما الأكثر فاعلية، لممارسة هذا المنطق المادي.
مصادر:
* الببلاوي، حازم. (1990). "الدولة الريعية في الوطن العربي" ضمن كتاب الدولة الريعية. تحرير: حازم الببلاوي وجياكومو لوتشياني. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
* شعبان، عبد الحسين. (2010). أسئلة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. بيروت: منشورات ضفاف.
* عبد الجبار، فالح. (2007). الدولة، الديمقراطية والمسألة الطائفية في العراق. بيروت: دار الساقي.
* ماركس، كارل. (1986). مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي. (ترجمة: أنور محمود). بيروت: دار الطليعة.
* الأمم المتحدة، الجمعية العامة ومجلس الأمن. (23 أغسطس 2004). سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع وما بعد الصراع: تقرير الأمين العام. (S/2004/616).
الفصل الثاني: البنية التحتية: الاقتصاد السياسي العراقي وتحولات ما بعد 2003
مقدمة الفصل:
- بعد أن وضعنا الإطار النظري في الفصل الأول، ينتقل هذا الفصل من التنظير إلى التشخيص. يهدف إلى تحليل "البنية التحتية" المادية الحقيقية للدولة العراقية، تلك القاعدة الاقتصادية التي شكلت المنطق الخفي والمحرك الأساسي للأحداث السياسية والقانونية التي تلت عام 2003. سيجادل هذا الفصل بأن انهيار الدولة المركزية البعثية لم يؤدِ إلى ولادة دولة مؤسسات حديثة، بل أدى إلى تفكيك احتكار توزيع الريع وفتح الباب أمام صراع محموم بين نخب سياسية جديدة للسيطرة على هذا الريع. وقد تبلور هذا الصراع في نهاية المطاف في نظام "المحاصصة الطائفية"، الذي لا يجب فهمه كصيغة سياسية لتقاسم السلطة فحسب، بل كآلية اقتصادية لتقاسم ثروة الدولة الريعية.
المبحث الأول: الدولة الريعية البعثية - مركزية العنف والغنيمة
- لكي نفهم طبيعة التحول الذي حدث بعد 2003، لابد أولاً من فهم طبيعة الدولة التي انهارت. كانت الدولة العراقية تحت حكم حزب البعث تجسيداً صارخاً للنموذج الريعي السلطوي. فالدولة، التي كانت تسيطر بشكل كامل ومطلق على عائدات النفط الهائلة، لم تستخدم هذا الريع لبناء اقتصاد إنتاجي متنوع، بل استخدمته لتحقيق هدفين أساسيين: أولاً، بناء آلة عسكرية وأمنية قمعية ضخمة لضمان السيطرة المطلقة على المجتمع، وثانياً، إنشاء شبكة واسعة من الزبائنية والمحسوبية لشراء ولاء قطاعات اجتماعية معينة وضمان تبعيتها للدولة.
- وكما يصف المفكر العراقي كنعان مكية، فإن النظام لم يكن مجرد ديكتاتورية، بل "جمهورية خوف" قائمة على "إعادة توزيع الثروة النفطية بشكل انتقائي لخدمة بقاء السلطة" (مكية، كنعان، 1991، "جمهورية الخوف"، ص 45). في هذه البنية، كانت الدولة هي المالك والموظِّف والمانح الوحيد. وكانت العلاقة بين المواطن والدولة ليست علاقة حقوق وواجبات، بل علاقة خضوع وولاء مقابل الحصول على حصة من الريع (وظيفة، قطعة أرض، امتيازات). لقد كانت السيطرة على الدولة في ظل هذا النظام تعني السيطرة المطلقة على كل شريان للحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
المبحث الثاني: انهيار 2003 - تفكك الاحتكار و"التدافع على الغنيمة"
- لم يكن غزو العراق عام 2003 مجرد عملية تغيير نظام سياسي، بل كان بمثابة تحطيم السد المركزي الذي كان ينظم توزيع مياه الريع. لقد أدى حل الجيش والأجهزة الأمنية، واجتثاث كوادر الدولة العليا، إلى انهيار الآلية المركزية التي كانت تحتكر توزيع الثروة والسلطة. هذا الانهيار خلق فراغاً هائلاً، ليس سياسياً فحسب، بل اقتصادياً بالدرجة الأولى.
- هذا الانهيار خلق فراغاً هائلاً، ليس سياسياً فحسب، بل اقتصادياً بالدرجة الأولى. وقد انعكس هذا التحول في الوعي الثقافي والأدبي العراقي، حيث تحولت صورة الدولة في المخيلة العامة من مؤسسة جامعة إلى مجرد غنيمة. ويجسد الروائي العراقي سنان أنطون في أعماله، مثل رواية "فهرس"، هذا الشعور العميق بالخيبة، حيث يتم تصوير الدولة ما بعد 2003 ليس كمشروع وطني، بل كمصدر للصراع والإثراء على أنقاض مجتمع مدمر (أنطون، 2013). لقد بدأ سباق محموم ومفتوح بين هذه القوى للسيطرة على مفاصل الدولة" ليس من أجل الحكم، بل من أجل الوصول إلى منابع الريع النفطي الذي تسيطر عليه هذه المفاصل، وتحديداً الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة.
المبحث الثالث: نظام المحاصصة كآلية اقتصادية لتقاسم الريع
- إذا كان "التدافع على الغنيمة" هو ما ميز المرحلة الأولى بعد 2003، فإن "نظام المحاصصة الطائفية والعرقية" هو الآلية التي تم ابتداعها لترسيم هذا التدافع وتحويله إلى نظام مستقر. على السطح، تم تقديم المحاصصة كصيغة سياسية لضمان "تمثيل جميع المكونات" في السلطة. لكن في جوهرها المادي، كانت المحاصصة، كما يصفها فالح عبد الجبار، "اقتصاداً سياسياً" يقوم على تحويل الدولة إلى "مجموعة من الإقطاعيات الحزبية-الطائفية" (عبد الجبار، فالح، 2007، "الدولة، الديمقراطية والمسألة الطائفية في العراق"، ص 155).
- بموجب هذا النظام غير المكتوب، تم توزيع الوزارات والمناصب العليا في الدولة بين الأحزاب المهيمنة وفقاً لوزنها الطائفي والعرقي. وكل حزب حصل على وزارة، لم يتعامل معها كمؤسسة دولة تخدم كل المواطنين، بل "كمحفظة استثمارية" خاصة به. وأصبحت الوزارة أداة لتحقيق هدفين ماديين:
أ) توزيع الريع المباشر: عبر توظيف الآلاف من أنصار الحزب ومؤيديه في الوزارة، بغض النظر عن الكفاءة، مما يضمن بناء شبكة واسعة من الولاءات التي تعتمد في بقائها على استمرار الحزب في السلطة.
ب) استخلاص الريع غير المباشر: عبر التحكم في عقود الوزارة ومناقصاتها، وتوجيهها إلى رجال أعمال وشركات مرتبطة بالحزب، مما يولد تدفقات مالية ضخمة تمول الآلة الحزبية وتثري قادتها.
- وهكذا، فإن البنية التحتية للاقتصاد السياسي العراقي بعد 2003 لم تعد دولة مركزية واحدة، بل تحولت إلى "أرخبيل من الإقطاعيات الريعية" المتنافسة، حيث كل قطعة من الدولة هي مصدر غنيمة لفئة سياسية معينة. هذه هي القاعدة المادية الصلبة التي ستُبنى عليها "البنية الفوقية" الهشة للعدالة الانتقالية، والتي ستخضع حتماً لمنطق الصراع على الغنائم هذا.
مصادر:
* أنطون، سنان. (2013). فهرس. (ترجمة المؤلف). بيروت: دار الجمل.
* عبد الجبار، فالح. (2007). الدولة، الديمقراطية والمسألة الطائفية في العراق. بيروت: دار الساقي.
* مكية، كنعان. (1991). جمهورية الخوف: السياسة في عراق صدام. (ترجمة: فؤاد شربل). بيروت: دار الساقي.
الفصل الثالث: البنية الفوقية: العدالة الانتقالية كساحة للصراع المادي (دراسة حالة)
مقدمة الفصل:
- بعد أن حللنا في الفصل السابق طبيعة "البنية التحتية" للاقتصاد السياسي العراقي كنظام محاصصة لتقاسم الريع، يركز هذا الفصل على "البنية الفوقية". سنقوم بتفكيك الآليات الرئيسية للعدالة الانتقالية التي طُبقت في العراق ليثبت أنها لم تكن أدوات محايدة لتحقيق العدالة، بل تحولت بشكل منهجي إلى أسلحة فعالة في الصراع المادي بين النخب السياسية الجديدة. سيتم تحليل ثلاث آليات مركزية: أولاً، "اجتثاث البعث" كعملية نزع ملكية اقتصادية وإحلال طبقي. ثانياً، "المحاكمات الجنائية" كأداة للشرعنة الأيديولوجية التي تبرر السيطرة على الدولة. وثالثاً، "مؤسسات جبر الضرر" كقنوات مباشرة لتوزيع الريع وشراء الولاءات.
المبحث الأول: اجتثاث البعث كعملية "نزع ملكية اقتصادية"
- ظاهرياً، تم تقديم قانون اجتثاث البعث كضرورة أخلاقية لتطهير الدولة من عناصر النظام السابق وضمان عدم عودته. لكن من منظور مادي، كانت العملية أعمق وأشمل من ذلك بكثير؛ لقد كانت أكبر عملية "نزع ملكية" اقتصادية وإدارية في تاريخ العراق الحديث. لم يكن الهدف مجرد إقصاء أيديولوجي، بل كان إفراغ جهاز الدولة الريعي من شاغليه القدامى لخلق مساحة للشبكات الزبائنية التابعة للنخب الجديدة.
- بدأت العملية بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (1) الذي كان "شاملاً وغير تمييزي"، وأدى إلى طرد عشرات الآلاف من الموظفين والعسكريين، ليس بناءً على جرائم ارتكبوها، بل لمجرد انتمائهم الحزبي أو رتبتهم الوظيفية. وكما يصف علي علاوي، الذي كان وزيراً في تلك الفترة، فإن العملية تحولت بسرعة من إجراء محدود ضد مجرمي الحرب إلى "عملية انتقامية واسعة النطاق أدت إلى شل قدرة الدولة العراقية على العمل" (علاوي، علي، 2007، "احتلال العراق: الفوز في الحرب وخسارة السلام"، ص 245).
- لكن "شلل الدولة" هذا كان هو تحديداً الفراغ الذي احتاجته الأحزاب الجديدة لملئه. فكل وظيفة تم إفراغها، من مدير عام إلى موظف بسيط، تحولت إلى غنيمة يتم توزيعها على أنصار الحزب وقواعده الاجتماعية. وهكذا، لم يكن الاجتثاث مجرد إقصاء سياسي، بل كان آلية عنيفة لإعادة الهيكلة الطبقية: تم تجريد طبقة بيروقراطية وتكنوقراطية كاملة، كانت تستفيد من ريع الدولة البعثية، من موقعها الاقتصادي والاجتماعي، وتم إحلال "طبقة جديدة" مكانها، لا تستمد شرعيتها من الكفاءة، بل من ولائها الحزبي-الطائفي وقدرتها على الوصول إلى الريع.
المبحث الثاني: المحاكمات الجنائية كأداة للشرعنة الأيديولوجية
- إذا كان الاجتثاث هو الأداة المادية للاستيلاء على جهاز الدولة، فإن محاكمة رموز النظام السابق في المحكمة الجنائية العراقية العليا كانت الأداة الأيديولوجية لمنح هذا الاستيلاء شرعية أخلاقية مطلقة. لم تكن المحاكمات مصممة لتكون عملية كشف حقيقة شاملة لكل جرائم الماضي التي عانى منها جميع العراقيين، بل كانت "مسرحاً سياسياً" يهدف إلى تحقيق هدف محدد: ترسيخ سردية "الضحية-الجلاد" التي تصور النخب الجديدة كوريث شرعي وحيد للسلطة بصفتها الضحية المطلقة للنظام السابق.
- لقد انتقدت منظمات حقوقية دولية، مثل هيومن رايتس ووتش، المحاكمات مراراً لافتقارها إلى "معايير المحاكمة العادلة الأساسية" وفشلها في "إظهار العدالة بشكل مستقل وحيادي" (هيومن رايتس ووتش، 2006، تقرير "الحكم بالإعدام: محاكمة صدام حسين"، ص 3). هذا الافتقار للإجراءات القانونية السليمة لم يكن مجرد "خطأ" تقني، بل كان منطقياً من وجهة نظر سياسية. فالهدف لم يكن عملية قانونية معقدة قد تكشف عن حقائق مزعجة للجميع، بل كان إصدار حكم إدانة سريع وحاسم يثبّت السردية المطلوبة.
- من خلال التركيز على جرائم محددة (مثل الدجيل والأنفال) وتقديمها كدليل على الشر المطلق للنظام القديم، تمكنت النخب الجديدة من تبرير سيطرتها الكاملة على الدولة باعتبارها "ضرورة تاريخية" لمنع عودة هذا الشر. وبهذا، أصبحت العدالة الجنائية هي الغطاء الأخلاقي الذي يبرر عملية الاستحواذ المادي على موارد الدولة التي تم تحليلها في الفصل الثاني.
المبحث الثالث: مؤسسات "جبر الضرر" كقنوات لتوزيع الريع
- لعل المثال الأكثر وضوحاً على تحول العدالة الانتقالية إلى آلية اقتصادية هو مؤسسات "جبر الضرر"، وتحديداً "مؤسسة الشهداء" و"مؤسسة السجناء السياسيين". ففي حين أن الهدف المعلن لهذه المؤسسات هو تعويض ضحايا النظام السابق، وهو هدف نبيل بحد ذاته، إلا أنها في سياق الدولة الريعية تحولت بسرعة إلى قنوات مؤسسية لتوزيع الريع النفطي على القواعد الاجتماعية للأحزاب الحاكمة.
- لقد أصبحت هذه المؤسسات، بميزانياتها الضخمة وامتيازاتها الواسعة (رواتب، قطع أراضٍ، منح دراسية)، جزءاً لا يتجزأ من "اقتصاد المحاصصة". وأصبح الحصول على صفة "شهيد" أو "سجين سياسي" لا يعتمد دائماً على إثباتات دقيقة، بل على الوساطة الحزبية والانتماء السياسي. لقد تحولت هذه المؤسسات إلى أدوات قوية لشراء الولاء، حيث يتم مكافأة الموالين للحزب الحاكم بمنحهم هذه الامتيازات الريعية، مما يضمن استمرار دعمهم.
- وهكذا، تم خلق "تسلسل هرمي للضحايا"، حيث يتم الاحتفاء بضحايا معينين (مرتبطين بالأحزاب الحاكمة) ومنحهم امتيازات مادية ضخمة، بينما يتم تجاهل ضحايا آخرين (مثل ضحايا العنف ما بعد 2003 أو من لا يملكون وساطة حزبية). وهذا يؤكد ما ذهب إليه فالح عبد الجبار بأن الصراع في العراق هو حول "تعظيم حصة كل جماعة من الريع الحكومي" (عبد الجبار، فالح، 2007، ص 112). لقد أصبحت حتى معاناة الماضي سلعة يتم توظيفها في هذا الصراع، حيث لم يعد جبر الضرر حقاً إنسانياً، بل امتيازاً ريعياً يتم توزيعه وفقاً لمنطق الغنيمة والولاء.
مصادر:
* علاوي، علي أ. (2007). احتلال العراق: الفوز في الحرب وخسارة السلام. (ترجمة: نصير الأنصاري وعمر الأيوبي). بيروت: دار الساقي.
* عبد الجبار، فالح. (2007). الدولة، الديمقراطية والمسألة الطائفية في العراق. بيروت: دار الساقي.
* هيومن رايتس ووتش. (نوفمبر 2006). "الحكم بالإعدام: محاكمة صدام حسين" (A Gavel of Their Own: The Trial of Saddam Hussein). (متاح باللغة العربية على موقع المنظمة).
الفصل الرابع: النتائج والآثار: إعادة تعريف الدولة والمواطنة
مقدمة الفصل:
- بعد أن أثبتت الفصول السابقة كيف خضعت "البنية الفوقية" للعدالة الانتقالية لمنطق "البنية التحتية" الريعية في العراق، يتناول هذا الفصل النتائج الكارثية لهذه العملية. يجادل بأن تحويل العدالة إلى غنيمة لم يكن مجرد فشل سياسي، بل أدى إلى تفكيك الأسس التي تقوم عليها الدولة الحديثة والمجتمع المدني. سيناقش هذا الفصل ثلاث نتائج رئيسية: أولاً، تآكل العقد الاجتماعي وتحول الدولة في وعي المواطن من مؤسسة للحقوق إلى مصدر للغنائم. ثانياً، تفتيت مفهوم المواطنة المتساوية وظهور "مواطنة متدرجة" تحددها علاقة الفرد بمنظومة المحاصصة والريع. وأخيراً، كيف أدى هذا الإقصاء المادي الممنهج إلى تغذية دوامات العنف، مما يثبت أن العدالة الانتقائية لا تنتج سلاماً، بل صراعاً جديداً.
المبحث الأول: تآكل العقد الاجتماعي والدولة كـ "غنيمة"
- يقوم مفهوم الدولة الحديثة على فكرة "عقد اجتماعي"، حيث يتنازل المواطنون عن بعض حرياتهم للدولة مقابل أن توفر لهم هذه الدولة الحماية والأمن وتضمن حقوقهم بشكل حيادي ومؤسسي. لقد أدت العملية التي حللناها في العراق إلى تمزيق هذا العقد الاجتماعي بشكل كامل. فالدولة، التي تم توزيعها كإقطاعيات حزبية-طائفية، لم تعد تظهر للمواطن كحكم محايد أو ضامن للحقوق، بل "كمجموعة من الشبكات الزبائنية المتنافسة التي تخدم مصالحها الخاصة" (International Crisis Group, 2008, "Iraq After the Surge," p. 15).
- لقد تحولت علاقة المواطن بالدولة من علاقة قائمة على الحقوق إلى علاقة قائمة على الولاء والزبائنية. فلكي يحصل المواطن على أبسط حقوقه (وظيفة، رعاية صحية، أمن) لم يعد يكفي أن يكون "مواطناً"، بل أصبح عليه أن يجد لنفسه مكاناً ضمن إحدى شبكات المحاصصة، وأن يقدم الولاء للحزب الذي يسيطر على المؤسسة التي تقدم الخدمة. وكما يلاحظ المفكر غسان سلامة في تحليله للدول العربية المتعثرة، فإن الدولة عندما تفقد قدرتها على تقديم الخدمات بشكل شامل، تتحول إلى مجرد "غنيمة" تتصارع عليها الميليشيات والأحزاب، ويفقد المواطن أي شعور بالانتماء إليها (سلامة، غسان، 1987، "المجتمع والدولة في المشرق العربي"، ص 98). هذا بالضبط ما حدث في العراق، حيث أصبحت مؤسسات العدالة الانتقالية نفسها جزءاً من هذه الغنيمة، مما أفرغ مفهوم "سيادة القانون" من أي معنى حقيقي.
المبحث الثاني: تفتيت المواطنة وولادة "المواطنة المتدرجة"
- لعل الأثر الأخطر لهذه العملية هو أنها لم تكتفِ بتدمير العقد الاجتماعي، بل قامت بإعادة تعريف مفهوم "المواطنة" نفسه، وتفتيته من مفهوم واحد متساوٍ للجميع إلى نظام طبقي غير معلن. لقد أصبحت وثائق العدالة الانتقالية (مثل شهادة "المساءلة والعدالة" أو هوية "مؤسسة الشهداء") بمثابة "أوراق مواطنة" جديدة تحدد القيمة الاقتصادية والاجتماعية للفرد. يمكننا تمييز ثلاث درجات من هذه المواطنة الجديدة:
أ) المواطن المستحق (الدرجة الأولى): هو الفرد الذي ينتمي إلى الشبكات الحاكمة ويحمل وثائق تثبت أنه "ضحية" للنظام السابق. مواطنته هنا مادية وملموسة، تُترجم مباشرة إلى راتب من الدولة، وامتيازات، وحصة من الريع. هذه الفئة لا تحتاج إلى الدولة كمؤسسة حقوق، لأن الحزب يوفر لها كل شيء.
ب) المواطن المشتبه به (الدرجة الثانية): هو الفرد الذي يُصنف، سواء كان ذلك صحيحاً أم لا، كجزء من النظام القديم أو منافس للنظام الجديد. قوانين اجتثاث البعث تجعل مواطنته مشروطة ومعلقة. هو محروم بشكل ممنهج من الوصول إلى اقتصاد الدولة الريعي (الوظائف العامة والعقود)، وعليه أن يعيش في خوف دائم من الملاحقة. حقوقه ليست مضمونة، بل تخضع للابتزاز السياسي.
ج) المواطن الهامشي (الدرجة الثالثة): هو المواطن الذي لا ينتمي بوضوح لأي من الفئتين. إنه يشكل الأغلبية الصامتة التي تجد نفسها خارج قنوات توزيع الريع الرسمية. مواطنته فارغة من أي محتوى اقتصادي، ولكي يبقى على قيد الحياة، عليه أن يلجأ إلى الفساد والواسطة والقطاع غير المنظم.
- بهذا المعنى، لم تعد المواطنة في العراق صفة قانونية مجردة، بل أصبحت تصنيفاً اقتصادياً تحدده أدوات العدالة الانتقالية. لقد نجحت هذه الأدوات في "خلق حدود جديدة للإدماج والإقصاء داخل المجتمع العراقي" (Dodge, Toby, 2012, p. 171)، مما حول المجتمع من أمة مواطنين إلى مجموعة من الفئات المتنافسة على فتات الدولة.
المبحث الثالث: تغذية دوامات العنف والصراع
- إن النظام الذي يخلق مثل هذا الإقصاء المادي والرمزي الممنهج لا يمكن أن ينتج سلاماً. فالعدالة الانتقالية، التي كان هدفها المعلن هو ضمان "عدم التكرار"، انتهت بأن خلقت الظروف المادية والنفسية لتكرار العنف بصور جديدة وأكثر بشاعة. لقد وفر الشعور العميق بالظلم والإقصاء الاقتصادي والتهميش السياسي، الذي ترسخ لدى قطاعات واسعة من المجتمع (خاصة بين العرب السنة) نتيجة لسياسات اجتثاث البعث الانتقامية، "بيئة خصبة لتجنيد المقاتلين من قبل الجماعات المتمردة والمتطرفة" (International Crisis Group, 2008, p. 21).
- لم يكن صعود تنظيم القاعدة في العراق، ومن بعده تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مجرد ظاهرة أيديولوجية مستوردة، بل كان له جذور عميقة في الواقع المادي الذي خلقته سياسات ما بعد 2003. لقد استثمرت هذه التنظيمات خطاب المظلومية السنية، ووفرت بديلاً اقتصادياً واجتماعياً للشباب الذين تم إغلاق أبواب الدولة الريعية في وجوههم. وبهذا نصل إلى النتيجة المأساوية: العملية التي بدأت باسم "العدالة للضحايا" انتهت بخلق أجيال جديدة من الضحايا، وأنتجت صراعاً أكثر دموية من الذي كانت تهدف إلى معالجته. إنها النتيجة الحتمية عندما تتحول العدالة من غاية أخلاقية إلى وسيلة في صراع مادي لا يرحم.
***
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان
..................................
مصادر أولية تم استخدامها في هذه المسودة:
* سلامة، غسان. (1987). المجتمع والدولة في المشرق العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
* Dodge, Toby. (2012). Iraq: From War to a New Authoritarianism. Routledge.
* International Crisis Group. (2008). Iraq After the Surge: The Need for a New Strategy. Middle East Report N°81.