
مفتتح: أصبحت مسألة التراث والموروث الثقافي، موضة كل المنتديات واللقاءات الفكرية والكتابات الثقافية فكثيرة جدا الكتب والمطبوعات التي تصدر والندوات واللقاءات التي تعقد في مختلف أنحاء العالم لتدارس هذه المسألة والقضية، وتسعى هذه الكتابات والندوات إلى تحديد نوعية العلاقة التي يجب إن تربط الأمة وموروثها الثقافي.
بالطبع فإن هذا التوجه نحو الماضي والتراث بشكل عام يستجيب لذلك الإحساس الذي تستشعره الأمة العربية والإسلامية في حاضرها، وهو ضرورة العودة إلى تاريخها وأصالتها والإستمداد منه لتكوين الوجود الثقافي والحضاري بعيدا عن الإستنساخ الحرفي لحضارة الغرب ونمط عيشه وحياته.
انهيارات الواقع
ولا شك أن توجه الأمم والشعوب نحو تاريخها وموروثها الثقافي تشرطه دوافع الحاضر ومتطلباته وتؤثر فيه إلى حد بعيد. والذي يراجع التاريخ يكتشف أن الشعوب تزداد إشغالا بتاريخها وماضيها حين يكون حاضرها مأزوما ويعيش القهقري، فكيف يمكن إغفال حالة التزامن في ظهور تاريخ الطبري وفتنة القرامطة.
إن الأزمات الكبرى التي تطال حاضر الإنسان دائما تدفع به إلى أستعادة تاريخه والإنشداد إلى ماضيه المجيد، ولذا ليس من الصدف والعبثية إن يطغى على الخطاب العربي بعد حرب 1967م إنشغال عميق بدراسة التراث وإعادة قراءته، والواقع أن عودة الأمم إلى تاريخها حين تأزم حاضرها هو نوع من الإدراك الطبيعي والإيجابي الذي تتمتع به الأمة، حيث غبية تلك الأمة التي تحاول تبديل حاضرها المأزوم من دون إستعادة ماضيها وموروثها الثقافي والعقدي.
وغبية تلك الأمة التي تستغني عن تجاربها التاريخية وتنطلق من الصفر، فلا يبتدئ من الصفر إلا الصفر نفسه !(والمجتمعات المأزومة،كما يعلمنا التاريخ، هي أكثر المجتمعات عناية بماضيها، بإعادة الانتباه إليه، وإعادة التفكير فيه وقراءته، عساها تعثر في خبرته التاريخية عن أجوبة ناجزة أو خدمات قابلة لتصنيع أجوبة، عن مشكلات حاضرها.وقد تأخذ الأزمة في هذه الحال، شكل انقسام ثقافي واجتماعي داخلي، حول تصور المستقبل، بين قوى مهيمنة، تفرض هيمنتها باسم ماض تخلع عليه أردية من التقديس، وقوى جديدة صاعدة، تحاول أن تعيد قراءة ذلك الماضي في ضوء مصالحها الجديدة. كما قد تأخذ الأزمة شكل خوف على الهوية مما يتهددها من أخطار المحو، أو التلاشي، أو التهميش، على نحو ماعرفت ذلك مجتمعات تعرضت للاحتلال الأجنبي. وهي ربما أخذت أشكالا أخرى مختلفة تبعا لنوع الشروط التاريخية والبيئات الاجتماعية التي نشأت فيها).
ولكن هذا التوجه إلى التراث ومتعلقاته الذي نشهده حاليا في حياتنا الثقافية والفكرية العربية والإسلامية، لا زال محتاجا إلى كثير تقويم ودراسة، فلا يخلو من سلبيات متعددة، وأول هذه السلبيات وأخطرها، أن أغلب الدراسات والقراءات المتواجدة حاليا تنطلق من مفاهيم ومنهجيات غربية، فتكون إمكانية الرؤية والإبصار تتحكم فيها مناهج الغرب وتطوراته، والمنهج بطبيعة الحال ليس أداة صامتة سالبة، وإنما هو وساطة تنهض بمسؤولية خطيرة، وهي تقل الموضوع إلى الذات، ولذا فالوساطة المنهجية الغربية حين تتصادم بتراثنا وتاريخنا لا تنقل إلينا منه إلا ما يتوافق مع مسلماتها العقدية والفلسفية، وهكذا لا تعجب حين تنقل إلينا الوساطة المنهجية مكونات هامشية من تاريخنا وتغفل أو تتجاوز المكونات الحقيقية لتاريخنا وماضينا.
كيف نقرأ التراث
سعت مختلف المدارس الفكرية والسياسية في المجال العربي إلى الاستفادة من التراث في تدعيم أيدلوجياتها وتسويغ خياراتها وأنها الامتداد الفكري والثقافي لتلك المدرسة أو الفئة في التاريخ والتراث.. فتحول من جراء ذلك التراث إلى فضاء للتوظيف بكل ما للكلمة من معنى.. فالتيارات العقلانية والمادية، عملت على إبراز هذه الجوانب من التراث، وكتبت في سبيل ذلك الكثير من الأبحاث والدراسات، التي توضح النزعات المادية والعقلانية في التراث.. كما أن التيارات النقلية والنصية عملت على إبراز هذا الجانب من التراث العربي والإسلامي.. فعمل كل طرف على إبراز رموزه من التراث، وانتصر للبعض على حساب البعض الآخر.. وكل طرف يدعي أن هذه الشخصية أو تلك الفئة هي الجانب الناصع الذي ينبغي إبرازه من تراثنا..
فعمل الجميع ومن مواقعهم الأيدلوجية والسياسية المختلفة على إعادة صوغ الماضي والتراث بما يتناسب ورؤى ومواقف هذه المجموعات من الراهن. فأصبح الموقف من التراث، هو انعكاس طبيعي لمستوى التباين الأيدلوجي والسياسي الحالي.. فيتم الصراع بأدوات وموضوعات وشخصيات تراثية. ولعل من أهم الأسباب التي ساهمت بشكل أو بآخر في تشويه التراث أو عدم فهمه ومعرفته حق المعرفة، هو حالة التوظيف والتعسف الأيدلوجي في التعامل مع التراث. فكل الأطراف تعاملت مع التراث، تعاملا انتقائيا وسياسيا.. فالذي يتبنى المقولات العقلانية فضل المعتزلة على غيرهم، واعتبرهم هم رموز الإسلام والتراث وتغافل أو تجاهل عن ما ارتكبوه من قمع فكري وعمليات إقصاء وتهميش حقيقيين لكل مخالفيهم في أيام المحنة. والذي تبنى المنهج الفلسفي رفع من شأن ابن رشد وذم غيره، واعتبر أن متطلبات النهوض المعاصر، بحاجة إلى إحياء تراث ابن رشد. ومن موقع آخر ولاعتبارات فلسفية وعرفانية، هناك من أبرز مساهمات ابن سينا وعده هو فيلسوف الإسلام الأول.. وهكذا تم التعامل مع التراث بكل مقولاته ورموزه بانتقائية فجة وتوظيف متعسف، لا يعتني بحقائق التراث ومعارفه، بل يعمل على تكريس خياراته ومتبنياته الراهنة. وهكذا تصر النخبة على حد تعبير (الفضل شلق) لدينا على التواصل مع التراث وعلى الانقطاع عن التاريخ كما مع العالم الخارجي الراهن، للتأكيد على أن إنجازاتها يجب أن لا تقاس بعظمة إنجازات الماضي ولا بالمقاييس العالمية الراهنة، بل على أساس معايير تصاغ داخليا، على أساس معايير تضع هي شروطها ومواصفاتها. فهي تشيد لنفسها، عن طريق مقولة التراث، مكانا تختبئ فيه، فلا تظهر عيوبها.. فالممارسة الفكرية والنظرية التي تقرأ التراث بعيون أيدلوجية معاصرة، هي ممارسة انتقائية، وتستهدف بالدرجة الأولى تعزيز المواقع الأيدلوجية وتوظيف التراث بكل دلالاته وشحناته المعنوية لخدمة بعض الأغراض السياسية والأيدلوجية المعاصرة.. لذلك فإننا نعتقد أن كل القراءات الأيدلوجية للتراث، هي قراءات انتقائية وليست أمينة للتراث، إذ تجاهلت جوانب عديدة منه، وتغافلت عن بعض أحداثه وشخصياته. من هنا نحن بحاجة اليوم إلى إعادة قراءة التراث قراءة جديدة نتجاوز من خلالها كل التحيزات الأيدلوجية التي مورست بحق التراث.. وفي تقديرنا أن من أهم مواصفات القراءة الموضوعية للتراث هي النقاط التالية:
1- أن تكون القراءة تحليلية، وتبتعد عن كل القراءات التبجيليةللتراث. نحن بحاجة أن نتعرف على هذا التراث بوصفه تجربة إنسانية – تاريخية، تحتضن الغث والسمين، وفيها المواقف الشجاعة كما فيها المواقف الانهزامية، وفيها الشخصيات العملاقة في علمها وعملها والتزامها، كما فيها الشخصيات الوصولية والانتهازية التي كان همها الأساسي هي مصالحها الآنية والضيقة.. لذلك فإننا بحاجة إلى قراءة تحليلية للتراث ترصد المتغيرات وتبحث عن أسبابها، وتتعامل مع التراث بوصفه تجربة إنسانية عميقة، تحتضن العناصر الخيرة والشريرة معا.. ومهمتنا هي قراءة التراث بموضوعية وبعيدا عن التحيزات الأيدلوجية أوالمواقف المسبقة..
2- إن التراث كتجربة إنسانية لا قدسية لها، لذلك من المهم أن نقرأ هذه التجربة بروح علمية رصينة وبعيدا عن الانتماءات الضيقة.. فالمطلوب هو التحرر من الرؤى الضيقة التي تعمل بشكل أو بآخر لتوظيف التراث لمصالح فئوية ضيقة.
فالقراءة المطلوبة للتراث، هي التي تتحلى بالعلمية حين التعاطي والتعامل مع مختلف أحداثه وشخصياته. وهنا من الضروري التفريق بين التراث والنص الديني. إذ أن التراث هو جملة المنجزات التاريخية الإنسانية في قطاعات الحياة المختلفة. وبالتالي فإن المقصود بالتراث هو مجموع اجتهادات وكسب الإنسان المسلم عبر التاريخ. بينما النص هو الوحي الإلهي الذي لا يأتيه الباطل ولا يعتو ره التغيير.
3- التراث في أي أمة، يتحول إلى مؤثر حقيقي وفاعل، حينما تتحرك الأمة باتجاه صناعة راهنها وفق نسقها الحضاري. أما السكون والجمود وتضخم عقلية ليس بالإمكان أبدع مما كان، فإنه يحول التراث إلى عبء يزيد من عوامل الإحباط في جسم الأمة. فالأمة المتحركة والفاعلة والحية هي وحدها التي تستفيد من تراثها الخاص وتراث الإنسانية أيضا..
والتراث في زمن الجمود والتقهقر الحضاري، يتحول إلى بديل عن الراهن. بمعنى أن المجتمع الجامد والمنهزم لا يستطيع أن يواجه واقعه بشجاعة، ويلجأ إلى تراثه، للعيش على أمجاده، ولكي يجبر نقصه الحالي.. لذلك فإن الاهتمام والاستغراق في التراث في زمن الهزائم، قد يكون هروبا من الحاضر واستقالة عن مسؤوليات المرحلة. فالتراث بعناوين متعددة حاضر بيننا، ولكن ينبغي أن لا نعتقد أنه بديلا عنا، أو يقف موقفا مضادا من كسبنا في مختلف مجالات الحياة الإنسانية.. لذلك كله لا يمكن أن نقرأ التراث قراءة حضارية ونحن نعيش السكون والجمود.. فالواقع الجامد لا يخلق إلا قراءة تبريرية وجامدة للتراث.. من هنا فإن من الشروط الأساسية لقراءة التراث قراءة صحيحة وسليمة هو فعالية المجتمع وحيويته وديناميته. فالجمود يحول التراث إلى وسيلة للهروب من تحديات وآفاق الراهن. كما أن السكون يحول التراث بكل مضامينه ورموزه إلى عبء حقيقي على الحاضر. فالحضور والحيوية والفعالية الاجتماعية، هي وحدها التي تفضي إلى قراءة حضارية للتراث. وبكلمة فإن النهضة الاجتماعية والثقافية، هي التي تجعل بتأثيراتها ومتوالياتها المجتمع من القيام بقراءة جديدة لتراثه، تحوله لمحفز ومحرض للمزيد من العمل والبناء.. لذلك فإن مهمة قراءة التراث، تتعدى مسألة طباعة الكتب التراثية والانكفاء على قضاياه أو همومه، وإحياء كل أشكال الفلكلور الشعبي، وتصل إلى مستوى التجاوز بالمعنى الفلسفي والمعرفي. بمعنى أن مهمة قراءة التراث، تتطلب الفعل الراهن والشهود الحضاري والحيوية الاجتماعية، حتى يتواصل الفعل الإنساني المبدع عبر التاريخ. والحفاظ الحقيقي على التراث، يتطلب العمل على البناء والإبداع.. فلا معنى لحفظ التراث ونحن نعيش الجمود والتراجع، إن الوسيلة الحقيقية لحفظ التراث، هي حيويتنا وأعمالنا النوعية التي تتجه صوب الفرادة والإنجاز..
فالقراءة الحية للتراث، تتطلب قاعدة اجتماعية نهضوية تستوعب حقائق التراث دون التيبس عندها، وتنطلق بوعي عميق نحو التطوير وخلق حقائق التقدم في الفضاء الاجتماعي.. فالجمود لا يفضي إلا إلى قراءة متخشبة وتبريرية للتراث، ولا يمكن الاستفادة من دروس التاريخ وعبر الماضي وحقائق التراث إلا بوعي ثقافي واجتماعي جديد، يزيل عن عقولنا كل أشكال الزيف ويطرد من فضائنا كل أشكال الترهل، ويعمل على التحرر من كل الأعباء والاحباطات التاريخية والاجتماعية.
وإن هويتنا الاجتماعية والثقافية، هي في صيرورة مستمرة، لا بمعنى أنها سيالة ورخوة، وإنما بمعنى أنها متجددة ولا يمكن أن تكون ثابتة حتى الجمود. وإن كل نقد للتراث وقراءة جديدة له، هي مساهمة في صيرورة الهوية وتجددها.
وإن المرحلة الراهنة بكل تحدياتها وصعوباتها وآفاقها وفرصها، تتطلب منا قراءة نهضوية وحضارية لتراثنا حتى نستمد منه عنفوانا وشهودا وحيوية، ونضيف إليه من جهدنا وسعينا الحثيث نحو صناعة المنجز وتحقيق التطلعات والطموحات العامة..
منهجية أو منهجيات
يبدو انه لا يمكن لأية أمة أو ثقافة أن تعيش بلا ماض وتاريخ.. حيث أن التاريخ والتراث، يشكل بالنسبة إلى جميع الثقافات، المخزون الرمزي والعقدي والنظام الفكري لتلك الثقافات.. لهذا لا يمكن أن نتصور أن هناك ثقافة بلا تاريخ وتراث.. ولكن تختلف الثقافات والمدارس الفكرية، في الموقف من الماضي والتاريخ والتراث.. فثمة ثقافات ومناهج فكرية، تمارس عملية القطيعة الإبستمولوجية مع تاريخها وتراثها، وتعتبر نفسها وليدة الحاضر بكل جوانبه وحقوله..
ولكننا نرى أن تحديد العلاقة بين حاضر الأمة الثقافي، بتراثها الثقافي والحضاري، مسألة أساسية في عملية فقه الحاضر..
فلا يوجد على مستوى التاريخ قطيعة، لأننا نحمل مسؤولية الماضي، لأن الماضي الموصول بالحاضر، والأثنين معا، لهما صلة بالمستقبل.. فلا فصل في التاريخ، هناك وصل استمراري لحركة التاريخ.. أي ثمة حتمية وجبرية يفرضها الوجود، جبرية السنن والقوانين، جبرية النتيجة المتصلة بالمقدمات، والنهايات الموصولة بالبدايات.. فلا يمكن إذا أن نقابل بين الحاضر والماضي، ونجعل تحقيق أحدهما على حساب الآخر.. ويشير إلى هذه المسألة الكاتب المصري (زكي نجيب محمود) بقوله: ليس الماضي جثة ميتة موضوعة، في تابوت، وعلينا نحن أبناء الحاضر أن نحافظ على هذا التابوت في المتحف.. بل هو أقرب إلى الرافعة، التي نزحزح بها الأثقال الراسخة، لتتحرك، ولهذا فنحن إذ نصنع ماضينا، من بين المادة الخامة القريرة التي خلفها لنا الآباء.. فإننا لا نحسن هذا الصنع، إلا إذا اخترنا الروافع التي تثبت الحياة في الحاضر، وفي الإعداد للمستقبل على حد سواء.. وإلا انقلب تاريخ الماضي بين أيدينا صخورا جوامد، تعرقل التيار دون الانسياب الدافق إلى الهدف..
فـ(عدم تحديد بوصلة نظرية) واضحة وسليمة في علاقة الحاضر بالماضي، يجعل الإنسان (الفرد والمجتمع)، يعيش الازدواجية في كل نواحي وحقول حياته..
لأن التراث يعتبر ذاكرة الأمة، فكلما كانت هذه الذاكرة حافظة، وقادرة، على الاستفادة من تجارب الماضي، وتوظيف ذاكرة الأمس لخدمة الراهن والمستقبل.. دون التوهم لحظة واحدة إننا نقف عند التراث فقط.. لأن التاريخ حركة سائرة دوما إلى الأمام، والأحداث، وإن بدت متشابهة في بعض ظواهرها وعناصرها، إلا أن شروطا جديدة ومختلفة تتولد باستمرار وبالتالي فإن الظواهر الجديدة تملي معالجات جديدة.. فالتراث ليس إجابة جاهزة عن أسئلة الراهن، إنه مجرد وعاء وذاكرة، وبمقدار استيعاب مضمون هذا الوعاء وجوهرة، تتوافر القدرة الكافية لمواجهة أعباء الحاضر والمستقبل.. وبهذا لا يصبح التراث كما يزعم البعض معيقا أو كابحا عن التقدم والتطور..
من هنا فإن التراث هو تلك الحصيلة من المعارف والعلوم والعادات والفنون والآداب والمنجزات المادية التي تراكمت عبر التاريخ. وهو نتاج جهد إنساني متواصل، قامت به جموع الأمة عبر التاريخ، وعبر التعاقب الزمني أصبحت هذه الحصيلة المسماة (التراث)، تشكل مظاهر مادية ونفسية ونمطا في السلوك والعلاقات، وطريقة في التعامل والنظر إلى الأشياء..
من هنا فإنه لا يجوز النظر إلى هذا التراث العربي والإسلامي، بأنه نهاية المطاف، أو قمة الإبداع الوحيدة، وأكمل صورة من صور الحضارة.. وإنما هو جهد إنساني استطاع أن يحقق قفزة نوعية في مسيرة الإنسان الفرد والمجتمع.. ويقول في هذا الصدد الروائي العربي (عبد الرحمن منيف): أن التراث الشعري للعرب مثلا، والذي هو ديوانهم عبر أغلب العصور كما يقال، يشكل فخرا لهم، ويعطيهم ميزة بالمقارنة مع الشعوب الأخرى.. لكن هذا التراث يجب ألا يكون قيدا عليهم في المرحلة الحالية أو المقبلة.. وما يقال عن الشعر، يمكن أن يقال عن الأمور الأخرى، بما فيها اللغة، والتي تعتبر سببا أساسيا في تشكيل الأمة العربية، وخلق مناخ ثقافي لها، ولكثير من الشعوب خلال فترات تاريخية طويلة.. بهذا المعنى نحن نتعامل مع التراث، وبهذا يتحول، تراث الأمة العربية والإسلامية، إلى سبب من أسباب الثراء والتطور لو أحسنا التعامل والاستفادة منه.. لأن التراث، كما هو التاريخ، يمكن أن يدفع ويساعد، إذا نظرنا إليه نظرة موضوعية، وأكدنا على الجوانب الإيجابية فيه، واستخرجنا العناصر الحية منه، لكي تستمر وتنمو.. وإذا هضمناه هضما جيدا، دون أن نغفل عن نبض العصر وحاجياته..
لهذا فإننا نرجع إلى تراثنا، قصد التزود، وحفز الهمم، والإبقاء على الأمل، والتماس القدوة والأنموذج.. لهذا فإن تكرار التراث، والانشغال السلبي به عن طريق الوقوف عنده.. وضعا كهذا على المستوى الحضاري، لا يمكن أن ينتج فكرا أو ثقافة قادرة على تأسيس القاعدة النظرية الضرورية للرقي والتطور على المستوى العام.. وبهذا يفقد المجتمع العربي والإسلامي الصلة الضرورية التي تربطه بتراثه وماضيه، من أجل استفزاز جانب الإبداع والابتكار في المجتمع.. لأن التاريخ كما يقول (كروتشه) هو بأجمعه تاريخ معاصر.. أي أن التاريخ يتألف بصورة أساسية من رؤية الماضي، من خلال عيون الحاضر وعلى ضوء مشاكله.. وأن العمل الأساسي للمؤرخ ليس فقط التدوين، وإنما وبالدرجة الأولى التقويم..
لهذا فإننا نحافظ على هويتنا الثقافية والاجتماعية، ليس عن طريق الانطواء والهروب إلى الماضي وذكرياته العديدة.. كما أنه ليس عن طريق الاستلاب والتبعية.. إن طريق الحفاظ على هوية المجتمع وتراثه، لا يأتي إلا عن طريق إعادة تنظيم الحياة العقلية والمادية والأخلاقية للمجتمع، على ضوء ثوابت الحضارة والتاريخ..
إن الهوية تعبر عن ذاتها، في الكفاح المستميت في تطوير التراث، لا في الانحباس فيه.. وفي تحرر الذات من رواسب الماضي السيئ، وأوهام المستقبل المجهول والغامض.. إن الهوية تتجسد في إطلاق إمكانات الذات في البناء والتطوير..
وهذا هو الرأسمال الأول، الذي ينبغي استخدامه لتنمية راهننا وصولا إلى بناء مستقبلنا المنشود.. وبهذا يتحول التراث إلى مصدر حيوي، لمدارس ثقافية – اجتماعية – تجديدية، تسعى لبناء حاضر هذا المجتمع وفق ثوابته التاريخية والحضارية.. وباستمرار تلح ضرورة قراءة التراث، والتعلق بالخصوصيات الحضارية أبان خضوع المجتمع لعمليات تغيير ثقافي أو اجتماعي سريعة، ولا تنسجم والخصوصيات الذاتية.. بدون فرق سواء جاءت عمليات التغير السريعة من الداخل أو الخارج..
وأن أي محاولة لقطع حاضر الأمة الثقافي والحضاري، عن ماضيها وموروثها الثقافي، لا يؤدي إلا إلى المزيد من ظهور الكيانات الاجتماعية المشوهة، والتي لا تقدر عمل أي شيء يذكر على المستوى الحضاري.. والعالم العربي والإسلامي ليس وحيدا على الصعيد الدولي حين يهتم بقراءة تراثه والعمل على إحيائه.. إذ تجد جميع الأمم والشعوب تهتم بهذه المسألة وتوليها أهمية قصوى.. والمثال البارز في هذا الصدد هو نقل ملحمة (بيود لف) الشهيرة من اللغة الإنجليزية القديمة إلى الإنجليزية الحديثة لتيسير قراءتها للأجيال المعاصرة.. كما أنه لم تهمل الأساطير اليونانية القديمة رغم أنها خرافات، تتعارض ونظريات العلم الحديث، وإنما خضعت لتفسيرات التحليل النفسي والتأويلات الأنثربولوجية..
وعلاقتنا بالتراث ليس علاقة ترفية أو كمالية، وإنما ترتقي إلى مستوى الدين والحضارة.. بمعنى أن علاقتنا بالتراث تنبع من أن في هذا التراث الأنموذج التطبيقي لديننا ومبادئنا أو ما يطلق عليه بـ(الإسلام التاريخي).. كما أن انجازات الأمة الحضارية ومكاسبها الإنسانية قد تبلورت وتحققت فعلا في تلك الحقبة التاريخية من الزمن التي نطلق عليها حاليا جزءا من التراث.. وعلى هذا فإن إخراج الإسلام وحضارته من التراث، يحول التراث إلى لا شيء..
وثمة مسوغات عديدة لضرورة قراءة التراث من جديد أهمها:
1- تجديد الرؤية: إن قراءة التراث (كما قلنا آنفا) ليس حالة ترفية تعيشها الشعوب والأمم.. وإنما هي حالة ضرورية لبناء الحاضر.. إذ أن القراءة الواعية للموروث الثقافي والحضاري، يؤسس العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية، لتجديد رؤيتنا إلى موروثنا الثقافي، وكيفية الاستفادة منه في حاضرنا.. لهذا فإننا لا نطلب الماضي لذاته، وإنما من أجل تجديد الرؤية، إلى الأصول والمنطلقات والقيم التي صنعت الماضي المجيد، لتوظيفها بما يخدم حاضرنا ومستقبلنا..
2- تحديات الواقع المعاصر: بفعل عمليات التحديث القسرية والسريعة التي أصابت العالم العربي والإسلامي، بدأ الواقع المعاش، يتشكل وفق منظومات وقيم جديدة.. وهذا أدى بشكل أو بآخر إلى تفكيك منظومة القيم السابقة، واللغة كأداة للتواصل الثقافي والاجتماعي، وجميع أشكال التواصل بين أبناء المجتمع الواحد.. وبطبيعة الحال فإن هذه العملية وتداعياتها، شكلت تحديا صريحا لشعوب العالم العربي والإسلامي..
والرجوع إلى التراث وقراءته من جديد، ما هو في حقيقة الأمر إلا من أجل مقاومة الانسحاق والاستلاب القيمي – الاجتماعي، وتحقيق التوازن المطلوب للعالم العربي والإسلامي أمام تحديات الواقع المعاصر..
3- تحقيق التطلعات: يخطأ من يعتقد أن تحقيق تطلعات العصر الحديث، يمر عبر إلغاء الذات والتراث.. لأنه لا يمكن لأي شعب أو أمة أن تحقق تطلعاتها، وهي فاقدة لذاتها.. فالشرط الأول والضروري لتحقيق التطلعات هو حضور الذات الحضارية لأنها هي القادرة وحدها في تحريك كل عوامل وعناصر المجتمع الفاعل والمؤثر والشاهد.. فقراءتنا للتراث، ليس هروبا من الحاضر ومسؤولياته وتحدياته (كما يزعم البعض) وإنما هي عملية واعية لتوفير كل شروط الانطلاقة الحضارية المنشودة..
أما كيف ينبغي أن تكون علاقتنا بالتراث، فنحددها بالنقاط التالية:
1- العلم بالتراث: من الثابت أن مجموعة البشرية، التي تنفصل عن تراثها وماضيها، فإنها تقوم بعملية بتر قسري لشعورها النفسي والثقافي والاجتماعي.. وسيفضي هذا البتر إلى الاستلاب والاغتراب الحضاري.. لهذا فإن العلاقة التي ينبغي أن تربطنا بتراثنا، هي علاقة (العلم)، حتى نتمكن من الاستفادة القصوى من المخزون الرمزي والمعرفي والشعوري الذي يوفره التراث للعالم به..
2- الإضافة إلى التراث: بما أن التراث عبارة عن الجهود الإنسانية المختلفة، التي أثرت في مجرى التاريخ والمجتمع.. لذلك فإن إيقاف مسيرة الإبداع الإنساني يعد ظلما لتراثنا المجيد.. لهذا فإن العلاقة التي ينبغي أن تربطنا بتراثنا، هي علاقة الإضافة.. بمعنى دفع الجهود الإنسانية في مختلف الحقول والجوانب لاستمرار حركة الإبداع في راهننا..
ويخطأ من يعتقد أن أوروبا الحديثة، تنكرت لتراثها وماضيها، وإنما الشيء الذي قامت به هو التخلي عن نظرة الكنيسة التي كانت تنظر بشكل سلبي، إلى حركة المجتمع وسعيه نحو الانفكاك منها..
وجماع القول: إن أهمية قراءة التراث، تنبع من ضرورة تحديد العلاقة السليمة بين الماضي والحاضر، في مستوى التقدم المادي (علاقة الإنسان بالطبيعة)، وفي قدرة الإنسان على التحكم بأسرار الطبيعة.. وإن هذا التصاعد في قدرة الإنسان على الطبيعة وتسخيرها ارتفاقا بها وانتفاعا منها، تطرح قضية العلاقة بين حاضرنا وتراثنا، باعتباره منجزا إنسانيا – اجتماعيا، حدث في حقبة زمنية على أرضنا التاريخية، وانطلاقا من ذات القيم التي نعتقد بها نحن.. وإن عدم تحديد العلاقة السليمة بين الماضي والحاضر، هي التي تنشأ حالة مزدوجة يعيشها إنسان هذا العصر.. حيث التقديس المطلق للماضي، والانبهار التام بمنجزات الحضارة الحديثة.. وحدها القراءة الواعية للتراث، هي التي تؤهلنا للجمع بين جمال الماضي وقوة الحاضر..
التراث سؤال أيدلوجي أم معرفي
إن التراث بما يتضمن من تجارب وخبرات، تشكل ذاكرة الأمة التي لا يمكن الاستغناء عنها.. فالحقب التاريخية بأحداثها وتجاربها لا تنتهي بمجرد زوالها الوجودي.. وإنما تظل حية في خبرة الأمة وذاكرتها.. لهذا لا يمكن القبول بمقولة انفصال ماضي أمة من الأمم وحاضرها وراهنها.. كما دعا إلى ذلك (مارينيت) بقوله: " إننا نريد أن نهدم المتاحف والمكاتب، فالمتحف والمقبرة صنوان متماثلان في تجانب الأجساد التي تتعارف بشكل محزن ونحس.. إنها مضاجع عمومية حيث تنام الأجساد جنبا إلى جنب مع كائنات مبغوضة أو غير معروفة .. خذوا المعاول والمطارق !.. قوضوا أسس المدن العريقة والمحترمة "..
فالحديث عن التراث ليس دفنا للحاضر والمستقبل، وإنما نحن نتعرف على التراث وكنوزه الثمينة، وننطلق من نقاط قوته والقيم التي صنعته، لفهم الحاضر والمشاركة بعقولنا وعملنا في صناعة مستقبلنا ومستقبل أجيالنا اللاحقة.. فالتراث ظاهرة مركوزة في التكوين الداخلي للأمة، لا يمكن الفكاك منه.. وإن الحفر المعرفي والتاريخي في تراثنا، لا يفضي إلى التعامل مع جوامد أو رمائم أو مومياءات، وإنما إلى خريطة ثقافية – حية، استطاعت في حقبة زمنية، أن تحولنا من أمة هامشية إلى أمة في قلب العالم وأحداثه وتطوراته.. وبهذا نحقق الوصل المعرفي بين ما ينبغي أن يكون حيا من تاريخنا وتجربتنا الماضية وحاضرنا..
لهذا فإن التقاط مركبات ذهنية وفكرية من الفضاء المعرفي الأوروبي، والعمل على تعميمها على النموذج العربي والإسلامي، لا يؤدي إلى معرفة سليمة لكلا الفضاءين (العربي والأوروبي).. لأن مجال المجتمع والحركة الإنسانية، ليس كمجال الميكانيكا، وهو لا يرتضي كل الاستعارات، لأن أي حل ذا طابع اجتماعي يشتمل تقريبا ودائما على عناصر لا توازن..لذلك فإن قراءة التراث ينبغي أن تتم وفق منهجية خاصة تنسجم وطبيعة الخصائص العقدية والتاريخية للمجتمع.. وعلى هذا من الضروري، أن نبتعد عن عملية الإسقاطات المنهجية، التي تتم على مستوى التاريخ والثقافة، حتى لا نكون جزءا من منظومة ثقافية – فكرية، لا تنتمي إلى بيئتنا وتربتنا الثقافية.. فقراءة التراث العربي والإسلامي، لا يمكن أن تتم بمنهجية غريبة عن بنية المجتمع وإنتاجه الإنساني عبر التاريخ.. وإنما من الضروري تأسيس المنهج الذاتي المنسجم وخصائص الأمة العقدية والتاريخية، حتى نتمكن من فهم التراث العربي والإسلامي على أكمل وجه..
ومن هنا نجد أن الكثير من الكتاب والمفكرين الذين قاموا بقراءة تراثنا العربي والإسلامي، بمنهجيات مختلفة ومتغايرة عن بيئتنا الذاتية، وصلوا إلى نتائج، لا تنطبق على تاريخنا، وإنما تنطبق على تاريخ ذلك المجتمع الذي أبدع المنهج.. والمثال المباشر لهذه المقولة هو (الموقف من العلم).. لقد حاول قراء التراث العربي والإسلامي، بمنهجيات الآخر الحضاري، أن يؤكدوا أن العرب والمسلمين، وقفوا موقفا سلبيا تجاه العلم ومنجزاته، اعتمادا على تعميم النموذج التاريخي الغربي.. إذ ينسجم هذا الموقف والمنهجية الغربية، لأن الميتودولوجيا الغربية، تضع استبعاد الدين شرطا أوليا لتحقيق العلمية..
بينما الموضوعية تقتضي القول: أن العرب والمسلمين وقفوا موقفا مشجعا للعلم والعلماء، واحترام منجزات الإنسان في شتى حقول الحياة.. لهذا نجد أن موضوعية (كونت) تؤكد في كتابه (نسق السياسة الوضعية) أنه: في الوقت الذي كان فيه الغرب المسيحي مشغولا بقضايا لاهوتية عقيمة، كان العالم الإسلامي ينفتح على العلم والمعرفة والفنون وبالتالي أصل اجتماعيته جنبا لجنب مع روحانيته.. إن التفوق الاجتماعي (يضيف كونت) وأهميته في التعاليم الإسلامية، أهلت المسلم، ليكون أكثر صلاحية من غيره اجتماعيا وأهلته للعالمية..
وقد أكد سان سيمون أيضا على مسألة أن انهيار الفكر اللاهوتي، كان مدينا لدخول العلوم العربية والإسلامية إلى أوروبا بعد أن غيرت طبيعة البنية الفكرية الخرافية لذلك التفكير.. يقول سان سيمون " إن ذلك (سقوط النظام الكنسي) حدث مع إدخال العلوم الوضعية إلى أوروبا عن طريق العرب، وقد خلق ذلك بذرة هذه الثورة المهمة التي انتهت اليوم تماما.. ويضيف: انطلاقا من القرن الثالث عشر كان روجر بيكون يدرس العلوم الفيزيائية بشكل رائع، وأن تفوق الوضعي على الحدسي والفيزيقي على الميتافيزيقي كان جد محسوس منذ البداية حتى من قبل السلطة الروحية نفسها إلى درجة أن كثيرا من الإيكليروس السامين،ومن بينهم اثنان من الباباوات توجهوا في نفس الفترة تقريبا إلى قرطبة، ليتموا تعليمهم مع دراسة العلوم القائمة على الملاحظة، على أيدي أساتذة عرب "..
وبهذا فإن استعارة منهجية غريبة عن بنيتنا العقدية والفكرية، ودراسة أوضاعنا وأحوالنا، من خلال تلك المنهجية، يجعل هؤلاء (أهل الاستعارة المنهجية) يفرضوا التشابه على غير التشابه، ويجعلون وطنهم يكرر أداء تمثيلية جرت وقائعها في بلاد أخرى، وضمن ظروف ومعطيات مختلفة.. وفي هذا تقليد مجانب للأصالة والاستقلالية والإبداع على حد تعبير الكاتب العربي (منير شفيق).. وبإمكاننا أن نضرب مثالا على الاستعارة المنهجية في قراءة التراث العربي والإسلامي، بالنتاج الفكري والثقافي للمفكر الجزائري (محمد أركون)، الذي يرى أن قراءة تراثنا الثقافي والفكري، ينبغي أن تتم بمنهجية (الإسلامية التطبيقية) التي تعتمد على العرض العلمي، والقراءة المجردة من كل تحيز أيدلوجي للتراث.. وهدف هذه المنهجية النهائي على حد تعبير أركون نفسه هو " خلق الظروف الملائمة لممارسة فكر إسلامي محرر من المحرمات العتيقة والميثولوجيا البالية، ومحررا من الأيدلوجيات الناشئة حديثا "..
وهو بهذا يسعى نحو تحقيق قطيعة ايستمولوجية مع فكر الإسلام وثقافته.. ويوضح (أركون) هذه المسألة بقوله: "إن نيتي العميقة أن أعطي مثالا لما ينبغي أن يكون عليه اليوم اجتهاد مخلص في مستوى القوة الروحية والعقلية لكبار المفكرين الكلاسيكيين، ولكن مع قطيعة عقلانية مع الدعاوى المنطقية والمسلمات الإيبستمولوجية، والجهاز التصوري لهؤلاء المفكرين أنفسهم وآمل أن تجلب كثير من القراءات إسهاما إيجابيا، لاستكشاف وتقدم الحقل الديني والحقل العلمي الذي ما فتئت متجهة إلى فتحة، لتجنب هذه القراءات العقيمة التي تأخذ جملة ما أو تعبيرا ما، لتشكل منه المحضر المعتاد ضد كل ما هو مخالف".. (مقال بعنوان الإنتروبولوجيا الدينية: نحو إسلامية تطبيقية)..
وهو منهج يتجنب الأحكام التقويمية للظاهرة، واعتبار النتائج التي ينتهي إليها البحث الإمبريقي وحدها نتائج علمية..
إننا لا يمكننا أن نقرأ تراثنا بدون منهجية واضحة، لأنه لا بحث سوسيولوجي بدون منهجية تحدد البحث وتوجهه.. والأبحاث والدراسات الأمبريقية المجردة، ما هي في حقيقة الأمر إلا عملية تجميع لأكوام من البيانات والمعلومات عديمة الدلالة والتحليل.. وقد عبر (كرين برينتن) عن أزمة الميثودولوجيا الغربية حيث قال:" إن العقل الذي يتسلط على مشكلات الدين، يستطيع أن يبين للناس، أنه ليس هناك شياطين..
والعقل الذي يعمل على مستوى البحوث الطبية والسيكولوجية، يستطيع أن يثبت أن الجنون اضطراب طبيعي في العقل (وربما في البدن) يؤسف له.. هو باختصار مرض يمكن أن يعالج أو يخفف على الأقل بمزيد من استخدام العقل ".. وهذه مسألة طبيعية لاعتماد المنهجية الغربية وتطبيقها على حقول مغايرة لها في المبنى والمعنى..
وهذا يعني أن المنهجية جزء من السياق العقدي والحضاري لأي مجتمع.. لهذا لا يمكن أخذ المنهج مجردا من مقولاته ونماذجه..لأنه تشكل في أحشاء النماذج التي عالجها، واكتسى باللحم من خلال الموضوعات التي ولدها..
وتأسيسا على هذا نجد أن التراث السوسيولوجي الذي يصدر انطلاقا من المنهجية الغربية، يسعى جاهدا للتأكيد على قيم الغرب ومتبنياته الفلسفية.. لهذا فإننا لا يمكننا أن نفهم مشاكلنا وأزماتنا المعاصرة، بمعزل عن فهم تاريخنا وتراثنا، والقوانين التي تتحكم في مساره، والمنهجية التي نستعملها في معالجة أمورنا وقضايانا.. لأن الانجاز الإنساني السابق الذي نطلق عليه اليوم مقولة (التراث) على علاقة مباشرة بالمنهج، والطريقة التي أفرزت النمط الاجتماعي والإنساني السابق.. لهذا لا يعقل أن ندرس المنجز الإنساني دون معرفة المنهجية والطريقة المتبعة التي أوصلت أولئك إلى هذا المنجز.. فالأنماط الاجتماعية والحضارية، تختلف باختلاف المناهج والمقولات والنماذج.. وعلى هذا لا يصح لنا أن ندرس النمط الاجتماعي والحضاري الإسلامي، بمقولات ونماذج منهجية تنتسب إلى نمط مجتمعي حضاري مختلف.. " فالذين يقرؤون الإسلام والتراث والتاريخ والأنماط المجتمعية الإسلامية، ومختلف ظواهرها من خلال ما يسمونه المنهج العلمي القائم على الموضوعات والنماذج المستمدة من النمط الحضاري الأوروبي ماضيا وحاضرا ليسوا من العلمية في شيء، وليس منهجهم علميا بالرغم من كل إدعاء.. لأنه من غير العلمي أن تقرأ الأنماط المجتمعية المختلفة، من خلال منظور التجربة الأوروبية، وعبر نظرة الغرب إلى نفسه وإلى العالم.. أما العلمية فتقضي الإمساك بالمنطق الخاص بسمات النمط المجتمعي الحضاري المحدد وآليات حركته ".. (الإسلام في معركة الحضارة – منير شفيق – ص 168)..
وعلى هذا فإن قراءة تراثنا العربي والإسلامي، وفق منطق مجتمعي وحضاري مغاير، يجعلنا نبتعد من رؤية الأشياء والأمور والقضايا على حقيقتها.. وبالتالي تضيع الحقيقة، كما هي في الواقع التاريخي نفسه.. وبهذا لا يمكننا أن نقرأ تراثنا وقضايانا التاريخية، وفق منهجية القراءة الغربية للتاريخ الأوروبي والحضارة الأوروبية..لأنها قراءة محكومة بمنطق خاص يختلف ومنطق التراث العربي والإسلامي.. والجدير بالذكر في هذا الصدد هو، أن ما يمنع التراث، من ممارسة دوره المأمول في حاضرنا وعصرنا، يرجع في اعتقادنا إلى المنهجيات الانتقالية الغريبة عن واقعنا، التي نستخدمها (أدوات ومفاهيم) لفهم تراثنا وماضينا القريب والبعيد.. إذ أن نقل (الخارج) معرفيا وحضاريا إلى (الداخل) مع اختلاف الخصوصيات والظروف، لا يؤدي إلى تطور الواقع الفكري والحضاري للداخل، وإنما على العكس يؤدي إلى تلاشي الذات وأفولها.. من هنا تنبع أهمية تحديد البوصلة النظرية، التي ننطلق منها لتقويم حاضرنا وبناء مستقبلنا وفق معايير وأهداف تلك البوصلة النظرية.. وأن هذه المقدمات المنهجية لقراءة تراثنا العربي والإسلامي، تهدف إلى وصل الحي بالحي، وتقديم خطاب عربي – إسلامي، ينسجم وتطلعات العصر..
وجماع القول: إن استخدام هذه المقاربة الواعية بين ماضينا وحاضرنا هي التي تؤدي إلى إخصاب فكرنا، وإخصاب مقدرتنا على العطاء والابتكار الحضاري..
الخاتمة
يشكل التراث حصيلة معرفية وسلطة رمزية ومضمون اجتماعي، لذلك حينما إلتفت إليه المثقفون، حاول كل طرف من أطراف المشهد الثقافي الاستيلاء على التراث، والتعامل معه، بوصف قيمه هي المعادل الموضوعي لذات القيم التي يحملها هذا الطرف أو ذاك.
لذلك شهدت حقبة الستينيات من القرن الماضي، محاولات عديدة قام بها اليسار العربي بكل تلاوينه للاهتمام بالتراث وخلق مقاربات فكرية وأيدلوجية بين متبنياتهم الأيدلوجية والفكرية والسياسية وأحداث التراث ومقولاته الأساسية. وهذه الممارسة بصرف النظر عن بواعثها الأيدلوجية والاجتماعية، هي تؤكد حقيقة ثابتة بواعثها الأيدلوجية والاجتماعية، هي تؤكد حقيقة ثابتة، مضادة أن التراث بشكل مادة عابرة لحقب التاريخ، وتتمكن كل الجماعات الأيدلوجية الإفادة من التراث مو مواده [ولقد يعيشه الناس، أو يعيشون بعضها من رموزه ومعطياته، كما يعيشون حاضرهم ومعطيات حاضرهم، من دون أن يشعروا بالتناقض. بل إنهم لا يشعرون بالتناقض لأنهم يخضعون ذلك الماضي لحاضرهم فيعيشونه كجزء من يومياتهم] (ص43)
نقد التراث
لذلك فإن كل المشكلات أو أغلبها، التي تطرح على التراث، هي مشكلات معاصرة، وتبحث عن رؤية أو حلول أو شرعية من التراث إلى الراهن. بمعنى أن جميع الأطراف الأيدلوجية في المجال العربي ـ الإسلامي، تعامل مع التراث بكل حقبه بنزعة أيدلوجية، بحيث تسعى كل منظومة أيدلوجية لتغطية خياراتها بنموذج تراثي أو ممارسة سياسية أو اجتماعية تشكلت في حقب التراث.
فالعودة إلى التراث لدى الغالبية من المهتمين، لم تكن عودة علمية ـ معرفية محصنة، بل هي عودة من أجل الاستقواء بالتراث ومقولاته وخلق حالة من الربط الأيدلوجي أو المعرفي أو الفكري بن لحظات وخيارات من التراث مع لحظات وخيارات راهنة ومعاصرة.
***
محمد محفوظ – كاتب وباحث سعودي








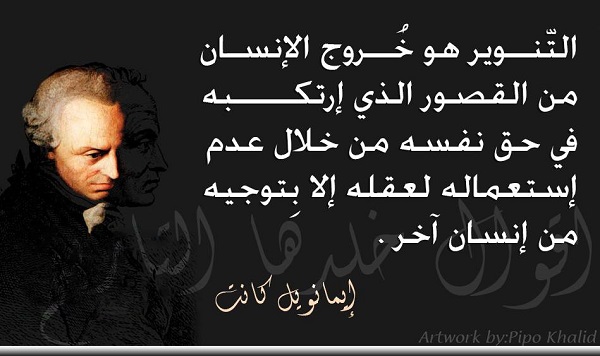







 لعل العنوان أو المصطلح المركب يبدو متناقضاً بين العرفان الذي هو تجربة ذوقية روحية باطنية فردية خارج دائرة المجتمع وانشغالاته ومصطلح السياسة الذي يشير إلى عملية بشرية اداتية لأدارة السلطة وشؤون الدولة عموماً، وهو أمرٌ دنيوي صرف ولا شأن له بعالم الباطن أو عالم الاخرويات.
لعل العنوان أو المصطلح المركب يبدو متناقضاً بين العرفان الذي هو تجربة ذوقية روحية باطنية فردية خارج دائرة المجتمع وانشغالاته ومصطلح السياسة الذي يشير إلى عملية بشرية اداتية لأدارة السلطة وشؤون الدولة عموماً، وهو أمرٌ دنيوي صرف ولا شأن له بعالم الباطن أو عالم الاخرويات. 1- بعدما بهت الذين كفروا أمام الذي رأوا في الصحيفة الظالمة من خلال تحقق معجزة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي كانت ذات قوة مضاعفة جمعت بين الصور المادية المتمثلة في انتقاء الحق من الباطل، كما ارتقت على كل العقول والتخمينات البشرية العادية إخبارا بالغيب كمعجزة معرفية وعلمية.
1- بعدما بهت الذين كفروا أمام الذي رأوا في الصحيفة الظالمة من خلال تحقق معجزة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي كانت ذات قوة مضاعفة جمعت بين الصور المادية المتمثلة في انتقاء الحق من الباطل، كما ارتقت على كل العقول والتخمينات البشرية العادية إخبارا بالغيب كمعجزة معرفية وعلمية. لا شك بأن ظاهرة الأسطورة تعتبر ظاهرة ثقافية، فهي تمثل المحاولة الأولى للأنسان في سعيه لأنتاج المعرفة، وهي تعكس شوق الأنسان لرصد الحقيقة، والغوص في أعماقها، وهي ظاهرة أختص بها الأنسان عن غيرة من الكائنات الأخرى، هذا التميز كان نتيجة لما يتمتع به هذا الكائن البشري من قدرات عقلية خلقت فيه قابلية التفكير، وأثارت فيه النزعة الملحة لأشباع نزعته المعرفية. فالأسطورة كانت تعتبر الخطوة الأولى للأنسان القديم في تصديه لمحاولة تفسير ما حوله من ظواهر طبيعية أثارت في نفسه الخوف والدهشة، كما أثارت فيه الرغبة والأمل في معرفة كنهها، ولعل لتجنب مضارها، وجلب فوائدها. أن أول سرد أسطوري وضعه الأنسان كان هو أسطورة التكوين، لأن معرفة الكون الذي هو جزء منه كان هاجسه الأول، وكان هاجساً قوياً هزه من الأعماق، مما جعلها تحتل في نفسة مكاناً مقدساً، وقد سيطرة على عقله ومشاعره، وسجلت درجة الأعتقاد منزلة القداسة، حتى بات يزاول طقوساً وشعائر يعبر بها عملياً عن شغفه وأحترامه لها، كما يمكننا القول بأن هذا الأعتقاد شكل أول خطوات التدين عند الأنسان، ومن ذلك سجل الدين له حضور منذ بداية ظهور الأنسان، ومن ذلك لا يمكن لأحدنا أن يجد مجتمعاً أنسانياً خالياً من الدين، منذ الخليقة وليومنا هذا، فالدين حاجه نفسية وعقلية . فالأسطورة كانت باكورة التدين، وهذا ما جعل الباحث فراس السواح يصفها في كتابه (الأسطورة والمعنى ص 20) بأنها (حكاية مقدسة) . أستمرت سطوة الأسطورة على نفوس وعقول البشر لفترة طويلة كنمط تفكير أوحد، الى أن جاءت الفلسفة كنمط تفكير متقدم، أنتقل فيه الأنسان من الخيال والحدس ووعي المشاعر الى التفكير العقلي والمنطقي، ومن نظرة التسليم المطلق لما جاء به السرد الأسطوري الى فلترة عقلية تعتمد في قناعتها على المسلمات المنطقية . هذا التحول في النظرة هو الذي حدى بأفلاطون بجمهوريته بأن صرح بضرورة أبعاد الشعر عن الجمهورية الفاضلة التي تقوم على العقل، لأن السماح بالشعر يعني فتح الطريق أمام الأسطورة (الأسطورة والمعنى ص31). يتضح من كتابات الدكتور خزعل الماجدي، بأستخدام حسه الشعري الخيالي، في التحليل التاريخي للأسطورة، كما أن لأفلاطون كل الحق في أبعاده للشعراء من جمهوريته الفلسفية، وأن هذه الجمهورية حسب أدعاءه تقوم ركيزتها على المنطق، في حين أن الدكتور الماجدي هو في الأصل شاعراً ومجيئه للدراسات التاريخية متأخر على شاعريته، فمزج شاعريته في المنهج العلمي للدراسات التاريخية وخاصة الأسطورة، مما جعله يقع بالمحذور الذي حذر منه أفلاطون بضرورة أبعاد الشعراء من هذا المجال الذي يعتمد بشكل أساس على المنطق.
لا شك بأن ظاهرة الأسطورة تعتبر ظاهرة ثقافية، فهي تمثل المحاولة الأولى للأنسان في سعيه لأنتاج المعرفة، وهي تعكس شوق الأنسان لرصد الحقيقة، والغوص في أعماقها، وهي ظاهرة أختص بها الأنسان عن غيرة من الكائنات الأخرى، هذا التميز كان نتيجة لما يتمتع به هذا الكائن البشري من قدرات عقلية خلقت فيه قابلية التفكير، وأثارت فيه النزعة الملحة لأشباع نزعته المعرفية. فالأسطورة كانت تعتبر الخطوة الأولى للأنسان القديم في تصديه لمحاولة تفسير ما حوله من ظواهر طبيعية أثارت في نفسه الخوف والدهشة، كما أثارت فيه الرغبة والأمل في معرفة كنهها، ولعل لتجنب مضارها، وجلب فوائدها. أن أول سرد أسطوري وضعه الأنسان كان هو أسطورة التكوين، لأن معرفة الكون الذي هو جزء منه كان هاجسه الأول، وكان هاجساً قوياً هزه من الأعماق، مما جعلها تحتل في نفسة مكاناً مقدساً، وقد سيطرة على عقله ومشاعره، وسجلت درجة الأعتقاد منزلة القداسة، حتى بات يزاول طقوساً وشعائر يعبر بها عملياً عن شغفه وأحترامه لها، كما يمكننا القول بأن هذا الأعتقاد شكل أول خطوات التدين عند الأنسان، ومن ذلك سجل الدين له حضور منذ بداية ظهور الأنسان، ومن ذلك لا يمكن لأحدنا أن يجد مجتمعاً أنسانياً خالياً من الدين، منذ الخليقة وليومنا هذا، فالدين حاجه نفسية وعقلية . فالأسطورة كانت باكورة التدين، وهذا ما جعل الباحث فراس السواح يصفها في كتابه (الأسطورة والمعنى ص 20) بأنها (حكاية مقدسة) . أستمرت سطوة الأسطورة على نفوس وعقول البشر لفترة طويلة كنمط تفكير أوحد، الى أن جاءت الفلسفة كنمط تفكير متقدم، أنتقل فيه الأنسان من الخيال والحدس ووعي المشاعر الى التفكير العقلي والمنطقي، ومن نظرة التسليم المطلق لما جاء به السرد الأسطوري الى فلترة عقلية تعتمد في قناعتها على المسلمات المنطقية . هذا التحول في النظرة هو الذي حدى بأفلاطون بجمهوريته بأن صرح بضرورة أبعاد الشعر عن الجمهورية الفاضلة التي تقوم على العقل، لأن السماح بالشعر يعني فتح الطريق أمام الأسطورة (الأسطورة والمعنى ص31). يتضح من كتابات الدكتور خزعل الماجدي، بأستخدام حسه الشعري الخيالي، في التحليل التاريخي للأسطورة، كما أن لأفلاطون كل الحق في أبعاده للشعراء من جمهوريته الفلسفية، وأن هذه الجمهورية حسب أدعاءه تقوم ركيزتها على المنطق، في حين أن الدكتور الماجدي هو في الأصل شاعراً ومجيئه للدراسات التاريخية متأخر على شاعريته، فمزج شاعريته في المنهج العلمي للدراسات التاريخية وخاصة الأسطورة، مما جعله يقع بالمحذور الذي حذر منه أفلاطون بضرورة أبعاد الشعراء من هذا المجال الذي يعتمد بشكل أساس على المنطق.






