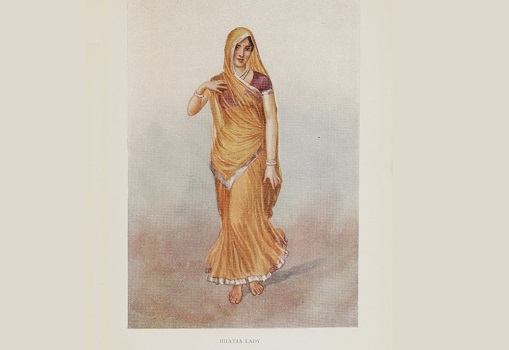قصة: سيلفيا مورينو-جارسيا
ترجمة: د. محمد عبد الحليم غنيم
***
قِيلَ لها إنها ستعرف دائمًا متى سيأتي حبيبها من خلال تعويذة عرافة. كانت لعبة تلعبها مع فتيات القرية الأخريات — معتقدات غريبة تنتقل من جيل إلى جيل. كانت التعويذة تتطلب أن تخلع العذراء قميص نومها وتضعه تحت وسادتها ليلة اكتمال القمر. فتحلم بوجه رجل، وفي الصباح، تجد شيئًا عند عتبة بابها يعطيها دليلًا عن هوية زوجها المستقبلي. لم تستطع جوديث أن تتذكر الوجه عندما استيقظت. ومع ذلك، بعد أن ارتدت ملابسها في عجلة، بالكاد تكلفت عناء تمشيط شعرها، رأت غصينًا على درجات منزلها. عرفت أنه يرمز إلى الأشجار، إلى الغابة وكان ذلك جيدًا، لأنها كانت تكره القرية وسكانها، وتُفضل بدلاً من ذلك تخيل مناظر الأراضي البعيدة وفي قصور رجالٍ وسيمين من طبقة النبلاء.
وبعد بضعة أشهر، تحققت النبوءة. دخل غريب إلى القرية متعثر الخطى. كان صيادًا، يرتدي معطفًا رماديًا من الصوف وحذاء أسود يصل إلى منتصف ساقه، يتمتم بكلمات غير مفهومة وهو يخطو إلى داخل المتجر. تظلّل وجهه قبعة واسعة الحواف. في الفترة من الربيع وحتى الخريف، كان يُقام سوق للمزارعين كل أسبوعين، لكن في قسوة الشتاء، كان متجر أختها من الأماكن القليلة التي يمكن للمسافر أن يبتاع منها بعض الضروريات.كانت أليس قد تزوّجت زواجًا جيدًا. وحين مات زوجها، ترك لها بيت الضيافة ذو الباب البنفسجي، والمتجر الملاصق له.
كان هناك نُزل في القرية، لكنه أغلق أبوابه حتى ذوبان الجليد. أما الحانة، فكانت أسرّتها موبوءة بالبراغيث. كل من احتاج مكانًا لائقًا للمبيت في فصل الشتاء، قصد بيت الضيافة. قال الرجل وهو يدخل المتجر ويخلع قبعته:
- قيل لي إنك تعرفين كيف أجد غرفة أقيم فيها.
كان ذا شعر بني فاتح، ووجه وسيم الملامح وقويّ التكوين. أنزلت جوديث الكتاب القديم الذي كانت تقرأه، وأومأت برأسها:
- أختي تدير بيت الضيافة المجاور. الغرف نظيفة، والطعام وفير.يمكنك أن تلقي نظرة على الغرف قبل أن تدفع، إن أحببت.
قال مبتسمًا:
- أعتقد أنها ستكون مناسبة. تبدين أهلًا للثقة، وإن لم يكن السعر باهظًا، فسأكون راضيًا.
ابتسم لها ابتسامةً كادت أن تسقط الكتاب من يدها. قالت:
- تعال معي.
أرشدت الرجل. وبينما كانا يسيران معًا، فكرت: "إنه هو، إنه هو، إنه هو".
***
كان اسم الصياد ناثانييل، وبقي طوال ذلك الشتاء، يستكشف الغابات والجداول القريبة، ثم يعود محمّلًا بالأرانب والثعالب التي تُسلخ جلودها لاستخدامها في صنع الفرو. كان الضيف الوحيد في المنزل، رغم أن أليس وجوديث والأطفال كانوا يعيشون هناك أيضًا.
قبل أن تتزوج أليس وتلد طفلين، عاشت الشقيقتان مع الجدة في منزل أصغر. كانت جوديث مضطرة لمساعدة الجدة في غسل الملابس التي كانت تتلقاها من الناس، فخشنت يداها منذ كانت طفلة صغيرة. أما أليس، فلم تضطر أبدًا لفرك قطع الصابون على الملابس، لأنها كانت جميلة، وتوقعت الجدة أنها ستتزوج رجلًا نبيلًا. وهذا ما حدث. انتقلت الجدة وجوديث للعيش في بيت الضيوف مع أليس، وبينما استطاعت أليس شراء فساتين مخملية وقفازات تدفئ يديها، وعاشت الجدة بقية أيامها في راحة، ظلّت حياة جوديث كما هي، لم تتغير.
كانت جوديث قد بلغت الثامنة عشرة من عمرها، لكنها ما زالت تغسل الملابس؛ غير أنها الآن تغسل لأليس، والتوأمين، والضيوف كذلك.
كان اسم الصياد ناثانييل، وكان وسيمًا أكثر مما يبدو للوهلة الأولى، بعينين جميلتين تعبران عن الكثير وضحكة مُبهجة. كان يحلق ذقنه بدقة ويمشط شعره بأناقة. كان يحكي في العشاء قصصًا تجعل الأطفال يصرخون من الفرح — كان التوأمان في الرابعة — وتجعل أليس تبتسم. كانت جوديث تبتسم هي الأخرى، وتغسل ملابسه بأقصى درجات الحرص، وتفرك أرضية غرفته حتى تبرق، وتنفض الغبار عن أرجاء المنزل لتضمن أنه لن يجد ما يشتكي منه. كان ناثانييل يتمتع بمظهر رجل نبيل، وأرادت أن تعاملَه على هذا الأساس. كان يقول: " صباح الخير، جودي. " كم بدا صوته جميلًا—عميقًا ونقيًا. وكانت تسأله: "صباح النور. ما الذي تأمل في صيده اليوم؟" فيخبرها إن كان يأمل في الحصول على فراء ثعالب أو ظربان، أو شيء آخر. ويتحدث عن قطع الأوتاد أو بناء المصائد، وكيف كان يصطاد في وقت فراغه في شبابه، لكنه الآن يحاول أن يصبح صيادًا محترفًا، فهناك مالٌ يُكسب في هذا العمل إن كان المرء ماهرًا بما يكفي. وكان المال هو ما يسعى إليه. ثم يلوح لها مودعًا بغمزة وابتسامة. وفي مناسبات قليلة، كان يوجه لها إطراءً، كان يقول: "جودي الجميلة، أراك لاحقًا" مما يجعلها تحمر خجلاً.
لسوء الحظ، لم يكن ناثانييل هو الوحيد الذي كان يصطاد ذلك الشتاء. لم تدرك جوديث ذلك إلا بعد فوات الأوان. كانت أليس ترتدي ملابس الحداد منذ عام، وفي أول أيام الربيع، أعلنت أن هذا يكفي. وعادت إلى ارتداء الفساتين الملونة التي تركتها في خزانتها.
وبعد ذلك بوقت قصير، أصبح واضحًا للجميع في البلدة — ما عدا جوديث ربما، التي حجبت أحلامها وخيالاتها الجامحة رؤيتها — أن أليس كانت تفكر في جعل الضيف ضيفا دائمًا في منزلهم. كان شابًا وسيمًا، وتهامس القرويون: كان زوج أليس الأول مريضًا،دميمًا، وثروته كانت تعويضًا عن قبحه.أما هذه المرة، فالأمر مختلف — الشاب قد كسب ودّ السيدة بسحره ووسامته. ورغم أن البعض رفعوا حواجبهم استغرابًا لهذا الزواج السريع، إلا أن الجميع اتفقوا على أنه لا يمكن توقع أرملة في الثالثة والعشرين أن تدير عملًا ومنزلًا بمفردها. كان الصياد مهذبًا؛ يستطيع القراءة والكتابة والحساب. ويستطيع إجراء أعمال في البلدة لا تستطيع أليس القيام بها. سيكون زوجًا ثانيًا مناسبًا.
كان اسم الصياد ناثانييل، وتزوج أليس في الصيف. انتقل من غرفته في الطابق الأرضي إلى إحدى الغرف في الطابق العلوي. اشترت له زوجته ملابس جديدة، وحقيبة حلاقة من الجلد الفاخر، وساعة جيب مطلية بالفضة. استمرت الحياة كما كانت من قبل، إلا أنه الآن كان يدخل المتجر في أيام معينة لمراجعة الحسابات ويصدر الأوامر للصبي العامل خلف المنضدة.
كان اسم الصياد ناثانييل، وللأسف، لم يكن عاشق جوديث.
في الخريف، جلست جوديث خارج المنزل على نفس الدرجات حيث وجدت ذات يوم غصيناً وظنته نذيراً بالرومانسية. نظرت باتجاه الغابة التي تمتد قريباً منهم، والأشجار تتحول من الأخضر إلى الذهبي إلي الأحمر.
أخبرها ناثانيل وهو ينزل ليقف بجانبها:
- سيكون شتاءً قاسياً.
سألته:
- كيف تعرف؟
قال:
- أستطيع أن أخمن. السماء تحذرنا
لكنها فقدت اهتمامها بالعلامات، فهزت كتفيها بلا مبالاة تجاه تنبؤه. قال:
- نعم، سيكون شتاءً قاسياً. يجب أن تتوقفي عن جمع الفطر. الذئاب ستكون متلهفة لأي لقمة، وقد أصبح الجو بارداً جداً على أي حال،.
ثم، للحظة، انتشرت قشعريرة في جسدها، إحساس خافت بالخوف. هزت رأسها باستخفاف. قالت:
- الذئاب لا تتجول أبداً بهذا القرب منا.. عشت هنا لفترة أطول منك.
استمرت في هز سَلَّتها والزحف إلى الغابة، رأسها منحنية وهي تبحث عن فطر الشانتيريل الذي ينبت حول أشجار الدردار والبلوط. مع تقدم الخريف، اضطرت للذهاب إلى أعماق الغابة، عبر الجدول، حتى وصلت إلى بستان التفاح القديم المليء بالأشجار الميتة.
بجوار البستان كانت هناك كوخ مهجور. تمتلكه عجوز، صديقة للجدة، كانت تعيش هناك، وفي بعض الأحيان كانت جوديث تحمل لها طرداً مقابل حلوى. لكن العجوز غادرت منذ عامين وانتقلت لتعيش مع ابنها. ما زالت تملك الكوخ، لكنها لم تعد تزوره. أوكلت العناية به إلى أخت جوديث، لكن جوديث هي التي اعتنت به. نما النبات وانتشر، يضرب الهيكل الذابل، لكن السقف بقي صلباً. أحياناً كانت جوديث تدخل، تشعل النار وتجلس على السرير الصدئ لتقرأ، هرباً من المتجر ونزل الضيافة.
كانت الجدة توبخ جوديث عندما تمسكها تقرأ، قائلة إن هناك أعمالاً منزلية يجب إنجازها، لكنها لم توبخ أليس عندما كانت تقف أمام المرآة تمشط شعرها، أو عندما تجلس في الصالون تنظر إلى مجلات الموضة. ماتت الجدة، والآن تستطيع جوديث أن تفتح كتاباً حتى يُصدر ظهرها صوتاً، جالسةً بلذة شرسة في دفء الكوخ لبعض الوقت.
في أحد الأيام، بينما كانت تقف خارج الكوخ تعد الفطر الأصفر الكبير في سَلَّتها، مرّ ناثانيل بخطوات واسعة. قال:
- الوقت متأخر أختك قالت إنه يجب عليّ إحضارك.
أزعجها تدخله، وأزعجها أكثر أن أليس أخبرته أين يمكن أن يجدها. كانت هذه البقعة مكاناً تلعب فيه الفتاتان معاً عندما كن أصغر سناً، قبل أن تتزوج أليس وتتظاهر بالأهمية، تدهن كريماً غالياً من اللوز على وجهها وتعطر مناديلها بالعطور. قال:
- غداً يوم السوق، تريد أليس أن تعودي إلى المنزل وتُهيئي الأسرة. هناك ضيوف سيصلون لقضاء الليل.
كان النزل والفندق والحانة يستقبل المسافرين الذين يبيعون بضائعهم في السوق، ويستضيفون الأعيان والأثرياء منهم. أما المزارعون البسطاء والعمال الشباب، الذين يتجمعون كباقات زهور مكتظة، فكانوا يصلون في الصباح الباكر جداً لبيع أو شراء البضائع بدلاً من السفر في الليلة السابقة. بعضهم كان يبيت عند الأصدقاء، والبعض الآخر كان ينام في الحقول كالمتشردين. سألت جوديث:
- ألا تستطيع هي تهيئة الأسرة بنفسها؟
لم تكن لتعبر عادةً عن أفكارها بهذه الصراحة، ولكن مع تقلص الموسم، كانت أليس تبذل أقل جهد ممكن في المساعدة بأعمال المنزل. لطالما كانت أختها على هذا النحو، لكنها حاولت لفترة قصيرة ذلك الصيف أن تصبح امرأة مجتهدة، ربما في محاولة لإظهار مهاراتها المنزلية لزوجها الجديد. لكن تلك الحماسة لم تدم طويلاً.
لم يجب ناثانيل. بعد أن كُلّف بإعادتها إلى المنزل، لم يكن ليسمح لها بالهرب. مشت معه غاضبةً عائدةً إلى النزل.
في الصباح، استيقظت مبكراً. كان آخر أيام السوق في الموسم. بعد ذلك، ستغلق القرية أبوابها على نفسها، لكن في ذلك اليوم، ولبضع ساعات ثمينة، كانت القرية تعج بالحركة والنشاط. كان هناك بيض للبيع، وأسماك مملحة، وأكياس بطاطس، ولكن أيضاً بضائع فاخرة: صناديق شاي، وفواكه مجففة، وشوكولاتة، وشرائط ودانتيل، وصابون معطر،و تبغ، ومسحوق أسنان. كان ناثانيل يبيع الفراء، وكان من المفترض أن تساعده جوديث.
كم أحبت أيام السوق في السنوات الماضية، لكن في هذا الخريف، أصبح من الصعب تحمل الوقوف بجانب ناثانيل وهو يتحدث إلى الزبائن - الوقوف قريباً منه جداً في كشكهم الصغير وهو يبتسم لها بلطف بينما قلبها يشتعل بعدم الراحة والتململ.
بينما كان ناثانيل منشغلاً بالحديث مع رجل، تسللت جوديث بعيداً. تجولت بين الأكشاك الأخرى، تتمنى لو كان لديها ما يكفي من المال لشراء أمشاط فاخرة أو دانتيل، لكنها لم تحصل من أختها سوى بضع قطع نقدية لقاء عملها، وكانت تلك تُمنح لها على مضض رغم أن أليس اشترت لنفسها أحذية جديدة، وشالاً جديداً، وقطعاً كثيرة من القماش لتجهيزاتها. نفقات لا داعي لها، إذ كانت أليس مجهزة بالفعل، لكنها تصرفت وكأنها عروس لأول مرة.
ركلت جوديث حصاةً صغيرة وتوقفت لتنظر إلى عربة بائع الكتب.
- مرحباً، الآنسة جوديث، هل تبحثين عن قراءة خفيفة؟ لدي تشكيلة جيدة من كتب السيدات:
قال ذلك وهو يربت على كومة من الكتب إلى يساره. ثم رفع كتاباً لحكايات خرافية مصورة.
في الأوقات العادية، ربما كانت جوديث لترضى بمثل هذه الكتب، أو كتب تعليم التطريز التي يعرضها، أو الروايات الخفيفة عن بطلات صابرات ينلن السعادة في الصفحة الأخيرة. لكنها في ذلك اليوم كانت تشعر بالاكتئاب.
قالت مشيرةً إلى صندوق كان الرجل يستند إليه:
- أريد أن أرى ما لديك هناك.
قال الرجل وهو يستقيم واقفاً
- أوه، لا، هذه الكتب ليست لكِ، هذا كتاب حكايات خرافية مناسبة للشابات، مع شرح المغزى من كل قصة في نهايتها
- ولماذا لا يمكنني الحصول على الكتب الأخرى؟
- تلك مجلدات صغيرة فاحشة للرجال.
عرفت جوديث ذلك، رغم أنها لم ترَ كتاباً "فاحشاً" عن قرب من قبل. كثير من شباب القرية كانوا يشترون تلك الكتب ويخفونها بسرعة، متجهين نحو الحانة أو أي مكان آخر حيث يمكنهم مشاركة الشراب والضحك على محتوى تلك الكتب.
- كم ثمن الواحد منها ؟
- لا يمكنني.
أصرت جوديث:
- لدي المال.
قال الرجل:
- أختكِ ستخنقني إذا سمعت أني بعتكِ هذا، آنسة جوديث.
قال رجل:
- دعني ألقي نظرة على أحد تلك الكتب.
تقدم غريبٌ بجانب جوديث. لم يكن مزارعاً ولا تاجراً. بدت ملابسه فاخرةً في يومٍ ما، لكنها الآن متسخةٌ ومرقعةٌ مراتٍ عديدة. معطفه الأسود الطويل كان مهترئاً عند الحواف. كان شعره مربوطاً عند قفاه، ولم يكن يرتدي قبعةً كما يفعل أي رجل محترم، رغم أنه كان يرتدي قفازاتٍ بدت مصنوعةً من جلدٍ جيد. ربما كان نبيلاً سقط من مكانته، أو متشرداً جمع بعض الملابس اللائقة من محسنٍ ما. على الأرجح الاحتمال الثاني.
تردد بائع الكتب، لكنه فتح الصندوق وسلم الرجل كتاباً. تصفحه الغريب وسأل عن السعر. عندما ذكر البائع الثمن، دفع له بعض القطع النقدية.
بدأت جوديث بالابتعاد، لكن الغريب لحق بها بخطواتٍ سريعة. سألها:
- أتريدين قراءة هذا؟
أجابت:
- نعم، لكنك اشتريته، فماذا إذن؟
- سأبيعه لك.
- سترفع السعر."
- أبداً. من الواضح أنكِ أردتيه ولم تتمكني من الحصول عليه دون وساطة. التقي بي خلف الحانة عند الغسق. يمكنكِ الحصول عليه بسعرٍ زهيد "
- أعطيه لي الآن
قال الغريب وهو ينظر خلفها، وابتسم:
- ثمة رجل قادمٌ إليكِ.
التفتت جوديث ورأت ناثانيل يقترب منها. كان يداه في جيوبه وعلامات العبوس على وجهه. أسرع الغريب بالابتعاد، سألها ناثانيل:
- هل كان ذلك المتشرد يزعجكِ؟
- كان يسأل إن كان يمكنه المبيت في الإسطبل مجاناً. أخبرته أننا لا نستطيع تقديم مثل هذه الصدقة "
قالت جوديث ذلك، عسى ألا يلاحظ ناثانيل كذبها.
***
كان بيت الضيافة يعجّ بالناس، واستغرق الأمر من جوديث وقتًا أطول مما توقعت لتتسلل خارجه. أسرعت خلف النزل، وحين وصلت، وجدت نفسها وحيدة تحت أغصان شجرة معوجة. ربما كان قد أتى وذهب. لعنت في سرِّها. قال صوتٌ:
- لقد تأخرتِ.
فوجئت برؤية بقعة من الظلام تنزلق بعيداً عن الشجرة. كان الرجل متكئاً بإحكام على جذعها؛ لم تلحظه. عندما أصبح وجهه مرئياً أخيراً، لاحظت ابتسامته الحادة.
رفعت جوديث ذقنها بتحدٍّ.
- كان لديّ شغلٌ يجب إنجازه. هل معك الكتاب؟
ربت الغريب على معطفه وأخرج الكتاب. عندما حاولت انتزاعه، سحبه بعيداً.
- سآخذ أجرتي أولاً، يا جوديث ذات الشعر الأسود. أليس هذا اسمك؟
- كم تريد؟ لقد قلت أنه سيكون رخيصاً، أتذكر؟
-رخيص جداً. يمكنك الحصول عليه مقابل قبلة."
-هذا طلب غير لائق. أنت على الأرجح متشرد."
- لست متشرداً.
أضاف:
ومن سيراكِ في الظلام؟ القمر جديد الليلة."
لم يكن هناك قمر، لكن الضوء الخافت المنبعث من نوافذ النزل جعلها تتردد. علاوة على ذلك، كان المقايضة بالقبلات من أجل أغراض تافهة أمراً غير أخلاقي. أخبرته بذلك.
هز كتفيه. سأل:
- هل تريدين الكتاب أم لا؟
قالت:
- حسناً. قبلة واحدة فقط.
لم يكن لها حبيب، رغم أنها قبلت بعض الفتيان من البلدة. أمضت وقتاً طويلاً وهي تتخيل عشيقاً أحلامها لتقبل برجل عادي. فكرت في منحه ما منحته لأولئك الفتيان: قبلة سريعة خاطفة.
أمسك الرجل وجهها بيديه، وشعرت بلمسة الجلد الناعم على بشرتها بينما انحنى ليُقبّلها. انفتح فمها أمام فمه، وسمحت له بجذبها إليه من خصرها، وبنهش شفتها السفلى. لكن عندما حاول لمس صدرها، صفعَت يده بعيداً.
- لقد وعدت. أعطني كتابي.
- دعيني أرى صدركِ وسأحضر لكِ كتاباً ثانياً. ضعف المتعة."
قالت، بصوت يكاد يكون همساً غاضباً.
- أنت فظّ،.
ضحك، ممدداً ذراعه وعارضاً عليها الكتاب. انتزعته منه وأسرعت عائدةً إلى المنزل. لكنها لم تجرؤ على قراءة الكتاب داخل النزل. بقيت مستيقظة معظم الليل، وفي لحظة ما شعرت بإحساس غريب بأن شيئاً ناعماً مرّ بجانبها في الظلام، رغم أنه لم يكن سوى البطانية التي سقطت على الأرض.
***
مع بزوغ الفجر، أمسكت جوديث سَلَّتها ووضعت الكتاب بداخله تحت منديل أحمر، ثم خرجت إلى الغابة. تساقطت أولى حبات الثلج الموسمية، لكنها كانت لمسات خفيفة من البياض على الأرض. عندما وصلت إلى الكوخ، أشعلت النار وجلست على كرسي مهترئ، تقلب الصفحات.
كان الكتاب بالفعل فاحشاً، يحكي قصة امرأة شابة تترك الدير وتخوض مغامرات غرامية عديدة في العالم. تصور الرسومات التفصيلية كل مغامراتها. لم ترَ جوديث عري الرجال إلا في صفحة من الإنجيل تظهر آدم وحواء يمسكان بأيديها، مع الثعبان ملتف حول أقدامهما. لكن تلك الرسومات كانت بدائية، بينما النقوش في هذا الكتاب صورت الواقع بكل تفاصيله الجسدية، تظهر أعضاء الرجال الطويلة وشعر عانة النساء، بالإضافة إلى عشرات الأوضاع الغرامية المختلفة.
كانت منشغلة بالكتاب لدرجة أنها لم تلحظ وجود أحد عند الباب حتى هبّت رياح باردة حركت شعرها. لم تكلف نفسها عناء قفل الباب.رفعت رأسها وأعادت الكتاب بسرعة إلى السلة، وغطته بالمنديل. سأل ناثانيل:
- ألم تسمعيني؟
هزت جوديث رأسها.
- ماذا تفعلين هنا؟ هل هو معكِ؟
- من؟
قال بغضب:
- لا تتظاهري بالبراءة. رأوكِ خلف الحانة الليلة الماضية تتحدثين مع ذلك الرجل.
أكدت له:
- أنا وحدي.
ألقى ناثانيل نظرة حول الكوخ، لكنه كان صغيراً، ولا مكان يختبئ فيه عشيق.
- حسناً، دعينا نعود إلى البلدة. رأيت ذئباً أسود كبيراً بالأمس، ليس بعيداً عن هذا المكان. وحش ضخم حقاً. سأصطاده يوماً ما، لكنني لا أريده أن يعضكِ.
أمسك سَلَّتها، ربما ليحملها عنها، وفي لحظة ذعر جذبته نحوه، مما أدى إلى انقلابها. سقط الكتاب على الأرض، والتقطه ناثانيل. حدق في إحدى الصفحات، ثم نظر إليها. احمرّ وجه جوديث. تمتمت:
- إنها مجرد قصة.
سأل ناثانيل.
- هل أعطاكِ إياه ذلك الرجل؟"
- نعم.
- وماذا أعطاكِ أيضاً؟
- لا شيء.
أصر فى حدة:
- ماذا أيضاً؟
كررت
- إنها قصة.
كانت على وشك تقديم تبريرات لا حصر لها، لكنه جذبها إليه وقبّلها، ليس كما فعل الغريب في مزاح، بضحكة على شفتيه، بل بكل ثقل العالم.
سحبها نحو السرير، الذي صرّ بشدة تحت ثقلهما. سمعت عواء ذئب في المسافة بينما أمسك فخذها من خلال قماش فستانها، الذي بهت لونه من جرّه في برك الغابة وطينها.
كان على جوديث أن تدفعه بعيداً. لكنها بكت صباح زفاف أليس، ولم يكن لديها أي شيء خاص بها، سوى ملابس أختها المستعملة، وسواعد خشنة من الصابون والغسيل. وبشكل غريب، وجدت نفسها تفكر في أن الغريب كان يرتدي قفازات، فلم تتمكن من الشعور بيديه كما قد تريد. هل كانت ناعمة، أم خشنة كيديها؟
ثم قبّلها ناثانيل مرة أخرى، فنسيت الغريب، وأختها، وكل العالم.
***
خبت النار، وابتعد الذئب. ارتديا ملابسهما.
وجدت جوديث صعوبة في تذكر كيفية ربط أربطة حذائها - كانت أصابعها خرقاء - فساعدها في ارتداء فستانها ثم وضع قبلة سريعة على خدها.
- أراكِ لاحقاً.
قالها وهو يمسك ببندقيته المتكئة على الباب ويغادر.
أطفأت جوديث النار وعادت إلى نزل الضيافة، على هدي غريزتها أكثر منها بعقلها الواعي. عند دخولها، وجدت أليس تغلي غضباً، تحاول التعامل مع التوأمين المشاغبين وتوبخ الخادمة في نفس الوقت. قالت أليس لأختها.
- هلا أسرعتِ وغسلتِ الملابس؟
كان بإمكانها إعطاء الغسيل لإحدى نساء القرية، لكن أليس ظلت تكلِّف جوديث بهذه المهمة.
هذه المرة لم تعترض جوديث. غسلت الملابس الداخلية التي كانت ترتديها، وراقبت الماء وهو يتحول إلى اللون الوردي بفعل الدم الذي تسرب من جسدها - الدم ونطفته. كان عليها أن تغسل نفسها قبل مغادرة الكوخ لكنها كانت مشدوهة جداً اكثر من كونها. ساعدها البرد والسير في استعادة وعيها: لا يمكن أن يُكتشف أمرها.
فركت بقوة حتى اختفت كل آثار اللون. ثم أفرغت الماء القذر الملطخ بالدم في الخارج، وتركته يتغلغل في جذور شجرة.
***
عجنت الخبز بأصابع متراخية، بينما شردت أفكارها عائدة إلى ناثانيل، رغم أن أختها كانت بجانبها وخشيت جوديث أن تتمكن أليس من تخمين ما يدور في رأسها. فقد كانت أليس دومًا تمتلك قدرة غريبة على معرفة متى ارتكبت جوديث خطيئة. كانت تسرع لإخبار الجدة، فتعاقبها الجدة لسوء تصرفها. قالت أليس:
- انتبهي لما تفعلين. هذا الخبز لن ينتفخ أبدًا.
فلم تكن لتنزل إلى مستوى لمس الدقيق والزبدة؛ بل كانت تراقب جوديث والخادمة بعينين ثاقبتين كقائد جيش.
- سيكون على ما يرام.
- لن يكون كذلك. أنت مهملة. عليك أن تتعلمي الطهو جيدًا، وإلا لن تخطبي زوجًا أبدًا. لا عجب أن إليزابيث وراحيل تزوجتا بالفعل.
- أنا أطبخ جيدًا، ولا يهمني ما يفعله الآخرون.
قالت جوديث ذلك، وهي تفكر في الفتيات اللواتي ألقين تلك التعويذة معها قبل أشهر. كانت إليزابيث حاملًا بالفعل بطفلها الأول وتبدو ضخمة كسفينة شراع، بينما تشتكي راحيل بلا توقف من زوجها كلما زارت المتجر.
لم ترد جوديث أحد أولاد القرية المملين الذين تزوجتهم صديقاتها. لقد أرادت رجلًا وسيمًا، قويًا وبنيانًا. أرادت ناثانيل. وقد شاركته الفراش.
كان على جوديث أن تتوب.
قالت أليس:
- كل ما تعرفين طهوه هو الحساء. أحيانًا، يريد الرجل حلوى من زوجته. كعكة أو فطيرة.
ردت جوديث بفظاظة:
- أو ساعة جيب مطلية بالفضة.
احمرّت أختها غضبًا، لكن الجميع في البلدة همسوا بأن أليس اشترت ناثانيل. شعرت جوديث بالخزي من نفسها حينها. لم تكن تخون أختها سرًا فحسب، بل وتحدثت إليها بفظاظة. قالت:
- أنا آسفة.
قالت أليس:
- انهي هذا، أيتها الحمقاء.. لو كان الأمر بيدك، لكنا نأكل عجينة محروقة.
ربما، لكنها فكرت: لقد نلتُ الرجل الذي أريده. وغسلت يديها، راجية أن تطهّر نفسها من أفكارها الخائنة، لكن تلك الأفكار كانت هناك، رغمًا عنها — شعور بالنصر لا يمكن إنكاره، يتلوه ذلك الخزي الصامت.
***
ظلت القبلات التي غرسها على فمها عالقة، عميقة كالجراح في جسدها، وذكرياتها تسببت في ألم يشع منها. ومع ذلك كتمت هذا الألم، وحاولت محو لمساته من ذهنها. قررت أنها قد تخيلت اللقاء بأكمله، مسكونة بحلم غريب وحمى. يمكنها أن تكون فتاة صالحة، يمكنها أن تنسى، يجب عليها ذلك.
مر يومان ثم آخر. نزل ناثانيل الدرجات، بندقيته معلقة على كتفه. قال:
- صباح الخير، جودي.
أومأت له لكنها أبقيت عينيها على حذائها، متأملة أن تبدو مهيبة بدلاً من مذنبة.
- سأذهب للصيد اليوم. قرابة الظهيرة، قد أستريح في الكوخ المهجور الذي تفضلينه.
قالها بصوته الخفيف. رفعت جوديث عينيها، لكنه كان ينظر إلى الغابة، لا إليها. حدقت به وهو يبتعد.
لاحقاً، بعد أن ساعدت قليلاً في المتجر، تسللت جوديث إلى الغابة ثم إلى الكوخ.
لم يكن هناك، فوجدت الكتاب الذي تركته ملقى على الأرض. التقطته وجلست على السرير، تحدق عبر النافذة بزجاجها الصغير.لم تعرف هل تضحك أم تبكي، ودلكت يديها وهي تفكر أنها يجب أن تكفر عن ذنبها، بينما تذكرت ثقل جسد ناثانيل عليها.
كانت خطيئة أن تضاجع رجلاً ليس زوجها. كان عليها أن تعترف للكاهن. وقد تكون هرعت إلى الكنيسة أيضاً، لولا أن ناثانيل دخل في تلك اللحظة، وهز رأسه بينما يتساقط الثلج من على كتفيه. سأل:
- أنا أتجمد. ألم تشعلي النار؟
شاهدته وهو يشعل النار، ثم التفت إليها وابتسم. اعترضت بشكل غامض همست:
– لا يجب أن تشتهي.
لكنه خنق كلماتها بفمه، بينما كانت أصابعها العجلى تعاونه على نزع ثيابه.
***
تجنبته لمدة أسبوع كامل. الآن يكسو الثلج القرية مثل بطانية، خافِتًا كل الأصوات،
كما كانت أشجار الشوكران منحنية تحت ثقل هذا البياض.
ناثانييل، ناثانييل. كان قلبها ملتهبًا، وعيناها تبحثان عنه على مائدة العشاء، ومع ذلك كانت ترغب في أن تبقى فاضلة. إنْ جعلته عشيقها، فمصيرها إلى الجحيم. لقد اقترفت الإثم مرتين. مرتين من الحماقة. مرتين من اللعنة. لم تكن تنوي فعل الشر حقًا. في المرتين فاجأها الأمر، وكان اتصالهما حميمية يائسة، عفوية.
سلكت الدرب المؤدي إلى الكوخ لكنها حادت عنه، تتوه بين الأشجار، تلتقط غصينًا وتكسره إلى نصفين. سمعت همهمة فتوقفت، ظنًا منها أن ناثانيل هو الذي يتبعها، لكن الصوت لم يكن مألوفًا. سألت.
- من هناك؟ معي سكين.
قال الغريب وهو يخرج من خلف شجرة.
- حسنًا. معي مسدس.
كان يحمل على كتفه حزمة وفي يده اليسرى تفاحة، قضمها بعزم مع صوت قرمشة حاسم. عبست جوديث.
- ليس هذا مسدسًا.
- إنه مخبأ. بالإضافة إلى ذلك، لا أرى السكين.
وضعت جوديث يديها خلف ظهرها.
- ماذا تفعل هنا؟
- أبحث عن مكان لأنام."
- اذهب إلى الحانة.
- يطلبون مبلغًا كبيرًا."
- إذن أنت متشرد."
- أنا زائر.
ألقى التفاحة في الهواء والتقطها.
- سمعت أن هناك كوخ حطاب مهجور في مكان ما.
- إنه ليس كوخ حطاب، ولا يمكنك البقاء هناك.
- لماذا لا؟
- لأنك لا تستطيع. عد إلى البلدة واقتحم إسطبلًا."
- ثم أُطارَد من قبل رجل يحمل بندقية؟
قضم قطعة أخرى.
سرت ابتسامة على وجهه.
- خذيني إلى الكوخ. سأهديك هدية.
- لا أريد قبلة سخيفة أخرى منك.
- ليست قبلة. لن ألمسك،"
قال ذلك، وهو يمضغ وابتلع قطعة من التفاحة قبل أن يتكلم مرة أخرى.
- معي كتاب.
- لن أريك صدريّ مقابل ذلك. بالإضافة إلى ذلك، لدي كتاب بالفعل.
- لديك كتاب فاحش. ماذا عن كتاب عن وحوش مرعبة وأشباح بشعة؟
ظنت جوديث أنه من الغباء أن تستمع إلى هذا الوغد، لكن من ناحية أخرى،
شغلتها محادثتهما عن مسألة ناثانيل ولعنة روحها.
- تبقى ليلة واحدة، ثم تغادر – أفهمت؟ هذا مكاني وحدي.
وافق على ذلك.وعندما دخلا، أشعلت جوديث النار، وراقبته وهو يجلس على أحد الكراسي وينزع معطفه. كانت هناك حقيبة قماشية رمادية صغيرة تتدلّى من حبل حول عنقه. أخرج من جيب معطفه كتابًا، ووضعه على الطاولة. انحنت جوديث فوقه وبدأت تقلّب صفحاته. كانت الرسومات فيه بالفعل مليئة بوحوش بشعة تقفز من خلف الأبواب، وأشباح تهزّ سلاسلها.قال:
- ما هو شيطانك المفضل؟
قالت جوديث:
- الوحوش التي تسكن البحيرات... تلك التي تخطف الأطفال إذا اقتربوا من الماء.
قال:
- يا لك من مخلوقة شريرة.
سألته:
- وأنت، ما هو شيطانك المفضل ؟
قلب الصفحات ووضع إصبعه المغطّى بالقفاز بلطف على إحدى الرسوم.
قال:
- الذئب البشري- مبدّل الشكل.
نظرت جوديث إلى الصورة. كان رجلاً يمزّق صدره بيديه، ومن تحت الجلد كانت تخرج رأس ذئب، جاهزة لافتراس امرأة ذات شعر طويل منسدل، مستلقية على السرير وتصرخ.
قالت:
- تفاهة. هذا لا يُخيف.
قال وهو يمدّ لها التفاحة التي أكل نصفها:
- هل ترغبين في قضمة؟
قالت:
- كلا. قل لي، ما الذي تفعله هنا حقًا؟ هل أنت لصّ؟
قال مبتسمًا:
- أولًا متشرد، والآن لص؟
قالت، وهي تفكّر في ناثانيال الممدّد عاريًا على السرير في الزاوية:
- لست صيادًا. ولا أي شيء محترم.
قال:
- أنا نبيل هارب من لعنة رهيبة.
سألته:
- ما نوع هذه اللعنة؟
قال:
- لعنة الجوع... لا يمكن إشباعها. تتذوّق دم الفريسة الطازجة، فتُجبر على الصيد ليلًا. الشر يغلي في جسدك لأنك سرقت أثرًا مقدسًا من أرض بعيدة.
قالت وهي تشير إليه:
- ها أنت ذا. لصّ.
قال:
- إن كان يرضيك أكثر، فقد سحرني ساحر يعيش في كهف.
ضحكت على ذلك، ثم وقفت. كانت قد أطالت الغياب. لا بد أن أختها بدأت تتساءل أين هي، وإن لم تكن هي، فربما ناثانيال. لم تكن تريد أن يجدها برفقة الغريب.
قالت وهي تمسك بغطائها:
- غادر قبل الصباح، أتسمعني؟
قال:
- سأغادر. لكنني سألقاكِ مرة أخرى، في وقت آخر، يا جوديث ذات الشعر الأسود.
كان الغريب قد أنهى أكل تفاحته ورمى اللب في النار، ثم اتكأ بهدوء على كرسيه. أما هي، فخرجت من الكوخ.
***
حاصرها ناثانيال في المطبخ تلك الليلة. بدا شديد الكآبة، وتحدث بصوت منخفض. كان وجهه الوسيم مشوّهًا بالحزن.
قال:
- ماذا فعلتُ؟ ما الأمر؟
أجابت وهي تنظر إلى يديها المرتجفتين قليلًا:
- أنت تعرف ما فعلناه.
قال:
- ألا تحبينني يا جودي؟
الحب! يا له من لفظ بسيط، لا يمكنه أن يحيط بما تشعر به، مشاعرها العميقة والمضطربة التي تخشى أن تغرق فيها لمجرد النظر إليه. كل لحظة من صحوها كانت شوقًا، ولياليها كانت سهرًا ووجعًا. منذ اللحظة الأولى التي كلمها فيها، أحبّته، ثم عاشت عذاب فقدانه. والآن عرفت عذابًا آخر، عذوبة عناقه وثقل الخطيئة.
سمعت جوديث وقع خطوات أختها تنزل على الدرج، والألواح الخشبية تئن تحت إيقاعها المألوف.
قالت له بسرعة:
- لا يمكننا الحديث الآن.
فقال:
- قابليني غدًا، في الكوخ.
***
وافقت على مقابلته، مضطرة لأنها كانت فضولية لتعرف إن كان الغريب سيظل هناك. لم تكن ترغب في مواجهة بين الرجلين، لكنها أرادت أن ترى إن كان الغريب سيوفي بوعده ويغادر الكوخ عند الصباح. يبدو أن ذلك ما حدث، ولم يترك أثراً له خلفه. الكتاب الذي كان على الطاولة اختفى، والنار انطفأت.
لم تكد تدخل حتى فتح ناثانييل الباب. أمسك بها على الفور وألقاها على السرير، يجذب تنورتها. قالت له بينما كان يقبل عنقها:
- هذا إثم، يجب أن نتوقف. أنت متزوج من أختي.
- لم يكن ينبغي لي الزواج من أليس. لم أشعر بأن لدي منزل منذ وقت طويل، وكنتم جميعاً لطيفين جداً، لم أرغب في فقدان ذلك. هي أوضحت أنه إذا لم أتزوجها، يجب أن أغادر. والله يا جوديث، لقد ارتكبت خطأً، لكني أحبكِ أنت، لا هي. أنا وأليس بالكاد نلتقي، أنتِ تعرفين ذلك.
كانت هناك حقيقة في هذا الكلام. كان ناثانييل مهذباً مع زوجته، لكنه لم يكن عاطفياً بشكل خاص، وكان لديهما غرف منفصلة. أليس وزوجها الأول أيضاً كانا يحتفظان بغرف منفصلة، لكن ذلك كان لأنه كان يشخر. حتى أن ناثانييل وأليس لم يقضيا شهر العسل معاً، رغم أن أليس كانت تتذمر من هذا: لقد أرادت السفر، وشراء حلي جميلة في مدينة ساحلية.
أوه، كان ناثانييل سعيداً بما يكفي للجلوس على مائدة أليس ومساعدتها في المتجر. بدا أنه يستمتع بمكانته المرتفعة في القرية، حيث أصبح تاجراً بدلاً من مجرد صياد. لكنه لم يبد أبداً مغرمًا بأليس كما قد تتخيل جوديث أن يكون الزوج الجديد.
قال أهل القرية إن أليس اشترته. ربما فعلت. قال
- إذا استطعت الاختيار مرة أخرى، سأتزوجكِ.
جعلها التفكير في تفضيلها على أختها تشعر بالفخر قليلاً، حتى لو لم يكن ينبغي لها ذلك، تماماً كما لا ينبغي لها أن ترغب في ناثانييل. تمتمت:
- ما تزال هذا خطيئة.
قال:
- يجب أن نهرب معاً.. ستجد أليس رجلاً آخر، فهي صغيرة بما يكفي. ستكون بخير ونحن يمكننا البدء من جديد، حيث لا أحد يعرفنا."
- أستفعل ذلك؟
- نعم.
قال ذلك بينما انزلق أصابعه على فخذيها وأغمضت عينيها، حتى وهي تحاول التمتمة عن الفجور والرذيلة. لكنها أحبته كثيراً في السر والصمت، والآن كان هنا. أكذ:
- سنذهب، في الربيع، مع الذوبان.
كان ذئب يعوي، متحدياً البرد القارس بالخارج. لكنها لم تكن تشعر بالبرد، ليس في قلبها، جسدها مشتعل ورأسها مليء بأفكار عن جميع الأماكن التي قد يذهبان إليها. المدينة، جنوب البلدة، حيث يبنون الكاتدرائيات والقصور العظيمة، حيث البرد لا يكسر العظام. انزلق داخل جسدها، وفكرت ربما كان هناك حقاً لعنات، ولعنتها كانت أن ترغب فيه هكذا، ضد كل منطق وأدب.
قال ناثانييل بعد ذلك وهو يلبس قميصه:
- هذا ذلك الذئب الكبير مرة أخرى،عندما أمسك به، سأصنع لكِ رداءً من فرائه.
- هل فراء الذئب يستحق أي شيء؟
- يجب أن يكون. الشتاء قاسٍ، هناك عدد قليل من الثعالب حولنا، وكل شيء آخر نادر. بالكاد أمسك بشيء. لكن مرة أخرى، أنتِ تشتتيني كثيراً."
- لا أحتاج إلى فراء، فقط أريدك أنت.
أجاب:
- وهذا ما تملكينه بالفعل.
سألته:
- ألا يمكنك البقاء قليلاً؟
تتمنى أن تستكشف ظهره العاري، أن تهمس بأسرار في أذنه، أن تستمع إلى دقات قلبه بينما تغفو.قال:
- سيترقبون عودتي إلى المنزل.
أليس ستترقبه. عضت جوديث على ظفرها وهي تشاهده وهو يعدل معطفه. قالت:
- لقد حلمتُ بك ذات مرة، قبل أن تأتي إلى هذه البلدة. لا يمكن أن يكون خطأً إذا حلمتُ بك، أليس كذلك؟
ضحك.
- وماذا كان الحلم؟
- لا شيء. قبلني.
طلبت جوديث وهي تتمسك به بيديها اليائستين، عسى أن يبقى دقائقَ أطول. لكنه ابتسم وقال إن عليه المغادرة قبل أن يفتقده أحد.
عندما خرج، ارتمت على السرير، يداها ممدودتان فوق رأسها، وقلبها ما زال ينبض بجنون على إيقاع لقائهما.
***
يُغطي الثلج الأبيض الثقيل سقوف القرية، بينما تميل قمم أشجار الصنوبر قليلاً نحو الشمس الصاعدة. داخل المتجر، كان ناثانييل يُراجع الحسابات بينما تعيد جوديث ترتيب برطمانات المربى. وقد خرج الصبي المُساعد متذمراً من ألم في ضرسه، ووعد بالعودة بعد ساعة، فوجدت نفسها تساعده في أعماله.
رن جرس الباب عند دخول أحدهم، وسمعت همهمة الرجل المميزة وهو يقترب من المنضدة. سأل.
- هل لديكم تبغ؟
وقفت جوديث متصلبةً وهي تحمل برطماناً بين يديها، ظهرها نحو المدخل، بينما ساعد ناثانييل الزبون. غادر الرجل سريعاً، وبعد دقائق دخل آخر يبحث عن الصابون. فخرجت جوديث من المتجر.
وجدت الغريب على بعد خطوات قليلة من المدخل، مستنداً إلى الحائط، حاملاً عقداً من البصل على كتفه. ابتسم لها. سألته:
- ماذا كنت تفعل هناك؟.
- أحصل على قليل من التبغ. سيجعل هذا البصل أطيب إذا دخنت غليوناً. هذا عشائي، كما ترين، وهو ضئيل جداً.
- كان عليك أن تنفق نقودك على اللحم بدلاً من التبغ.
قال:
- على المرء أن يُدلل بعض رذائله، ألا تملكين كسرة خبزٍ، أليس كذلك؟
- اغرب عن القرية. اذهب لتتسول في قرية كبيرة.
- يُعتقل المتسولون في القرى الكبيرة."
قالت:
- وفي الصغيرة أيضاً.
بدا عليه النحول أكثر من أول لقاءٍ بينهما، تبرز عظام وجنتيه تحت جلده. تخيلته تحت ثيابه عظماً أكثر من لحم. قالت:
- عد بعد حلول الظلام، سأعطيك كسرة الخبز حينها."
عاد الصبي، وذهب ناثانييل إلى دار الضيافة. قبل الغروب، أخبرت جوديث الصبي أنها ستُغلق المتجر وحدها. فغادر ممتنّاً كأنما يرقص وهو في طريقه إلى البيت. وحضر الغريب بعد قليل، فأغلقت الباب وقادته إلى المخزن، حيث أخذت برطمان مخلل وآخر من المربى، ووضعتهما في كيس خيش مع رغيف خبز سرقته من المطبخ. توقعت ألا يشكو من جودته، كما تفعل أختها.
قالت:
- خذ. احسب نفسك محظوظاً ولا تزعجني مرة أخرى.
قال، وابتسامته الساخرة الحادة كالعادة. حاد كالسيف كان، وعيناه تشبهان الجليد، براقتين وباردتين:
- أنتِ روح الكرم بذاته.
- أين تنام؟ ليس في الكوخ، آمل. لا يُسمح لك بالعودة هناك."
- لن أدخله إلا إذا دعوتيني.
- جيد. لأنك لو كسرت نافذة وحاولت التسلل، سوف تندم. هل تنام في إسطبل أحدهم؟ تتسلل ليلاً؟
قال:
- ربما أنزلق إلى سرير سيدة عجوز ترتدي قلنسوة نومها وأدفئها أفضل من فراء.
- أنت أحمق وعليك المغادرة. لماذا تبقى هنا؟
قال:
- الشتاء قاسٍ في كل مكان، وكاهن هذه القرية أكرم من غيره، أحياناً يُعطي الرجل صحناً من الحساء مقابل كنس الثلج عن درج الكنيسة. أما في أماكن أخرى، فقد يضربونك بعصا ويطاردونك."
فكّرت أنه لا بد أن تكون حياةً بائسةً أن تتجوّل هكذا من قرية إلى قرية، تتسوّل الفتات وتقوم بأعمال وضيعة، مع تهديد السلطات بسحبك إلى السجن.
جلس الغريب وخلع معطفه وقفازيه الجلديين. لم تبدو يداه خشنتين، رغم أن شعراً داكناً قبيحاً يكسو مفاصله وأظافره طويلة. مع ذلك، بدا أشعثاً من كل مكان، بلحية كثيفة وشعر غزير مجتمع عند قفاه. بينما كان ناثانييل يحلق خديه كل صباح، وهذا ما أعجبها. جعله ذلك يبدو أكثر أناقة من شاب القرية. أميراً، لا متسولاً.
بدأ الرجل يقضم خبزه وهو يهمهم أثناء الأكل، بينما حدّقت في وجهه وفي الحقيبة الرمادية المتدلية من عنقه.
سألت:
- ما هذا؟
- ألا تحبين أن تعرفي.
- هل تحتفظ فيه بمالك أو بإرث خاص؟
- إذا سمحتِ لي بملء كيس الخيش هذا ببضعة مؤن أخرى، سأخبرك.
فكّرت في عرضه. لن يكون من الصعب إخفاء اختفاء بعض الأشياء، إذا كانت صغيرة وغير مهمة. فأومأت برأسها. فألقت ببرطمان جزر وآخر بفجل أبيض في الكيس.
ركع أمامها، رافعاً الحبل عن عنقه. فتح الحقيبة وأفرغ محتوياتها على كفه. كان هناك ريشة، وعظمة صغيرة لا بد أنها تعود لطائر، وتراب، وحصى، وبتلات زهور مجففة، وخيط. قالت:
- إنه مجرد خردة.
- إنها تعويذة لتحويلي إلى ذئب في ضوء القمر حتى أستطيع العواء عبر الغابة. ثم أعود إنساناً عند الفجر."
- إذا كنت تستطيع التحول إلى ذئب، لماذا لا تصطاد عشائك؟
- أفعل، لكن لا أحد يرغب بمضغ عظام أرنب هزيل كل يوم. الشتاء كان سيئاً للصيد. وللمرء ولع ببعض السلع.
هزّت رأسها:
- مثل التبغ. لا أرى كيف تساعدك هذه الحقيبة في التحول إلى أي شيء."
- هذا يدل على مدى معرفتك. خذي بتلات خربق أسود ودهن ذئب، اغليهما لصنع مرهم وادهني به نفسك تحت ضوء القمر عند بلوغك الخامسة عشرة، ومن ثمّ ستستطيعين التحول إلى وحش.
سألت، مشيرة إلى كفه المفتوح.
- فهمت. وهذه العظمة الصغيرة، ما فائدتها؟
- تُجري السحر، هذا ما تفعله."
أعاد الأشياء إلى الجراب وناوله إياها. أمسكت جوديث به بين يديها وهزّته، سامعة صوت محتوياته تصطك.
- هل هذا سبب كونك متشرداً؟ دهنت نفسك بمرهم وتحولت إلى ذئب. ثم أكلت مواشي الجيران واكتشفت أمرك."
قال، وهو يفرك يديه معاً:
- ربما. أو ربما يكون ارتداء الفراء في الشتاء أكثر دفئاً.
- في السابق قلت أنك سرقت ذخيرة مقدسة، وأن ساحراً في كهف لعنك، والآن تقول أنك تدهن جسمك بمرهم وتلقي تعويذة كافرة. أي القصص صحيحة؟
سأل، وعيناه الغائرتان مليئتان بالأذى:
- ما رأيكِ، يا جوديث ذات الشعر الأسود؟
قالت، وهي تفحصه بدقة:
- أنت أكبر مني سناً، لكن ليس بكثير.أعتقد أنك كنت حتى وقت قريب تلميذاً عند خياط أو إسكافي، وهربت بمال من خزنة معلمك."
- ربما مع زوجته، التي اتخذتني عشيقاً لها بتهور.
قالت:
- ليس ذلك. لست وسيماً. ليس لديك عضلات، ولا قوة. وشعرك يشبه عش غراب.
اعتبرت أن عيني ناثانييل رائعتين بالمقارنة به. كان حاجبا هذا الرجل كثيفين جداً؛ وأنفه مكسور. مع ذلك، احمرّت وجنتاها عندما ابتسم لها بابتسامته الملتوبة.
سألت، وهى تحدق فى عينيه رغم الاحمرار على خديها.
- كيف وجدت هذه القرية؟
- تبعت النهر. فكان يغني لي.
عاد الغريب يهمهم وهو يلقي برطمان آخر في كيس الخيش.
سألت، ضاغطةً على شعرها ومسوّيته للخلف.
- ما هذه الأغنية؟
قال:
- ألم تسمعيها من قبل؟ إنها مشهورة هذه الأيام. إنها أغنية عن فتاة يسحبها عشيقها الشيطان إلى قاع النهر. ستعجبك.
- لا أعرف. أفضل السيد على الشيطان.
نظر إليها بعينيه الماكرتين
- إذاً، صاحب المتجر بملابسه الأنيقة أفضل؟. الرجل في المتجر هو عشيقك، أليس كذلك؟"
- كنت تتجسس علي!
- ليس تجسساً. كنت أتجول في الغابة، فرأيتكِ وإياه تدخلان الكوخ. لا تقلقي، لم ألصق وجهي بالنافذة لأرى كيف ينزلق بين ساقيك.
رمت الجراب الصغير نحوه ووقفت غاضبة.
- اغرب. ينبغي أن أغلق المتجر.
جمع أغراضه ووضع الكيس على كتفه، ممسكاً إياه بكلتا يديه، بينما رتبت هي البرطمانات على الرف بغضب.
***
نزلت أليس مبكرًا، بينما كانت جوديث لا تزال تتناول إفطارها، أفكارها كئيبة متشابكة بينما جلست إلى الطاولة. كانت رائحة أختها تفوح بعطر كريم اللوز الفاخر، وارتدت فستانًا بنفسجيًا جميلًا. لا بد أن أفكارها كانت كئيبة هي الأخرى، فقد ألقت على جوديث نظرة غاضبة.
- حسنًا، ها أنتِ في المنزل أخيرا.
سألت جوديث:
- وأين عساي أكون؟"
- لقد كنتِ كسولة مؤخرًا. كلما التفتُّ، لا أجدكِ في المنزل، ولا تساعدين في المحل أيضًا.
قالت جوديث
- لقد ساعدت هذا الأسبوع.
- ربما، لكنكِ مهملة في الطعام والمؤن. تستخدمين الكثير من الصابون في الغسيل. ناثانييل لم يحالفه الحظ في جلب الفراء هذا الشتاء، مما يعني أننا بحاجة إلى التقتير.
لم يكونوا بحاجة إلى التقتير عندما أرادت أليس أمشاطًا جديدة أو زوجًا من الأحذية. قالت جوديث:
- سيحصل ناثانييل على فراء الذئب العظيم.لا تقلقي.
- وماذا لو فعل؟ ليس هذا هو المقصود. أنتِ غير منتبهة هذا ما أعنيه. يقول صبي المحل إنكِ كسرت عدة برطمانات من المعلبات."
تلك كانت الكذبة التي أخبرتها. لم تستطع إخبار أختها أنها أعطتها لمتشرد سمحت له بدخول المحل. تمتمت جوديث:
- أنا آسفة.
قالت أليس:
- خرقاء كالعادة.. تركتِ الحليب يفيض الليلة الماضية. احرصي على عدم تكرار ذلك.
كانت تخاطبها كما تخاطب السيدة الخادمة الحقيرة. لكنهما كانتا غريبتين عن بعضهما منذ زمن طويل، حتى قبل أن تحب جوديث ناثانييل. فقد علمت الجدة أليس المكانة التي يجب أن تحتلها في الحياة، دائمًا بخطوتين فوق جوديث.
استمرت أليس في توبيخها قليلًا، لكنها في النهاية تعبت وتركتها وشأنها. وسرعان ما انطلقت جوديث بين الأشجار؛ كان الدرب الذي يعبر الغابة قد محاه الشتاء، لكنها عرفته من كثرة العادة. كان الجو باردًا جدًا في الخارج؛ ارتفعت أنفاسها من شفتيها، وتذوقت الحرية عندما لامسها ندفة ثلج على جبينها. ابتعدت، ابتعدت عن دار الضيافة، عن أليس، عن الأطفال الصارخين، عن ذكرى الجدة التي أعلنت أن أليس كانت الطفلة الأجمل بلا منازع، هاربة من كل ذلك. بين ذراعي ناثانييل، الذي لم يعنفها قط، والذي غمر وجهها بالقبلات.قالت له:
- أكره هذا المكان. أكره غرفتي والمنزل والقرية. لماذا لا يأتي الربيع عاجلًا؟ أتمنى أن يصبح كل شيء مختلفًا وجديدًا. أتمنى أن أحبك دون خداع أو أسرار. "
قال:
- التمني لن يحقق ذلك. كوني صبورة، يا حبيبتي.
- أنا خائفة.
كانت كلها مشاعر وحماس. لقد غاب العقل عن جوديث. نسيت معنى الخطيئة أو الفضيلة. لم تعرف سوى معالم جسد حبيبها. ولم تتمن سوى إرضائه.
لكنها أحيانًا كانت تخشى أن أليس تعرف كل شيء عنهما، أو أنها سوف تكتشف الحقيقة قريبًا، مثل النساء اللواتي يقرأن الطالع في رواسب القهوة. أحيانًا، مثل الآن، شعرت جوديث أيضًا بحزن شديد، ووحدة لا يمكن تفسيرها.
قال ناثانييل:
- لا تكوني سخيفة.
عضَّ بأسنانُه شحمةَ أذنها، ثم انزلق إلى كتفها. وفي الخارج، عوى ذئبٌ. رفع رأسه.
- إنه ذلك الوحش اللعين. أحاول اصطياده منذ أسابيع. إنه ذئب ضخم، أؤكِّد لك. هذا المخلوق يسخر مني. لقد نصبتُ له فخاخًا جديدةً - سأمسك به."
سألَتْ، وهي تُلقي نظرةً على بندقيته عند الباب:
- هل ستطاردُه الآن؟
بدا أن ناثانييل يفكر في الأمر للحظة، لكن منظر جسدها كان بلا شكٍّ أشدَّ إغراءً من جلد الذئب، لأنه بدلاً من ذلك شدَّ على أربطة ثوبها. فكَّرَتْ:" دعِ الوحشَ ينوحُ إذن."
***
رسم الشتاءُ صقيعَه على سُقُفِ المنازل، وحوَّل الأرضَ إلى عاجٍ أبيض، وجلَدَ الأشجارَ بقسوته. ثم صَمَتَ. كان الغابُ هادئًا لدرجة أن الثلجَ طَقْطَقَ تحت قدميها، وعندما سقطت حفنةٌ من الثلجِ عن غصنٍ، بدا صداهُ يترددُ عبرَ الغابة. ولعل هذا هو السببُ الذي جعلها تسمعُه يُهمهِمُ قبل أن تصلَ إلى الكوخ بفترةٍ طويلة، حتى قبل أن ترى شبحَه الأسودَ يستندُ إلى الباب.
- ماذا تفعل هنا؟
سألتْه. كانت تحملُ سلةً في يدها، وقد وضعتْ فيها كتابًا وقليلًا من الطعام.
- أحاولُ أن أتأكدَ إذا كنتِ وحدكِ، لأشارككِ الدفء.
قالتْ:
- لا ينبغي أن تكونَ هنا..
- تخشينَ أن يأتي عشيقُكِ فيضبطنا معًا؟ لن أؤذيه إلا إذا طلبتِ مني ذلك.
قالتْ:
- لن يأتي اليوم..إنه مشغولٌ في المحل.
- إذنِ هربتِ من أجل متعتكِ الخاصة.
نعم، لقد فعلتْ. في الآونة الأخيرة، لم يكن هناك سوى الهروب بالنسبة لها: من ضيقِ دار الضيافة، وأحيانًا حتى من الشهوةِ التي تقيدُها بناثانييل، لأنها أحيانًا كانت تتمنى ببساطة أن تأخذَ وجهه بين يديها وتقبلهُ في وسطِ البلدة، ليراهُ العالمُ أجمع. فتحتِ البابَ ودخلتْ، ثم التفتَتْ نحوه. بدا أكثرَ نحولًا من المرةِ الأخيرة، وعيناهُ محمرتان، ربما من الوقوفِ في البرد. وصوتُه بدا مبحوحًا. قالتْ بينما حلَّتْ وشاحَها عن عنقها:
- أشعلِ النار.
انشغلَ بالمهمة، بينما وضعتْ سَلَّتَها على الطاولة، وخلعتْ معطفَها، ونفضتْ الثلجَ عن حذائها، وهزَّتْ شعرَها ليتمددَ بحرية. وعندما اشتعلتِ النارُ، التفتَتْ نحوه. لاحظتْ جوديثُ على الفورِ الضمادةَ المتسخةَ حول يدهِ اليسرى.
- ماذا حدث لك؟"
- وقعتُ في فخ. ظننتُ أن عشيقَكِ سيطلقُ النارَ على رأسي، لكنني استطعتُ الهرب.
- أنت كاذب.
قالتْ ذلك بينما حلَّتِ الضمادةَ وتفحصتْ يده. كان هناك جرحٌ غائر، لكنه لا يمكن أن يكونَ ناتجًا عن مصائدِ ناثانييل الحديدية. لكان فقدَ يدهُ في إحداها. على الأرجح، أصيبَ عندما اقتحمَ إسطبلًا لشخصٍ ما، وجرحَ نفسه بزجاجٍ أو حتى مسمار.
- سأنظفه.
جمعتْ حفنةً من الثلجِ ووضعتها في قدر، ثم علقتِ القدرَ فوق النار حتى غلى الماء. لم يكن لديها ضماداتٌ طبية، لكن هناك الكثيرُ من الأقمشةِ القديمةِ التي يمكنُ تمزيقها واستخدامها لهذا الغرض. وعندما انتهتْ من تنظيفِ يده، لفَّتِ الضمادةَ المؤقتةَ بعنايةٍ حول راحته. قالتْ.
- الآن أعرفُ بالتأكيد أنك لستَ مستذئبًا.
- ما الذي فضحني؟
- الطريقة الوحيدة لاصطيادِ مثل هذه الوحوش هي أن يمتطي عذراءُ فرسًا أبيضًا ويتجولَ في البلدة. سيقتربُ الحصانُ من مسكنِ الكائن، وسيتمُّ تقطيعُه وإحراقه. إنهم لا يقعون في مصائدَ عادية. وأنا أعرفُ أيضًا أن الصبيَ يتحولُ إلى ذئبٍ بعد أن يشربَ ماءَ المطرِ من أثرِ قدمِ ذئبٍ في ليلةِ اكتمالِ القمر. قرأتُ ذلك في كتاب، مثل الذي أرَيْتَني إياه. لكنك لم تذكرْ شيئًا عن ماء المطر.
- يا له من إهمالٍ مني."
قالتْ جوديثُ وهي تربطُ العقدة
- أخبرني إذا كان الرباط مؤلمًا.
قالَ وهو يحركُ أصابعه:
- إنه جيد. شكرًا لك.
قالتْ وهي تناولهُ قطعةَ خبزٍ وشريحةَ جبن
- تفضل.. كُلْ شيئًا.
قال:
- أنتِ لطيفةٌ جدًا لأنكِ تشاركين وجبتَكِ مع كاذب.
جلسا أمامَ النار. مدَّ ساقيهِ وأخرجَ شريطًا أحمرَ من جيبه قال:
- من أجلكِ.
أمسكتْ جوديثُ بالشريطِ بين أصابعها ونظرتْ إليه.
- لا أستطيعُ قبولَ بضائعَ مسروقة.
- لم أسرقها. على أي حال، إنها لكِ، لتصبحي مثلَ تلك الأغنية.
- أية أغنية؟
- التي سألتِ عنها ذات يوم، عن الشيطانِ الذي يغوي امرأةً حتى هلاكها."
بدأ يُهمهِمُ اللحنَ مرةً أخرى.
"كانت العذراءُ شابةً جميلة، ترتدي شريطًا أحمرَ في شعرها الأسود."
غنى.
"لكنها لم تكن حكيمة، غرقتْ في النهر، وكان ذلك حتفها. فلتكن هذه الأغنيةُ تحذيرًا يبعدكِ عن الشر والخطيئة."
لفَّتْ جوديثُ الشريطَ حول معصمها. كانت عيناها مثبتتين على النار. فكرتْ في ناثانييل. ذلك الشعورُ الخانقُ بالوحدةِ الذي يهاجمُها أحيانًا بدأ ينبتُ من جديد. هزَّتْ رأسها محاولةً إبعاده. أخبرتِ الرجل:
- لا يمكنني أن أعطيكَ شيئًا مقابلَه..
- إنه مجاني لأنكِ تعجبيني. لديكِ مخالبُ مغروسةٌ في قلبي، يا جوديثَ ذاتَ الشعرِ الأسود. سأرحلُ عندما ينتهي الشتاء، لكني سأعودُ في الخريفِ لأرى كيف حالك. "
- لن أكون هنا الخريف القادم.
قالت ذلك، بينما خطرت في بالها صور المدينة بكنائسها الفخمة ومبانيها العظيمة وساحاتها الواسعة. نهضت ومررت يدها في شعرها.
صر كرسيه صريرا مزعجا عندما أمال ظهره للخلف. أدارت رأسها نحوه. وجهه النحيل بدا متأملاً بينما مرر ظفراً على ذراع الكرسي. سألها.
- هل ستشترين ثوباً حريرياً أحمر مطرزاً بالذهب، وترقصين في قصر أحد النبلاء؟ مثل تلك الكتب التي كان يحاول ذلك الشاب إعطاءك إياها، حيث تُشرح عبرة القصة في الصفحة الأخيرة؟"
- أنا بالتأكيد لن أعيش في إحدى قصصك عن وحوش المستنقعات والمستذئبين."
قال:
- تعالي هنا
جذبها إليه لتجلس في حجره، فاجتاحها حزن مرير رغم محاولاتها دفعه بعيداً. فكرت مرة أخرى بناثانييل، وكيف عليه أن يعود مسرعاً إلى المنزل بعد لقاءاتهما، وكيف لا يوجد أبداً وقت كافٍ لهما.
احتضنها الغريب. كان شعوراً لطيفاً أن تشعر بدفء شخص آخر وتجلس في صمت، دون عجلة، حتى وهي تفكر في رجل آخر. قال أخيراً.
- قبليني بإخلاص.
أجابت:
- مقابل ماذا؟ الزيف؟ لقد قبلتك مرة واحدة بالفعل، وهذا أكثر مما تستحق.
قال، واضعاً مفاصله تحت ذقنها وأمال رأسها لتتمكن من النظر إليه:
- لم تكن تلك قبلة عاشق.
قالت، وهي تلهث قليلاً
- أنت رجل مغرور لتعتقد أنه يمكنك أن تطلب أي شيء مني، أنا لا أعرف حتى اسمك.
- ليس لدي اسم.
- كل الناس لهم أسماء.
- كل الناس، لكن ليس كل الأشياء. هل تطالبين الشجرة أو الغراب باسمه؟"
سألها، بينما كان يمسك وجهها بلطف، وإبهامه يمرر على شفتها السفلى ليحدد شكلها. أضاف:
- الاسم لا يهم. أنتِ تعرفينني. ليس لدي حرير أو ذهب، لكني أعدكِ بأن آكل قلب عدوكِ وأمزق رئتيه بمخالبي مقابل قبلة منكِ، يا جوديث العزيزة، وهذا أكثر مما يمكن لأمير أن يعد به."
أحمرت وجنتاها وخفضت نظرها. أربكها، لكنها سرعان ما استجمعت نفسها. وقفت جوديث وانحنت فوق كرسيه وقبلت خده. قالت:
- هاك،لا داعي لوعود سخيفة.
ثم ضحكت وتراجعت خطوة، دارت كراقصة. ابتسم هو ولم يحاول إقناعها أو جذبها إلى حجره مرة أخرى.
مسحت شعرها عن وجهها وأشارت إلى الباب.
- هيا بنا، لنخرج، أنا إلى القرية وأنت إلى حيثما أتيت.
- من الغابة، بوضوح. ألا يمكنكِ البقاء لفترة أطول؟
قالت جوديث وهي تتنهد عند تذكر كومة الأعمال المنزلية التي يجب أن تنجزها.
- حفلة عيد ميلاد أختي بعد أيام قليلة. لدي الكثير من التحضيرات قبل ذلك،"
فتحت الباب وخرجا. بدأت الثلوج تتساقط، فلفت شالها فوق رأسها.قالت له:
- لا تمت جوعاً قبل ذلك وسأحفظ لك بعض الحلويات.
وربتت على ذراعه. ثم، وهي تشعر بنحول جسده النحيف، همست بجدية:
- اعتنِ بنفسك حقاً.
سألها، وهو يمسك يديها بين يديه. الضمادة التي يرتديها دغدغت بشرتها.
- هل سترتدين الشريط الأحمر في شعرك أثناء الحفلة؟"
- نعم.
رفع يدها ووضعها بلطف على شفتيه، في محاكاة ساخرة لقبلة رجل نبيل.
- سأفكر بكِ ليلة الحفلة، يا جوديث، بينما أعدو عبر الغابة وأمزق حلق أيل بعضة واحدة. سأتذكر كيف يطابق لون الشريط الأحمر لون دمه."
قالت، وهي تتحرر من قبضته وتعدل شالها:
- أنت مجنون. اذهب، الحق القمر، وأخبره بأكاذيبك.
ابتسم وبدأ يهمهم من جديد وهو يبتعد عنها.
***
في ليلةٍ كان القمرُ فيها بدرًا مُحاطًا بهالةٍ متجمدة، أقامت أخت جوديث حفل عيد ميلادها. وكالعادة، كان حدثًا فاخرًا. ارتدت أليس فستانًا جديدًا بلون الكريمة، بينما كانت جوديث ملفوفةً بفستانها المخملي الرمادي الذي ارتدته منذ ثلاث سنوات في مثل هذه المناسبات. كانت جوديث قد نسجت الشريط الأحمر بين خصلات شعرها الأسود، ووقفت وهي تمسك كوبًا من العصير بين يديها، تبتسم ابتسامةً خفيفةً وتحدق في اتجاه ناثانييل، الذي كان يرتدي بدلةً سوداءً كويها بعناية ذلك الصباح. بالكاد نظر إليها، وابتسامته تتجنبها.
قالت زوجة الخباز لجوديث.
عزيزتي، كم تبدين رائعة، نضجتِ كثيرًا!
ردت أليس ببرود
لم تنضج بعدُ بما يكفي..
- هراء! أليس العزيزة، أختك ستتزوج قريبًا - انظري إليها. بيتر كان يتحدث عن هذا.
أجابت أليس
- آمل ألا يكون ذلك قريبًا جدًا. ما زلت بحاجة إلى مساعدة جوديث في المنزل لفترة، خاصةً الآن وأن عائلتنا ستكبر.
لم تسمع جوديث بقية ما قالته زوجة الخباز، فقد كانت مشغولةً بمحاولة إمساك الكوب بين يديها المرتعشتين. في النهاية وضعته جانبًا ورفعت عينيها، لترى أليس تقف بجانب ناثانييل، يدها على ذراعه.
نظرت أليس إلى أختها بنظرة باردة ثابتة.
اقترب أحد التوأمين من جوديث وجذب تنورتها، يطلب قطعة خبز بالمربى. هدأت الطفل، لكنه بدأ بالصراخ.
في منتصف الليل، استيقظت جوديث على صوت عواء. لكنه لم يكن صراخ طفل، بل عواء ذئب في الغابة. دفنت وجهها في الوسادة وبكت بتناغم مع الوحش.
***
في اليوم التالي، توجهت إلى الكوخ. فأين عساها تذهب؟ عرفَت قدماها هذا الدرب، فسلكتاه بلا وعي. كانت قد شدّت الشريط الأحمر في شعرها مجددًا ذلك الصباح، كعلامة على بهجة زائفة، ولمست طرفه بأصابعها وهي تسير.
في الأعلى، نعق غرابٌ ظل يتبعها كظلّ عبر الغابة، حتى بلغت المكان القديم فدخلت، هزّت رأسها، تتساقط رقاقات الثلج من على كتفيها إلى الأرض وتذوب سريعًا. كان هو قد أشعل النار بالفعل، وأضاء الشموع. جلس ناثانييل على الكرسي وابتسم لها. قال:
- متأخرة قليلاً.أوشك الليل أن يحل.
تمتمت:
- صار الليل دائمًا على الأبواب الآن.
غربت الشمس باكرًا؛ بالكاد بضع ساعات من الدفء كانت تقف حاجزًا أمام الليل. كاد السواد القاتم يكون مخمليًا، يبسط سدوله فوق رؤوسهما، النجوم كالجواهر اللامعة، والقمر قرص فضي، والثلج رداء عاجي..نظرت من النافذة إلى هذا المشهد الجميل وفكرت في الانزلاق مرة أخرى إلى الشفق، إلى الظلام الآتي. لابد أنه خمن أفكارها، فقام فورًا وأمسك بها. طمأنها:
- سنفر معًا.
لو لم تكن متأكدة من قبل، فقد حسمت كلماته الحقيقة. أو بالأحرى، الأكاذيب. أدركت أنه لم يقصد أيًا من تلك الأشياء التي قالها. لن يكونوا معًا أبدًا. ومع الربيع سيختلق عذرًا، ثم عذرًا آخر.قال:
- أحبك.
صفعته. صرخت.:
- محتال! كذاب!لست لي، بل لها!
- جوديث، أرجوك، استمعي....
- ليس هذه المرة، لا.
شرح، توسل، هدد، أغراها، حاول أن يقتنعها، توسل مرة أخرى. بكت. في النهاية، أطبقت فمها على فمه لإسكاته. داعب شعرها وقال إنها جميلة، كاملة.
حاولت أن تكذب على نفسها وتصدق أكاذيبه المنسوجة بدقة، في فعل يائس من إحراق الذات. لكن ذلك لم يجد نفعًا، وعندما تحركا نحو السرير، بقيت ضائعة، وحيدة، باردة حتى العظم. كان الأمر كمن يحاول إحياء نارٍ أُطفئت بالماء: لم يبق سوى الدخان.
ظنت أنها سمعت صوتًا خارجًا، حكًا خفيفًا. ربما كانت الرياح تضرب مصراعي النافذة.
لم تجد متعة في عناقه، ولا حتى شرارة منها.
في النهاية تكورت على السرير، تضحك ضحكة مكسورة على نفسها وعلى الفراغ في صدرها. لابد أنه ظن أن هذا رضا حقيقي، لأنه غرق في نوم هانئ وسلمي بينما كانت هي ممزقة بجانبه.
كانت النوافذ مغطاة بصقيع أبيض شبحي، واقتربت من الزجاج، ترسم أشكالًا بأصابعها. بالخارج، لم تستطع رؤية شيء. لا النجوم، ولا الأشجار، فقط الثلج المخيف. مرة أخرى، جاء الصوت، خشخشة خفيفة—فتجهم وجهها.
عوى ذئبٌ خارج النافذة مباشرة.
التفتت جوديث لتوقظ ناثانييل، لكن شيئًا ما أوقفها. ظنت أنها تسمع همهمة تعرفها. هل كان الغريب بالخارج أيضًا؟
اقترب الصوت، وتكرر العواء، لكنه كان أبعد قليلاً الآن؛ حتى ظننت أن الذئب عند الباب.
تحركت نحو المدخل، والبرد يعض جسدها بينما تضع أذنها على الباب.
وقفت جوديث ساكنةً تستمع مرة أخرى.
ارتفع العواء، مما جعل الألواح الخشبية تحت قدميها تهتز.
حدقت في ناثانييل، الذي كان لا يزال نائمًا، إما مسحورًا أو ببساطة منهكًا. كانت البندقية عند المدخل، لكنها لم تكلف نفسها عناء أخذها.
شدت الباب بقوة. هبت الرياح على بشرتها؛ وتطايرت الرقاقات وتشابكت في شعرها الأسود.
دخل الظلام السائل بأسنان تلمع بيضاء كالثلج - ظلامٌ يمتلك عيونًا كالزئبق، تشبه حد السكين. انحنت بعض الشموع واهتزّت، كما لو كانت تحاول الفرار من ذاك المخلوق الهائل،
الذي قرعت مخالبه الأرض بإيقاع جليدي..
لحظة، فكرت في الصراخ صرخةً حادةً غبيةً، لإيقاظ الصياد.
لكن الظلام ابتسم لها، ابتسامة باردة كالجليد، مكونة من مجموعة من الأسنان المسننة التي يمكنها أن تحطم العظام بعضة واحدة.
عرفته الآن.
لطالما علمت أن عشيقها سيأتي من وراء الغابة. أغلقت الباب برفق خلفه، وأشارت إلى السرير حيث وجبة دافئة تنتظره
(النهاية)
***
.........................
الكاتبة: سيلفيا مورينو-جارسيا/ Silvia Moreno-Garcia : روائية وكاتبة قصص قصيرة ومحررة وناشرة مكسيكية-كندية. وُلدت مورينو-جارسيا في 25 أبريل 1981 ونشأت في المكسيك. وكان والداها يعملان في محطات إذاعية. انتقلت إلى كندا عام 2004. حصلت مورينو-جارسيا على درجة الماجستير في دراسات العلم والتكنولوجيا من جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر عام 2016. وتعيش حاليًا في فانكوفر.لها أكثر من عشر روايات وأكثر من مجموعة قصصية، وتعد كاتبة غزيرة الإنتاج.