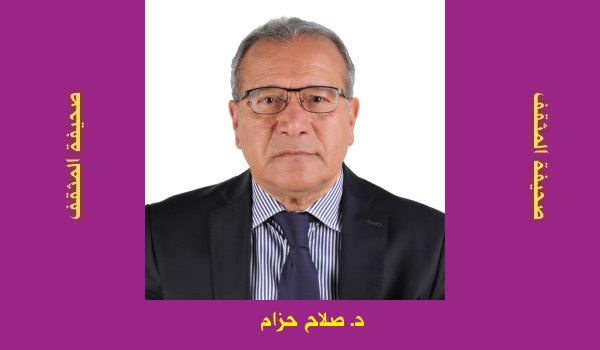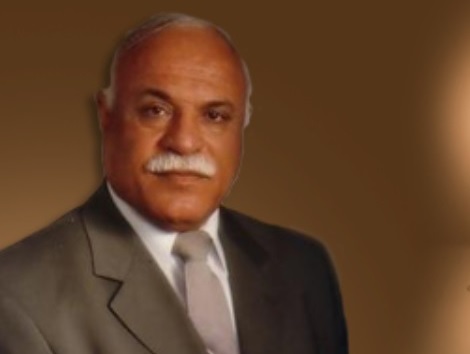تقول الحكاية أن حسن تقدم للزواج من فاطمة. ولمّا كان الزفاف أوصتها خالاتها ألا ترد عليه بأية كلمة إلا إذا قال لها: " أمك الشمس وأبوك القمر وخالاتك الكواكب".
في ليلة العرس حاول حسن أن يكلمها ويلاطفها وهي لا ترد، فظن أن السبب هو خجلها. ومرت الأيام وفاطمة لا تكلمه بشيء حتى ملّ منها. وفي يوم قرّر أن يُغضبها عسى أن تتكلم فأخبرها أنه دعا إلى منزله عشرين ضيفا، وأن عليها أن تُعد الغذاء لهم وإلا فهي طالق.. ثم خرج.
كانت خالات فاطمة قد جهّزنها بصحون وأطباق سحرية، فطلبت منها أن تخرج من الرفوف، وتملأ المائدة بأشهى الطعام. وفي وقت الغذاء جاء حسن وضيوفه، ففوجئ بالمائدة الفاخرة، وانتابه شك في الأمر.
بعد مضي أسابيع طلب منها إعداد وليمة أخرى واختبأ في ركن بالبيت، فشاهدها وهي تأمر الأطباق بإعداد المائدة، ثم وقع طبق على الأرض فقال: وحياة أمك الشمس وأبيك القمر سامحيني، فردّت عليه: سامحتك.
عندئذ عرف حسن سر كلام زوجته، فقال لها: وحياة أمك الشمس وأبيك القمر ردي عليّ وكلّميني، فكلّمته، وعاشا معا في سرور وسعادة.
كل امرأة هي فاطمة؛ لها أسرارها ومفاتيحها، ولها سلطتها الناعمة على آدم ليظل طفلا بين يديها. إن عاملها بقسوة ضربت بينها وبينه بسور من الصمت والغموض، وإن عاملها باللطف والرقة فتحت له أبواب جنتها ليسكن إليها ويسكن معها.
لكن يبقى السؤال المحير الذي تتوقف عليه السعادة وطمأنينة العيش: هل نفهم المرأة حقا؟ هل نعرفها حق المعرفة؟ من هي المرأة، وما هي خصائصها؟ هل هي مخلوق ناقص لأنها لم تُخلق من تراب مثل آدم؟ أم خُلقت من الضلع لتكون مصدر حنان للرجل، كما تحنو الأضلاع على الصدر وتحمي القلب؟
في أمريكا تحمل الأعاصير والزوابع والقنابل أسماء نساء.. كارولينا.. كاترينا.. ويلما.. كاميلا وغيرها. فهل المرأة خطيرة إلى هذا الحد، أم أن العلماء وخبراء الأرصاد يُعبرون عن تعاستهم الزوجية بتأنيث وسائل الخراب والدمار؟
أكيد أن المرأة ليست مصدرا لهذا الشر كله، فكل حياة جديدة تنشأ في رحمها، ويكبر الوليد في حضنها ليرضع من صدر الأمومة حليب العطف والحنان. وعندما يصير رجلا تبدأ رحلة البحث عن الزوجة؛ وهنا تصير المرأة لغزا وقضية، وتتدخل العادات وتقاليد الأسر لتجعل من الزواج إما راحة وسكينة، وإما رحلة من المشاكل والمتاعب التي تنتهي بالطلاق.
نعود إلى السؤال الأول: من هي المرأة؟ لأن الإجابة عنه تحدد شكل العلاقة معها، خاصة داخل مؤسسة الزواج. فكلما فهمنا المرأة وخصائصها استطعنا أن نتقبل قائمة الاختلافات التي تُميزها عن الرجل، وأدركنا أن سر السعادة الزوجية أن تُقدر عطاءها، وتحترم تميزها، وتمنحها دفء المشاعر حتى لو رددنا ما قاله حسن: أمك الشمس.. وأبوك القمر.. وخالاتك الكواكب!
كي نجيب عن سؤال: من هي المرأة؟ لا بأس أن نلقي نظرة على حضورها في تاريخ حضاراتنا القديمة؛ في مصر والعراق والشام، ونرى كيف كان الرجل يعامل المرأة وما هي مكانتها في المجتمع.
أول شيء يثير انتباهنا أن المرأة كانت مقدسة، والسبب أن الرجل وجد نفسه أمام مخلوق يشبهه، لكن يمتاز عنه بخواص الحمل والولادة والرضاعة والأمومة. هذه القدرة العجيبة للأنثى دفعته لأن يعبدها لأنها مصدر الخصب والعطاء، فظهرت تماثيل عشتار، والعُزى، وإيزيس، وفينوس في المعابد. بل كان الإنسان يعتقد بأن الكواكب بنات الأرض، أنجبتهن من زواجها بالقمر، فكانت كل عناصر الطبيعة تعكس إيمانه بأن المرأة هي المسؤولة عن الخلق وصناعة الحياة من عدم.
واستمر هذا التقدير بشكل آخر حين تولت بعض النساء مهام الحُكم، فظهرت ملكات وحاكمات كبلقيس وزنوبيا وكيلوبترا. وفي الجزيرة العربية كانوا يعتقدون أن المرأة هي التي تُحدد صفات الطفل ومكانته بين قومه، فكان الرجل إذا أراد أن يفتخر يقول: أنا ابن الحُرة!
إن ما يحتاجه الرجل اليوم ليس أن يعبدها بل أن يفهم عالمها حتى يكسب ثقتها؛ لهذا عندما بحث بيير داكو في سيكولوجية أعماق المرأة وجد أن أقصى ما تطمح إليه هو الاستقرار العاطفي، وأن تكون علاقتها مع الآخر، خاصة الزوج، مبنية على الرعاية والاحترام، والتعامل مع مصاعب الحياة بهدوء وصبر. وهي تُعبر عن حاجتها لهذا الاستقرار في اهتمامها بتفاصيل الحياة اليومية، ومشاركة كل شيء مع الزوج. للأسف لا يُقدر آدم هذا السلوك ويعتبره ثرثرة وتدخل في شؤونه، ولا يفهم أن الدافع هو حرصها على الاستقرار، فهي تكره الغموض والأسرار.
في كوريا يُرددون وصفا جميلا لعلاقة آدم بضلعه، فالرجل يولد من المرأة كما يولد الملح من الماء. لذا عندما يقترب منها بالزواج تمتصه ثانية كما يحدث للملح في الماء، وهذا تفسير للخوف الذي ينتاب بعض الشباب في بداية العلاقة الزوجية؛ فآدم يحس أن للمرأة قوة غامضة تدفعه للابتعاد أو الحذر، لكن الحقيقة أنها تريد أن تقترب منه، أن تتحدث إليه وتعبر عن شعورها واهتمامها. هذا هو أسلوبها في الشعور بالذات وتفريغ شحنات الأحداث اليومية، وليس مجرد ثرثرة كما يشكو أغلب الرجال.
إن العالم في تصورها هو اتصال دائم، واستمرار في خلق جو من المحبة والوئام. ووسيلتها المفضلة في ذلك هي الكلمات. وبلغة الأرقام فإن الدراسات العلمية توصلت إلى أن عدد الكلمات التي تنطق بها المرأة في اليوم الواحد تبلغ 20 ألف كلمة مقابل 7 آلاف كلمة للرجل؛ موهبة نحتاج لتقديرها كما ينصح بذلك أخصائيو علم النفس والاستشارات الاجتماعية. إنها تحس بالضيق، أو يزعجها شعورها المستمر بالمسؤولية.. تبحث عن التعاطف والمساندة. وفي الحياة الزوجية يكون دور الشريك أن يتفهم حالتها، ويساعدها بالتقرب الوجداني والمودة وليس بتقديم الحلول. إنها تحتاج فقط إنسانا ينصت إليها لتشعر بالراحة.
وأما أسلوب تفكير المرأة فهو مختلف قطعا عن الرجل؛ كل منهما يستعمل نظارة مغايرة ليرى العالم. فالرجل يتميز تفكيره عادة بالتركيز وربط الأمور ببعضها، بينما تنظر المرأة للعالم من زاوية التوسع. عندما تفكر في موضوع ما فهي ترسم أولا صورة واضحة عنه، ثم تبدأ باكتشاف الأجزاء المتعلقة به وربطها ببعض.
إن من مفاتيح المرأة طبيعتها التوسعية، وهو أسلوب وحاجة نفسية يجب أن يفهمها آدم ويتقبلها لأنها تكون أحيانا سبب لبعض المشاكل التي تطرأ على الحياة الزوجية. فمثلا لو أثرنا مسألة التسوق فإن الرجل يميل إلى التركيز وإنجاز المهام بسرعة، لذا لو دخل إلى السوق سيلتقط الحاجة ويخرج بسرعة. أما التسوق عند المرأة فهو متعة واكتشاف لكل المعروضات، وإن هي اتبعت أسلوب الرجل ستشعر بالتعب وتتأذى حالتها النفسية. ولهذا فهم يضعون المقاعد في محلات التسوق الكبرى خصيصا للرجال، لأن الأبحاث السيكولوجية أكدت أنهم لا يتمكنون من مسايرة أسلوبها التوسعي أكثر من نصف ساعة ثم يبدأون بالتضايق.
ويقودنا الفكر التوسعي لضلع آدم إلى الحديث عن اهتماماتها ونظرتها للحياة. فالمرأة عادة تهتم بتطوير العلاقات الاجتماعية وإشباع رغبتها في الحوار، وعالمها هو عالم الحب والعواطف الجياشة، لأن كيانها يتحقق من خلال المشاركة في الحياة. وهي تملك حاسة توقع احتياج الآخرين للمساعدة فتقدم المشورة والاقتراحات كدليل على الاهتمام والرعاية. وللأسف بعض الأزواج يعتبرون هذا الأمر تدخلا أو فضولا أو إهانة لهم. في حين أنه جزء من طبيعة المرأة واهتمامها. فبينما يميل الرجل إلى الكفاح وتحقيق النتائج، تميل هي إلى تنمية المشاعر الإيجابية.
إن حاجة المرأة للمشاركة الوجدانية والمساندة هو أحد مفاتيح شخصيتها، وفيه يتجلى ضعفها وسرعة تقبلها للتحليلات الخاطئة. فهي تشعر بالسعادة حين تسارع لتلبية حاجة الآخرين، لكنها بعد فترة من العطاء تتوقع منهم نفس الشيء. وحين لا ينتبه أحد لذلك تقرر إغلاق الأبواب، وتتوقف عن الطلب، وربما تفكر في إنهاء العلاقة.
يقول المثل العربي: لو كان الرجل نهرا لكانت المرأة جسره..
وفي ألمانيا يرددون أن البيت لا يُؤَسس على الأرض بل على المرأة..
وتستمر المرأة في عطائها واختلافها.. وحاجتها لأن يفهم آدم ضلعه حتى تكتمل صورته ووجوده.. ويقطعا معا تذكرة إياب إلى جنة الخُلد.
***
حميد بن خيبش