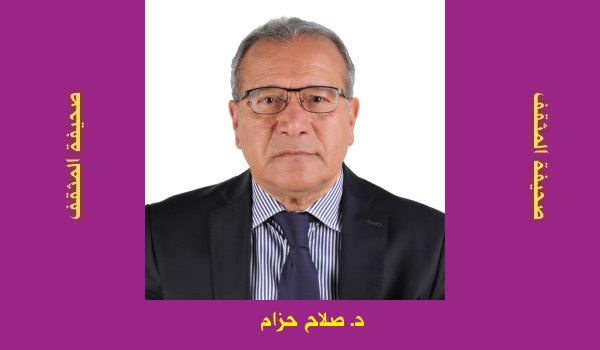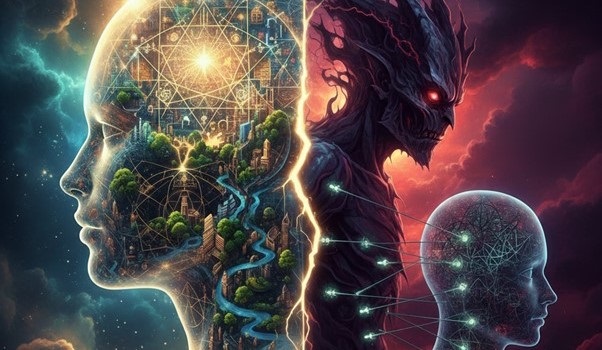السؤال الذي لا يشيخ منذ أن وعى الإنسان ذاته، وهو يسأل: من أنا؟ ولماذا وُجدت؟ وإلى أين تمضي هذه الروح التي تسكن الجسد لحظة ثم تفارقه؟
هذا السؤال هو نفسه الذي أقلق هيجل في ليل أوروبا المضطرب (حروب نابليون)، وأضاء قلب محمد ﷺ في ليل مكة الهادئ.
سؤال واحد، لكن طريقين. طريقٌ يبدأ من العقل وينتهي عند العقل، وطريقٌ يبدأ من الوحي فينتهي عند الله
هنا تبدأ رحلتنا.. لا لنحاكم الفلسفة، ولا لنخاصم العقل، بل لنضع السؤال في موضعه الصحيح، ونرى أين تلتقي العقول، وأين تفترق المصائر؟.
مشهدان متقابلان: ليلُ يينا (جرت معركة بين يينا وأويرستيدت الاسم القديم: أويرستادت في 14 أكتوبر 1806 على الهضبة الواقعة غرب نهر زاله في الأراضي التي يطلق عليها ألمانيا اليوم، بين قوات نابليون الأول ملك فرنسا وفردريك وليام الثالث ملك بروسيا. ) وليلةُ القدر في مكة المكرمة بالحجاز.
في أوروبا، هيجل يكتب فينومينولوجيا الروح على وقع المدافع، يرى التاريخ صراعاً، والروح ابنة التناقض، والفكرة وليدة الألم..
وفي الجزيرة العربية، ينزل الوحي في ليلة القدر، لا كصدى حرب، بل كإعلان هداية
﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ الفرق ليس في الزمن، بل في الرؤي.
هيجل يبحث عن نظام داخل الفوضى، والقرآن ينزل بالنظام ليُخرج الإنسان من فوضى الداخل
هل الروح: بذرةٌ تتطور أم خلقٌ يُربّى؟
يرى هيجل أن الروح كالبذرة، تحمل في ذاتها كل ما ستصير إليه، وتنمو بالصراع حتى تبلغ كمالها
أما القرآن فيعيد السؤال إلى أصله ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾
الفرق عميق في الفلسفة، الروح مشروعٌ ذاتيّ الاكتمال وفي الوحي، الروح مخلوقٌ مكرَّم، يُربّى بالهداية، ويُزكّى بالابتلاء.
ابن تيمية لخص المسألة بدقة الفلاسفة رأوا الشجرة، ونسوا البستاني
أما الإسلام، فرأى الشجرة، والماء، واليد التي ترعاها لحظة بلحظة هيجل يقول: لا تطور بلا تناقض
القرآن يقول: لا ارتقاء بلا ابتلاء ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾
التناقض الهيجلي ينتهي بذوبان الفروق في الروح المطلقة
أما الابتلاء القرآني فينتهي بوضوح الطريق: عبدٌ ورب، مخلوقٌ وخالق، مسؤولية لا ذوبان، وحرية لا تيه.
ابن القيم شبّه النفس بالفضة، لا تصفو إلا بالنار لكن النار هنا ليست صراع الأفكار، بل امتحان القيم
فكرة الكون هل هي فكرة عقلية أم آية إلهية؟
في فلسفة هيجل، الكون تجلٍّ للعقل المطلق، والنجوم أفكار تلمع في فضاء الفكر.
أما القرآن، فيضع الإنسان في موقع مختلف ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ﴾
الكون عند الفيلسوف موضوع تفسير وعند المؤمن خطاب هداية
ابن خلدون نبه إلى هذا الفارق
الفلسفة تسأل: كيف يعمل الكون؟
والوحي يسأل قبل ذلك: لماذا وُجد الكون؟
دوستويفسكي في رواياته رسم إنساناً ممزقاً راسكولنيكوف يقتل ليصنع لنفسه فكرة، فيغرق في العذاب.
أما القرآن فيقدّم صورة أخرى آدم يخطئ، فيتوب، فيُعلَّم، فيُستخلف ﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾
الإنسان في الأدب الغربي يبحث عن الخلاص داخل ذاته
وفي الإسلام، يجد ذاته حين يعرف طريق العودة إلى ربه
من الظل إلى النور: أي نور نريد؟
هيجل يتحدث عن خروج الروح من ظلال الوهم إلى نور الوعي.
والقرآن يقول ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾
نور هيجل هو اكتمال المعرفة.
نور القرآن هو طمأنينة النفس.
الأول يملأ العقل، والثاني يسكُن القلب ويهدي العقل معاً.
سؤال واحد.. ونهايتان
لقد تبيّن لنا أن السؤال واحد في الشرق والغرب
من نحن؟
لكن الجواب هو الذي يصنع الحضارة والإنسان.
عند هيجل: الروح تصعد حتى تعي ذاتها بذاتها.
عند الأدباء الوجوديين: الإنسان يتعذب ليخلق معنى مؤقتاً.
عند القرآن: الروح تسافر.. لا لتكتشف نفسها فقط، بل لتعود إلى ربها
﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ﴾.
هنا تنتهي مرحلة السؤال الفلسفي، وتبدأ مرحلة التاريخ والواقع
كيف تعيش هذه الروح في الأمم؟
وكيف تصنع الحضارات؟
وهل التاريخ حتمية عمياء أم سُننٌ تُدار بالحكمة؟
الروح في مسار التاريخ.. بين الجبر والاختيار
من نحن حين نصبح أمة؟
هنا لا تعود الروح فرداً يتأمل، بل تتحول إلى قوة تصنع التاريخ أو تُسحق فيه
وهنا يتقابل تصوران كبيران
تصور يرى التاريخ قدراً عقلياً لا يُقاوَم، وتصور يراه ميدان ابتلاء، تُكتب صفحاته بالأعمال لا بالأفكار وحدها.
إذا هل التاريخ: مسرح الروح أم ساحة الامتحان؟
هيجل يرى التاريخ سيرةً ذاتية للروح المطلقة، كل حضارة مرحلة، وكل حرب ضرورة، وكل سقوط خطوة للأمام .
التاريخ عنده عقلٌ يسير على الأرض، وإن بدا دموياً.
أما القرآن فيكسر هذه الحتمية الصلبة ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾
ليس التاريخ خطاً صاعداً لا ينكسر، ولا مسرحاً تُمثِّل فيه الأمم أدواراً مكتوبة سلفاً، بل حركة تداول، يعلو فيها من أخذ بالأسباب، ويزول فيها من خان القيم..
ابن خلدون هنا يقف في المنتصف، لا مع الجبر ولا مع الفوضى :التاريخ تحكمه سنن،
لكن السنن لا تعمل إلا إذا دخلها الإنسان بإرادته.
إذا صعود الحضارات وسقوطها: نهاية مفتوحة لا ذروة أخيرة.
هيجل توهّم أن الحضارة الأوروبية هي ذروة المسار الإنساني أما القرآن فلا يمنح شهادة (النهاية) لأحد
﴿وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾.
الحضارات لا تُقاس بتقدمها التقني وحده، بل بميزان العدل والمعنى.
مالك بن نبي أضاء هذه النقطة بوضوح الأمة لا تسقط حين تفقد القوة، بل حين تفقد الفكرة التي تبرر القوة.
هل الأمة: روح العقيدة أم روح القومية؟ هيجل تحدث عن روح الشعب ورأى الدولة التعبير الأعلى عنها
الدم، الأرض، اللغة.. كلها تصوغ هوية الروح الجمعية
لكن القرآن نقل الإنسان من ضيق العرق إلى سعة الرسالة ﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾
الأمة في الإسلام لا توحِّدها الجغرافيا، بل توحِّدها البوصلة.
ابن تيمية حسم الأمر ما جمعته العقيدة لا تفرقه الحدود، وما جمعته المصالح تفرقه أول أزمة
هل الذاكرة التاريخية: تكرار أعمى أم بصيرة واعية؟
في الفلسفة الغربية، التاريخ يُقرأ للعبرة العقلية وفي القرآن، يُقرأ للهداية ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا﴾
قصص الأمم السابقة ليست حنيناً إلى الماضي، ولا ترفاً ثقافياً، بل مرايا نرى فيها وجوهنا اليوم.
ابن القيم قالها بعمق:
من لم يقرأ التاريخ بعين القلب، سيعيد أخطاءه بعين الرأس. .
الحرية والمسؤولية: بين الحتمية و الاختيار، في الفكر الفلسفي الحديث، إما تاريخ تحكمه القوانين الصماء، أو حرية مطلقة تُغرق الإنسان في القلق.
القرآن جمع بين الأمرين دون تناقض ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾
القدر ليس سجناً، والحرية ليست فوضى هي مساحة العمل بين علم الله السابق، وفعل الإنسان اللاحق
من الذات الفردية إلى الوعي الجمعي.
الغزالي قال: العقل يدرك، لكن القلب هو الذي يوجّه ولهذا ربط القرآن بين فساد القلوب وسقوط الأمم، لا بين ضعف العقول وانهيار الحضار.
﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ﴾
حين تضل القلوب، تتقدم الجيوش بلا معنى، وتتكدس الثروات بلا بركة، ويتحول التاريخ إلى مقبرة حضارات متشابهة إذا التاريخ ليس عذراً.. بل شهادة.
لسنا ضحايا تاريخٍ أعمى، ولا أبناء صدفة كونية نحن شركاء في صناعة مصيرنا، تحت سقف سنن لا تحابي أحداً.
الفلسفة رأت في التاريخ مساراً للعقل الأدب رآه مأساة إنسانية متكررة.
القرآن رآه محكمة مفتوحة، يُستدعى إليها الأفراد والأمم وهنا يبرز السؤال الأخير، سؤال عصرنا نحن
كيف تعيش الروح في زمن الآلة، والسرعة، والذكاء الاصطناعي؟
هل تذوب في التقنية؟
أم تستعيد معناها وتوظفها؟ ذلك هو أفق الرحلة الأخيرة..
حيث نغادر التاريخ، و ندخل العصر
الروح في زمن الذكاء الاصطناعي.. بين الإنسان والآلة، وبين العلم والافكار
الروح في زمن الآلة.. حين يسأل الإنسان نفسه من جديد
من تاريخ الأفكار إلى أفق الاستخلاف
نحن اليوم لا نعيش أزمة معرفة، بل أزمة فكرة
العقل لم يعد عاجزاً، بل متخماً والآلة لم تعد أداة، بل صارت شريكاً في التفكير
لكن السؤال القديم عاد بصيغة أكثر حدة إذا كانت الآلة تحسب، وتتعلم، وتكتب، وتقلّد..
فأين تقف الروح؟
وهل ما زال للإنسان امتياز في هذا العالم المتحوّل؟
هنا يبلغ مسار الرحلة ذروته من سؤال الذات، إلى حركة التاريخ، إلى امتحان العصر
الذكاء الاصطناعي: عقل بلا روح
التقنية الحديثة توحي بأن الوعي مسألة تعقيد حسابي، وأن الإنسان يمكن اختزاله إلى خوارزمية متقدمة
لكن القرآن يعيد رسم الحدود بدقة
﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾
الآلة قد تحاكي العقل، لكنها لا تعرف الدهشة، ولا الذنب، ولا التوبة، ولا الشوق.
عبد الوهاب المسيري نبه إلى هذا الفارق الجوهري
العقل أداة، أما الروح فهي مصدر القيمة.
وحين تُفصل المعرفة عن القيمة، يتحول التقدم إلى خطر ناعم
نهاية المادية أم بدايتها الأخيرة؟
الفيزياء لم تعد ترى الكون مادة صماء، بل شبكة احتمالات، ونظاماً بالغ الدقة، يكاد يشبه الفكرة أكثر مما يشبه الصخرة.
﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾
العلم كلما تعمق، اقترب من سؤال الغاية، لكنه يعجز عن الجواب.
وهنا يتدخل الوحي لا ليصادم العلم، بل ليمنحه أفقاً أخلاقياً ومعنى وجودياً
مصطفى محمود عبّر عن ذلك ببساطة عميقة :العلم يخبرك كيف يعمل الكون، لكن الإيمان وحده يخبرك لماذا.
علم الوراثة يقول: فيك برنامج سابق
والقرآن يقول ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾
لسنا أسرى الجينات، ولا آلهة نصنع ذواتنا من عدم
نحن كائنات مهيّأة، ومسؤولة
ابن القيم لخص المعادلة
السنن لا تلغي الإرادة، والإرادة لا تخرق السنن
وهنا تتجلى كرامة الإنسان.
ليس في قوته، بل في محاسبته.
الفضاء الرقمي: اغتراب جديد أم فرصة للمعنى؟
العالم الافتراضي يضغط الزمان والمكان،
لكنه يهدد بتسطيح الروح.
الإنسان قد يصبح متصلاً بكل شيء،
ومنقطعاً عن نفسه. ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾
الطمأنينة لا تُحمَّل من تطبيق، ولا تُستخرج من خوارزمية
لكن هذا العصر ليس شراً محضاً
هو فرصة لنشر الحكمة، ولبناء وعي عالمي،
إذا بقيت البوصلة واضحة.
بعد هذه الرحلة الطويلة، تتضح معالم طريق جديد: عقل منفتح.. ووحي موجِّه
العقل لا يُلغى، لكن لا يُؤلَّه.
التقنية تخدم الإنسان، ولا تعرّف الإنسان.
إنسان مستخلف لا مركز الكون كما قال طه عبد الرحمن.
الإنسان ليس سيد الوجود، بل أمين عليه.
حضارة لها معنى لا حضارة الاستهلاك.
القوة بلا قيم انهيار مؤجَّل.
إذا من السؤال إلى السكينة.
بدأنا الرحلة بسؤال الفلاسفة: من أنا؟
ومررنا بتاريخ الأمم: كيف نحيا معاً؟
وانتهينا بسؤال العصر: ما الذي يبقى إن تقدمت الآلة؟
والجواب لم يتغير.
﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ﴾
هيجل علّمنا أن التاريخ له معنى والفلاسفة علّمونا شجاعة السؤال
لكن القرآن علّمنا أن للمعنى نهاية، وللسؤال جواباً، وللرحلة لقاء
فالروح لا تتيه إلى الأبد، بل تعود.. حين تعرف الطريق
تمت الرحلة بحمد الله ومنّته.
***
الأستاذ بلحمدي رابح – شاعر، قاص، ناقد
البليدة الجزائر