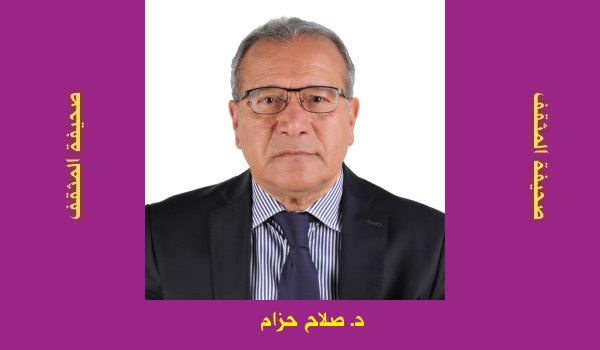"ما لا نستعد له هو ما يحدث دائماً".. جملة تحمل في طياتها إدانة لكل المنظومات الأمنية التي تعتقد أن الماضي كفيل بحماية المستقبل. ديفيد أوماند، الرجل الذي عاش في دهاليز الاستخبارات البريطانية، يقدم في كتابه "حماية الدولة" تشريحاً دقيقاً لمعضلة العصر: كيف تحكم دولة في عالم لم تعد فيه الجيوش هي الفاعل الوحيد، بل صارت الفيروسات والبيانات والهويات المتفجرة أسلحة أكثر فتكاً؟
السؤال الذي يطرح نفسه على الطاولة العربية هو هل يمكن للدولة أن تكون "حامية" دون أن تتحول إلى "سجان"؟ وهل الأمن يصنع بالحديد والنار، أم بالعقول والثقة؟
من "الدولة العميقة" إلى "الدولة الهشة"
في القرن العشرين، كانت الدولة العربية تقاس بقوة أجهزتها الأمنية، لكن القرن الحادي والعشرين كشف أن هذه الأجهزة – رغم بطشها – لم تستطع حماية الأنظمة من العواصف الداخلية. الربيع العربي كان صفعة تاريخية كشفت أن "الأمن القومي" الذي بني على مراقبة المواطن بدلاً من فهمه، يشبه قلعة من الرمال أمام موجات الغضب الشعبي.
أوماند يذكرنا بأن "الحكومة السيئة هي التي تفقد التوازن بين الأمن والحرية". والعالم العربي شهد نماذج فاشلة في هذه المعادلة: أنظمة قمعت شعوبها باسم "مكافحة الإرهاب"، ثم اكتشفت أن القمع نفسه أصبح وقوداً للإرهاب. مصر وسوريا والعراق أمثلة على أن الأمن الذي يبنى على الخوف لا يدوم.
التكنولوجيا غيرت قواعد اللعبة. اليوم، "الجاسوس" قد يكون خوارزمية تتنبأ بالجرائم قبل وقوعها، لكن أوماند يحذر: "امتلاك المعلومات لا يعني فهمها". الهجوم الإلكتروني على Aramco السعودية عام 2012 كان جرس إنذار: فالدول العربية – رغم إنفاقها المليارات على الأمن التقليدي – ظلت عاجزة أمام هجمات "هاكرز" في غرف نومهم.
والأخطر من التهديدات الخارجية هو "العمى المؤسسي" الداخلي. أوماند يشير إلى أن حرب أكتوبر 1973 كانت فشلاً استخبارياً ليس لنقص المعلومات، بل لأن إسرائيل صدقت أن العرب غير قادرين على المفاجأة. والعرب أنفسهم وقعوا في الفخ: فقبل "الربيع العربي"، كانت أجهزة الأمن تعرف كل شيء عن المعارضين، لكنها لم تفهم شيئاً عن المجتمعات.
المواطن.. "ضحية" أم "شريك" ؟
الدرس الأهم من كتاب أوماند هو أن "الأمن لا يمنح، بل يشارك فيه". النموذج البريطاني في مواجهة "الجيش الجمهوري الأيرلندي" نجح لأنه جمع بين الضربات الأمنية والإصلاح السياسي. أما في العالم العربي، فما زال المواطن ينظر إليه كعدو محتمل، لا كشريك في صنع الأمن.
لكن الثمن باهظ عندما تنهار الثقة بين الدولة والمواطن، يصبح الأمن مستحيلاً. ليبيا واليمن نموذجان لدول امتلكت أجهزة أمنية عملاقة، لكنها تحولت إلى غنائم للصراعات الداخلية حين فقدت شرعيتها.
الاستنتاج الذي يصل إليه أوماند – وأؤكده هنا – هو أن "الأمن الحقيقي ليس جداراً يبنى حول الشعب، بل نسيجاً يحاك داخله". الدول العربية أمام خيارين: إما الاستمرار في نموذج "الدولة الحارسة" الذي يحول الأمن إلى سلعة نخبوية، وينتج مجتمعات مكبوتة تنتظر الفرصة للانفجار. أو الانتقال إلى نموذج "الدولة الحامية" التي توازن بين القوة والشرعية، بين الأمن والحرية، بين السرية والشفافية.
التاريخ لا يرحم. الأنظمة التي تعتقد أنها قادرة على شراء الأمن بالخوف ستفاجأ – كما فوجئت من قبل – أن الخوف نفسه أصبح سلاحاً ضدها. والعالم العربي، الذي يعيش في قلب العاصفة، عليه أن يتعلم أن "حماية الدولة" لا تعني حماية السلطة، بل حماية المجتمع.
في القرن الحادي والعشرين، لم تعد الدبابات تحسم المعارك، بل "البيانات".. تلك هي المفارقة التي يسلط عليها ديفيد أوماند الضوء في كتابه. العالم العربي، الذي أنفق ملياراته على شراء أحدث الأسلحة، وجد نفسه عاجزاً أمام هجمات إلكترونية من مراهقين في أوروبا الشرقية!
- عام 2017: هجوم "WannaCry" الشهير شل أجهزة المستشفيات والمطارات، وكشف أن "السيادة الرقمية" أصبحت جزءاً من الأمن القومي.
- عام 2020: وثائق "الاستخبارات الإماراتية" المسربة كشفت كيف تحولت برامج التجسس إلى أدوات لقمع المعارضين تحت شعار "مكافحة الإرهاب".
هنا يطرح أوماند سؤالاً وجودياً: هل يمكن بناء جدار إلكتروني يحمي الدولة دون أن يخنق المجتمع؟ الإجابة تكمن في معضلة "المربع المستحيل" الذي ذكره: الفعالية الأمنية مقابل الحريات الفردية. فالدول التي تختار القبضة الحديدية – كما حدث في مصر بعد 2013 – تكتشف لاحقاً أن "الأمن" الذي اشترته بثمن الحريات تحول إلى "سرطان" ينخر جسم الدولة من الداخل.
استراتيجية "الخوف"!
أحد أكثر الفصول إثارة في كتاب أوماند هو ذلك الذي يحلل فيه سيكولوجية صناع القرار. في العالم العربي، نجد نمطاً متكرراً: الخوف المرضي من التهديدات الذي يتحول إلى "بارانويا" مؤسسية، كما حدث مع نظام صدام حسين الذي ظن أن امتلاك أسلحة الدمار الشامل سيحميه، فإذا بها تصبح سبباً لغزوه!
الغرور المعرفي حيث يصدق الحاكم أن أجهزته الأمنية قادرة على التنبؤ بكل شيء، كما ظن زين العابدين بن علي قبل ساعات من هروبه من تونس!
أوماند يذكرنا بأن "أكبر الأخطاء الاستخبارية تحدث عندما نصدق أننا نعرف كل شيء". وهذا ينطبق على الأنظمة العربية التي تعاملت مع "الربيع العربي" كـ"مؤامرة خارجية" بدلاً من قراءة التحولات الجيوسيكولوجية في مجتمعاتها.
الأمن المجتمعي..
النموذج الذي يطرحه أوماند لـ"المواطنة الأمنية" يضع العالم العربي أمام مرآة قاسية، ففي لبنان تحولت "الميليشيات" إلى أجهزة أمن موازية، ففقدت الدولة احتكارها للعنف. أما في سوريا فقد أصبح "الأمن" سلعة تقدمها الميليشيات للأحياء الموالية، بينما تحولت المناطق المعارضة إلى ساحات عقاب جماعي.
لكن هناك نموذجاً مختلفاً في المملكة المغربية، حيث نجحت "الاستخبارات الوقائية" في تفكيك خلايا إرهابية عبر التعاون مع المجتمع المحلي، دون التضحية بالحريات. هذا يثبت أن "الأمن الفعال هو ذلك الذي يجعل المواطن شريكاً لا ضحية".
السؤال الآن هو: هل يمكن إنقاذ الدولة العربية من نفسها؟
الدرس الأعمق الذي يقدمه أوماند هو أن "الدولة التي تختزل الأمن في القمع تصنع سجناً كبيراً، لكنها لا تصنع وطناً". التاريخ يعلمنا أن الأمن القائم على الخوفينتج مجتمعات ميتة كتلك التي بنتها كوريا الشمالية. أما الأمن القائم على الثقةفيبني دولاً مرنة كالسويد التي تحولت من دولة عسكرية إلى نموذج للرفاهية.
العالم العربي أمام مفترق طرق، إما أن يعيد تعريف الأمن كـ"عقد اجتماعي" جديد، أو سيصبح الأمن نفسه سبباً في انهياره. وكما قال أوماند: الثمن الذي ندفعه مقابل الأمن يجب أن يشتري لنا حياة تستحق العيش، لا مجرد بقاء يستحق الانقراض.
***
د. عبد السلام فاروق