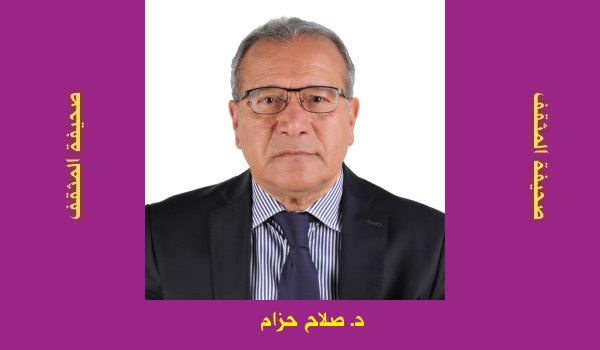يُعَدّ الأدب الشعبي العراقي واحدًا من أغنى وأقدم أشكال التعبير الإنساني في المنطقة العربية، بل إنّه يُعدّ امتدادًا طبيعيًا لإرث حضاري يمتدّ من سومر وأكد وبابل إلى العصور الإسلامية والعثمانية وصولًا إلى العراق الحديث ولأن العراق كان وما يزال ملتقى حضارات وثقافات وأعراق، فقد كان الأدب الشعبي فيه مختلفًا عن غيره، متنوّعًا في أشكاله، واسعًا في لغته، متجددًا في إيقاعه، وحاملًا لروح الناس بكل تفاصيلها وأفراحها وجراحها وأحلامها.
- البيئة العراقية.. رحمٌ ولود للأدب الشعبي
بيئة العراق بيئة غنية بالتناقضات التي تُنشئ أدبًا متنوعًا: أنهار دجلة والفرات بساتين النخيل، البوادي الواسعة، المدن الكبرى، الأرياف، العشائر، الحروب، الفقر الازدهار، الانهيارات، الوقوف من جديد وهذه المشاهد تصنع خيالًا مختلفًا، وتمنح الكلمة الشعبية مادة خامًا استثنائية فمن يزور العراق يجد أن كل منطقة فيه تمتلك نبرة خاصة في الجنوب لغة الرطب والنخيل والماء، وفي الفرات الأوسط نبرة العتابة والطور، وفي الأنبار والموصل لهجة البوادي وفي بغداد خليط من كل هذا يذوب في روح المدينة العريقة.
هذه البيئات المتنوعة خلقت أدبًا شعبيًا واسعًا لا يمكن اختزاله في نمط واحد فهو شعر وغناء وحكايات وأمثال ومواويل وروايات شفاهية وأساطير صغيرة تتناقلها البيوت جيلاً بعد جيل.
- الشعر الشعبي العراقي.. قلب الموروث
يحتل الشعر الشعبي في العراق مركز القلب. فهو ليس مجرد فن، بل هو وسيلة للتعبير وسلاح للاحتجاج، وتعزية للمصاب واحتفال بالفرح، وتوثيق للحرب، وسردٌ للتاريخ.
1. العتابة
العتابة مثال رفيع على جمال الوجدان العراقي. وهي تعتمد على الكلمات ذات الجذر الواحد واختلاف المعنى، مما يخلق تحديًا لغويًا ممتعًا وغالبًا ما تمتلئ بالحزن والحب والغربة والشكوى وصوت العتابة يخرج كأنه بكاء الأرض حين تجف، أو حنين الروح حين تتعب.
2. الدارمي
قصيرة، لكنها تحمل حكمًا وتجارب طويلة. تُقال عند المواقف، وتُستخدم في الغزل وتدخل في سرد الحوادث اليومية والدارمي دليل أن العراقي قادر على اختصار حياة كاملة في بيتين فقط.
3. الزهيري
تسعة أبيات، مع بصمة لغوية معقدة، لكنها محبوبة، وتعد من أرفع الأنواع لثرائها وقوة تأثيرها. الزهيري مدرسة مستقلة في السرد الشعبي، تربط بين الحكمة والشعر والمعنى العميق.
4. المواويل
الموال العراقي أشهر من أن يُعرّف وموال "الأبوذية" الذي يخرج كأنّه أنين إنسان عاش بين الفقد والموت والحصار والعشق والخيبة ومن يستمع لموال بغدادي أو ريفي يشعر أن الصوت يحمل تاريخ العراق كله.
5.الهوسات والدبكات
الهوسة ليست فنًا فقط، بل هي صوت الجماعة، صوت الفزعة، صوت القوة وفي الهوسات كلمات تُفجّر الروح، وتنهض القبيلة، وتُشعل الحماسة، وقد سجلت مواقف بطولية خلال الاحتلالات والحروب والأزمات.
- الحكاية الشعبية العراقية
الحكايا جزء من تكوين الذاكرة العراقية خصوصًا أن العراق شهد حضارات قصصية منذ جلجامش والحكايات تتنوع بين:
- حكايات الجدات: السعلوة، وغيرها.
الأساطير الصغيرة: قصص الخوف التي تُروى لردع الأطفال عن الخطر.
- قصص البطولة: عن الرجال الذين عاشوا في الريف، وعن الشجاعة والشرف والكرم.
- القصص المرحة: جحا العراقي بطبعات مختلفة، وروح الدعابة البغدادية التي لا تتكرر.
هذه القصص كانت المدرسة الأولى للطفل العراقي، وهي التي كوّنت مخيلته وشكّلت تصورات الخير والشر.
- الأمثال الشعبية.. حكمة العراق المختصرة
الأمثال الشعبية في العراق ليست أقوالًا فقط؛ إنها دستور اجتماعي كامل غير مكتوب زكل مثل يحكي قصة، ويحمل تجربة، ويقدّم درسًا. مثل:
"المي ما تغسل العار"
"الناموس أهيب من الفاس"
"راح الزلم وبقيت تْنِهّ"
"الباب اللي يجّيك منّه الريح سدّه واستريح"
وغيرها هذه الأمثال أثبتت أن العراقي يرى الحياة بعين الحكمة رغم الألم.
- الأغنية الشعبية العراقية
الأغنية العراقية تحمل نبرة لا تشبه أي نبرة في الوطن العربي وهي خليط من الحزن والفرح، من الطرب والشكوى، من الشجن والرقص. ومن ميزاتها:
- الأبوذية الملحنة
- الطور الريفي الجنوبي
- المقامات البغدادية
- الأغاني البدوية
- الهناوي والسويحلي
وكل منطقة صنعت لونها الخاص الذي يشبه أرضها ولهجتها ونخيلها ومائها.
- الأدب الشعبي في العراق زمن الأزمات
قلّما مرّ العراق بفترة هدوء طويلة. الحروب الحصار، الاحتلال، الضياع، الانقسامات.. كل ذلك كان مادة للأدب الشعبي، الذي تحوّل إلى مرآة صادقة لأوجاع الناس.
في الحروب، كتب الشعراء الشعبيون عن الفقد والفراق والجنود الذين عادوا نعوشًا. وفي الحصار كانت القصائد تبكي الخبز والدواء وفي الاحتلال كان الأدب الشعبي وسيلة مقاومة، يوثّق الحقيقة ويصرخ بها.
بل إن العراقيين استخدموا الشعر الشعبي في الاحتجاجات السياسية، وفي مواجهة الفساد، وفي رفع صوت الشارع، فكان الشعر أقوى من الرصاص أحيانًا.
- المدن العراقية وصوتها الشعبي
- بغداد
مدينة الشعر الناعم والسخرية الذكية. أمثالها لا تشبه غيرها، ونكاتها لها طابع فلسفي ساخر.
- الجنوب
مسقط رأس الأبوذية والطور ولغة الماء والطين والبردي والهور والشعر هناك يشبه النخل: راسخ، عميق، شامخ.
- الفرات الأوسط
مركز العتابة والزُهيريات والناس هناك يقولون الشعر كما يتنفسون.
- الموصل والأنبار
- لغة البادية والقوة والفروسية.
العراق فسيفساء أدبية، وكل منطقة تقدم لونًا يزيد المشهد جمالاً.
- لماذا الأدب الشعبي العراقي مختلف ؟
لأنه قديم قِدم الحضارة.
لأنه عاصر المجاعات والحروب والغزوات.
لأنه نابع من ناسٍ يعرفون قيمة الأرض والشرف والكرامة.
لأنه أدب صادق ومعجون بالدمع والعرق.
لأنه أدب يُقال بالعامية لكنه يحمل روح الفصحى وحكمة الأجداد.
- تأثير الأدب الشعبي العراقي على الهوية
لا يمكن للعراقي أن ينقطع عن جذوره لأن الأدب الشعبي يشده دائمًا للوراء ليرى نفسه. هذا الأدب يمنح الناس:
انتماءً
ذاكرة
شجاعة
عزاء
وضحكة وسط الخراب
إنه ليس أدبًا فقط، بل هو قوة روحية وثقافية تحافظ على تماسك المجتمع.
- الأدب الشعبي اليوم
اليوم، وبعد انتشار وسائل التواصل واليوتيوبرز والبرامج الفضائية، عاد الأدب الشعبي بقوة وصار الشعراء نجوماً، وصار الناس يستمعون للمربعات والطور والموالات أكثر من أي وقت مضى بل أن كثيرًا من القصائد الشعبية أصبحت جزءًا من الحياة اليومية.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على الأصالة ومنع التشويه والسطحية فالأدب الشعبي إرثٌ يجب صونه، وتعليمه وتدوينه، وتقديمه للأجيال كجزء من الهوية العراقية.
ختاما الأدب الشعبي العراقي ليس مجرد تراث، بل هو شجرة تمتد جذورها إلى آلاف السنين وهو تاريخ العراق غير المكتوب والصوت الذي لم يخن أصحابه، والمرآة التي تعكس وجه الإنسان العراقي بجماله وخوفه وصبره وكرامته وإنه أدب يثبت أن الشعب الذي يمتلك هذا الثراء اللغوي والوجداني، قادر على الوقوف مهما اشتدت المحن.
***
د. رافد حميد فرج القاضي