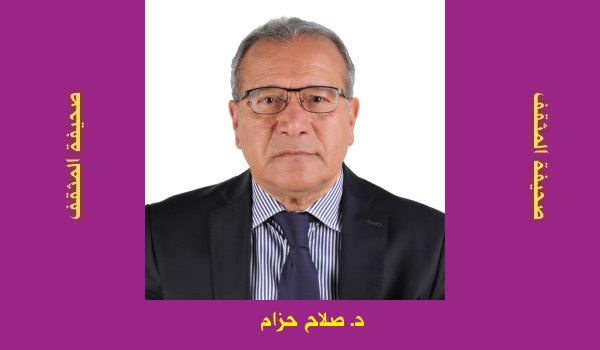من أخطر ما أصاب الوعي الديني عبر التاريخ أن يتحوّل الدين من رسالةٍ إلهيةٍ جامعة إلى هوياتٍ طائفيةٍ متناحرة، ومن دعوةٍ للإنسان إلى الله إلى دعوةٍ للناس نحو الجماعة، والمذهب، والراية، والزعيم. وهنا تتبدّى الفجوة العميقة بين إسلام الله بوصفه دينًا للإنسانية، وإسلام الطوائف بوصفه صناعةً بشرية، مشحونة بالخوف، والسلطة، والاصطفاف.
إسلام الله: رسالة قبل أن يكون هوية
إسلام الله لم يأتِ ليصنع «طائفة ناجية» في مقابل «طوائف هالكة»، بل جاء ليحرّر الإنسان من كل انتماءٍ ضيّق يحجبه عن أخيه الإنسان. جاء ليبني الضمير لا القطيع، وليوقظ العقل لا الغريزة الجماعية.
﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾… لا: يا أيها الطائفة
﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ لا: أنقاكم مذهبًا
إسلام الله يخاطب الإنسان قبل المسلم، والإنسانية قبل الجماعة، والأخلاق قبل الشعارات.
إسلام الطوائف: حين يتحوّل الدين إلى سور
أما إسلام الطوائف، فهو حين يُختَزل الدين في فهمٍ واحد، ويُختَطف النص لصالح جماعة، ويُرسم خطٌّ وهميٌّ بين «نحن» و(هم). هنا لا يعود الاختلاف ثراءً، بل يتحوّل إلى تهمة، ولا يعود التنوع آيةً، بل بدعة.
تشدُّدُ بعض الطوائف لم يكن دفاعًا عن الدين، بل دفاعًا عن الهوية المهدَّدة. وحين يخاف الإنسان على هويته، يصبح مستعدًا لتبرير العنف باسم المقدّس.
العنف باسم الله: أمثلة لا تُنكر
التاريخ الإسلامي – كما غيره من تواريخ الأديان – ليس بريئًا من الدم. جماعاتٌ رفعت شعار «تطبيق الشريعة»، لكنها مارست القتل، والتكفير، وإلغاء الآخر:
فرقٌ كفّرت المجتمع لأنه «لا يشبهها»، فاستحلّت دمه.
جماعاتٌ رأت في الاختلاف العقدي مبررًا للقتل، لا مجالًا للحوار.
حركاتٌ أقامت «دولة الله» على جماجم البشر، ونسيت أن الله لا يُختصر في دولة ولا يُمثَّل بسلاح.
والمفارقة المؤلمة أن كل هؤلاء يستشهدون بالقرآن، بينما القرآن يقول بوضوح:
﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾
لم تتأسس أغلب الطوائف بدافعٍ دينيٍّ خالص، بل في سياقات سياسية واجتماعية: صراع على السلطة، خوف من الإقصاء، شعور بالظلم، أو حاجة نفسية إلى الانتماء. ثم جاء الفقه لاحقًا ليُشرعن الواقع، وجاء التاريخ ليكتبه المنتصر، وجاءت القداسة لتُلبِس البشر لباس العصمة. وهكذا، تحوّل الاجتهاد إلى عقيدة، والرأي إلى إيمان، والزعيم إلى ظلّ الله في الأرض.
إلغاء الآخر: أخطر أشكال الشرك الخفي
إلغاء الآخر ليس خطأً أخلاقيًا فحسب، بل انحراف ديني. لأن الله نفسه أقرّ بالاختلاف:
﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾
فالذي لا يحتمل المختلف، إنما يعترض – دون أن يشعر – على مشيئة الله في التنوع.
حزب الله الحقيقي: لا الطائفي
حين ندعو إلى الرجوع إلى حزب الله، فلا نعني حزبًا سياسيًا، ولا تنظيمًا، ولا رايةً جغرافية. نعني ما قصده القرآن:
﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾
وحزب الله هنا ليس بطاقة عضوية، بل قيم: العدل، الرحمة، الصدق، كرامة الإنسان، ونصرة المظلوم أيًّا كان. كل من جعل الله غايته لا وسيلته، وكل من جعل الإنسان مقصد الدعوة لا وقودها، فهو من حزب الله… وإن لم ينتمِ إلى أية طائفة.
التعايش: أصل الدعوة لا تنازلٌ عنها
التعايش ليس ضعفًا، بل فهمًا عميقًا للدين. والنبي محمد ﷺ عاش في مجتمع متعدد: يهود، مشركون، منافقون، ولم يُلغِ أحدًا، ولم يُجبر أحدًا على الإيمان.
﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾
هذه ليست آية هدنة، بل مبدأ وجود.
كسر الأصنام الجديدة
أخطر أصنام عصرنا ليست حجرًا، بل شخصيات مقدسة لا تُسأل ولا تُناقَش. زعماء طوائف، شيوخ جماعات، دعاة كراهية… نرفعهم إلى مقام العصمة، ثم نتساءل: لماذا تعطّل العقل؟
الدين لا يحتاج أوصياء، والله لا يحتاج محامين، والحق لا يخاف من السؤال. إسلام الله واحد، واسع، رحيم، إنساني. أما إسلام الطوائف فكثير، ضيّق، متنازع، ومثقل بالتاريخ والخوف. الخلاص ليس في تبديل طائفةٍ بأخرى، بل في الخروج من منطق الطوائف أصلًا. الخلاص في دينٍ يعيد الإنسان إلى مركز المعنى، ويعيد الله إلى مقامه: إلهًا للهداية… لا أداةً للصراع.
أكتب هذا وأنا منحازٌ إلى الله لا إلى الطائفة، وإلى الدين بوصفه هداية لا هويةً مغلقة. أريد إسلامًا من الله، لا إسلامًا صاغته الفرق وصادقَت عليه الصراعات. أؤمن بربٍّ واحد لا يتجزّأ على المذاهب، ولا يُمثَّل بجماعة، ولا يُحتكَر براية. وإن كنتُ قد وُلدتُ في طائفةٍ دان بها والداي، فذلك انتماءُ الميلاد لا خيارُ الإيمان، أما إسلامي فهو اختيارُ وعي، وموقفي أن الله أوسع من الطوائف، وأن الإنسان هو غاية الرسالة لا وقودها.
***
بقلم: د. علي الطائي
2-1-2026