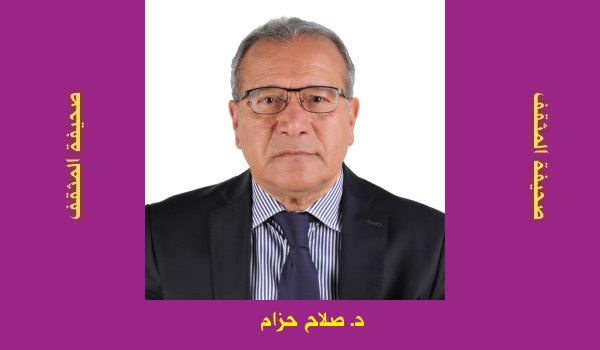تابعت مانشره الشاعر الأستاذ ناهض الخياط حول نقده لما ورد بكتاب السيد ناجح المعموري المعنون (قبعة موفق محمد) وفي صفحة مركز النور وما همني هو ما يخص قصيدة (جسر الحلة) للشاعر المبدع الحلي موفق محمد والتي تأثرت بما حاء فيها من مفردات رمزية وصور مرسومة بالكلمات أدخل فيها العامية بشكل محبب وجميل ومن دون أن يضعف أو يشوه الوزن أوالبحور التي يحتاجها الشعر الحر أضافة للموسيقى اللفضية التي يتمتع بها الشاعر موفق والذي كان موفقا كل التوفيق من أستخدامه الرمزية وتحويل المكون الجامد (الجسر) الى كائن مثلوجي يحس ويشعر بما حوله من الكائنات
لم التق بالشاعر ولم يسعفني الحظ والوقت لأبدي له وجهة نظري حول أسلوبه المتميز باستخدام الرمز لغرض تحريك الساكن من الأشياء والتسميات الى رؤى تأخذ مكانها في الفراغ والخيال الممتع وأن ما شدني اليه هوحين مشاهدتي له على شاشة التلفاز وهو يلقي قصيدته جسر الحلة بصوته (السوبر سونك) والقائه (السبرانو)
وما تمكنت عليه في وقتها أن أنظم قصيدة محاكاة لقصيدته جسر الحلة وبعنوان الجسر عبرناه سوية نشرت في جريدة 14 تموز ومن ثم قام مركز النور مشكورا بنشرها.
أن ما يهمني هو ما ذكره الأستاذ الشاعر ناهض الخياط من نقد بخصوص ما جاء بكتاب الأستاذ ناجح المعموري المشار اليه وما يتعلق بشعر موفق محمد مبينا رأيه بأن ما أورده الناقد المعموري حول شعر موفق محمد لايخضع للمنهج الأسطوري بشكل مطلق مفسرا بما أوحى له منهجه الأسطوري والفرويدي معا حيث أخضع النهر الى مجال الأسطورة الأزلية المتوارثة مع عقائدها وطقوسها ليس غير كما لم يسلم من رؤيته النقدية جسر الحلة بقوله لم يكن الجسر في النصيين شكلا معماريا وسيطا لعبور المشاة بل هو وسيط رمزي ينطوي على معنى اجتماعي حضاري ويرد السيد ناهض على الناقد بنقده للنقد بقوله أن الجسر بناء معماري تقتضيه حركة الناس اليومية والحياتية في أي زمان ويتمم قوله على أية حال فأن اختلافنا مع الناقد لايقلل من أطاريحه كونها أجتراحا جريئا بين ما اعتدنا عليه من مدارس النقد في اتجاهها واحتفاؤها بمنجز شاعر بارز له أهميته في مسيرة الشعر الحديث .
أن ما يهم من ذكره بما يتعلق بموضوعتي هو أن أوضح بعض الأمور التي دفعتني للكتابه في هذا المجال واود أن ابين للقاريء الكريم بأنني لست ضليعا في مجال النقد ولادخل لموضوعي بهذا الشأن وباعتقادي بأن من يخوض بأمر ليس من أختصاصه كمن يريد اصطياد السمك في المياه العكرة ولايسعني ألا أن أقدم أعتذاري للناقد الأستاذ ناجح المعموري لأنني لم أطلع على كتابه قبعة موفق محمد وبالمثل للشاعر ناهض الخياط وأيفاء لسؤاله حول قصيدتي الجسر عبرناه سوية وهل هي خاضعة للأسلوب الفرويدي الرمزي أقول وحسب معرفتي المتواضعة ما يلي
1 – يرتبط الرمز عند سيجموند فرويد بالطبيعة الأنساتية فهو في مفهومه عبارة عن أشارات سابقة لوجوده وهي أفعال أو أيماءات قابلة للأدراك والفهم والتأويل في استدلال عما يشير اليه الرمز وان الكثير من أفعال الأنسان بتصوره لايمكن تفسيرها ذلك لأن الحلم هو تعبير رمزي عن رغبات لاشعورية يصعب تحقيقها في الواقع وتكمن نظرته الفكرية بالكشف عن الدلالة أي دلالة الظواهر النفسية ومحاولته فك اللغة الرمزية بين الدال والمدلول وبذلك أستطاع اكتشاف لغة جديدة هي لغة اللاوعي. والحلم عنده واقعة نفسيه ينبغي تجديدها وكيفية أرتباطها بالفرد حيث تتحول الواقعة المادية عنده الى واقعة نفسية.
وبرأي أن تفسير هذه الحالة يخضع لحالة الكائن والمكون، الكائن الحي الذي يتنفس والمكون المنتج المادي. والرمز يركز على المنتوج الدلالي لاعلى جوهر الظاهرة وما يميزرمز الدلالة في المنتوج ليس مادتها وخصائصها في الوجود بل المنبثقة عنها من رمز ودلالات والرمز يمكن أن يتسرب الينا في غفلة منا ويتحول الى كلمات وأشياء وطقوس وحركات وإيماءات تمنح المتلقي صور تخرجها من وضيفتها المادية واستعمالاتها الى رموز لحالات انسانية ويمكننا أن نتعرف على المفاهيم المتناقضة للدلالة على الأشياء بما تصوره اللغة أي لغة ومفرداتها المتعارف عليها والتي كثيرا ما تكون عاجزة عن التعبير عن المشاعر الكامنة في اللاشعور وقد تتخلف وتختفي تلك المشاعر خلف اللغة عندما لاتجد لها طريقا في المفردة اللغوية فلا توجد علاقة كاملة بين اللسان وما ينتجه من أصوات وبين المدلولات والتعبير عما يختزنه العقل من مكنونات مثلا كلمة كلب في اللغة العربية لها مدلول بحروفها المركبة وهي تعني حيوان وباستخدام هذه المفردة كرمز تتغير الدلالة وتعني أمرا آخر كما ورد ببيت الشعر الذي جاء على لسان علي بن الجهم وهو يمتدح الخليفة العباسي المتوكل بسليقته البدوية قائلا له
أنت كلكلب في حفاظك للود
وكالتيس في قراع الخطوب
*
وكالدلو لاعد منك دلوا
من كبار الدلال كثير الذنوب
وقول الآخر وهو يصف نفسه بالحمار
بل رأتني أخت جرينانا إذ أنا في الدار كالحمار
ومنه يظهر الفرق بين دالة المشبه والمشبه به وأوجه الشبه والأختلاف بينهما
ففي البيت الآول يرمز أبن الجهل باستخدامه لمفردة الكلب الى الوفاء وفي البيت الثاني شبه القائل نفسه بالحمار وهو يرمز للقوة والصبر
وفيما يلي بعض ألأستخدامات الرمزية للمفردة والتي تعبر عن مفهوم يختلف عن التصور المتداول:
المتنبي –واحتمال الآذى ورؤية جانيه غذاء تضوى به الآجسام
أستخدم كلمة الغذاء بعكس وضيفتها المادية وليرمز بها السم الذي تضوى به الأجسام
وابو العلاء المعري- ليلتي عروس من الزنج في جيدها قلائد من جمان
وتظهر صورة اللاوعي لديه جلية وهو الأعمى الذي لايرىالأشياء بل يتصورها فأصبح الليل عنده انسانة حية هي العروس وأنا له أن يدرك لون الجمان وهو أعمى؟
عبد الوهاب البياتي –يرمز الى حالة الجنود في الخنادق في قصيدة الملجأ العشرون
أماه ما زلنا بخير والقمل والموتى يخصون الأقارب بالسلام فاستخدم القمل والموتى كعناصر ترمز لحالة التردي في خنادق القتال
شاكر بدر السياب – في أنشودة المطر واسمع النخيل يشرب المطر كيف تسنى للسياب أن يسمع النخيل وهي تشرب المطر بغير الرمزيه والآيماءة الشاعرية
سعدي يوسف – توهمت أن نخلة السماوة نخل السماوات بتوهمه يلجأ في رمزية مرهفة فيعمل من أجل أظهار اللا شعور من جلباب اللغة فهل هناك ما هو أروع من ذلك في أستخدام المتصور الرمز؟
الشاعر التركي ناظم حكمت- في سجنه المطل على الدردنيل يريد أن يهدي لشعبه هدية فيستخدم القلب كرمز للهدية فيقول:
قلبي مياه البحر تحمله تفاحة حمرا كتذكار
أما الشاعر الفرنسي المناضل الشيوعي أركون فيلجأ لوسع السماء رمزا لوسع عيون حبيبته ايلزا فيقول: أن السماء تتسع للنجوم لكنها لاتتسع لعيون ايلزا.
أن الرمزية لم تقتصر على الشعر فقط بل شملت القصة كقصص الف ليلة وليله والسندباد البحري والبري وبساط الريح وكليلة ودمنه على لسان الثعلبتين لفيلسوف الهند بيدبا وترجمة ابن المقفع والأدب الا معقول لبكت مثلا ورواية ياطالع الشجرة لتوفيق الحكيم وماتظمنته من اهزوجة شعبية (يا طالع الشجرة هات لي بقرة تحلب وتنطيني بالملعقة الصيني) كما شمل الرمز الأمثال والحكم كالمثل المعروف(تمخض الجبل فولد فأرا)وبالأهازيج الشعبية(مطرت الدنيه عصيدة راح للكرمه يصيده) وياحوته يامنحوته هدي كمرنه العالي) وفي مجال الفن التشكيلي المدرسة الرمزية والسريالية والتجريدية وحتى بعض من المدرسة الكلاسيكية والرومانسية وكذلك ما وأجدته السينما من مادة تصلح لتحريك الخيال وبعيدة عن الواقع المعتاش كأفلام الخيال العلمي وأفلام الكارتون توم اند جيري وآخرها الأسفنجة المتحركة التي الهبت حماس الآطفال في العالم أجمع وهناك مجالات أخرى استخدم فيها الرمز كقصص الأطفال في الكتب المدرسية وحكايات الجدات القديمة عن السعلوة والطنطل وتجاوزها الى أساليب الدجالين والمنجمين وفتاحين الفال وقراءة الفنجان وغيرها من امور الحياة الآنسانية والتي التجأ لها الأنسان منذ الخليقة ليؤسس عليها عالما خاصا بعيدا عن الواقع يخضع لعوامل عديدة منها نفسية وأبداعية ذات مدلولات ومعاني راقية وان ما قام به الأنسان من مثل هذا السلوك ومنذ القدم قد سبق التفسيرات والنظريات الفلسفية والتي ظهرت في القرون المتقدمة وارست دعائم للسلوك البشري وطريقة تفكيره ونظرته الذاتية للحياة والآشياء المحيطة به
2- الرمزية في قصيدة جسر الحلة لموفق محمد ومحاكاتها الجسر عبرناه سوية
عند قراءتي لمقالة الشاعر ناهض الخياط المتظمنة مناقشة ماجاء بكتاب الناقد الأستاذ ناجح المعموري (قبعة موفق محمد) وتعرضه لقصيدة جسر الحلة لموفق محمد ومن ضمن ما أورده من رأي حول الشاعر وأسلوب شعره وبما أنني قد أستمعت للشاعر وهو يقرأ قصيدته جسر الحلة أعجبني ما ورد فيها من رمزية واستعارات لفضية احتوت على مثلوجيا شعبية تتداولها الأمهات لتنويمة الأطفال كقول أمه وهي تحاول أن تنيم النهر(دللول يا النهر يبني دللول) وجسر الحلة يحلق لحيته رفقا بالصبية المتعلقين فيها وأسمع أنينه وهو يرى الجنود العابرين الى الحروب والجسر طالت لحيته وابيضت فتعلق فيها الصبايا وغيرها من الصور التي تمكن فيها الشاعر موفق ان ينفخ الروح بالجسر ويجعل منه كائن حي يشعر ويتنفس ولم تقتصر صوره على الرمزية فقد تعدتها لتشمل كل ما يتعلق (بالملوديا الشعبية والميلو دراما والجيو بولتيكيا السياسية والمكانية) انها محاكاة شاعرية مرهفة.
لقد بينت للأستاذ ناهض الخياط بأنني كتبت قصيدة مقاربة لقصيدة الشاعر موفق محمد وطلبت أن يبدي رأيه فيها وكان جوابه هل أن قصيدتك تخضع للمنهج الرمزي أيضا؟ ولبيان ما دفعني لكتابة القصيدة والكتابه عن المنهجين اورد بعض المقتطفات من قصيدة الجسر عبرناه سوية مع شرح موجز لمقاطعها واتمنى من النقاد أن يبدو رأيهم في القصيدة الكاملة والمنشورة بمركز النوروبالملف الخاص باسمي وسأكون شاكرا وممتنا لكل اسهام يدفع نحو الأحسن والأرقى درجات في سلم الثقافة والمعرفة.
مقتطفات من الجسر عبرناه سوية:
يفتل شاربه الفولاذي يتلمس لحيته السوداء
يختلس النظر الى ماتحت نفانيف الصبايا
يغمض عينا ويفتح عينا أخرى يتمتم في المساء
هذا أحمر وذاك أخضر والآخر نوماي أصفر
الجسر هنا تحول الى مراهق يمكن ان نعتبر تصرفه يخضع لتفسير فرويد لغرائز الأنسان الجنسية في بعض التصرفات ومنها ما اتسمت به تصرفات الجسر الرمز
أيها الذي استلقى على قفاه أرهقه انتظار
وفي (توالي العمر) يشده الحنين ويستعيد
أهزوجة الآطفال (كوكوختي كوكوختي وين أختي بل الحله)
هنا تدخل الميلوديا الشعبية لتحرك مشاعر الجسر ومنه المتلقي
شاخ الجسر فما عاد صبيا يتدلع
لايهتم بهندامه ولايتلمع طالت لحيته وابيضت
الجسر الذي تحول الى كائن حي فهو هنا مثله كمثل كل الأحياء يكبر ويهرم
(عيني عليك باردة) لم تغب عنك شاردة أو واردة
تستذكر بيقضتك الدائمة
الذاهبين الى المحارق والحروب
والعائدين بلا رؤوس
الصامدين (بقطار الموت)
السجناء بسجن الحلة ينشدون لمظفر النواب
كي يحث الخطى في الهروب
وهنا تتحرك الميلو دراما للأحداث التي مرت على الجسر فينقلها بدوره الى القاريء والمتلقي
أمك يا موفق تريد للجسر أن تنيمه
(دللول يا الجسر يابني دللول)
والجسر يقضان لاينام أنا له أن ينام
فكلما مرت على هيكله الهمر
تضج كل لوحة بجسمه يسمع أنينه النهر
هذه محاكاة لما عرضه موفق في قصيدته حيث جعل أمه تهدهد النهر كي ينام ولما كان الأمر يتعلق بالجسر فرأيت من المناسب أن أجعل أمه تهدهد للجسرأيضا الذي لم ينم منذ أمد بعيد ولكن الجسر يأبى أن ينام وينطلق صائحا
ياناس يا سامعين: يا ولاد الحرام أريد أن أنام.
وختاما لقد توفق موفق بشاعريته المرهفة ورمزيته المحببة أن يجعل من جسر الحلة كائن حي وهل تمكنت من أيصال فكرتي بشكل مقبول والأمر متروك للقاريء الكريم.
وختاما هذه مرثية بحق شاعرنا الراحل موفق محمد عسى وأن أقدم جزء ولو يسيرا بحقه:
يا أيها الربان ويا حادينا: من سيأخذ في الركب أيدينا؟ لم أخذت معك كل أحزان العالم؟ أحزان الثكالى والفقراء والمحرومين، لم تبق لنا حزنا يليق في رحيلك الطويل، ولازال صوتك الجهوري يسبح في نهر الحله، يحلق فوق الجسر والمدينة، بكيناك في خشوع من غير دموع! لقد جفت مآقينا منذ حين، فنم في رقادك الأبدي وستبقى ذكراك منارا للطيبين.
***
لطفي شفيق سعيد
.....................
(تنويه: المقالة تم نشرها في حينها في مواقع أخرى وأعيد نشرها بمناسبة رحيل الشاعر موفق محمد).