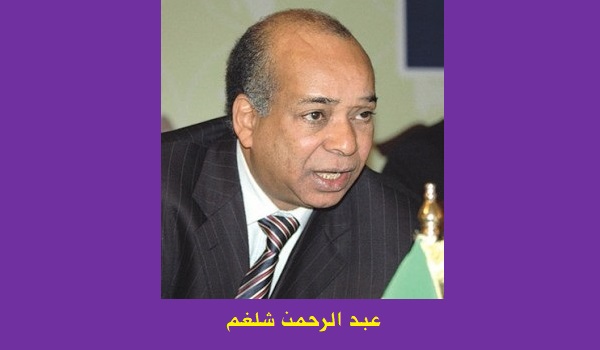كلما ازدادت الضغوط على تجمعات المسلمين وخصوصا العرب منهم، بسبب التراجع، والتفكك، والانفجار، من الداخل، والتفجير من الخارج، كانت الحاجة ماسة إلى محاولات تفسير ما يحدث، فكان خطاب عبد الجواد ياسين (١٩٥٤/ ١٣٧٣) وتجربته كقاضٍ وكمنتمٍ سابق للسلفية الدينية نظريًا، وليس تنظيميًا ومحاولته الخروج من أسرِ السلفية فيما بعد.
فقد حاول خطاب عبد الجواد ياسين فعل ذلك من خلال مقولات "الدين" و"التدين" و"الديانة". والسعي للتفرقة بين جوهر الدين، الذي هو مطلق وإلهي وقادم من خارج الاجتماع ومفارق وأزلي ومؤبد، وغير قابل للتعدد ولا إلى التطور، وحَصَره ياسين في عنصرين، الأول "الإيمان بالله" - الذي هو مكوِّن فطري في الإنسان - الثاني "الأخلاق الكلية". ويفرق ياسين بين هذا المكون الجوهري "الدين"، وبين "التدين": الذي هو ممارسة الإنسان لهذا المطلق في الواقع الاجتماعي، أما "الديانة" فهي ما تجسد في التاريخ من المذاهب ومن ممارسات السلطة الدينية والسلطة الحاكمة على أنه الدين.
ويسأل عبد الجواد ياسين سؤالًا مهمًا:
هل الدين كله إلهي، أبدي مفارق، ثابت؟ أم أن منه ما هو نسبي متغير، وليد الاجتماع، والتاريخ، والسياسة؟
ويحاول ياسين التعرض للعقل الديني الذي يرى أن الدين كله مفارق كما يتعرض أيضًا للدرس الاجتماعي الحديث الذي تعامل مع الظاهرة الدينية، ومع الدين على أن مصدرهما كله من الاجتماع البشري.
حاول ياسين الإجابة على الأسئلة فقال إن الإلهي والأبدي والمفارق من الدين هما "الإيمان بالله" و"الأخلاق الكلية"، وهما الثابتان فقط منه، وأضاف أن بالدين ما هو نسبي، وما هو متغير، ومتطور، مثل التشريع. ففي الشريعة الإسلامية جاء القرآن، مُنجمًا على مدى بضع وعشرين عامًا، وحدث تطور للتشريعات، من خلال النسخ، مما يعكس الحالة الاجتماعية والاقتصادية للناس الذين خاطبهم النص وقت الوحي.
ونبَّه ياسين إلى أن تصور الدين كمفارق كله، يتصادم مع فكرة أن موضوع الدين هو الإنسان؛ الذي هو بطبعه متغير ونسبي، ويتم الاتصال به عبر نص لغوي، واللغة وسيط اجتماعي. كما أن الإنسان هو الكائن الذي يتدين بهذا الدين، أي يدركه، ويعبر عنه، ويدعو الآخرين إليه. فالإنسان هنا ككائن وكظاهرة اجتماعية؛ يفرض ذاته على النص الديني، من خلال التدين، فيصبح في بنية الدين؛ ما هو إلهي مُطلق، ثابت، وما هو اجتماعي، متدَيَن. فيه الإيمان بالله والأخلاق، من جهة وفيه ما هو متغير وغير ثابت من جهة أخرى.
وحسب التصور السابق؛ يكون القرآن متضمِّنا لنوعين من الأحكام: ما هو إلهي مُطلق ثابت، وما هو اجتماعي متدين متغير ونسبي. تعامل القدماء مع القرآن بأن كل ما ذُكر في القرآن وورد فيه فهو مطلق لأنه في النص، حتى أصبحت النصية مرادفة للإطلاقية حيث أن التشريع تطور داخل القرآن في النسخ وتضمن القرآن اجتماعيات قابلة للتطور، من خلال تنجيمه الذي استمر سنوات، ومن خلال أسباب نزوله، ومن خلال الناسخ والمنسوخ.
هكذا يصور عبد الجواد ياسين المشوار: جاء التدين من التاريخ والاجتماع، وليس من عند الله. وهو يشمل كل هذا التراث البشري، فهمًا وتطبيقًا وممارسةً. وقد صبغت هذه البنية الدين ذاته ببصماتها التي تراكمت عبر السنين، فأضافت ما يدعو إلى الكراهية والبغض التي تم تقديمها باعتبارها جزءًا من الدين.
ويجعل ياسين مرحلة التأسيس في فترة نزول الوحي على النبي أصل الدين، حيث عاد بعدها تأثير الاجتماع، فأصبحت بنية التدين تُحدِث تأثيرًا كبيرًا، سواء بتبلور الدولة كسلطة أو عبر الفتوح العسكرية، واعتمادها على ثقافة الغزو كممثلة لاجتماعيات القبيلة العربية. كما أثَّرت التعددية السكانية والثقافية في هذه الدولة الإمبراطورية على الفقه وتطوره. وكذلك أثرت مسألة الصراع على السلطة في ظهور التعددية المذهبية؛ والتعددية اللاهوتية وظهور تعددية تشريعية في الأحكام وتعددية ثقافية، وحتى على مستوى ما يسميه ياسين قانون الإيمان؛ مثل ما حدث مع التشيع، حول مفهوم الوحي والنص وولاية الإمام، واستمرار التواصل بين السماء والأرض.
وفي نظر ياسين، أصبحت البنية في تاريخ المسلمين هي: هياكل اقتصادية رعوية، واجتماعيًا قبلية. وعقليًا ساد العقل اليوناني وغلبة الأفلاطونية عليه.
غير أن هذه البنية التي استمرت لقرون، - كما يوضح عبد الجواد ياسين - تعرضت لتحد كبير مع الحداثة ومع الرأسمالية؛ حتى أصبحت المجتمعات أمام حياة أخرى.
وهنا فَرض سؤال التطور ذاته بقوة على الطرح التديني وعلى العقل الديني؛ سواء في التشريعات أو الطقوس. لكن ظلت فكرة الإيمان والأخلاق الكلية صامدة. وهذا هو سبب المشكل الذي تواجهه مجتمعاتنا، في التناقض بين حركة التدين (السلفية التقليدية) وبين الهياكل الاجتماعية، أو بعبارة أخرى: التناقض بين النظام الديني وبين النظام الاجتماعي، كما يرى ياسين، وأن أزمة الإصلاح الديني، خلال القرنين الماضيين، أنه تم من داخل النظام الديني.
يحث ياسين على إعادة النظر في المفاهيم الكلية للنظام الديني، وفي القلب منها: اللاهوت، ومفاهيم التدين والدولة، التي قامت في تاريخنا بما قامت به الكنيسة في العصور الوسطى المسيحية. أعلنت الدولة عندنا ذاتها دولة مسلمة حارسة للدين، وورثت المنظومة الفقهية هذا الدور ضمنيًا مع الدولة. ويرى أن للبنية "الأشعرية الشافعية دورًا كبيرًا في ذلك، وأن فكرة المقاصد، وفكرة المصالح، لا تكفيان لتجاوز الأزمة، وأن المذهبية - سواء الفقهية أو اللاهوتية - هي أساس المرض.
نسق خطاب عبد الجواد ياسين يدرك البعد التاريخي والشامل - بما يحمله من اجتماع وسياسة واقتصاد - في تركيبة النص الديني، وقد خطا خطوة كبيرة في تفرقته في داخل النص الديني، بين ما هو ثابت أبدي - حصره في "الإيمان بالله" كفطرة إنسانية وليس كفكرة لاهوتية؛ كما ظهرت في المذاهب وفي الأخلاق الكلية - وبين ما في الدين من متغير، نسبي؛ مثل التشريعات. وكذلك أدرك ياسين بشرية التراث وتاريخيته، وهو ما أسماه بالتدين، بل ودور هذا التدين - الذي شكّله الاجتماع والتاريخ - وصبغه للدين ذاته بصبغته. فياسين ينطلق من مفهوم لإسلام جوهري، مفارق، أبدي، ثابت ويقترب من التصورات الصوفية.
لاهوت الإسلام
يحاول عبد الجواد ياسين تفكيك المنظومة "الشافعية الأشعرية" التي سادت في التدين من داخلها. وكان قد تناول عملية التفكيك من خلال تفكيك "السلطة في الإسلام" التي تناول فيها العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ. كما تناول الجزء "التشريعي/ الشافعي" في كتابه "الدين والتدين"، ويحاول تناول الجزء "اللاهوتي/ الأشعري" في كتابه "اللاهوت"، وهذا يحتاج إلى درس تفصيلي أوسع ليس مكانه هذا النص الذي هو بمثابة "مقدمة". أركز هنا على الفصل الثالث من الكتاب الذي خصصه ل "لاهوت الإسلام”1 ص281.
يحاول ياسين هنا التركيز على فكرة "هل اللاهوت الإسلامي نتاج تلاقح "عبري عربي؟"ص285، ويفعل ذلك حذرًا ومنبهًا إلى أن موقفه النقدي "موجه إلى هذا الشكل التاريخي، وليس إلى فكرة الدين في ذاته"، بل يصرح بأن موقفه "يصدر عن انحياز قبلي لقضية الإيمان"، التي يرى أن "التدين التاريخي التقليدي لم يحسن تمثيلها بمقاييس الدين المحض، مثلما أن الطرف الوضعي التقليدي لم يحسن التعاطي معها بمقاييس العلم الموضوعية" ص282.
وموقف ياسين هنا موقف المنحاز للإيمان طبقًا "للدين المحض"، الذي لم يفهمه الطرفان حق الفهم، فيما سيقدم الفهم الصحيح.
ورغم إدراك ياسين، بل وتصريحه، بأن اللاهوت في النهاية لا يمكن إدراكه إلا تصورًا، وأن كل تصور هو فعل إنساني، "تقوم مادته على تصور الذات"، مهما كان مفارقًا للعالم يظل مُحجمًا عن الخطو بأن اللاهوت مجرد تصورات إنسانية عن الغيب. فهو متحسب "لحساسيات العقل الديني التقليدية، التي لا يريد - عبد الجواد ياسين المؤمن - الدخول معها في مواجهة سجالية" ص281، ويؤكد أنه ناقدٌ وليس خصمًا.
بهذا الحذر من "السجال"/الصدام، وذلك الانحياز المسبق "للإيمان طبقًا للدين المحض2" شكلًا، تناول ياسين اللاهوت كما ينبغي أن يكون، طبقًا للدين المحض، أو اللاهوت كما تشكل في التدين التاريخي طبقًا لاجتماع إنساني. بل وتعامل ياسين شكلًا مع نصوص القرآن ومحاولات تقديم قراءة لها، خارج إطار التراث التفسيري في تاريخ التدين الإسلامي الذي لم يستطع إدراك الدين المحض وعجز التيار الوضعي الموضوعي عن إدراك الظاهرة الدينية الإبراهيمية وروحيتها.
ورغم إدراك ياسين البعد التاريخي وحرصه عليه3، فإنه يهمل الدور المركزي لتصورات اللاهوت في تشكيل الفقهي4، والدور المركزي للسياسي في تشكيل اللاهوتي وبعده الفقهي، بل والثقافي5، الأمر الذي يحتاج إلى دراسة أعمق، لمعرفة سبب ذلك عند ياسين، وهل هو جزء من تجنب الصدام/ السجال فقط أم هناك عوامل أخرى؟
من المُلفت للنظر أن ياسين حين ينقل آراء عن أبي الحسن الأشعري ينقلها عن الجويني وعن ابن عساكر وليس عن الحسن مباشرة، كما في ص427 - 428) والهوامش فيها.
نقطة أخرى أن ياسين يحيل إلى نفسه وإلى مؤلفاته فيما يخص "اللاهوت الإسلامي"، ربما لأنه في النهاية يقدم قراءته هو "للدين المحض/ المطلق"، المخالفة حسب تصوره لقراءة من سبقوه، الأمر الذي يحتاج إلى تقصي من باحثينا.
وبالرغم من مركزية الشافعي في الدرس الفكري الذي يقدمه عبد الجواد ياسين لتراثنا في كتاباته السابقة فإن ياسين يشير دائما إلى ما فعله الشافعي (767/ 150 - 820/ 204)، ويعرض لنا ما فعل الشافعي، ولكنه لا يشرح لنا كيف فعله، ولماذا فعله معرفيًا، وفي هذا الكتاب الذي تناوله تحديدًا لاهوتيًا/ ثيولوجيًا، فبالرغم من أننا في ظل دراسة من المُفترض أنها "أنثروبولوجية" للاهوت من قبل عبد الجواد ياسين، فنحن نفتقد الأسس اللاهوتية التي أقام عليها الشافعي حججه وكيف وظفها ولماذا.
نقطة أخيرة في هذا السياق تحتاج إلى تقصٍ وهي نهج عبد الجواد ياسين في تأويل نصوص القرآن، حيث يطابق بين فهمه وبين دلالة القرآن بطريقة ضمنية، فيقول "نحن نرصد مفهوم التوحيد كما طرحه القرآن، لا أتكلم عن معانٍ يمكن استنباطها من النص عن طريق الاستدلال التحليلي، فهذا ما سيفعله الكلام - يعني علم الكلام - لاحقًا، ولكن أتكلم عن المعنى المباشر كما فهمه المتلقي الأول من الآيات، أي عن المعنى الظاهر الذي قصد إليه النص في سياق لحظته الثقافية" ص431.
فإذا كان الفيلسوف الألماني كانت "1724 - 1804) رابضًا بفكره تحت خطاب عبدالجواد ياسين، فإن ابن حزم الأندلسي (994 - 1064)م موجودٌ بقوة تحت تلافيف الخطاب، مما يحتاج أيضًا للفحص من باحثينا.
الجانب الآخر في نهج ياسين في قراءة نصوص القرآن، أنه يقرؤها في ضوء أحداث السيرة، ويرفض في نفس الجملة الاعتماد على "مرويات منقولة" هامش 370 ص364، في حين أن السيرة في النهاية مجرد مرويات منقولة، بل إن مرويات السيرة مبنية على القرآن أصلًا، لكن لهذا حديث آخر يطول.
عبد الجواد ياسين يريد حل مشكلة مجتمعه ومشاكل أمته، عبر نسق توحيدي جامع متجاوز للمذهبية بكل صورها، فهو مسلم وفقط، وإنسان حديث. ورغم كل إنجازه في الوعي التاريخي بالنصوص وبتجربة المسلمين في التدين وتشكيل التدين للدين، وفي تشكيل الديانة، ووعيه بالأسس اللاهوتية التي لم يتعامل معها خطاب الإصلاح الديني، وخصوصًا (الأشعرية/ الشافعية) ودورها في الحد من ثماره، وأهمية التعامل معها نقديًا. لأن الأمر يحتاج إلى تفكيك المنظومة من داخلها، كما يفعل، إلا أن الأمر ربما يحتاج إلى شيء من المواجهات/ السجالات، التي يحاول ياسين بقدر الإمكان تجنبها، أو التقليل من احتقانها، فما زال ثمنها غاليًا.
لكن - من ناحية أخرى - فإن تجنب هذا الانخراط، قد يؤدي إلى صيغة تنتهي عنده إلى تصوف فلسفي "حديث"، فخطاب ياسين يحوي داخله كل المتناقضات بجوار بعضها، مهملًا الصراع السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، الذي كان في قلب تجربته هو ذاته في التمرد النظري - وإن لم يكن تنظيميًا - على المجتمع وعلى ما هو سائد من استبداد سياسي وتقليد ديني يُرَسِّخ الاستبداد السياسي ويبرر كل منهم وجود الآخر. والله أعلى وأعلم.
***
بقلم: جمال عمر
كاتب وباحث مصري، مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، عمل على جمعِ فكرِ الكاتب الراحل «نصر أبو زيد» ولديه عدة مؤلفات نذكر منها: هكذا تحدث نصر أبوزيد، «مقدمة عن توتر القرآن»، و«مدرسة القاهرة في نقد التراث والأشعرية»، و«الخطاب العربي في متاهات التراث»
عن مجلة تفكير - مركز دراسات تفكير، ضمن ملف حول سبعينية المفكر المصري المستشار عبد الجواد ياسين
....................................
هوامش
1- ستتم الإحالة في النص لرقم الصفحة من طبعة كتاب اللاهوت: انثروبولوجيا التوحيد الكتابي، عبد الجواد ياسين، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، ط1، 2019. توزيع، المركز الثقافي للكتاب وللنشر والتوزيع، المغرب، الدار البيضاء.
2- ربما بالتحليل الدقيق، قد يكون الإيمان طبقا للدين المحض، هو الإيمان كما عاشه الطفل عبد الجواد ياسين في رحاب أسرته وإيمان الأم تحديدا. رغم ليبرالية الأسرة ذات الانتماء الوفدي، كان إيمانها "طبيعي" غير متكلف، يعكس الإيمان كما يتصوره ياسين ك "دين محض".
3- سواء في كتابه "السلطة في الإسلام" عن تتبع المفاهيم الكلامية عند الفرق "من رحم الوقائع والتطورات السياسية". وحتى في كتاب "اللاهوت" يدرك ذلك، ص395 وهامش 403. ورغم أنه ياسين يُرجع للدولة في الإسلام بأنها كانت الحامية للدين وقامت بما يشبه دور الكنيسة في تاريخ المسيحية، أي دور السياسي في تشكيل الديني.
4- “ في المدونة الرسمية السنية - حيث يسيطر الفقه على الكلام وحيث أدت تنظيرات الشافعي الأصولية إلي تثبيت مدرسة الحديث ذات الأفق النقلي الضيق - يظهر التشدد واضحا حيال التفكير الصوفي والفلسفي"، عبد الجواد ياسين، اللاهوت، ص407.
5- صراع دائم بين مركزية علم أصول الفقه في تشكيل العقل الذي ساد عند المسلمين، كما توجه الشيخ مصطفي عبد الرازق (1985 - 1947) وصار علي ذلك محمد عابد الجابري (1935 - 2010) وهنا كذلك عبد الجواد ياسين. في حين هناك اتجاه آخر يجعل من علم الكلام أو علم أصول الدين صاحب الدور المركزي في تشكيل الرؤى التي كونت العقل الذي ساد عند المسلمين، والدور المركزي للصراعات السياسية في تشكيل هذه الرؤى، ويمثل هذا التيار كثيرون منهم حسن حنفي (1935 - 2021) ونصر أبوزيد (1943 - 2010) وعلي مبروك (1958 – 2016).