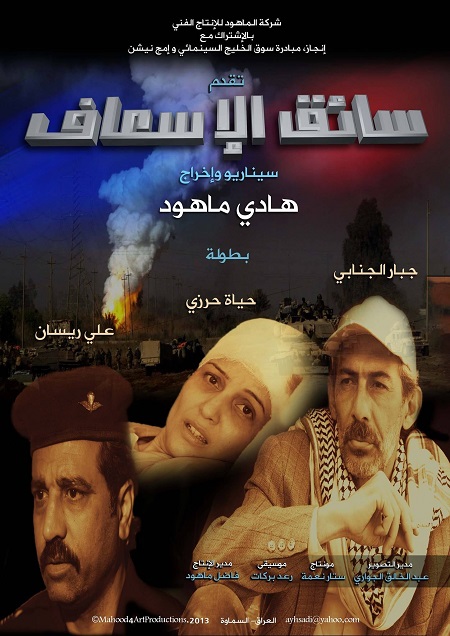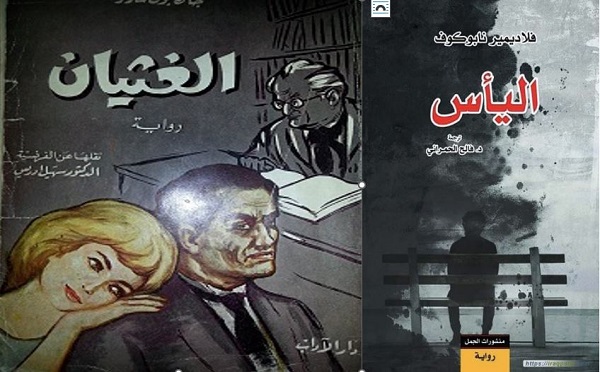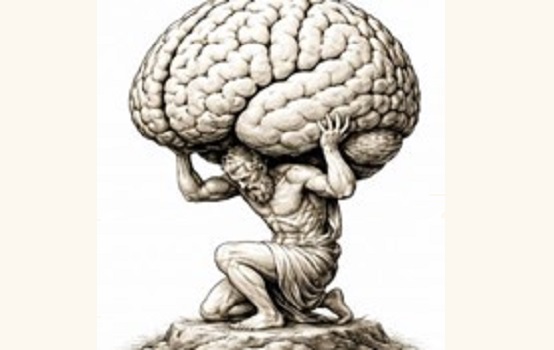"الجميلات النائمات" لكاواباتا الياباني و"ذكرياتي مع غانياتي الحزينات" لماركيز
أجملُ ما في الكتابة الإبداعيّة أنّها تُعرّي صاحبَها وتتغلغلُ في ثنايا نفسيّته وأفكاره، وتَعْرضُه على القارئ بجرأة وسَطوة، تجعلُ هذا القارئ يُسحَرُ ويَدهَش ويتمنّى ويحلم، ولكنّه يظلّ لا يتعدّى ذلك.
كلّ إنسان يتمنّى في ساعات من عمره لو بإمكانه أنْ يقفَ على مُرتفع ليروي لكلّ الناس عمّا يحلم، وبماذا يُفكّر، ليعترف أمامهم بكلّ خطاياه، يكشف لهم أسرارَه الخاصّة ويُشركُهم في همومه التي تُعذّبه. لكنّ هذه هي منحة الخالق التي خَصّ بها المُبدعين وحدَهم وحرمَ الآخرين منها، فكان المبدعون مرافقي الزمن، خالدين بخلوده، بينما يضمحلُّ الآخرون ويغدَوْن كما لو أنّهم لم يكونوا.
ويظلّ الزمنُ رفيقَ المُبدع اللدود، يُطاردُه في كلّ تحرّكاته ويُذَكِّرُه بأنّه له بالمرصاد. وهذا ما دفع هنري جيمس (1843 – 1916) ليقول: "أرصدوا ما حولكم في شكل متواصل، أرصدوا قدومَ العمر.. وأنا نفسي أرصد انهياري الخاص. بهذه الطريقة كلّ شيء يمكن أن يكون مفيداً.. أو هذا ما آمله على الأقل. لذا أحاول أن ألتقط من الزمن أفضلَ ما يُعطيه". وقد تكون هذه المُلازَمةُ القاتلة للزمن هي التي دفعت بفرجينيا وولف (1882-1941) إلى اقتناعها بعَدَميّة جدوى الحياة بقولها "أجل.. إنّ هذا ما أفكّر فيه، إننا نعيشُ من دون مستقبل. وهذه هي غرابة الأمر، إذ نبدو كمَن يطرقُ أنفَه على باب موصد" وتُقرر الانتحار برَمي نفسها في الماء، وتفارقُ الحياة قانعة راضية بما اختارت.
لكن معظم الناس يتشاغلون عن الزَّمن، يتهرّبون منه، ويحاولون نسيانه، وفي بعض الحالات تَحدّيه.
حقيقة إنسانيّة يعيشها كلُّ إنسان، أنّ عبورَ الواحد للعقد السابع من عمره يجد نفسَه مشدودا من حيث لا يدري بالماضي البعيد الذي كانَه يوما، فتجده ينتهز أيّة فرصة ليعودَ بجُلسائه، والأكثر بنفسه، إلى أيام زمان التي كانت ومضَت، يتحسّرُ عليها، ويشتاق إليها، ويتمنّى لو تعود. ويجد نفسَه في أحلامه المُتَقاربة يعود إلى البيت الذي وُلد وكَبُر فيه، ولأفراد الأسرة، وللحارة والأقارب والجيران، ويعيش من جديد ما كان له من صَداقات وخلافات مع هذا وذاك، وأيّة قصص حبّ كانت له مع هذه الفتاة من الأقارب أو الجيران، وقد تأخذُ به الأحلام، وعلى ليال مُتقاربة ليعيشَ من جديد قصّةَ حبّ كانت قد عصَفت به في شبابه وتركت أثرَها على حياته كلّها.
هكذا يجد الواحدُ نفسَه تتأرجحُ ما بين ماضٍ كان، ويُلاحقه بقوّة، وحاضر يعيشُه لم تعُد له فيه أيّةُ آمالٍ وطموحات، وإنّما عقاربُ ساعة تُذكِّرُه في كلّ نظرة إليها بأنَّ العمرَ يمضي، وساعةَ الرّحيل قادمةٌ، فيستزيدُها بالسّرعة ليرتاحَ ويتخلّصَ ممّا هو فيه إذا كان زاهدا في حياته، أو يرتجفُ مع كل نَقلة لعقاربها، ويُخَيّلُ له تَرَصُّدُ رسول الموت به ليَحملَه وينقلَه إلى حيث المُسْتَقرّ الأبديّ.
وإذا كان الإنسان العاديّ يكتفي بسَرد بعض قصص ماضيه للأصدقاء المُقَرّبين منه أو يحتفظُ بها لنفسه خوفا من تعليقات الناس وانتقاداتهم والنَّيْل منه وقد تقدّمَت به السنون، فإنّ المُبدعَ من الكُتّاب والشعراء يجد نفسَه في صراع شديد يُعاني منه، وفي انشداد كبير لتفريغ ما يختزنُ في ذاكرته على مدى سنين عمره كلّها بسَرد سيرته الذاتية ليخلّدَها لأنّه يراها الأكثرَ صدقا وأمانة للإنسان الذي كانَه.
وتزدادُ المشكلةُ وتتأزّم، وقد تؤدّي إلى خلافات وعداوات في مجتمع كمجتمعنا العربي المُحافظ، المُتمَسّك بالعادات والتَّقاليد والمَفاهيم الجاهليّة والقَبَليّة والتَّباينات المَذهبيّة والدينيّة والعائليّة فلا يرضى ولا يؤمن بأيّة علاقة صداقة بريئة بين رجل وامرأة، وتثور ثائرتُه إذا عرف بقصّة حبّ بين شاب وفتاة، والوَيل لهما إذا كانا ينتميان لدينَيْن أو مَذْهَبَيْن مُختلفَين. وكم من ضحيّة لاقت مصيرَها بقَتْلها للمحافظة على شرَف العائلة، وكم من نزاعات دامية وحتى حروب قامت.
يجد المُبدع العربي في وطننا العربي نفسَه مُحاصرةً بكلّ هذه القُيود والمُحرّمات، والذين تمرّدوا وكسروا القيود لاقوا الأَمَرَّيْنَ وخاصّة إذا كانت مُبدعةً أمثال ليلى بعلبكي وأحلام مستغانمي وحنان الشيخ وكوليت خوري وسلوى النعيمي. ويذكر كلّنا العاصفةَ التي واجهتها غادة السمّان عندما نشرَتْ رسائلَ غسان كنفاني الغراميّة لها.
ويعترف محمود شقير في كتابه "أنا والكتابة" قائلا: "ولأعترف بأنّ الخوفَ انعكس بشكل أو بآخر على كتاباتي. وإذا ما تذكّرنا المحرّمات الثلاثة: الجنس والسياسة والدين، التي يُحْظَرُ على الكاتب في البلدان العربية الاقترابَ منها إلّا على نحو طفيف، فإنّ نتاجي الإبداعي يُعاني من هذا الخوف، وحين يتعلّقُ الأمر بالكتابة، فإنّني أخاف من السلطة الدينيّة في المقام الأول ثم من السلطة الاجتماعيّة، يأتي بعدها الخوفُ من السلطة السياسيّة ثالثا، ومن الاحتلال الإسرائيلي في المقام الأخير" ويعترف بأنّه لم يُفكّر بكتابات لها هذه الدرجة من التحدّي. والرّقابة الداخليّة لديَّ قويّة إلى الحدِّ الذي لا يجعلني أفكِّرُ بكتابة من هذا النوع". (أنا والكتابة. محمود شقير. مكتبة كل شيء 2023 حيفا ص188 وص190)
والآن إلى منزل ذكريات محمود شقير
هذه المقدّمة الطويلة قصدتُ بها التّمهيدَ لتناول رواية محمود شقير الأخيرة "منزل الذكريات" إصدار (نوفل 2024) التي يصفها بالنوفيلا، أيّ الرواية القصيرة رغم عدد صفحاتها التي تصل إلى 177 صفحة.
وأتخيّل محمود شقير وقد تجاوز الثمانين من عمره، يجلس أمام نافذة بيته ينظر إلى البعيد ويُقلِّبُ بين يديه روايتَيْ الكاتب الياباني ياسوناري كاواباتا "الجميلات النائمات" والكاتب الكولومبي غابرئيل غارسيا ماركيز "ذكرياتي مع غانياتي الحزينات" ويشطح به الخيالُ إلى سنوات بعيدة تُعيدُ له رفاقَ الطفولة وزملاءَ المدرسة وأصدقاءَ فترَتَي المُراهقة والشباب وما فيهما من تقلّبات، ومفاجآت، وحبّ، وألم. ويسقطُ الكتابان من يديه فينتبه إلى نفسه ويُفاجَأ ببطلَي كاواباتا وماركيز يبتسمان له ويقولان معا:
- استمر في بَوْحك الجميل، نحن في شوق للمزيد.
فينتفضُ ويستعيذُ بالله من الشيطان الرجيم، ويُقسم أنّ كلّ ما باح به من تدابير محمد الأصغر، وحاشا له، وهو الإنسان المحافظ الملتزم بعادات وتقاليد أهله، ولا تُشغله إلّا قضايا وهموم أبناء شعبه الرّازح تحت الاحتلال، وأمَّته التي تعيشُ كلَّ هذا الذلّ في هذا الزمن الرّديء، فحاشا له أنْ يلتفتَ لمثل هذه التّرْهات والمُغريات.
وقبل أنْ ينهيَ كلامَه يدخلُ محمد الأصغر يُرحِّب بالضَّيفَيْن العزيزين ويدعوهما للانضمام إلى الحضور الذين ملأوا صحنَ الدّار للمُشاركة في تشييع جثمان زوجته سناء التي فتك بها كوفيد 19.
وهكذا نأى الكاتبُ محمود شقير بنفسه عن كلّ ما قد يجلبُ عليه كلامُ الناس من المَتاعب، وحَمَّلَ هذا العِبْءَ الثقيلَ لقريبه وقرينه محمد الأصغر الذي اعتاد على السّهرات الجميلة والقصص برفقة قريبه رهوان.
ويتجلّى محمود شقير في إطلاق خياله تاركا قرينَه وصنيعتَه محمد الأصغر ليمارسَ حياتَه التي تحلو له ما بين تخييلٍ لا ضوابطَ له، وواقعٍ يدمي القلوبَ من ظلم المُحتل وتَفَلُّتِ المُجرمين، وشعبٍ ضعيفٍ يعاني كلّ صُروف الظلم، لكنّه لا يفقدُ الأملَ في المستقبل.
محمد الأصغر ليس غريبا علينا، فقد عرفناه في قصص وروايات محمود شقير يتقمَّص شخصيتَة ويتستّر عليها، ويُطلق العِنانَ لنفسه لتنطلقَ كما يحلو لها في هذه الحياة التي يعيشُها بحلوها ومُرّها، وكما عرفنا محود شقير هكذا يكون محمد الأصغر نموذجا للإنسان المُنفتحِ على الحياة والناس، الوفيِّ والمُحبِّ لزوجته سناء التي تُرافقه في السّرّاء والضّرّاء، وتبقى له نِعْمَ الزوجة. وإذا كان قد خَتَم قصصَ "نوافذ للبَوْح والحنين" بجلسته الهادئة الدافئة مع سناء وهما يحتسيان القهوة بتفاؤل ووئام تحتضنُه ويحتضنُها.. فإنه ابتدأ روايتَه "منزل الذكريات" بموت سناء ومشاهد مأتمِها وتشييعها إلى مَرقدها الأخير، وإحساسِه الكبير المؤلم بفَقْد شريكة حياته، وتَشكَّكَ في قدرته على العيش وحدَه بدون سناء وأنه، كما يقول" ربّما لن أعيش بعد سناء سوى سنة واحدة أو سنتين. وأنا أشعر بضراوة الفَقْد، حين أجد مكانَها شاغرا في السّرير، وحين يكون الفراغُ المُتشكِّلُ فيه أكبرَ ممّا يُمكن احتمالُه في أيّ حال. أشعر بوحشة ضارية تلفُّ غرفة نومنا والبيتَ ومحيطَ البيت والحيّ، وأينما نظرتُ تكبر الوحشةُ ويُعلن الموتُ هيمنتَه على الأمكنة المُحيطة بي، ويُعذّبني وجهُ سناء الشاحبُ وعيناها المغمضتان على فراغ" (ص10)
وتُعذّبه الكوابيس التي تُحاصره في الليل، وتدفعه للشك في في حقيقة موت سناء، لربّما تعرّضت لحالة إغماء؟ وتسرّعوا في دفنها، وفكّر بنبش قبرها وإخراجِها من القبر لكي يتأكّدَ من حقيقة موتها. (ص12)
وظلّ لفترة يتخيّل سناء تعيش معه، تزورُه، تنام إلى جانبه، تُشاركه في شرب القهوة الصّباحيّة، وتستحمُّ بنعومة وهو يراقبها عاريةً والماءُ ينسكبُ على جسدها، وتُرافقه في تجواله في شوارع وأزقّة القدس، ويتناول معها وجبةَ الغذاء في المطعم الذي اعتادا على الأكل فيه.
لحظة التَّحوّل في مشاعر محمد الأصغر
الإنسان بطبيعته وُجد ليعيش مع غيره من الناس، ولا يجد سعادته إلّا برفقة أنيس يُؤنسه ويُشاركه في حياته، والرجل وجَد أنيسَه في المرأة، والمرأةُ وجدَتْه في الرجل. ولا يختلف محمد الأصغر عن غيره من البشر، فما كاد الأسبوع الثالث ينقضي على فراقه لسناء حتى بدأت الوحدةُ تُزعجه، وإهمالُ الناس له يُضايقه، وشوقُه لأنيس يملأ عليه حياتَه يُدغدغ مشاعرَه ويذكّره بكلام عجائزِ حَيّه "أعزب دهر ولا أرمَل شهر".
وكانت لحظةُ التَّحوّل بدخول جارته الأرملةِ أسمهان التي فقدت زوجَها قبل خمسة أشهر من جرّاء إصابته بفيروس الكورونا عليه بجسدها الطويل الفتّان بما يبعثه من إثارة وجاذبيّة مثيرة للفضول. جاءت أسمهان كما قالت لتأخذَ ملابسَ المرحومة سناء للتبرع بها صَدَقة عن روحها لمَن تحتاج إليها من النساء. (ص22) لكنّها بتلميحات جنسية واضحة قالت له:
-كانت سناء غاطسة في النّعيم معك.
وتابعت بكلماتها المُثيرة له: انتبه لنفسك، طوال سنوات وهي تمصُّ دمَك، وأنت تكتبُ عنها يا عيني أحلى كلام. (ص23)
وتركته يستعيد كلماتها ونغَمَة صوتها وتلميحاتها، وفي أحلام ليله بدأت تُزاحمُ سناءَ في الاستئثار به. تأتيه سناء بقميص نومها الداخليّ، تقتربُ منه وتنام إلى جواره ملتصقة به بشغف وإذا ما فتح عينيه ونظر إليها يكتشف أنها أسمهان بكل ما لديها من شَبَق ومكبوتات فيُشَدُّ إلى جسدها الفتّان النّابض بالحياة. (ص28)
وهكذا بدأت الأيام تُبعد بمحمد الأصغر عن سناء وذكراها، فالبعيدُ عن العَين بعيدٌ عن القلب. وأخذت الحياة تفعل فعلَها، ووجد نفسَه وقد استسلم للنوم يحلم "كمَن يقف على مَفْرق طرق، مهموما حائرا مُشتّتا" وكان رهوان المُنقذَ له من حيرته بأنْ جاءه وعرض عليه الخروجَ من سجنه البيتي إلى مكان سيجد فيه الرّاحةَ والاستمتاع، ولم يتردد محمد الأصغر ولم يستفسر، فقد كان راغبا في الخروج من حالة الحزن والحيرة والضّياع، ارتدى ثيابه وتعطّر كما لو أنه ذاهب إلى حفل استقبال. (ص29)
وأخذه رهوان إلى بيت "فريال" التي تبيع المُتعة لطالبيها من مُحبّي المغامرة. وكنّا قد تعرّفنا على بيت فريال في مجموعة "نوافذ للبوح والحنين ص203، ووجد محمد الأصغر نفسَه مندفعا نحو فريال بجسدها الجميل "وقوامِها الرّشيق وتنورتِها القصيرة التي تكشف مساحةً غير قليلة من فخذَيْها، وبلوزتِها التي تنمُّ عن نهدين مُكتنزين وهي تنثر شعرَها على صدرها في حركة إغراء، " (ص30) وسارع رهوان الذي لاحظ اندفاعَ محمد الأصغر نحو فريال بتَقديمه لها بقوله: "أقدّمُ لك أحدَ أبناء عائلتي، العم محمد الأصغر، محرّر الكتب ومُصحّح الصحف قبل صدورها وذهابها إلى القرّاء، الذي ماتت زوجته قبل أسابيع ، وهو الآن فاقدٌ مُلتاعٌ، محتاجٌ إلى مَن تُسْري عنه وتقتلعُ الحزنَ من صدره وتمنحُه الحبّ والحنان." وفاجأته في هذا الموقف زوجته سناء تُعاتبه وتؤنّبه على فعلته قائلة:
-ما الذي تنوي أن تفعله يا محمد؟ هل وقعتَ في حبائل رهوان؟ وإلى أين يأخذُك هذا الدّاشر وأنتَ عجوز طاعن في السّن؟!!
فتضايق، وكاد يشتبك معها في شجار، وقال لها بغضب:
-اسمعي يا سناء، نامي واتركيني أنام" (30-32)
وقرّر بعد زيارته لقبر سناء ألّا يعود مرّة ثانية لزيارته، وحتى انجذابه إلى الكَنَبة التي كان يجلس هو وسناء عليها خفّ وانصرف إلى مراقبة بيوت الحيّ من خلف زجاج شرفته. وبدأت أسمهان تُشغله فيتذكّر حديثها عن النسيان بمرور الزمن، ويندفع في قراءة كتابي ماركيز وكاواباتا عن الجميلات الصغيرات النائمات، ويشدّان به ليحذو حذوهما فيكتب رواية شبيهة لما كتبا.
وهنا كانت المشكلة، ومنها انبثق الحلُّ.
المشكلة في الصيغة التي يُقدّم فيها الكاتبُ تفاصيلَ مغامراته الماضية والتي يفكر بالخَوض فيها مُتَشَبِّها ببطلَي ماركيز وكاواباتا للقارئ العربي المحافظ الرّافض لما يمسّ العادات والتقاليد والمُعتقدات الدينيّة.
ووجد الحلّ السّريع في إمكانيّة البَوح بكل أسرار حياته الخاصّة الماضية والحاضرة، ويبدو للقارئ في ذات الوقت مِثالَ الطهارة والنَّقاء والالتزام بكلّ مَفاهيم المجتمع الذي يُعايشه، وذلك باختياره كتابة رواية لما تُتيحُه له الرواية من الحريّة في بناء عالم كما يحلو له، تعيش فيه نماذج متنوّعة ومتناقضة من الناس، تتصرّف كما تريد.
ووجد في "الواقعيّة السِّحريّة" المَخْرَج الأمثل، وكان قد فعل ذلك في أعمال سابقة له، وأتى بشخصيات يرفضها المجتمع المُحافظ مثل شخصيّة المغنية شاكيرا والرّاقصات العاهرات في "نوافذ للبوح والحنين"، ورهوان بكل أفعاله المُنافية لمفاهيم مجتمعه. ولم يثُر أحد على الكاتب، ولم تُوَجَّه إليه سهامُ الاتّهام بالخيانة والدَّعارة ونَشْر الفَساد. كما أنّه أتى بشخصيّات مشهورة ومحبوبة مثل لاعب كرة القدم البرازيلي رونالدو ومايكل جاكسون ورامبو وهو يرى "أن المَزج والتّقابل والتّعايش وتبادل التّأثير، وخلط الواقعي بالخيالي الذي يتبدّى في قصصي التي تحمل أسماء هؤلاء النجوم، يقود المتلقي إلى حالة من التأمّل ومن التفكير في أوضاعنا التي تصل حدّ السرياليّة حينا، والضّحك المُبكي حينا آخر". (أنا والكتابة ص80)
وهو في قَصِّه هذا استحضر شخصياتِ بطلَي ماركيز وكاواباتا وكذلك ماريا زخاروفا الروسيّة، وكُثْرا من الذين ذكرهم في قصصه ورواياته السّابقة. وتحاشى السّهامَ ضدّه بجعل محمد الأصغر يقوم مقامَه ويظهر بدلا منه أمام الناس.
فالكاتب منذ الصفحة الأولى من "منزل الذكريات" انتزع القارئ من واقعه المَعيش الذي تعوّدَ عليه ورضيَ به إلى أجواء يتداخلُ فيها الواقع باللاواقع بتَوافق تام وتناسُقِ العناصر المُتَضادّة مع بعضها. فنلتقي في تشييع سناء زوجة محمد الأصغر بشخصيّات مختلفة منها التي نعرفها ولا تزال على قيد الحياة مثل رهوان وبعضٍ من عائلة محمد الأصغر، ونلتقي بعدد من شخصيات قصصه ورواياته التي كتبها، وبطلَي رواية ياسوناري كاواباتا وماركيز، وهكذا نرى تَجَمُّعَ شخصيات مختلفة، منها شخصياتٌ هو خلقَها في رواياته وقصصه، وشخصيّاتٌ ماتت منذ سنوات، وأخرى أبطالُ روايات لكُتّاب غير عرب. كلّهم اجتمعوا معا لتشييع سناء زوجة محمد الأصغر. هذا التّداخل ما بين الشخصيات في الواقع المرئي وفي اللاواقع المُتَخيّل جعل حتى محمد الأصغر نفسه يتساءل بحيرة ودهشة:
-"هل أحلم؟ هل أهلوس؟ أم هو عالمي الذي أدمنتُه مع الكتب وأبطال الروايات؟ ولو أنّ أمي ما زالت على قيد الحياة كانت ستُصابُ بالحيرة والذهول، وستقولُ إنّني ممسوس ولم أعد مالكا قوايَ العقلية" (ص10)
هذا الواقع الذي يتقاطع فيه العالمُ الرّوحيّ بالعالم الماديّ، وما هو خارق للطبيعة والدُّنيوي، ويتعايش فيه الواقعُ مع اللاواقع بتوافق وقبول هو ما اتُّفِقَ عليه باسم "الواقعيّة السحرية" التي تَميّز بها كُتّابُ أمريكا اللاتينية مثل ماركيز منذ روايته "مائة عام من العزلة" ومن ثم اكتسحت العالم الروائي وأصبحت الوسيلةَ المفضَّلةَ عند الكاتب للهروب من المُواجهة المُباشرة إلى التستُّر بخَلْق هذا العالم السّحريّ بشخصياته المختلفة ليقول ما يريد ولينتقدَ ويثيرَ ويٌحرّضَ ويبوحَ بقصص حبّه ويكشف أسرارَ الآخرين من خلال شخصيّات روايته المُتعايشين معا بتَصاف وقبول.
وإذا كان محمود شقير في رواياته وقصصه السابقة مثل: "احتمالات طفيفة" و "صورة شاكيرا" و "ابنة خالتي كوندوليزا" قد لامس "الواقعيّة السحرية" بخَفَر وتهيّب، فإنّه ازداد بأسا وتفاعلا ومُمارسة في قصص "نوافذ للبوح والحنين" حتى نجدَه في "منزل الذكريات" يعيش هذا الواقع السحري الذي خلقَه، ومنه ينطلق ليُوَجّه سهامَه في كلّ الاتجاهات وليقولَ كلمتَه بقوّة ووضوح.
فمنزل الذكريات هي نموذج ممتاز للواقعيّة السحرية، فيها تتشابك الشخصياتُ وتتداخلُ المشاهد، فلا يتمَكَّن القارئ من التّمييز بين الواقع والخيال وحياةِ الواحد اليومية وما يعيشُه في أحلامه، ويُطلق لنفسه الحرية فيشتم جُندَ الاحتلال ويتمنى زوالَهم، ويفضح تدميرَهم لحياة الناس بإطلاق المجرمين والقَتَلة والعملاء للاعتداء على الناس، وتقويض أمنهم، وتنغيص حياتهم، وتمزيق وحدتهم وتشتيت شملهم كما يفعل البلطجي جميحان شقيق أسمهان وعصابتُه من المجرمين، وحماية الاحتلال للموبقات كي تنتشرَ في المجمتع بتأمين بيوت العاهرات ومجالسِ شُرْب الخمور التي تُقامُ قريبةً من معسكرات المُحتل كما رأينا بيت فريال.
"السّهل المُمتنع والسُّخرية النّاعمة" ما ميّزا أسلوب محمود شقير السّرديّ في معظم كتاباته، ويلمس القارئ السّخرية الناعمة القويّة في عرض وشرح وتفسير ووصف وحوار محمود شقير. ويقول محمود شقير "إنّ هذه السّخرية جاءته نتاجا أكيدا للأوضاع المُرّة التي نحياها تحت الاحتلال، حيث العُسْفُ والاذلالُ ومصادرةُ الأرض وتغييرُ مَعالمِ المَشهد الفلسطيني وخَلقُ مَشهد آخر غريب من جهة، ومن جهة أخرى ثمّة التّخلّفُ الذي نُعاني منه وانهيارُ القيم، وتراجعُ العقلانيّة وانتشارُ النَّزَعات العشائريّة والعائلية المتخلّفة، وتعريضُ مجتمعنا وحياتنا إلى مصير بائس لم نشهده من قبل (أنا والكتابة ص126).
الحلم مَهْرَب ومَصْيدة محمد الأصغر
استخدم محمود شقير الحلمَ بصورة جميلة في المواقف التي تستحيل أن تجري في الواقع في العديد من قصصه السابقة. وفي بعض قصص مجموعة "نوافق للبوح والحنين" يجد في الحلم وسيلته ليلتقي الجميلة المغنية شاكرا ويُجالسها ويحدثها وهي في كامل عُريها ص 170 ومرّة ثانية صفحة 181. وفي روايته "منزل الذكريات"
شكّل الحلم عنصرا أساسيا في حياة محمد الأصغر، وقام بمهمّتين متناقضتين:
الأولى أنّه كان القَيْدَ الذي شلّ حياتَه وحدّد مَسارَه وسَببَ ما لاقاه من مَشاكلَ وآلام.
الثانية تحوّل ليكون المَهْربَ الذي يجد فيه فرصة للابتعاد عن مُضايقات الغَيْر له.
في الحلم كانت تعزيتُه عن فَقْد زوجته سناء التي كانت تأتيه، رغم موتها، كلَّ ليلة وتنامُ إلى جانبه وتتناول معه وجبةَ الفطور ويتجوّلُ برفقتها في شوارع وأزقّة القدس.
وفي الحلم كانت تحضرُ إليه أسمهان بفتنتها وإغرائها، ولا تغيبُ عن فكره حتى ساعات النهار.
وزارته الصغيرة الفاتنة سميرة وقضى معها الساعات.
وفي الحلم يزوره بطلا مركيز وكاواباتا يحادثانه ويتحاوران معه ويشدّانه إلى عالمهما السّحري الجميل، يقرأ في روايتيهما ويشعر بأنهما يتسبّبان باجتذابه نحو تجربة لم يُفكر فيها من قبل حتى أصبح رهينتهما، وأمنيتُه فقط أن ينجحَ في كتابة قصة كالتي كتباها. (ص34).
ولكن الحلم أصبح سببَ تعاسته والقَيدَ الذي شلّ حياتَه وحدّد مسارَه، وما لاقاه من مشاكلَ وآلام، وتضاءل دورُه وانحصر، كما ذكرتُ أعلاه، ليكونَ المَهْربَ الذي يجد فيه فرصةً للابتعاد عن مُضايقات الغير له.
حتى سناء زوجته أصبحت المُلاحقةَ له في الأحلام والمُراقبةَ، فلا يقوم بعمل أو يُفكر بغيرها، وخاصة بأسمهان، حتى تكونَ له بالمرصاد، فتلومُه وتوبّخه حتى أنها أصبحت تُضايقه، وصارحها بضيق واضح بقوله لها ساعة اعترضته وهو في بيت فريال بلومها له لقبوله عروض رهوان له بزيارة بيت العاهرات:
-اسمعي يا سناء، نامي واتركيني أنام. (ص32)
ومن ساعتها قرّر الابتعاد عن سناء والانقطاع عن زيارة قبرها.
وأحلامه، خاصة بأسمهان، واستحواذها على فكره وأعصابه كانت السببَ في وقوعه بحبائلها حيث قالت له بعد زيارتها له لأخذ ملابس سناء:
-شُفتَك قبل ليلتين في المَنام.
وكان هو قد تذكّر لقاءَه بها في الحلم وتساءل:
هل تَمكّنتْ من الإطلال على حلمي أم كان لها حلمُها الخاص؟ (ص49)
وفي لقاء آخر صارحته باتّهامها له بمضايقتها والاعتداء عليها:
-أنتَ عملتَ العَمايل معي، تخطّيْتَ الحدودَ يا محمد. هل نسيتَ حلمَك المفضوح؟ وأنت تتنعمُ بجسدي وما تقول إلّا أنّه حلال عليك.
وحاول الدّفاع عن تهوِّره معها في الحلم بقوله:
-لقد التبس عليَّ الأمر لأنكِ جئتِ إليَّ بقميص داخليّ اعتادت سناء أن ترتديَه.
فقاطعته قائلة:
-ولا تنسَ أنّكَ كلما جئتُ إلى بيتك، تخترقُ جسدي بعينيك.
وهدّدته قائلة:
-لازم تُصْلح الخطأَ الذي ارتكبتَه، أو أرفعُ الأمر إلى أخي جميحان. والزواج هو دواء كل علّة. (51-55)
ولم يتأخر أخوها جميحان، وجاءه مُهدّدا شاتما مُتّهما إيّاه:
-أنتَ مَسَستَ شرفَ أختي، وتخطيتَ الحدودَ معها في حلمك الآثم، وبنظرات عينيك الآثمتين.
وصفعه على وجهه وضغط على عنقه حتى كاد يختنقُ، وأمره بأنْ يتزوج أختَه أسمهان.
وبالفعل تزوّجها. (ص66)
وظلّ جميحان يلاحقُ محمد الأصغر وأحلامَه، وأجبره على الذهاب إلى المسجد والصلاة خمس مرات في اليوم، ثم أجبره على القيام بالعُمرة.
وعندما قال محمد الأصغر لجميحان:
-بأيّ حقّ يُحاسَبُ المرء على أحلامه مهما اشتطت هذه الأحلام؟
أجابه جميحان:
-هذه الأحلام تشير إلى رغبة فاسقة فاجرة تحقّقت، أو هي في طريقها إلى التحقّق. والمطلوبُ منك محاصرة الأحلام المرفوضة ودحرَها، وعدم الاقتراب من أيّ شيء يُعكرُ قُدْسيّة الزواج. (ص119)
وبدأ محمد الأصغر يخافُ الأحلامَ وما تجرّ عليه من ويلات، ولكنه لا يستطيع التّحَكّمَ بها. وفكّر في التّوقّف عن النّوم فلا ينام مُطلقا كي لا يحلمَ. ولكن كيف يُمكنه ذلك وقد يغلبُه النُّعاسُ فينام ويحلم؟
ويعود جميحان ليطارده في أحلامه، فيباغته مرة مع أسمهان وهو في الحمام يستحم مع الفاتنة الصغيرة سميرة، وأخرى يأتيه وهو يلعب بالسيف في كلّ اتّجاه مهدّدا متوعّدا. (ص132) ممّا دفعه للتّفكير بالهرب من البيت والبلدة خوفا من اعتداءات جميحان.
ولم تتوقف ملاحقات جميحان لمحمد الأصغر، واضطره على التَّنازل لزوجته أسمهان عن كلّ ما يملك وحتى البيت، وبعد أن حصل على التّوكيل من أخته أسمهان قام بإجباره على الطلاق منها، وطرَدَه من البيت. (ص171) فالتجأ إلى قريبه رهوان وسَكن عنده.
علاقة محمد الأصغر ببطلي كاواباتا ومركيز ما بين الإعجاب والتّحدّي
يقول محمد الأصغر قرين محمود شقير وبطل منزل ذكرياته:
-"أوّل كتابين انشدَّ اهتمامي نحوهما وفضّلتُهما على غيرهما هما رواية "الجميلات النائمات" للياباني كاواباتا ورواية "ذكرياتي مع غانياتي الحزينات" للكولومبي ماركيز". وكانا دافعا قويّا لتفكيره بتصرّفاتهما وليسأل نفسَه:
-هل كان العجوزان مضطرّين إلى الدّخول في تجاربَ مع فتيات شابات وهما طاعنان في السنّ، بينما يُفتَرضُ فيهما أن يحترما شيخوختيهما فلا يُفرِّطا في الرّكض وراء المُتَع الزائلة؟
واستمرّت حياةُ محمد الأصغر، بطل محمود شقير تتأرجحُ ما بين حياته الخاصّة التي يُمارسها في حياته اليومية وحياته التي يعيشها في أحلامه وكوابيسه. وما بين الحياتين نجدهُ يعيش في عالم أحلامه وكوابيسه، ولا تكون حياتُه اليوميةُ إلّا صَدى ونتيجةً لها ومُوجِّهةً لكلّ أفكاره وتصرّفاته. وتوالت الجلساتُ التي تجمعهم، وتعدّدت الأحاديث والمواضيع وتبادل الهموم وأوجاعها، وحدّثه كلٌّ منهما عن متعة النوم في السرير إلى جوار فتاة مُخَدَّرة عذراء. وكيف أنّه بهذه الساعات التي ينامُها إلى جانب الصغيرة الفاتنة النائمة يستعيدُ الشريطَ الطويل من ذكرياته عن مغامراته في سنوات الفتوّة والوقوف على تفاصيلها، وكأنّه بذلك يردُّ على العَجْز الذي يأتي مُرافقا لسنوات الشيخوخة، وكأنّه في الوقت ذاته تعبيرٌ عن العَزاء بأنّ حياة العجوز لم تذهب خواءً وسُدى، ولم تكن مجرّد خيبات تليها خيبات. (ص105).
وازدادت رغبة بطل شقير في كتابة روايةٍ شبيهة، بل وتتفوَّقُ على ما كتبا مع إدراكه للفروق الكبيرة ما بين المجتمعات التي عاشها ويعيشها كلٌّ منهم. وقلّدهما في التّوجه لبيت العاهرات طالبا أنْ يقضي ساعات مع فتاة صغيرة يتأملها وهي بكامل عُريِها ساعات الليل وهو يتمدّدُ إلى جانبها.
وانبهر محمد الأصغر بجمال الفتيات وخاصة سميّرة، التي انتبه إلى أنّها كانت تريدُه وتحاولُ إغراءَه وهي تتظاهرُ بالنَّوم إلى جانبه بحركاتها، حتى أنّها زارته في بيته ودخلت الحمامَ معه واستحمّا (ص160-161). وهذا مما أشعره بالغرور، فأراد المُباهاة بجميلاته أمام بطلَيْ ماركيز وكاواباتا، وبدافع داخلي أنْ يريهما أنَّ الفتاة الفلسطينيّة تتفوَّقُ على غيرها بالجمال والفتنة.
الاحتلال وظلمُه للناس، وحمايتُه للظّواهر السلبيّة وزيادتها
لم يتجاهل محمد الأصغر بطل محمود شقير وجودَ المحتل الإسرائيلي والمُضايقات والتَّعَدّيات التي يقوم بها ضدّ الجماهير العربية في الأراضي المحتلة، ولم ينج هو، رغم تقدّمه بالسّن، من مُهاجمة الجنود لبيته وتوقيفِه بتهمة التّحريض ضدَّ المُحتلين ومن ثم لأنّ ابنَ أخيه مُتَّهم بعمل مُناهض. (ص73-75) كذلك اعتُقل رهوان (ص156)
ويذكر بعضا من موبقات الاحتلال التي تُدمّر العلاقات الاجتماعية والسلوكية، وكيف يعمل المحتّلُّ على حماية تجّار المُخدّرات وعملاء الاحتلال الذين يحملون السلاح جهارا ويهدّدون أبناء جلدتهم من المواطنين العُزَّل، ويتجاهل عن قصْد تصرّفات المجموعات العابثة والفَوْضويّة، والمجموعات الإجراميّة المُتمَّثلة في جميحان ومجموعته، ورعايته لبيوت العاهرات الليلية والملاهي المختلفة كبيت فريال المُقام قريبا من المستوطنة، وجُند الاحتلال (ص35)، هذه البيوت التي تجذب إليها مختلف انتماءات الناس. ويفضح تصرّفات المُحتَلّ الذي يقوم بتزويد الناس بمختلف المواد والحاجيّات وحتى بالأدوية المَغشوشة مُنتهية الصّلاحيّة. (ص39) ويصفه أنّه احتلال استعماري طاغ(ص45).
ويشير إلى ما وصلت إليه الحياة المعيشيّة للناس، وضَعف العلاقات الاجتماعية نتيجة لظلم المُحتَل، وسيطرة مجموعات الإجرام وتجّار المخدّرات والعملاء حتى لم يعد الضّعيفُ أو المسكين أو المُعتَدى عليه من قِبَل البلطجيّة والفوضويين يجد مَن يقف إلى جانبه ويمدّ له يدَ المساعدة، كما جرى معه هو عندما اعتدَتْ بعض هذه المجموعات من الزعران (ص93) على بيته وسبَّبت بعضَ الأضرار، واختطاف ثلاثة شبّان ملثمين له من بيته وتهديدهم له بالموت إذا لم يصمت ونطق بأيّة كلمة. ولم يجد مَن يقف إلى جانبه ومساندته حتى من أبناء عائلته، ولكلٍّ أسبابه التي شرحها، وشعر أنّهم لا يملكون ردّا على مًن تعرّض له وعلى مًن يتعرّض له لاحقا في ظلّ غياب القانون (ص58-61).
وما جرى لمحمد الأصغر في علاقته بجميحان البلطجي الذي لاحقه وضايقه وأجبره على الزواج من شقيقته أسمهان، واضطره على الذهاب إلى المسجد وأداء الصلاة ومن ثم على القيام بالعُمرة وبعدها على تسجيل كل ما يملك حتى داره باسم أسمهان وأخيرا اختلق أسبابا واهية ليُجبره على الطلاق ثم طرده من البيت واستولى عليه. وما هذا إلّا صورة مُصَغّرّة لما يُعانيه الناس العاديين في ظلّ الاحتلال وحمايته لأمثال جميحان وغيره من العملاء والبلطجيّة.
محمد الأصغر نموذج للفلسطيني الصّامد
قد يبدو محمد الأصغر للقارئ، نتيجة لما جرى له من قبل جميحان، ضعيفا مستسلما لا يجرؤ على الرّفض والدّفاع عن نفسه حتى إذا ضُرب وأهينَ وطُرد من بيته، ولكن محمد الأصغر الحقيقي هو الذي نرافقه وهو يواجه جنودَ الاحتلال وتعدِّياتهم واعتقالاتهم بقوّة وصمود وثقة بالنّفس (ص74-75).
وفي حديثه مع بطلي كاواباتا وماركيز يتوسّع في الكلام حول ما يُعانيه الشعب من ظلم المحتلين وصمود الناس وتقديمهم التضحيات الكبيرة (116) وعندما يخبره رهوان بعد أن خرج من الاعتقال "أن المحققين يرونك مُحرِّضا ولديهم قناعة أنّك تجتمع بشباب عائلة العبداللات وتبثُّ فيهم روحا مُعادية، فأنت في نظرهم مٌحرِّض بشكل مباشر من خلال الاجتماعات، وغير مباشر من خلال الكتب المسمومة "(ص157-158) وتمنى محمد الأصغر بعد سماعه كلمات رهوان "لو أنّ البغل جميحان يُقدِّر كم أنا عرضة للأذى من المحتلين فيعتقني من أذاه" (ص158).
فمحمد الأصغر كان ضعيفا ومُستسلما وخاضعا لأبناء شعبه أمثال جميحان ومجموعات الشباب، فهو يشفق عليهم ويرثي لهم لأنَّهم ضحيّة الاحتلال وثمرته ونتيجة للأوضاع المعيشيّة السيّئة التي يُعاني منها الناس، أمّا مع المحتل وجنوده فكان قويّا ثابتا لا يضعف ولا يهين ومُثابرا على الرفض والمقاومة بما يبثُّه في الشباب من روح المقاومة والصّمود، وبما يكتبه في كتبه التي يقرؤها الكثيرون.
وما هذه الكلمات التي ينهي بها محمد الأصغر سيرته "أمّا جنود الاحتلال فقد ذابوا في ثنايا الليل مثل عصابة من لصوص أو مثل قُطّاع طرق نَهّابين" (ص176) إلّا الشهادة التي تؤكد قوّة وعزيمة وصمود محمد الأصغر في رفض المحتلّ ومقاومتة.
مفاجأة محمود شقير
استطاع محمود شقير في الكثير من رواياته وقصصه القصيرة أن يخلق شخصية محمد الأصغر لتكون مشابهة له إلى حدّ التّطابق بكل ما يتَّصف من الصّفات التي تُقرّبُه من القارئ وتُحبّبه به، فالكثير من الصّفات، وخاصّة في كلامه وسُخريَّته النّاعمة، وهدوئه وتفكيره المُتّزن ونمط حياته البسيطة هي نفسها التي نعرف محمود شقير بها.
ويُفاجئني الصديق الكاتب محمود شقير في الأمسية التي شاركنا فيها حول روايته "منزل الذكريات" في مدينة حيفا يوم 6.2.2025 بقوله لي هامسا إنّ "ع" الذي يسطو على كتُب محمد الأصغر هو مَن يُمثّله، وليس محمد الأصغر. وعدتُ في ساعات الليل المتأخرة لأكتب له عبر الواتس آب: " العزيز محمود. راجعتُ اليوم شخصيّة "ع" في مجموعة "نوافذ للبوح والحنين" فهل هو بالفعل الذي قلتَ إنّك هو؟ فالشَّبَه بينك وبين محمد الكبير أكثر ومع محمد الأصغر تطابق كامل. فعَنْ أيّ محمود آخر قصدتَ بأنّك هو؟
وجاء جوابه: "ع هو أنا محمود شقير/ أنظر آخر مشهد في "نوافذ/ محمد الكبير هو أخي وجه الشبه بيننا أنّه شيوعي وأنا كذلك. دمتَ وسلمتَ."
ولم يُقنعني بذلك لأنّ شخصيّة "ع" كما عرفناها ورافَقْناها في مجموعة "نوافذ للفرح والحنين" مناقضة لشخصية محمود شقير اللهم إلّا إذا قبلنا بما يراه علم النفس إنّ هناك من الناس مَن يرَوْن شبيها لهم ومُتمّما لشخصيتهم في مَن هو النّقيضُ والمُغايرُ لكلّ ما يتّصفون به.
وأرى في شخصيّة محمد الكبير في مجموعة "نوافذ للبوح والحنين" و"منزل الذكريات" الشخصية الأقرب من شخصية "ع" إلى شخصية محمود شقير، فهو مثله انتمى للحزب الشيوعي واعتُقل وعُذّب ونُفي لسنوات عديدة وتشرّد إلى أن عاد وسُمح له بالإقامة في القدس. ولكن شخصيّة محمد الأصغر تظل هي الأكثر مطابقة لشخصيته.
وإذا ما قبلنا بما يقوله محمود شقير فإنّه يؤكّد بذلك ما قد يحدثُ لبعض الرّوائيين حيث تتمرّد عليهم شخصيّة يخلقونها في عملهم الروائي وتخرج عن طاعتهم وتتصرّفُ بحرية تامة. ويحدث أيضا أن يُلقي الروائي من صفاته على أكثر من شخصيّة من شخصيات روايته فيُرى في كلّ منها أو في إحداها فقط.
القدس تظلُّ في القلب وجُنود الاحتلال إلى التّلاشي
رغم ظلم المحتل وتفشّي الجريمة والاعتداءات، وانحسار الشعور بالأمان ظلّ محمد الأصغر، كغيره من الناس، العاشقَ لمدينته القدس، يتجوَّلُ في شوارعها وأزقتها، يتحدّث إلى الناس في أسواقها، يتناول الطعام في مطاعمها مع زوجته سناء والجلوس مع أصدقائه في مَقاهيها.
وكانت نهاية بطل "منزل ذكريات" محمود شقير أن صَحا في بيت رهوان على ضجيج في الخارج وطَرَقات شديدة على الباب واقتحام عدد من جنود الاحتلال بهدف اعتقاله مع رهوان.
لكنّ جنود الاحتلال ذابوا في ثنايا الليل مثل عصابة من لصوص أو مثل قُطّاع طُرق نهّابين.
وكان هو ورهوان يستقبلان الشمس ويضحكان باستمتاع، وعلى مقربة منهما وقفت أسمهان مبتسمة مشجّعةً، وقد تحرّرت من سطوة أخيها المجرم الشيطان.
نهاية الكلام لمحمود شقير
وحتى لا يطول الكلام وتتشعّب النّقاط أنهي بكلمات محمود شقير نفسه التي قالها في كتابه "أنا والكتابة ص242" لتكون الخاتمة:
"أعترف أنّ الكتابة هي مصدرُ قوّتي الوحيدةِ تقريبا، أستطيعُ عبرَ الكتابة أنْ أخوضَ صراعي المشروع ضدّ التَّخلّفِ والجَهل وضدّ التَّسلّطِ والاستغلال، أستطيعُ أنْ أُعرِّيَ كلّ خَلَلٍ وأيّةَ مظاهرَ سلبيّةٍ من حولي، كما أستطيعُ أنْ أُعزّزَ النّفورَ من كلّ ما يتناقضُ مع الحسّ الإنساني السّليم. ولولا الكتابةُ التي تهَبُ معنى أكيدا لحياتي لَما استطعتُ مُواصلةَ العيش."
***
د. نبيه القاسم - الرامة