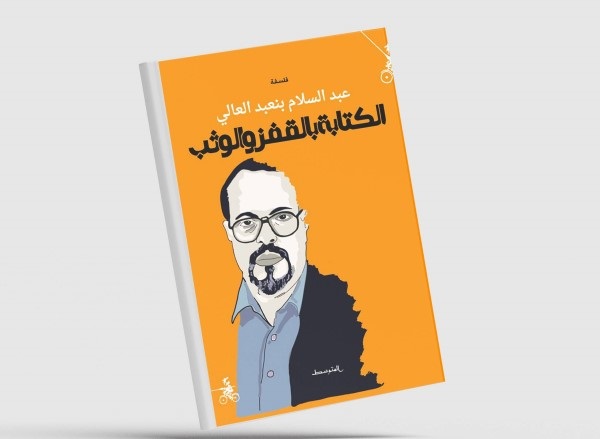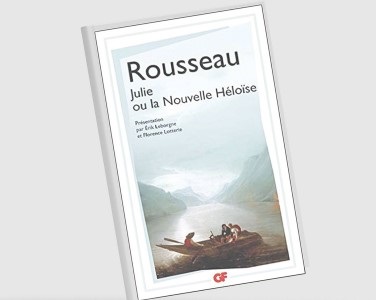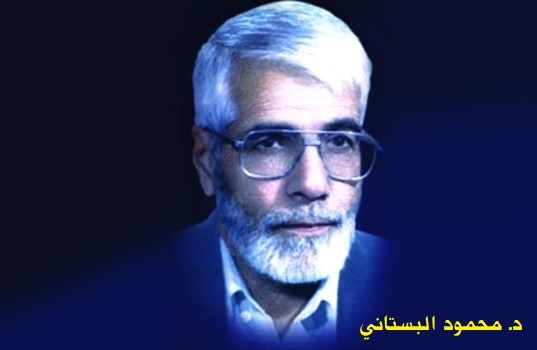كان الفيلسوف المسيحي غوتفريد فيلهلم فون لايبنتز (1646 - 1716) أكثر ارتباطاً بالفلاسفة الشكوكيين من أي فيلسوف آخر في نهاية القرن السابع عشر. ربطته علاقة شخصية بالثلاثة البارزين في ذلك الوقت؛ الأب سيمون فوشيه، والأسقف بيير دانييل هوييه، وبيير بايل. وككل الفلاسفة منذ أيام سقراط وأفلاطون، نشر كثيراً من كتبه المشهورة بوصفها إجابات عن أسئلة هؤلاء الشكوكيين أو للتعامل مع المشكلات التي أثاروها. وربما أشهر بيان عرض فيه لايبنتز آراءه الميتافيزيقية هي رسالة أرسلها في 1695 إلى فوشيه سماها «النظام الجديد».
لا شك أبداً في أن لايبنتز لم يكن شكوكياً، ومع ذلك فقد عدّه المشككون في عصره صديقاً أقرب من كل الميتافيزيقيين في تلك الفترة. وبينما هاجم فوشيه وهوييه وبايل الديكارتية وآراء مالبرانش وسبينوزا ولوك، فإنهم تعاملوا مع ميتافيزيقا لايبنتز بدرجة من الاحترام وضبط النفس لم تحدث قط في تعامل الشكوكيين مع رؤى الفلاسفة الدوغمائيين، وربما يرجع هذا إلى أسلوبه الدبلوماسي، وهو الدبلوماسي الكبير، في التعامل مع الناس، ومعهم خصوصاً.
وفي حين تعاهد آرنولد ومالبرانش وبيركلي على محاولة تدمير خطر الشكوكيين الذي يطارد الفلسفة الأوروبية، كان لايبنتز شديد الهدوء في معالجته التحديات التي تواجه العقلانية. وفي حين كان كثيرون لا يرون في حجج الشكوكيين سوى أنها خطرة للغاية، أو أنها ستقلب كل اليقين في المعرفة الطبيعية والموحى بها، وأنهم لم يستطيعوا رؤية الشكوكيين إلا بوصفهم شخصيات شيطانية عازمة على تدمير كل الثقة في النظرية المسيحية، وجد لايبنتز قيمة كبيرة وإلهاماً نافعاً في شكوك أصدقائه، وكان يرى فيهم أفضل نقاد فلسفته، وأن شكوكهم لن تتسبب في تدمير العالم العقلاني والديني، بل يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف أعمق المبادئ الأساسية للفلسفة والدين.
في ذلك الزمن، تعرض الشكوكيون للهجوم من جميع الأطراف، بوصفهم شياطين لا يستحقون المناصب التي شغلوها، واضطهد الكالفينيون الفرنسيون بايل في هولندا، وحاول المتعصبون مثل آرنولد فضح ما عدّوه الخطر الخبيث في دعاوى هوييه. في مقابل هذا، كان لايبنتز يعاملهم كأعز أصدقائه، وعندما أدان قاضي روتردام بايل وعزله من منصبه، سعى لايبنتز إلى إيجاد وظيفة جديدة له في ألمانيا.
تعرَّف لايبنتز على مشكلات الشكوكية مبكراً، فقد كتب أحد أساتذته ونشر بحثاً يرد به على فرنشيسكو سانشيز، كما أنه نشر هجوم سانشيز الشكوكي على الرياضيات. ويبدو أن لايبنتز قد أخذ بعض هذه النقاط الشكوكية على محمل الجد واستمر في مناقشتها مع علماء الرياضيات طوال حياته. وقد انغمس حقاً في عالم الشكوكيين عندما ذهب إلى باريس في مهمة دبلوماسية ابتداء من عام 1672.
لم تثر صداقة لايبنتز مع هوييه أي جدل، فكل واحد منهما كان يكنّ احتراماً كبيراً للآخر، ويفرح بموافقة الآخر له على آرائه. يبدو أن لايبنتز قد عدّ هوييه رجلاً يتمتع بسعة الاطلاع الهائلة في المسائل المتعلقة بتاريخ الدين. كما أنه يثمن بشدة نقد صديقه للديكارتية، ولذا دعمه بأدلة جديدة لاستخدامها في طبعة جديدة من كتابه «الرقابة على الديكارتية»، فقد كان ينظر لمناوشاته مع الديكارتية بوصفها عملاً مكملاً لجهد هوييه. ثم عاد ونشر بصورة مستقلة في تسعينات القرن السابع عشر بعضاً من هجماته على فلسفة ديكارت بناءً على اقتراح هوييه وتشجيعه. وبعد أن تقاعد هوييه وطواه النسيان وأهمل ذكره بقي لايبنتز يتذكره ويجلّه.
ومع كل هذا، كان بايل هو المؤثر الأعمق في لايبنتز، ومعه تبادل الأفكار الأكثر حيوية وأهمية عبر الرسائل، مع أن هناك شكاً كبيراً في أنهما قد التقيا فعلاً. ويبدو أن أول اتصال بينهما كان عام 1687، عندما أرسل إلى بايل رسالة حول كتاب للأخير كان بعنوان «أخبار جمهورية الرسائل» ويظهر من المراسلات أن لايبنتز كان حريصاً على أن يسمع من بايل رأيه في مشاكساته ضد الديكارتية، بغرض تطويرها.
مع صدور قاموس بايل بدأت مرحلة جديدة في علاقة الرجلين، فبعد سنوات من محاولة إقناع فلاسفة من مثل مالبرانش ولوك بالنظر في فلسفته الجديدة، وجد لايبنتز الاعتراف والتأييد من قبل بايل الذي عدّه واحداً من أبرز العلماء الميتافيزيقيين في ذلك العصر. وفي مقالة بايل عن أرواح الحيوانات كتب يقول: «ثمة صعوبات تنطوي عليها فرضية لايبنتز، إلا إنها تشير إلى مدى عمق عبقريته». لم يمنعه التقدير من انتقاد نظرية لايبنتز، كما أعلن أنه لم يكن جاهزاً بعد لتفضيل نظرية لايبنتز على نظرية مالبرانش؛ لأنه كان يريد أن ينتظر حتى يُحكِم لايبنتز عمله. فكتب لايبنتز ليجيب عن النقاط التي انتقده بايل بسببها، ثم جلس ينتظر الرد بفارغ الصبر، وكان بايل سعيداً بأن اعتراضاته قد دفعت لايبنتز إلى تطوير آرائه، وكتب معلقاً: «أنا الآن أعتبر هذه النظرية الجديدة فتحاً مهماً سيكون من شأنه توسيع حدود الفلسفة». هذا تعليق مهم يدل على وعي هؤلاء العظماء بدور الشكوك في تطور المعرفة.
إنه لأمر يثير الدهشة حقاً حين ننظر في المناقشات بين لايبنتز والشكوكيين فنجد الحوار الراقي السلمي، بعكس النقاشات الحادة المختلفة بين رجال الدين وفلاسفة القرن السابع عشر، مثل تلك التي جرت بين ديكارت وغاسندي، أو مالبرانش وآرنولد. لقد بذل لايبنتز وأصدقاؤه الشكوكيون قصارى جهدهم ليكونوا لطفاء، بعضهم مع بعض، وليقدموا صورة مشرفة للحوار الحضاري الخالي تماماً من التجريح، حتى في المراسلات الثنائية. يصعب أن نتصور أن مثل هذين؛ السلام والهدوء، ومثل هذا الإعجاب المتبادل والنيات الحسنة، يمكن أن توجد في ذلك العصر، والفضل في ذلك، فيما يظهر، يعود إلى لايبنتز ونفوره من الصدام.
***
خالد الغنامي - كاتب سعودي
عن صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، يوم: 4 ديسمبر 2023 م ـ 20 جمادي الأول 1445 هـ