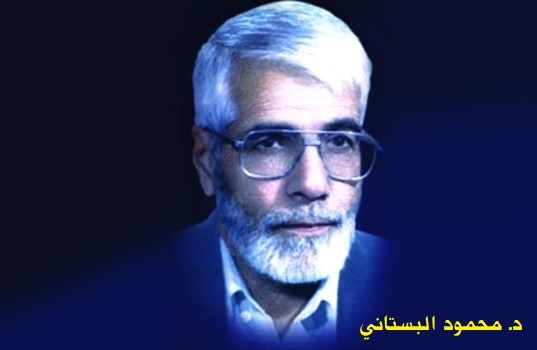للشاعر محمد لشياخ
الحلمة كورال، ملحمة زجلية للشاعر الزجال ذ.محمد لشياخ، تقع في 84 صفحة، صدرت عن دار بصمة للنشر والتوزيع، من تقديم الشاعر أمغارالمسناوي . ومادامت الملحمة هي " قصيدة قصصية طويلة، تسرد مآثر بطل حقيقي أو أسطوري تتجسد فيه المُثل، أو سرد لحادث طريف شيق، بإمكان سرده أن يلقي الأضواء على خفايا ونفسيات " [1]. فإن الحلمة.. كورال عصارة تجربة إبداعية ناضجة غذتها الثقافة الأدبية والنقدية للشاعر/الكاتب محمد لشياخ، هي عالم إبداعي يتلبس فيه الشاعر بالحاكي ليوصلنا إلى الخفي الكامن وراء الإنجاز الفعلي للغة، يدل السرد والحكي فيها عن تأمل الكاتب للواقع، وعن صراعه من أجل الوجود والحياة عبّر عن ذلك بواسطة الحوار بين الشاعر/الزجال (الحاكي) والجهال(شويكات غرسهم الزمان ف اقدام الحياة) [2] من جهة، والشاعر المفترض من جهة أخرى موضوعه "القصيدة الزجلية " بين الإمكان والوجود، متأملا ما كانت عليه ووجودها الجمالي في حاضرها وفي تطورها، مستشرفا إلى مستقبل أروع. إنه صراع مر يعيشه الكاتب مع اللغة يغوص في ثخومها باحثا عن معانيها الإيحائية وصورها الجمالية، من أجل بناء عالمه الإبداعي وتأتيت صوره الشعرية الدالة العميقة والمركبة التي تبتعد عن الصور المتداولة الحسية البسيطة، حيث تلتقي في النص مقومات السرد مع مقومات القصيدة الشعرية مما أضفى عليه صبغة التميز والفرادة .
وسنقف على بعض الرموز التي استعملها الشاعر/الكاتب ودلالتها. كما سنستجلي بعض القضايا الأدبية والنقدية التي يتضمنها الديوان مع إحالاتها. الحلمة.. كورال فضاء مليئ بالعتبات والإشارات والنصوص المتناصة التي يستدعيها الكاتب/ المبدع مقتبسا معانيها، و التي يمكن الوقوف عندها زيادة على العتبة الرئيسة وهي العنوان . يسافر الشاعر/ الكاتب بالمتلقي في أزمنة متعاقبة رتبها ورقمها، فجعلها ، تبدأ ب "زمن الظلمة" وتنتهي " بالزمن اللي صبح فيه الظلام جنة، والضوء محنة " الذي يحيل إلى المعاناة وإلى الضبابية وعدم الوضوح، وبهذا يحقق الشاعر الشكل الدائري الذي هو من خصائص القصيدة الحديثة في بنائها من حيث المعنى .إذ يتمم المختتم معنى المفتتح فيها، يقول في المفتتح:
قال الزجال اللي كتب:
صرخة ف الظلام خارجة عميا
ولد الحلمة كبر ف العتمة. [3]
ويقول في المختتم:
تم بين القصب
غنى الحالم لحنك المرتل يا جنة
والجنة حلمة. [4]
التيمة الرئيسية المولِّدة للكتابة الشعرية هي " الحلم "، وتدور في فلكها تيمات صغرى من قبيل: الحالم، زمن الحلم، عالم الظلمة، عالم النور، الزجل أو الكلمة أو الحرف .
فبناء النصوص يعتمد على ثنائية الظلمة / النور، وهي ثنائية تضرب عميقا في التاريخ الإنساني فكرا ووجدانا، وهي لصيقة بعالم الحلم، حيث البداية عند الشاعر الزمن الأول الذي مازالت فيه الكلمة في وجودها الأول لها قدسيتها، إذ لم يدنسها بعد الاستعمال، وقد امتطى الشاعر للصعود إلى هذا النبع الصافي أمواج الحلم التي بلغ عددها ثمانية، تؤسس بدورها تلك الأزمنة الثمانية المرتبة، غير أن الشاعر ينحاز إلى عالم الظلمة الذي تختبئ فيه الأسرار، ويخاف من عالم النور حيث تتضح الحقيقة الكاذبة، وتحضر المحنة المؤلمة. إن خروج الشاعر من حيز الظلمة إلى حيز النور، واكتشافه لهذين الحيزين معا يشبه تلك الصرخة الأولى التي تعلن عن خروج الوليد، توا، من الرحم المظلم إلى الفضاء المنير، وهي في هذا السياق، ليست صرخة فرح وحبور وإقبال على الحياة بقدر ماهي صرخة هلع ورعب من مغادرة عالم دافئ تعمه الطمأنينة والسلام، ولا غرابة أن يستهل الشاعر النص الثامن باقتباس مأخوذ من منتسكيو ومفاده: " ينبغي أن نبكي الناس في يوم ميلادهم لا في يوم مماتهم ".
فالحلمة، كلمة، خروج من الظلمة للنور و شمساته، الحلمة رواء ضد العطش، الحلمة حياة خالدة، الحلمة عند الشاعر أنثى ولادة. إذ يعيش ولد الحلمة الكاتب/ الزجال مع القصيدة تحولاتها الكبرى عبر الأزمنة على مستوى الإبداع نتتبع فيها أحوال الذات المستلهِمة لأحوال النفس المتوحدة والقصيدة الزجلية في شتى مراحل وجودها من الإفصاح والخروج إلى النور إلى التطور في الحياة إذ تتماشى الأحداث والتطورات النفسية للكاتب / الشاعر في نفس طويل، بدايته هيام وعشق يقول:
تسع شهور من العشق
قبل ما التاريخ يبدا
قبل ما اللوح يفتح سرداب الرعدة
ويبيع الخوف ف قراطس الندى
قبل ما تبدل وجعة الصوت ثوبها
وتلبس دربال الكلام. [5]
يتنامى الحدث هنا، وتتظافر تقنيات السرد من شخوص وحوار وأزمنة لتصور عسر الولادة والمعاناة الرمزية التي يطرح الكاتب من خلالها أفكاره الخاصة بأسلوبه الخاص وقد اختار له الصراع بمستوييه الواقعي والرمزي، حيث المعاناة النفسية الحقيقية إبان الإبداع، والبحث الدؤوب عن اللغة المعبرة والتراكيب الدالة تحقيقا للتناسب بين ما هو وجداني والشكل الإبداعي الأدبي في تجربة الشاعر، كل ذلك انطلاقا من تراكم معرفي وتجريبي ورهانات الكاتب الزجال، حيث يبقى الزجل موروثا إبداعيا وفكريا، وملاذا آمنا لطرح الأفكار التي لها علاقة بهذا الفن الأدبي من أجل إيصال المعنى وإسماع الصوت، صوت الزجال الراوي المتلبس في القصيد بالآخر . قال:
فعين راس الماء
تفتل الماء بين صبيعات مطرزة
وبين النقش ترسمت كلمة
برمها الريح على راس عكازه
وجلس مجابه فلجة الشمس. [6]
يدل رسم الكلمة على الكتابة، كما يستنتج ذلك من قوله: قال الزجال اللي كتب. تأكيدا على الكتابة، لأن الكتابة سلطة وتعاقد بين الكتاب والمبدعين والقراء. يريد الشاعر أن يضفي الطابع العالم على الأدب الشعبي، "الحلمة كورال" تنتمي إلى الأدب الشعبي، والشعر الشعبي تحديدا، تضعنا في قلب نظرية الأنواع الأدبية، ونعتمد في هذا المجال على ثنائية لغوية: هي اللغة العامية / اللغة الفصيحة أو لغة العوام / لغة الخواص، وكذلك على ثنائية تاريخية انثروبولوجية: شفهي / مكتوب، فتجعلنا نلمس التحول الذي طرأ على الأدب الشعبي، وهو الانتقال من الشفهية إلى الكتابة مع الاحتفاظ بالنوع والخصائص المشتركة ، وكذلك انتقال النصوص الشعبية مما هو منسوب للجماعة ، حيث يبقى المؤلف مجهولا (مثل ألف ليلة وليلة، كتب السير،عنترة بن شداد..) إلى النص المنسوب إلى الثقافة الخاصة، فتصبح لدينا ثنائية أخرى هي الثقافة الشعبية المنسوبة إلى الجماعة/والثقافة الشعبية العالِمة المنسوبة إلى الأفراد المحددين الذين يتوفرون على ملكية إنتاجهم الأدبي، وهكذا يضيف الكاتب الشاعر الأستاذ محمد لشياخ الطابع العالم على هذا النوع الأدبي .
فإذا كان الزجل يستمد مفهومه اللغوي من الحمام الزاجل الذي يحمل الرسائل، فإن للزجال هذا الدور المنوط به ككل أديب ومثقف، أي له رسالة أو رسائل، ومحمد لشياخ ف "الحلمة كورال " أداه بكل المقاييس وعلى جميع المستويات سواء منها الفكري أو الفني الأدبي في تناغم وانسجام تام، بين الشكل والمضمون، فقد أثار من خلال النص مجوعة من الآراء والقضايا التي لها علاقة بهذا النوع الأدبي على مستوى التنظير نقف على بعضها:
- يقول: الزجال نبي الكلام، الزجال لابس دربال الكلام، يشير إلى الخصائص والصفات التي يجب أن تميز هذا الشاعر، وهي امتلاكه ناصية الإبداع، أي الكلام وصنعته ، وصنعة الكلام، معرفة تامة باللغة وخصائصها، ومعرفة بقواعدها الفنية في أداء المعاني وتوليدها .
- قال الحلمة باتول ولدت كلمة، والكلمة بتول الحروف، تدل الباتول على العذراء عموما، فكذاك القصيدة جديدة وإن كانت ذات أصول وتاريخ، نفهم من هذا أن على كل شاعر وكاتب أن يتميز ويتجدد بأسلوبه، الذي يصبح علامة فارقة بينه وبين غيره.
- المبدع لا يموت الزجال لا يموت ينبعث من رماده مثل الفنيق يخلده إبداعه. قال:
ومن تحت الرماد
غتسمعوا كبدة الزجال
كوني يا نار على حرفي " برد وسلام". [7]
وأيضا
الزجال إلى قتلتوه
راه جلدوا كناش للكلمات
راه عظامه قصايد موحيات(..)
غيقراو صبيانكم وصايته ف كتاب الأموات. [8]
ونطرح في هذا السياق، السؤال كيف يخلده شعره؟ يخلده شعره إذا توفرت له الشروط والصفات ، وأول صفة في الإبداع الذي يمكن أن يخلد صاحبه هي أن يعبر عما هو انساني، وقد سماه "القدرة على السمو اللي ما تيفرقش لا بين الألوان ولا بين الأشكال لا في الحياة ولا في الإنسان" [9]. يضاف إليه شرطا آخر وهوان يكون مدونا ومحينا. قال:
ها روحي
ها خبز معاشي
نقعوا فيه رشاتكم
شاركوني ملحة الكتابة . [10]
- الشعر والزجل ككل شعر إبداع خلاق وليس انعكاسا ميكانيك للواقع، يستشف هذا الرأي من تكرار "مرايا كذابة" ودلا لتها، ومنه قوله:"لما العالم ضاق بالحالم قرر يرجع للظلام، فين كان قادر يقرا كينونته بلا لغة بلا مرايا كذابة" [11]، والإبداع يستدعي المعرفة بالأدوات وامتلاكها، ويقتضي الموهبة التي يجب أن تنمى بالصنعة والقدرة على التصرف في اللغة.
- يشير الشاعر / الكاتب أيضا إلى علاقة القصيدة في فن الملحون والقصيدة الزجلية الحديثة على اعتبار أن الأصل واحد والجنس واحد. يقول:
فوسط الغمامة
سمعت خصومة
الرعد غضبان من خليلته السرابة
الماء بينهم حالف ما يشهد (..)
شكون قادر يسقي نخلة الكلام
هنا تفرق الكلام
هنا تكفا صدر النبي ف الحافة
هنا الحلمة نزلت تحفر طريقها ف فيافي
هنا وراء ظهر الشمس تخبا القدر
لابس سلهام الزهاد . [12]
- ونسجل مع الناقد الكاتب دور النقد الأدبي في إضاءة الموضوع، وأنه مايزال زهيدا بالمقارنة مع التدفق الإبداعي في هذا المجال، كما يتعزز هذا بالدعوة إلى غربلة التجارب وإعطائها حقها في التقويم والتقييم حيث ورد الغربال الذي يدل على هذا المفهوم في مواضع شتى منها قوله:
قالت الحياة:
وعلا ش ما يكون "إنسان"
"إنسان" تيتماهى مع الصفاء
قادر يقطع دروب الجراح
"انسان" تيعلم الشمس تكون غربالنا . [13]
أما على مستوى الأسلوب واللغة فقد انتقى الشاعر ألفاظا إيحائية يطغى عليها معجم صوفي يحيل إلى الصفاء والسمو مثل: الحلم، الرؤيا، النور، الماء، حيث ترتبط الرؤيا بالأنبياء صلوات الله عليهم، وخاصة رؤيا سيدنا يوسف عليه السلام التي كانت دليله إلى العزيز، كما فسر رؤى غيره ، أما عند المتصوفة فقد ارتبطت الرؤيا بالبشرى الإلاهية، وقد استعملها الكاتب / الشاعر بهذا المفهوم فجعلها تتعدى الأحلام والحوافز النفسية وتحقيق الرغبات المكبوتة – عند فرويد مثلا – إلى الرؤيا والمكاشفة وتحقيق اللذة والشهوة بالمعنى الصوفي فتصبح لها علاقة بالنور يقول الشاعر مستدعيا في هذا المعنى معنى قول جلال الدين الرومي:"النور اللي ف العين ما هو إلا آثار من نور القلب .أما النور اللي ف القلب فهو النور الحقيقي". [14]
إن بين الرؤية والرؤيا يتحدد عالم الشاعر الإبداعي الجمالي الحالم، والذي يبدأ بالشهوة والغواية . يقول:
شهوتي أنا ..ف حلمة... سميتها الحياة (..)
شهوتي يعصرني مزاجها ف دوايته
يخوتمني ضمغة ف وصايته
شهوتي ف حلمة
راغ زينها ف رقاد الضاية
لما غزات بلادها الخيول
يوم خرجت لمناجل ترضع الصابة
تنشر الدفى فصبيعات الحطابة. [15]
أما "الماء " فله ارتباط بالحياة والوجود كما في القرآن الكريم " وجعلنا من الماء كل شيء حي " الأنبياء الآية 30. كما يحيل أيضا الى القوة والطوفان، لكن الشاعر استعمله استعمالا مرتبطا بالشعر وخاصة الصوفي الذي يحمل فيه الماء رمزية شدة العشق والشوق، كما ورد في دراسة رمزية الماء في التراث الشعري العربي، يقول الكاتب:" يرتبط الماء بالشعر الصوفي عند الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي فيصبح دلالة على الحب الإلاهي وتعبيرا عميقا عن الشوق والعشق وعن كل ما هو روحاني وصوفي، فالماء تعبير عن الإغداق في ملكوت الله وأسرار كونه" [16]. يقول:
قال الحالم
فين الماء اللي ماتت غمامته ف عشق أمي
باش تولدني حالم
فين السماء اللي تدلى صدرها باش ترضعني
فين حقي فصوفيات الحضرة
فين دربال الدرويش نحطو تاج
نهار يغسلني نورك من جهلي
نهار يعاوني الصبر على صبري. [17]
بصور تركيبة تجريدية تارة مبنية على المجاز والانزياح تارة أخرى، وباستثمار تجارب الآخرين والتأمل في الحياة، والقدرة على توظيف الرصيد المعرفي والثقافي المتنوع الذي يدل على الزخم المعرفي المتراكم، وامتلاك الكفايات والمهارات الإبداعية حقق الشاعر الزجال الأستاذ محمد لشياخ التناسب الوجداني بين حالته الانفعالية وبين الأسلوب الفني، في إيقاع قوي مبني على التوازي، وعلى تساوي الجمل والمقاطع مثلا:
ياك حنا اللي سمناك حلمة
يا كوكب الذر ف ملكوت الكتبات
يا تاج الورد ف سميت الزهرات
ياسوار كسرى ف قصور الطاووس
المفرخ بيضه فعشاش الكلمات. [18]
حيث تجد التساوي في التركيب "يا كوكب الذر، ياتاج الورد"، "ف ملكوت الكتبات ، فسميت الزهرات". يُكسب النص بنية إيقاعية داخلية قوية، حافظ عليها خصيصة مكتسبة أقرها الكاتب في وصف الحلمة ب "كرال"، وهذا تصنيف نوعي فرعي يعني الجوقة أو المجموعة، وهو مصطلح يستعمل في فنون أخرى، تصنيف كمي غير مؤثر، لأن الشعر يكتب في شكل قصائد مفردة أو قصائد متعددة موضوعها الحياة و" الحياة كورال من الوجعات" يتقاسمها الانسان. ومع ذلك تبقى للإبداع حرية مقيدة في الاشتغال على التخوم بين الأنواع – كما هو شأن التجريبيين -، لكن هناك ملامح كبرى، تراكمت عبر العصور، وشكلت تقاليد أدبية لا يمكن تجاهلها. إلا أن الحدود اليوم بين الأنواع الأدبية لم تعد واضحة. " فالشعر بهذا التصور مساحة يصطخب فيها الجدل بين عناصر الثبات وعناصر الحركة، ساحة تفنى فيها عناصر، وتتخلق أخرى، وتتحدد فاعلية العناصر المتولدة، بمقدار ما تقتضي من رؤى، ومقدار ما تحتوي من إمكانات الكشف وطاقات التغيير." [19]
هكذا عبر شاعرنا المبدع بأسلوبه المتميز ولغته الراقية عن الثابت والمتحول في القصيدة الزجلية عن وعي بالوظائف واستحضار تام للتراكم الثقافي والتجريبي بمؤثراته النفسية والموضوعية، فجاءت تجربته غنية تحتاج إلى أكثر من قراءة، وإلى النظر فيها بأكثر من زاوية.
***
د. فطنة بن ضالي
..................
الهوامش:
[1] سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية، دارالكتاب اللبناني، ط1985،1، ص205.
[2] الحلمة كورال، ص 31
[3] الحلمة كورال، ص 7
[4] الحلمة كورال، ص 81
[5] الحلمة كورال، ص 7
[6] الحلمة كورال، ص 11
[7] الحلمة كورال، ص 62
[8] الحلمة كورال، ص 64
[9] الحلمة كورال، ص 71
[10] الحلمة كورال، ص 40
[11] الحلمة كورال، ص 79
[12] الحلمة كورال، ص 73-74
[13] الحلمة كورال، ص 75
[14] الحلمة كورال، ص 11
[15] الحلمة كورال، ص 15
[16] خليل المعلمي، رمزية الماء في التراث الشعري العربي، جريدة الثورة 18 يناير 2016.
[17] الحلمة كورال، ص 76
[18] الحلمة كورال، ص 32
[19] اعتدال عثمان، قراءة في أوراق الغرفة للشاعر أمل دنقل ، فصول ، م4، ع1أكتوبر-ديسمبر 1983،ص121.