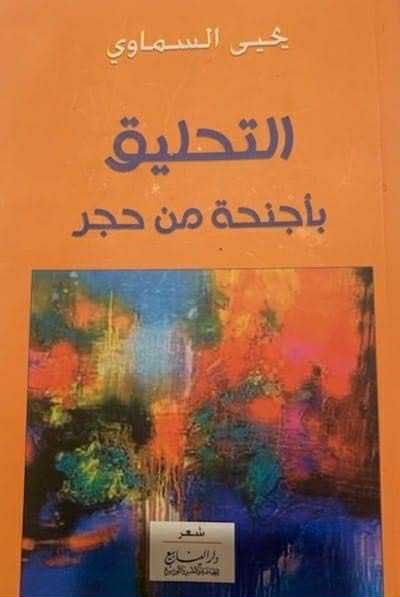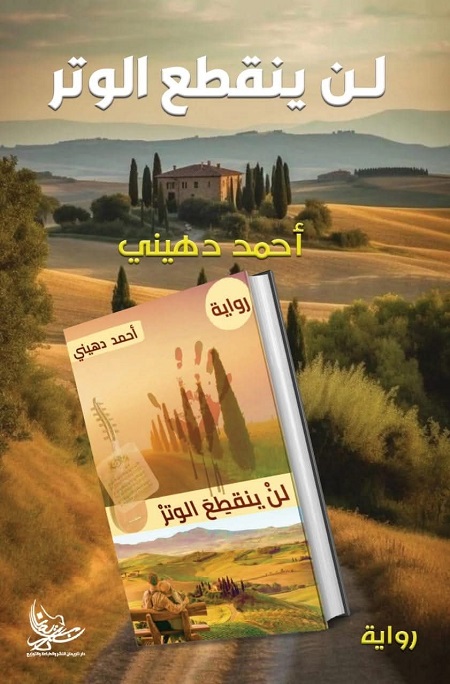قالوا: تدلّل! قلتُ: لا!.. الشعر كفعل مقاومة أخلاقية
الخلفية التاريخية للقصيدة*: وُلدت قصيدة «قالوا: تدلّل!» في عام 1978، في فترة سياسية عراقية مثقلة بالقمع وتقييد الحريات، حيث كانت المعارضة تتعرض لهجمات قمعية شديدة، وكان أعضاءها يُغَرى بعضهم للتنازل عن مبادئهم تحت ضغوط الأجهزة الأمنية. كتب الشاعر النص الأصلي مكوّنًا من ثمانية أبيات، (الأبيات: 1، 2، 3، 7، 8، 12، 20، 25)، ونُشرت حينها في مجلة الورود اللبنانية التي كان يصدرها الأديب المرحوم بديع شبلي. لاحقًا، ومع تغيّر الظروف السياسية في العراق وسيطرة قوى جديدة، أعاد الشاعر النظر في النص، وأضاف إليه أبياتًا جديدة، لتصبح القصيدة شهادة مزدوجة: على زمن القهر السابق، وعلى القدرة الشعرية على الصمود والمواجهة في مواجهة التغيّرات السياسية والاجتماعية. تعكس هذه التعديلات والاضافات مراحل مختلفة من الصراع مع السلطة، وتمكن القارئ من متابعة التحولات الفكرية والموقف الأخلاقي للذات الشعرية قبل وبعد التغير في العراق.
المقدمة
تهدف هذه الدراسة إلى قراءة قصيدة «قالوا: تدلّل!» للشاعر عبد الستار نورعلي من منظور مادي–بنيوي وسيميائي، مع إيلاء عناية خاصة للسياق التاريخي الذي ولدت فيه القصيدة وتحوّلاتها اللاحقة. تنطلق الدراسة من فرضية أنّ النص الشعري يتجاوز كونه تجميعًا جماليًا للمفردات، ليكون بنية صوتية ودلالية تشتغل كأداة موقف. لذلك نركّز على آليات تشكّل الهوية الشعرية في القصيدة — الإيقاع، التكرار، التوازي، التقَطيع الصوتي — وإلى جانبها على آليات الاستعارة والانزياح الدلالي التي تعيد تأويل المفردات وتُنشيء رموزًا مقاومة.
تأخذ هذه القراءة بعين الاعتبار البُعد الزمني المزدوج للنص: جذور القصيدة في أجواء القمع السياسي عام 1978 حين كُتبت النسخة الأولى، وما نَتج عن إعادة النظر والإضافة في المنفى لاحقًا، حيث اتسع مرجع «قالوا» ليشمل أقنعةً سلطوية جديدة (دينية وطبقية واجتماعية). في ضوء هذا التطور، تتحول عبارة النداء «قالوا: تدلّل!» من توجيه ترغيبي محض إلى علامةٍ لآليات ترويض متحولة، فيما تصبح «قلتُ: لا!» بفعل الصوت والوقفة يؤسّس لهويةٍ أخلاقية مقاومة تمتد عبر الأزمنة.
تنقسم الدراسة إلى محاور متكاملة تتقاطع منهجيًا: تفسير العنوان ونص القصيدة، قراءة الأبيات في ضوء ثنائية ما قبل التغيير وما بعده، تفكيك الاستعارات والانزياحات كآليات لإنتاج الذات الشعرية، تحليل البنية المادية للصوت والنبر كأدوات لتوليد التوتر الاحتجاجي، وفحص العلاقات الجدلية بين الذات، والآخر، والسلطة، والمجتمع. كما يتناول القسم السيميائي شبة العلامات الرمزية ويبيّن كيف تُشتغل هذه العلامات داخل البنية البنيوية للنص لتؤسس معنىً مقاومًا.
في نهاية المطاف، تسعى الدراسة إلى إظهار أن القصيدة ليست مجرد رد فعل تاريخي موثّق فحسب، بل نصٌّ متحوّل يُعيد صياغة مواقفه الأخلاقية والفنية عبر الزمن: من رفضٍ ظرفي إلى «لا» تأسيسية، ومن صورة شعريّة إلى فعلٍ أخلاقيٍ يبلور هويةً لا تُهرَب ولا تُشترى.
القصيدة
(قالوا: تدلّلَ!)
منْ قبلُ:
قالوا: تدلّلَ!
قلتُ: لا!
ما بالدلالِ حَيِيْتُ
المرءُ إنْ حميَ الهوى
في القارعـاتِ يفـوْتُ
لا يُصلحُ الوجهَ القناعُ
فـمُرتديـهِ مقيـْتُ
منْ رامَ وصلَ حبيبهِ
لا ينـثنـي، فيفـوْتُ
العشقُ خمرٌ صِرفُهُ
للعاشـقينَ القُـوْتُ
والتَّوقُ نشوةُ جَمرهِ
للهـائميـنِ مُـميـْتُ
صُبّوا الكؤوسَ فإنّني
في الشِّـاربينَ لَحوتُ
مَنْ يملأُ القدحَ الشَّرابَ
وعاقروهُ سكـوتُ!
لا أرتـضـي كأسـاً -
فإنّ العاتياتِ حُسِيْتُ
لمْ يروِ مِنْ ظمأي محيطٌ
هـادرٌ وصَمـوتُ
أو منْ تمنطقَ بالحروفِ
وحظُهُـنَ سُـكوتُ
فأنا البحارُ أنا السَّفائنُ
في الخضمِّ أفوتُ 3
ما كنتُ يوماً مِنْ صدىً
أو تـابـعًا فـدَنِـيْـتُ
أو خافضاً عيني لعِلجٍ
بالفُتـاتِ رُمـيْـتُ
فنساءُ أهلي الشَّامخاتُ
حليبَـهنَ سُـقيْتُ
ورجالُ بيتي الملحماتُ
تـوثـُّبٌ وثُـبـوتُ
إنّي الَّذي ذاقَ الهوا
للعـاليـاتِ قَـنُـوتُ
سيزيفُ، أحملُ صخرةً
ذراتُـها الكبـريـتُ
هذا أنا:
مِنْ كلِّ أدرانِ السِّفوحِ نَقِيْتُ
لمْ أخشَ منْ لبسَ الوقارَ
رداؤهُ الكَـهنـوتُ
أو منْ تبخترَ بالحريرِ
حـذاؤهُ الياقـوتُ
الكلُّ أصلٌ واحدٌ
مِنْ طينةٍ منحوتُ
وإلى ترابٍ عودةٌ
والباقياتُ الصِّيتُ
فلِمَ التَّكبُّـرُ والصُّدودُ!
ختامنُا مـوقوتُ
لا فرقَ بينَ العرشِ أو
مَنْ في الكفافِ يموت
تفسير العنوان والأبيات
تفسير العنوان:
يعمل العنوان «قالوا: تدلّل!» كبوابةٍ خطابية تكشف عن آلية السلطة في استمالة الأفراد: فالفعل «تدلّل» في ظاهره دلالة على التودّد أو المداعبة، لكنه في النص يُستعاد كقناع يموّه عملية ترويضٍ أوسع. صيغة «قالوا» توري بإبهامٍ الفاعل وتعمّم فعل الإغراء على «أخرى» اجتماعية أو مؤسساتية، بينما يحوّل ردُّ الشاعر «قلتُ: لا!» هذا الإغراء إلى لحظة تأسيسٍ أخلاقيّة. ومع إدخال الأبيات اللاحقة في المنفى، يتّسع مرجعُ «قالوا» ليشمل أقنعةً سلطويةً جديدة " دينيةً وطبقيةً " فتُصبح دعوةُ «التدلّل» علامةً مزدوجةً: أداة قمعٍ مموّهة عبر الأزمنة، وُالرفضُ المؤسَّسُ معيارَ الصدق والكرامة عند الشاعر.
والأبيات
منْ قبلُ: "قالوا: تدلّل! قلتُ: لا!" — لحظة التأسيس الشعري للموقف الرافض
تعمل عبارة «من قبلُ» بوظيفتين متداخلتين: وظيفة زمنية تُحيل إلى مرحلة سابقة (ظرف القمع عام 1978) ووظيفة وجودية تُؤسِّس للموقف؛ إذ لا تعني فقط «في الماضي» بل «من الأصل» أي أنّ رفض الذات لم يكن ردَّ فعل ظرفيًّا بل هو قاعدة وجودية متجذّرة. تحويل «قالوا: تدلّل!» إلى خطابٍ سلطويٍّ مموَّهٍ بالإغراء يبرز كيف تُعرض على الشاعر (أو على مجموعاتٍ من المعارضين) إمكانية التنازل مقابل امتيازات، فيردّ الشاعر بـ«لا» الحاسمة التي لا تؤشر إلى مجرد رفض تكتيكي، بل إلى تثبيت هويةٍ أخلاقيةٍ لا تقبل الانقياد. من ثمّ، يصبح هذا البيت محورًا تأسيسيًا لقراءة القصيدة ككلّ: هو نقطة الانطلاق التي تُفسّر الإضافات اللاحقة في المنفى — حيث تتبدّل أقنعة السلطة (من القمع المباشر إلى ستر الدين والطبقية) — فتؤكد استمرارية وضعف كل محاولات الترويض أمام «لا» الأصيلة. (يمكن توثيق «قالوا» في هامش: هل تعني الأجهزة الأمنية، أم دوائر اجتماعية متواطئة، أم كلاهما؟ — انظر الأبيات المضافة التي تكشف أقنعة الكهنوت والترف.)
«ما بالدلالِ حييتُ» تُقرأ على مستويين: لغويًّا وصيغيًّا، وبينهما دلالة تأويلية مركزية. نحويًا، «ما» نافية تُعطي الجملة صبغة إنكارية تامة، و«بـلا» ظرفية تدلّ على الوسيلة أو القاعدة (أي: «بواسطة/بواسطته»)، فالمعنى الحرفيّ هو: «لم أعش بواسطة الدلال». لكن الدلالة السياقية عميقة؛ فـ«الدلال» هنا لا تُقصد بمعناه الحسي أو الغزلي فحسب، بل تُستخدم مجازًا على التملّق والانحراف عن المبدأ، والانقياد لغرائز الملاءمة أو امتلاك امتيازات على حساب الموقف.
بالتالي، يُقرّ الشاعر أن حياته ليست مبنية على «الدلال» — ليست حياةً مباحةً بالرضا أو بالمكاسب المشروطة — بل على الصدق والتمسّك بالمبدأ. هذا البيان يلازم فعل الرفض («قلتُ: لا!») ويحوّله من صيغة رفض موقفيّ عابر إلى الوجودُ لا يتحقّق في القصيدة عبر التملّق أو التسوية، بل عبر الثبات على المبدأ والمواجهة.من جهة بلاغية، تمنح صيغة النفي «ما… حييتُ» الجملة وقعًا أقوى من «لم أُدلّل» أو «لا أدلّل»؛ فهي تعلن محرَّمًا وجوديًّا، لا مجرد سلوك تكتيكي، فتؤسّس لخطٍّ أخلاقيٍ يأبى الاستسلام للترويض، ويُفسّر الإضافات اللاحقة في النصّ باعتبارها تعاملاً مع أقنعةٍ جديدةٍ للسلطة لا تغيّر جوهر الموقف الرافض.
من العشق إلى التأمل الوجودي – إعادة صياغة أكاديمية:
تمثّل هذه المقاطع من القصيدة انتقالًا دلاليًا من الرفض إلى العشق، ومن الموقف المباشر إلى التأمل الوجودي. فالعشق هنا لا يُقدَّم كعاطفة فردية عابرة، بل كقيمة كونية وأخلاقية تتخذ وظيفة تأسيسية في بناء الذات الشعرية.
من رامَ وصلَ حبيبهِ / لا ينثني، فيفوتُ
الحبيب في هذا البيت ليس صورةً غزلية تقليدية، بل رمزٌ للمبدأ الأسمى: الحرية، الصدق، أو الحق. ومن أراد بلوغ هذا المبدأ لا يجوز أن يتراجع، لأن الانثناء يعني ضياع الهدف. البيت إذن يضع الالتزام في مواجهة التخاذل، ويؤكد أن الهوية لا تُبنى إلا على الثبات.
العشقُ خمرٌ صِرفُهُ / للعاشقينَ القوتُ
يتحوّل العشق إلى خمر صافٍ، غير ممزوج، يُشرب كما تُشرب الحقيقة في صفائها، فيغدو غذاءً روحيًا للمؤمنين بالقيم العليا. هنا يرتقي الحب من كونه عاطفة وجدانية إلى أن يصبح طقسًا وجوديًا، بل جوهرًا للحياة الأخلاقية.
والتوقُ نشوةُ جمرهِ / للهائمينَ مميتُ
التوق ليس مجرّد حنين، بل هو شوق إلى المبدأ، إلى الوطن، إلى الحرية. لكنه توق مؤلم، إذ يشبه جمرًا يحرق الهائمين في دروب الالتزام. إنه موت رمزي، أو احتراق داخلي، يعبّر عن ثمن الإخلاص للقيم.
صُبّوا الكؤوسَ فإنني / في الشاربينَ لحوتُ
هنا يعلن الشاعر انخراطه الكامل في التجربة: لا يقف على مسافة منها، بل يشرب الكأس بملء إرادته. الشرب يتحوّل إلى فعل وجودي يرمز إلى التضحية والمشاركة في المعاناة المشتركة.
من يملأ القدحَ الشرابَ / وعاقروهُ سكوتُ
المفارقة في هذا البيت تكمن في أن من يملأ الكأس يقدّم التجربة، بينما من يشربها يلتزم الصمت. هذا السكوت ليس تعبيرًا عن التأمل، بل عن التواطؤ أو العجز عن الشهادة. وهنا يضع الشاعر معيارًا أخلاقيًا: الموقف لا يكتمل بالصمت، بل بالكلمة الملتزمة.
لا أرتضي كأسًا / فإنّ العاتياتِ حُسيتُ
يرفض الشاعر الكأس الممنوحة له، لأنه ذاق كأسًا أشدّ، هي المحن العاتية التي اختبرها في واقعه. إنه إعلان عن صلابة ذات مجروحة بالتجربة، لكنها أكثر نضجًا وصلادة في مواجهة السهل والزائف.
لم يروِ من ظمأي محيطٌ / هادرٌ وصموتُ
حتى المحيط بما فيه من هدير واتساع لم يستطع أن يُروي عطش الشاعر. هنا يصبح الظمأ رمزًا للبحث عن الحقيقة والمعنى، والبيت يُجسّد خيبة وجودية: لا شيء يملأ الروح إلا الموقف النبيل الصادق.
أو من تمنطقَ بالحروفِ / وحظهنّ سكوتُ
يتجه النقد نحو المثقف أو الأديب الذي يتزيّن بالبلاغة ويكتفي بالشكل، بينما يظلّ المعنى صامتًا. البيت فضحٌ للزيف الثقافي وللخطاب الذي لا يشهد للحقيقة.
خلاصة نقدية
في هذه الأبيات، يرسّخ الشاعر مفهوم العشق بوصفه قيمة وجودية وأخلاقية، ويواصل مشروعه في فضح الزيف، سواء كان زيف التجربة (الكأس المزيّفة)، أو زيف التعبير (الكلمة الفارغة). هكذا تتكوّن الهوية الشعرية كذات ملتزمة، لا تتزيّن بالمواقف، بل تعيشها بصدق، ولا تكتفي بالصمت، بل تشهد بالكلمة والفعل.
الهوية الشعرية بين الفعل والوراثة
"فأنا البِحارُ، أنا السفائنُ / في الخضمِّ أفوتُ"
في هذا التوصيف الاستعاري يتماهى الشاعر مع رموز الحركة والعبور؛ فـ«البحّار» و«السفائن» لا يرمزان إلى ترفٍ أو ترددٍ بل إلى قدرةٍ على الانطلاقة والمجازفة. «الخضمّ» هنا رمزٌ للعمق والمخاطر، و«أفوتُ» فعل دخولٍ واشتباكٍ مع المجهول لا اجتيازٍ سطحيّ. البيت يؤسّس لذاتٍ فاعلةٍ تدخل حقل الحدث وتخطّ حواجزه بدلاً من أن تظلّ مراقبًا أو انعكاسًا للصوت الآخر.
"ما كنتُ يوماً من صدىً / أو تابعًا، فدنيتُ"
يُعلن الشاعر رفضه القاطع لأي وضعية تابعة أو انعكاسية. مصطلح «الصدى» يعبر عن التكرار الخالي من المبادرة، و«التابع» عن فقدان الاستقلالية؛ أما «فدنيتُ» فتدلّ على القرب الخاضع الذي يرفضه الشاعر. بالتالي يؤسس البيت لهوية تُعرّف نفسها عبر الأصالة والذاتية، لا عبر التقليد أو التبعية.
"أو خافضًا عيني لعلجٍ / بالفتاتِ رُميتُ"
يحوّل الشاعر موقف الاستعلاء والاحتقار إلى فعلٍ مرفوض أخلاقيًا؛ «العلج» هنا رمزٌ للغريب المتغطرس أو القاهر، و«الفتات» رمزٌ للذلّ الذي يطلبه الضعيف. رفض «خفض العين» يعني رفض الانحناء أمام القوة لقاء مزايا ضئيلة، وتعبّر الصورة عن موقفٍ قويمٍ يفضّل الكرامة على التنازل الطفيف
"فنساءُ أهلي الشامخاتُ / حليبهنّ سُقيتُ"
"ورجالُ بيتي الملحماتُ / توثّبٌ وثبوتُ"
يرسّخ الشاعر هويته بوصفها مُغروسة في إرثٍ اجتماعيٍ وأخلاقي. النساء هنا حاملاتُ الشموخ والتنشئة (الحليب رمزية للقيم والتربية)، والرجال رموزُ البطولة والفعل (الملحمة، التوثّب والثبوت). الهوية إذًا ليست فقط فعلًا فرديًّا وإنما وراثةُ قيمٍ تُغذّي الذات وتمنحها ثباتًا وقدرةً على المواجهة.
"إنّي الذي ذاقَ الهوا / للعالياتِ قَـنُوتُ"
يحوّل الشاعر مصطلحات العشق والتديّن إلى التزامٍ بالقيم العليا. «الهوا» هنا هو الشغف بالمبادئ، و«العاليات» دلالة على المثل السامية، أما «قنوت» فتعني خضوعًا طوعيًا ذو معنى روحاني/أخلاقي وليس خنوعًا مذلًّا. البيت يعبّر عن ولاءٍ أخلاقيٍ يتحمّل ثمنه باسم الصفاء والالتزام.
"سيزيفُ، أحملُ صخرةً / ذراتُها الكبريتُ"
باستحضار سيزيف يعيد الشاعر صياغة الأسطورة: الصخرة ليست مجرد عبء عبثي بل مادةُ نارٍ (كبريت) تدلّ على ألمٍ حارق وحرارةٍ اختيارية. هذا التأويل يُحوّل حمل العناء من عقاب عبثي إلى خيارٍ وجوديّ مشتعِل، حيث يصبح الصمود والمعاناة علامةً على الالتزام والقيمة.
«هذا أنا: مِنْ كلِّ أدرانِ السِّفوحِ نَقِيْتُ»
الإعلان النهائي عن الذات يأتي في صيغة تطهّرٍ ورفضٍ: الشاعر يُعلن نفيه للشوائب والانحدار، ويؤكد أن هويته بُنيت عبر التطهير من «أدران السفوح» - أي عن طريق الامتناع عن الانزلاق إلى الانحطاط الأخلاقي والاجتماعي.
خلاصة نقدية مُوجزة
تتشكّل في هذه الأبيات هوية شعرية مركّبة من فعل وراثي: فعل فردي فاعل يواكبه إرثٌ قيمِيّ يغذّيه الأصل والأسرة والمبادئ. الهوية ليست هنا مجرد موقع اعتزاز أو تزيين رمزي، بل مزيج من المغامرة (البِحار/السفائن)، والرفض الأخلاقي (ضد التبعية والذلّ)، والالتزام القيمي (الحليب/الملحمة/القنوت)، وحمل المعاناة المختارة (صخرة الكبريت). القصيدة بهذا المعنى تعرض نموذجًا للذات التي تُبنى عبر التفلت من الانعكاس والتبعية، والانغماس في تجربةٍ أخلاقيةٍ مؤلمةٍ لكنها مفضّلة على ذلّ السقوط؛ هو خطاب يربط بين الفعل الفردي والوراثة القيمية ليقدّم هويةً شعريةً صلبة ومتجذرة.
الذات النقية في مواجهة الزيف
"من كل أدران السفوح نقيتُ"
يعلن الشاعر هنا عملية تطهّرٍ أخلاقيٍّ واعية؛ فـ«السفوح» ترمز إلى بؤر الانحطاط والتواطؤ والتلوث الرمزي، بينما «النقاء» لا يفهم على أنه طهارة جسدية بل كخيار وجوديّ. إن الذات في هذا البيت تُعرّف نفسها عبر فعل الرفض والتطهير، فتصبح نقاؤها نتاج موقف لا ميراثًا بيولوجيًا، أي أنها «ذات مختارة» بوعيها ومقاومتها للانحدار.
لم أخشَ من لبس الوقار / رداؤه الكهنوت
يتجسّد الآخر هنا في هيئة الكهنوت الزائف: نوع من السلطة الدينية التي تختبئ خلف الهيبة والوقار لتبرير القمع. لا يستهدف النقد العقيدة بقدر ما يستهدف استغلال الهيبة الدينية لأغراض قهرية. يرفض الشاعر هذا الوقار المتصنع، ويعيد تعريفه على أنه يقينٌ يُعاش لا زينة تُرتدى، فتصير الذات قادرة على مواجهة الهيمنة الرمزية بصدقٍ واستقلالية:
أو من تبختر بالحرير / حذاؤه الياقوتُ
يمتد النقد ليشمل الزيف الطبقي؛ فالتبختر بالحرير والياقوت رمز للافتخار الفارغ واستعلاء الطبقات المترفة. يراهن الشاعر على أن القيم والكرامة لا تُقاس بالمظاهر، فتتشكل الذات بوصفها مقاومة مزدوجة: ضد التسلط المقدّس وضد التباهي الطبقي، ضد القناع الديني وضد الزينة الاجتماعية.
خلاصة نقدية
تتحدد الذات الشعرية في هذه المقاطع كذاتٍ نقية، صلبة، ومتمرّدة على كل أشكال الزيف — دينيًا أو طبقيًا —، إذ تُعرّف نفسها لا بما ترتديه من وقار أو ياقوت، بل بما ترفضه من قبائح. يقدّم الشاعر موقفًا أخلاقيًا صارمًا؛ تطهّرًا داخليًا ورفضًا للمظاهر، مُعيدًا بناء الكرامة كممارسة موقفية لا كمظهرٍ خارجي
الموت بوصفه مساواة، والصيت بوصفه أثرًا
تنتقل هذه المقاطع إلى مستوى تأملي أخلاقي وفلسفي يجعل من الموت مفهوماً معادلاً ومبدِّداً للفوارق الاجتماعية، ويمنح للصيت دلالةً مبدئية كمعيارٍ لقياس قيمة الإنسان.
"الكلُّ أصلٌ واحدٌ / من طينةٍ منحوتُ"
يعلن الشاعر هنا عن وحدة الأصل البشري، مفنِّدًا التمايزات المصطنعة التي تبرر التمايز الطبقي أو الديني. كلمة «منحوت» توحي بأن الاختلافات إنما هي صورٌ سطحية قابلة للنحت والتشكيل، وليست فوارق جوهرية. بالتالي يتحوّل الموقف إلى تأسيس فلسفي للمساواة: الإنسان قبل كل شيء مادةٌ واحدة تنتهي إلى نفس المصير.
"وإلى ترابٍ عودةٌ / والباقياتُ الصِّيتُ"
يرسم البيت تصوّراً وجودياً يربط بين النهاية المادية والخلود الأخلاقي. العودة إلى التراب تشي بعجز الامتيازات أمام الموت، بينما «الباقياتُ الصيتُ» تشير إلى الأثر الأخلاقي أو السمعة النزيهة التي تبقى بعد زوال الجسد. بهذا يحوّل الشاعر مفهوم الخلود من رغبة في بقاء جسدي إلى رغبة في بقاء أثرٍ معنوي يترسّخ في الذاكرة الجمعية.
"فلِمَ التكبرُ والصُّدودُ! / ختامُنا موقوتُ"
يتخذ الشاعر هنا موقفًا نقديًا من الغرور الإنساني: «موقوت» تذكير بأن لكل بداية نهاية محددة، وأن التعالي والتكبر لا يحرمان المصير المشترك. السؤال البلاغي يفضح عبثية التفاخر ويعيد التذكير بجدوى التواضع والصدق كقيم أخلاقية مبرِّرة للكرامة الحقيقية.
لا فرقَ بينَ العرشِ أو / من في الكفافِ يموتُ
يصل النص إلى ذروة تأمّله الفلسفي في هذا التباين؛ الموت بوصفه معادلاً كونيًا يلغى الفوارق المادية ويضع الجميع على مستوًى واحد. بهذه الصورة تصبح القصيدة بيانًا إنسانيًا شاملًا يتخطى الشكليات الاجتماعية ليؤكد على وحدة المصير والكرامة الإنسانية.
خلاصة نقدية
في هذه الأبيات يتحوّل الموت من حدث بيولوجي إلى أداة نقدية وفلسفية تفضي إلى المساواة وتفضح زيف التراتب الاجتماعي. أما الخلود فليس هنا في بقاء الجسد أو السلطان، بل في «الصيت» — أثرٌ أخلاقي ونزاهةُ فعلٍ تبقى شاهدةً على الإنسان. بذلك تختتم القصيدة بطوق تأمّل يُعيد ترتيب القيم: التواضع فضيلة، والصدق خلاص، والأثر الأخلاقي معيار الخلود..
الانزياح الدلالي والاستعارات في قصيدة «قالوا: تدلّل!»
تُعدّ الاستعارة والانزياح الدلالي من الأدوات البنائية المحورية في قصيدة «قالوا: تدلّل!»، حيث تُستخدمان ليس فقط كوسائل بلاغية لتجميل النص، بل كأدوات تأسيسية لخلق هوية شعرية مقاومة. في ظل التغييرات التي حدثت في القصيدة بعد أن أُضيفت الأبيات الجديدة في مرحلة المنفى، أصبحت الاستعارة والانزياح محملتين بأبعاد إضافية، تتجاوز الخطاب الأيديولوجي البعثي لتشمل الأسوار الدينية والطائفية التي نشأت بعد التغيير في العراق عام 2003.
1- الاستعارة والأنزياح الدلالي قبل التغيير
في النسخة الأصلية للقصيدة، التي كُتبت عام 1978 في العراق، كان الاستعمال الرئيسي للانزياح في النص محصورًا في محاربة القمع السلطوي. على سبيل المثال، استعارة «الخمر» التي كانت في الأصل رمزًا للمتعة، تمّت إعادة توظيفها لتصبح غذاء روحيًا» بدلًا من كماليات الحياة، ما يبرز المعاناة والالتزام بمبادئ الحرية.
أما استعارة «الصخرة» فقد كانت تمثل عبئًا ثقيلًا، لكنها بعد الانزياح الدلالي في القصيدة، صارت تشير إلى الصبر والمثابرة في مواجهة الاستبداد.
2- الاستعارة بعد التغيير
عند إضافة الأبيات في مرحلة المنفى بعد 2003، وتحديدًا بعد التغيير السياسي في العراق، بدأت الاستعارة تحمل معاني إضافية تتعلق بالهيمنة الدينية والتطرف. على سبيل المثال، استعارة «العمامة» قد تم إدخالها في الخطاب الديني بعد التغيير لتصبح رمزًا للهيمنة وقمع الحرية باسم الدين. وبتوظيف هذه الرمزية، قد تكون القصيدة قد عكست نضوج الشاعر في مواجهة سلطة جديدة تتخفى تحت غطاء ديني، مما جعل الكلمة «لا» في البداية تأخذ أبعادًا متعددة؛ فهي ليست مجرد رفض لسلطة بعثية، بل أيضًا رفض للهيمنة الطائفية.
3- الانزياح
الانزياح الدلالي في النص بعد التغير يعكس تحولًا في تركيز الشاعر من المقاومة السياسية إلى التصدي لسلطات اجتماعية ودينية جديدة. فعلى سبيل المثال الكأس، التي كانت تمثل بداية التمرد، أصبحت بعد التغيير تمثل السُكر الناتج عن التدين الزائف، أي الاستسلام للهيمنة الدينية التي حاولت في ذلك الوقت تزييف مفهوم الوطنية بالتماهي مع الدين.
الحرير والياقوت، كانا رمزين لا للترف والمال في الحقبة البعثية، أصبحا في الإضافات اللاحقة رمزًا للسلطة الطائفية التي تبخترت بغطاء ديني لتحقيق مكاسب اجتماعية وسياسية.
4- التحول في النبرة الاستعارية بعد التغييرات
في الإضافات اللاحقة، اكتسبت القصيدة أبعادًا وجدانية وجودية أعمق. الاستعارة ليست فقط أداة للتمرد ضد السلطة، بل أصبحت تجسد الرفض الدائم لمفاهيم التدجين والترويض الاجتماعي والديني.
على سبيل المثال، عبارة «من قبلُ» تُعبّر عن رفضٍ دائم الجذور، وبالتالي تكون «اللا» في بداية القصيدة ليست مجرد رد على الضغط السلطوي، بل تُصبح مبدأ وجوديًّا يتجاوز الزمان والمكان ويصبح رافضًا ليس فقط للسلطة السياسية، بل لكلّ قوى التغيير المزوّرة التي تتنكر في ثوب الدين أو الطبقة الاجتماعية.
5- الاستعارة بين الأبعاد الثقافية والتاريخية عند مقارنة الاستعارات والأنزياحات بين الفترة الأصلية (1978) والفترة اللاحقة بعد التعديل، يُلاحظ أن التغيير قد انعكس في التوظيف الرمزي للأشياء. فكل استعارة لم تعد مجرد توظيف لفظي، بل أصبحت أداة نقض لسلطة مستمرة عبر أطر مختلفة: دينية، طبقية، وأيديولوجية.
إن إضافة أبيات جديدة بعد التعديل في المنفى جعلت كل استعارة تحمل بُعدًا تاريخيًا يربط الماضي بالحاضر، ولا سيما مفهوم الرفض الجذري الذي يظل جزءًا أساسيًا من الموقف الشعري للذات الشاعرة.
6- خلاصة التحليل الاستعاري والانزياحي بعد التغيرات:
الاستعارة والانزياح الدلالي في قصيدة «قالوا: تدلّل!» تتحوّلان من أدوات بلاغية إلى أدوات مقاومة فعلية. وبعد التعديلات التي أُدخلت على النص، أصبحت القصيدة نموذجًا شعريًا مقاومًا يتجاوز الانكسار المحلي أو السياسي ليمتد إلى فضاء أكثر عمومية، يُحارب فيه الفساد والاستبداد، سواء كان دينيًا أو اجتماعيًا. القصيدة تُؤكّد على أن التغيير الحقيقي لا يتوقف عند الثورات الجغرافية أو السياسية، بل يمتد ليشمل الوعي الشعري الذي يُسائل، يرفض، ويُعيد تشكيل الهوية الثقافية والاجتماعية.
التوتر الشعري وتكثيف طاقة الرفض:
الإيقاع، التكرار، التوازي، والتقطيع الصوتي
الإيقاع وبنية التوتر:
الإيقاع في القصيدة لا يعمل كموسيقى زخرفية فحسب، بل بوصفه إيقاع مقاومة ينبثق من تكرار النفي والرفض. كلمة «لا» في المطلع تُحدث صدمة إيقاعية: جفافها وقَطعها يكسِران انسياب الخطاب ويؤسسان لجوّ شعري مشحون بالتوتر منذ البداية. ويأخذ هذا الإيقاع الداخلي زخمه بالتتابع الفعلي للأفعال (حَييتُ، رميتُ، أبيتُ...) التي تمنح الرفض ثبوتًا صوتيًّا ودلاليًّا.
التكرار كآلية توليد التوتر:
التكرار عنصر بنيوي محوري؛ تكرار «لا» و«ما» لا يكرّر المعنى فحسب، بل يضاعف وقع النفي حتى يصبح ترسيمة صوتية تضغط على المتلقي. كل عودة إلى النفي تُعيد إنتاج حالة توتّر إيقاعي وتصعيد انفعالي. ومع الإضافات التي أدخلها الشاعر في المنفى، صار التكرار أداة لبيان استمرارية الرفض عبر زمنين: رفض السلطة السياسية في الماضي، ورفض أشكال الهيمنة الدينية والاجتماعية لاحقًا.
التوازي الإيقاعي والدلالي:
تقوم القصيدة على بنى توازنية توازي بين صدر البيت وعجزه، فتتوزع القوة الإيقاعية بشكل يحوّل الجمود إلى رفض منظّم. تراكيب مثل «ما بالدلال حييتُ» و«ما بالخضوع ارتضيتُ» ليست تماثلاً لفظيًا فحسب، بل إيقاعٌ مضادّ للسلطة؛ إذ تكمل كل جملة الأخرى في رفضٍ متجدّد، وتؤسس لإيقاعٍ جدليّ يقيم «محاكمات شعرية» متكررة لمظاهر القمع المتبدلة.
التقطيع الصوتي وبناء الانكسار:
التقطيع الصوتي هنا يكشف عن وقفاتٍ ونبراتٍ مُتعمّدة: التوقف بعد «قلتُ: لا!» أو وقع الحروف الصلبة في «رميتُ» و«أبيتُ» يشحن الأبيات بطاقة جرسية حادة. هذه الصلابة الحرفية (التاء، الباء، الراء) تعمل كإيقاعات تصادمية تترجم الصراع الداخلي للذات الشاعرة مع محيطها. إذًا، التقطيع ليس ترفًا عروضياً بل تكسيرًا متعمَّدًا للانسياب يخاطب الاضطراب النفسي والوجودي للنص.
التوتر الشعري كحصيلة وظيفية:
تتلاقح في النص عناصر الإيقاع الحادّ، والتكرار الضاغط، والتوازي البنائي، والتقطيع الصوتي لصياغة توترٍ شعريٍّ متراكم. هذا التوتر لا يظل محصورًا بصيغة احتجاج لفظية مؤقتة، بل يصبح متنًا صوتيًا يعبّر عن موقفٍ «لا» يستحكم عبر الزمن: رفضٌ لا يقبل المساومة، وتمرّدٌ لا يهدأ حدّته. ومع التغيّرات التي طالت القصيدة لاحقًا، تزايدت حدة هذا التوتر لتجسد صراعًا أعرض يمتدّ من رفض سلطة بعثية إلى رفض كلّ هيئة قمعٍ تُلبَسُ رداءً جديدًا.
خلاصة موجزة: الإيقاع والتكرار والتوازي والتقطيع الصوتي في «قالوا: تدلّل!» لا تُشكّل سطحًا موسيقيًا فقط، بل هي أدوات جمالية فعّالة تُحوّل اللغة إلى جسد مقاوم. عبر هذه الأدوات يتحوّل النفي إلى قانون وجوديّ، وتصبح الكلمة صوتًا فعلًا يقاوم الاستبداد بأشكاله المتبدلة.
الشعر بوصفه بنية مقاومة:
قراءة بنيوية في «قالوا: تدلّل!»
1- البنية الزمنية: "من قبلُ" كبنية تحوّل:
تفتتح القصيدة باستذكار لحظة ماضية: «من قبلُ: قالوا: تدلّل!».
هذا الاستهلال يُؤسّس لبنية زمنية مزدوجة:
زمن القبل: زمن الإغراء والسلطة الناعمة التي تُحاول استيعاب الذات.
زمن الآن: زمن الوعي والرفض، حيث تتشكّل الذات من جديد.
وبذلك تتحول "من قبلُ" من مجرد مؤشر زمني إلى علامة بنيوية تعيد ترتيب النص، بوصفه سردية تحوّل وصيرورة، لا مجرد لحظة احتجاجية منفصلة.
2- البنية الحوارية: بين القول والرد:
تقوم القصيدة على حوار مختزل: قالوا: تدلّل! / قلتُ: لا
"قالوا": تمثل صوتًا جماعيًا سلطويًا، يفرض التبعية عبر الإغراء.
"قلتُ": تمثل صوتًا فرديًا مقاومًا، يعيد تعريف الذات كفاعل مستقل.
هذا التوازي الصوتي يُنتج توترًا بنيويًا بين القسر والحرية، بين الترويض والرفض.
3- البنية الإنكارية: النفي بوصفه بناءً:
يتكرّر النفي في النص بصيغ متعددة: «لا أرتضي»، «لا يُصلح»، «لا فرق»، «ما بالدلال حييتُ».
هذه التكرارات لا تؤسس موقفًا سلبيًا، بل تعيد تفكيك المعايير السائدة، لتؤسس معايير بديلة. النفي هنا أداة لإعادة بناء القيمة، أي أنه يشكل استراتيجية لغوية للمقاومة داخل النص.
4- البنية الرمزية: طقوس المعاناة وعبث سيزيف
تتأسس القصيدة على شبكة رمزية كثيفة:
الخمر، الكأس، الجمر: طقوس المعاناة المختارة، لا الاستسلام.
سيزيف والصخرة: إعادة تأويل العبث كفعل مقاومة
القناع والوجه: جدلية الزيف والحقيقة في المجتمع.
هذه الرموز تتفاعل لتبني معنى يتجاوز المباشر، حيث تتحول التجربة الفردية إلى رؤية وجودية وجماعية.
5- البنية الصوتية: الإيقاع بوصفه توترًا
الإيقاع لا يقوم على العروض الخليلي، بل على:
تكرار الأصوات الحادة (ق، ت، ح).
توزيع النبرات والتقطيع الصوتي.
الانقطاع الإيقاعي المتعمد
بهذا يصبح الإيقاع تجسيدًا لاضطراب الذات ومقاومتها، ويؤكد أن التوتر الإيقاعي جزء من دلالة النص، لا مجرد زخرفة موسيقية.
6- البنية الجدلية: الذات والآخر
يتشكل النص عبر جدلية ثنائية:
الذات: رافضة، صادقة، فاعلة.
الآخر: سلطة اجتماعية/طبقية/دينية تتحول لاحقًا إلى الآخر الإنساني العام.
هذه الجدلية تُعيد تعريف الهوية لا بوصفها انتماءً اجتماعيًا جامدًا، بل موقفًا أخلاقيًا ومقاومًا.
خلاصة بنيوية:
إن قصيدة «قالوا: تدلّل!» ليست مجرد نص احتجاجي، بل هي بنية شعرية مقاومة تتجلى في تعدد المستويات: الزمنية، الحوارية، الإنكارية، الرمزية، الصوتية، والجدلية. فالشعر هنا يُعيد ترتيب العلاقة بين الذات والسلطة، بين الكلمة والموقف، بين الشعر والحياة
الذات والآخر:
تشكّل الهوية في مواجهة السلطة والمجتمع (بعد التغيّرات)
تتشكل الذات الشعرية في قصيدة «قالوا: تدلّل!» كذاتٍ رافضةٍ ومستقلةٍ ومقاومةٍ لآليات الخضوع المتعدّدة؛ لكنها لم تعد مواجهةً موجهةً إلى شكلٍ واحدٍ من السلطة فحسب، بل صارت مواجهةً تمتدّ زمنياً ومؤسساتياً لتشمل أقنعة جديدة للهيمنة بعد التغيير السياسي في العراق. الذات هنا ليست انعتاقًا فرديًا منعزلاً، بل نتاج صراع جدليّ مستمرّ مع «الآخر» المتبدّل، الذي يتجلّى في صور عدة: سلطةٌ دينية متسترّة، طبقةٌ متنفّذة متبخترة، مجتمعٌ زائفٌ يروّج للصمت، وفي المقابل إنسانٌ آخر شريك في المصير. يمكن تفصيل هذا المحور كما يلي:
1- الآخر كسلطة دينية (الكهنوت) بعد التغيّر
في البيت: «لمْ أخشَ منْ لبسَ الوقارَ / رداءهُ الكَهنوتُ» يتبدّى الآخر في صورة رجل دينٍ لا تمثّل الدين بمعناه الروحي فحسب، بل تمثّل شبكةً من نفوذٍ وسلطاتٍ تستخدم «الوقار» كقناعٍ للهيمنة. بعد تغيّر المشهد السياسي وظهور قوىٍ ارتدت العمامة تشرعن سلطتها، يتسع مدلول «الكهنوت» ليشمل استغلال الدين كمبرّر للتمييز والسيطرة. النقد هنا موجه إلى قناة السلطة الدينية الزائفة لا إلى الإيمان ذاته؛ فالذات الشعرية ترفض أن يُستخدم المقدّس ستارًا للاضطهاد، وتعيد قراءة «الوقار» كصدقٍ أخلاقيٍ لا كمظهرٍ وظيفي للهيمنة.
2- الآخر كسلطة طبقية (الترف والزينة) في ظلّ التحوّلات
في قوله: «أو منْ تبخترَ بالحريرِ / حذاؤهُ الياقوتُ» يظهر الآخر في صورة الطبقة المتنفذة التي تستثمر الثراء والرموز المادية لفرض تفوّقٍ اجتماعي. بعد التغيير السياسي، لم يزل التبدّل الطبقي جذور التفاوت؛ بل ظهرت طبقات جديدة تتباهى بزينةٍ دينية أو وطنية، فتتكرر أساليب التبختر في مظاهرٍ متبدّلة. لذلك، تصبح مقاومة الشاعر نقدًا لكل أشكال التفاخر — سواء بالحرير أو بالغطاء الديني — وتأكيدًا أن الكرامة معيار موقف لا معيار زيّ.
3- الآخر كمجتمع زائف: (القناع، الدلال، الصمت) وتوسع مرجع «قالوا» المجتمع في القصيدة يُصوَّر كحقلٍ يطالب بالتزيّن والتواطؤ: «لا يُصلحُ الوجهَ القناعُ» و«قالوا: تدلّل! قلتُ: لا!». بعد الإضافات اللاحقة، يتسع مرجع «قالوا» ليشمل ليس فقط أجهزة القمع السياسي بل عناصر اجتماعية وثقافية ودينية تضغط على الفرد ليتماهى؛ فـ«التدلّل» يتحوّل إلى أسلوب ترويض ناعم يمارَس عبر المجاملة والسكوت. الذات الشعرية هنا لا تختزل استقلالها في رفضٍ ماضٍ فقط، بل في رفض متكررٍ يتماهى مع موقفٍ أخلاقيٍ ثابت أمام كل دعوات التواطؤ.
4- الآخر كمصير مشترك (الموت، التراب، الصيت) — تأكيد إنساني بعد التحوّلات:
رغم المواقف النقدية والرفض المتواصل، تحتضن الذات الآخر الإنساني كشريكٍ في المصير: «الكلُّ أصلٌ واحدٌ / مِنْ طينةٍ منحوتُ» و«لا فرق بين العرشِ أو / من في الكفافِ يموت». هذه اللحظة التأملية، التي تبرز بقوة بعد التغيّرات، تقوّي الفكرة بأنّ الفوارق الظاهرية (سلطة، طبقة، لباس) تنهار أمام المصير الواحد؛ وهنا تتحول المقاومة من رفضٍ انتقامي إلى موقف تواضعي يُعيد تأكيد الكرامة الإنسانية كأساس للهوية.
خاتمة نقدية:
الذات الشعرية في «قالوا: تدلّل!»، بعد التغيّرات وإضافة الأبيات في المنفى، تظلّ ذاتًا مقاومةً لا انعزالية، تتشكّل في قلب صراعٍ جدليّ مع «الآخر» بأدواره المتبدّلة: السياسي، الديني، الطبقي والاجتماعي. إن ما يميّز هذه الذات هو قدرتها على الجمع بين الرفض الأخلاقي وكشف زيف السلطة، وبين الاعتراف الإنساني بالمصير المشترك. بهذا، تُحوّل القصيدة فضاءها من مجرد بيانٍ شعري ضدّ قمعٍ معيّن إلى خطابٍ أوسع يُفحَص فيه كل قناعٍ للهيمنة، ويُعاد فيه تعريف الهوية كقيمة موقفية تتجاوز الزمان والمكان
التحليل السيميائي - تفكيك العلامات وبناء المعنى الرمزي بعد التغيّرات
تهدف هذه القراءة السيميائية إلى إعادة قراءة شبكة العلامات في قصيدة «قالوا: تدلّل!» في ضوء التعديلات التي أدخلها الشاعر لاحقًا (ما بعد 2003)، وربط هذه الدلالات الجديدة بما تكشّفناه في أقسام الدراسة الأخرى (الاستعارة والانزياح، البنية المادية، الذات والآخر). سنعالج العلامات الرئيسة ودلالاتها التحويلية، ثم نوضّح كيف تُوظَّف هذه العلامات ضمن عمليّة بناء معنى مقاوم ومركّب.
1- العنوان «قالوا: تدلّل!» — علامة المدخل/الاستدعاء
الدال الظاهر: نداء للمداعبة أو المجاملة.
المدلول القابع: خطاب ترغيبٍ سلطوي/اجتماعي يُخفي رغبة ترويضية.
ما بعد التغيير: «قالوا» يتوسّع ليشمل أجهزة قمعية قديمة وأقنعة جديدة (كهنوت، طبقات متنفِّذة، زعامات دينية).
وظيفته السيميائية: يعمل كمدخل حواري تأسيسي — يحوّل «الدلال» من فعلٍ اجتماعي بريء إلى رمزٍ لآلية ترويض تُواجهها «لا» التأسيسية. يربط المبادئ/ بين مقاطع ما قبل وما بعد التغيير.
2- القناع/الوجه — رمز الزيف والصدق
القناع (دال): الزينة، الوقار المزيف، المجاملة.
الوجه (مدلول): الهوية الحقيقية، الصدق الأخلاقي.
ما بعد التغيير: القناع لم يعد حكرًا على طبقةٍ واحدة؛ صار يتخذ أشكالًا دينية (الوقار الكهنوتي) واجتماعية (الحرير والياقوت)
علاقته بالأقسام الأخرى: يتقاطع مع قراءة الذات/الآخر: المواجهة ضد المجتمع الزائف تُقرأ صوتيًا (التكرار، الوقفات) وبنيويًا (التوازي بين «نساء أهلي» و«رجال بيتي»)؛ القناع موضوعٌ لكل من البنية المادية والسيمياء.
3- الخمر/الكأس/الجمر — رموز العشق، المعاناة، والالتزام
الخمر: انتقال من متعة إلى غذاء روحي (انزياح دلالي).
الكأس: وعاء التجربة الطقسية — شربٌ للصراحة/الموقف.
الجمر: الألم المميت/التطهير.
ما بعد التغيير: الرموز تُعاد وظيفيًا لتشمل مواجهة أشكال جديدة من التسيس الديني والاجتماعي: الشرب بمعناه الطقسي يصبح مقاومة للزيف الطقوسي.
ربط منهجي: تتلاقى هذه الرموز مع الاستعارة كآلية لتشكيل الذات («أنا البِحار…») ومع البنية الصوتية عندما تتكرر صور الطقس (صُبّوا الكؤوس) لتوليد طقس شعري مقاوم.
4- سيزيف/الصخرة/الكبريت — إعادة تأويل الأسطورة
سيزيف (دال تقليدي): عبثية العمل.
في النص: الصخرة ليست حجراً عبثيًا، بل كبريت — ألمٌ ناريٌ مختار.
دلالة جديدة بعد التغيير: المثابرة تتحول من مأساة عبثٍ إلى موقف فعال له وزن أخلاقي؛ حمل الصخرة هو خيار مقاوم في وجه أقنعة الهيمنة المتجددة.
وظيفة سيميائية: الأسطورة تعطي النص بُعدًا كونيًا يربط بين تجربة شخصية (منفى وشهادة) وتجربة جماعية (مصير الشعب).
5- العرش/الكفاف/التراب/الصيت — رموز المساواة الكونية والمصير
العرش والكفاف: تفريق طبقي/مراتب اجتماعية.
التراب: المصير المشترك، النهاية الموحّدة.
الصيت: الأثر الأخلاقي الباقي.
ما بعد التغيير: يسقط النص هياكل التفوق الجديدة (سواء جاءت بزي الدكتاتورية أم بزي الدين)، ويؤكد أن معيار الخلود هو الصيت الأخلاقي لا السلطة أو الثراء.
أين يلتقي ذلك مع باقي الدراسة؟ هنا يتقاطع السيميائي مع البنيوي: التوازي التركيبي والجملي (عرش/كفاف، طينة/تراب) يجعل الخاتمة أخلاقية متأصلة.
6- آليات سيميائية ناقلة: التكرار، الصوت، والتقابل
التكرار: يعيد إنتاج العلامة حتى تصبح علامة معيشية (مثلاً: تكرار «لا» يجعلها قانونًا سلوكيًا).
العناصر الصوتية (قوافل الحروف الصلبة، الوقفات): تمنح العلامات نبرة حاسمة؛ «لا» الصوتية تصير علامة فعلية.
التوازي والتقابل: ينظم دلالة العلامات عبر أزواج رمزية (قناع/وجه، عرش/كفاف) ما يسهّل قراءة الجدلية بين الذات والآخر عبر النص.
7- العلاقة بين السيمياء والأقسام الأخرى في الدراسة
مع الاستعارة والانزياح: السيمياء تبيّن كيف تُعيد الاستعارات إسكان المفردات في حقل دلالي جديد (خمر-غذاء روحي).
مع البنية المادية: العلامات لا تعمل منفصِلة عن الإيقاع؛ الصوت والوقفات يجعلان من العلامة حدثًا وقتيًّا مع الذات والآخر: السيمياء تكشف مَنْ هم «قالوا» عبر التوسع الدلالي بعد التغيير؛ تبيّن كيف تحوّل «الآخر» عبر الزمن من جهاز قمعٍ إلى كهنوت وطبقة وزيف اجتماعي.
مع التحليل البنيوي: العلامات تعمل كعُقدٍ في بنية نصّية تُنظّم المعنى عبر تكرارٍ وتوازيٍ وتقابل
خاتمة سيميائية موجزة:
بعد التغييرات، لا تقف العلامات في «قالوا: تدلّل!» على مدلولٍ ثابتٍ واحد، بل تتحوّل إلى شبكة دينامية تربط بين زمنين ومجالات هيمنة مختلفة. السيمياء هنا ليست مجرد قراءة رمزية، بل أداة لفهم كيف يُعيد الشاعر تأطير تجربته (الماضي/المنفى) ويحوّل العلامات إلى أدوات مقاومة أخلاقية. لذا، يُنصح بوضع هذا التحليل السيميائي
بعد قسمَي الاستعارة والانزياح والبنية المادية مباشرة في الدراسة: سيعمل كجسر يوضّح كيف تُشتغل الرموز داخل الإيقاعات البنيوية وتدعم تشكيل الذات في مواجهة الآخر.
خاتمة الدراسة
في قصيدة «قالوا: تدلّل!» يعيد عبد الستار نورعلي تشكيل الذات الشعرية لتصبح فعلًا أخلاقيًا، وموقفًا سياسيًا مستقلاً، لا مجرد انفعالٍ وجداني عابر. انطلق النص من نفي تأسيسي اتخذ شكل رفضٍ قاطعٍ أمام ضغوط الترويض، ثم تفَتّح هذا الرفض عبر شبكة من الاستعارات والانزياحات الدلالية التي صاغت هوية مقاومة؛ هوية تُعرف نفسها بالفعل والصدق لا بالمظاهر والزينة. تفكَّك النصّ المعايير السائدة وأعاد بناءها عبر رموز محورية: كـ«الخمر» و«الكأس» و«الصخرة» وِسيزيف. التي تحوّلت إلى أدوات تأويلية تجسد اختيار المعاناة والالتزام بالمبدأ، فصارت الصورة الشعرية ممارسةً أخلاقية تمنح للهوية معنىً جديدًا.
من ناحيةٍ أخرى، تؤكد قراءة البنية المادية للنص (الإيقاع الحرّ، النبرات، التكرار، التوازي، والتقطيع الصوتي) أن الصوت والوقفات ليسا زينةً بل أدوات مقاومة، تشتغل على توليد توترٍ شعريٍ، يرسّخ نبرة الرفض، ويمنح الخطاب طابعًا وجوديًا مشحونًا بالصدق والاحتراق. بهذا المعنى تتحول «قالوا: تدلّل!» إلى نموذج شعري متكامل يزاوج بين العمق الرمزي والصرامة الأخلاقية، ويعيد تصور الشعر كفعلٍ مقاومٍ يخاطب الضمير، ويعيد ترتيب العلاقة بين الذات والعالم، بين الكلمة والموقف، وبين الحياة والمبدأ.
خاتمة تأويلية مقترحة:
في ضوء هذا التحليل، لا تعود (قالوا: تدلّل!) مجرد قصيدة مقاومة، بل تتحوّل إلى لحظة وعي تتجاوز زمن كتابتها الأصلي عام 1978، وتستمر في إعادة طرح سؤال الكرامة في وجه كل سلطة تُغري لتُخضع، وتُزيّن لتُدجّن. إن رفض الشاعر لا يُعبّر فقط عن موقف فردي، بل يُجسّد قلقًا وجوديًا تجاه الزيف ويُكرّس أن الكلمة الصادقة هي آخر معاقل الإنسان حين تُغلق الأبواب.
كما أنّ القصيدة لا تتوقف عند زمن السلطة البعثية، بل تمتد لتستحضر واقع العراق بعد التغيير، حيث سيطرت القوى الدينية، وارتدت العمامة لتصبح غطاءً للهيمنة، فتظل كلمة "لا" في مطلع النص مؤسسة لموقف أخلاقي وسياسي مستمر، يتجاوز اللحظة التاريخية الأولى.
القصيدة تُعيد تعريف الشعر بوصفه فعلًا أخلاقيًا حيًا، لا يُكتفى بقراءته، بل يُعاش. كل استعارة فيها ليست صورة فقط، بل تجربة، وكل انزياح ليس بلاغة فحسب، بل إعادة ترتيب للواقع، وبنية صوتية وإيقاعية تُجسّد الصراع مع الزيف والمكانة المزدوجة للذات في مواجهة الآخر والمجتمع والسلطة. بهذا، تُصبح قالوا: تدلّل! مرآة للذات التي تختار أن تحيا بلا قناع، تُقاوم بلا امتياز، وتكتب لتُخلّد موقفًا أخلاقيًا لا يُشترى.
***
سهيل الزهاوي
........................
* بقراءةٍ تاريخيةٍ ونصّيةٍ يستحضر العنوانُ في الأصل خطابَ الأجهزة الأمنية عام 1978، لكنّ الإضافات اللاحقة في المنفى توسّع دلالةَ «قالوا» لتشمل أشكالًا جديدة من الهيمنة (دينية/طبقية)، فتصير «التدلّل» رمزًا لكل أشكال الترويض والتمَيّز الاجتماعي.