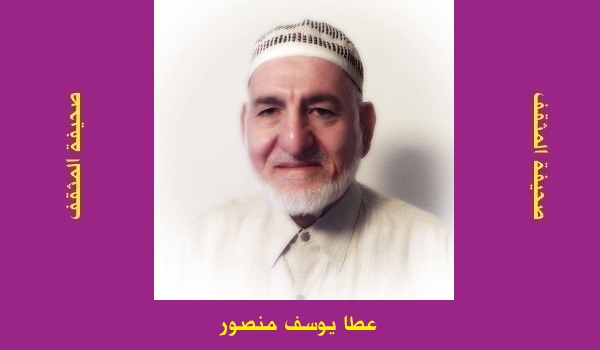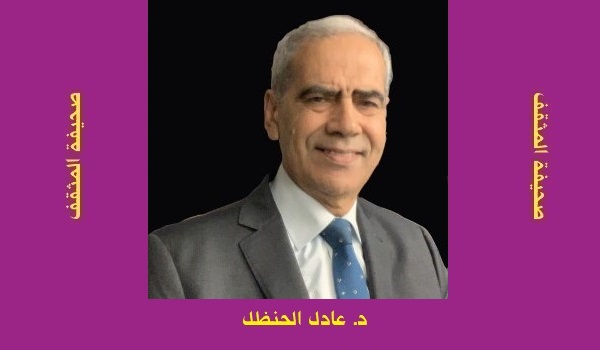الجزء الأخير من رواية الحرز
تمتمت بهمسة خرجت من عتبةٍ كانت تخاف الاقتراب منها:
"حان الوقت.. لأعرف".
مدّت
يدها
نحوه
ببطءٍ
حَذِر،
كأنها تخشى أن تستيقظ الأرواح النائمة بين ثناياه.
تناثرت الأوراق التي في داخله واحدةً تلو الأخرى، رقيقة كأجنحة فراشات ذابلة، مرقَّمة بأناة تنحدر من الواحد إلى العشرة...
كأن حياةً كاملة أُفرِغت في هذا الترتيب الغريب.
التقطت إيفا الورقة الأولى بأطراف أصابعها المرتجفة، ثم فردتها ببطء، وكأنها تخشى أن تتمزّق الذاكرة ذاتها.. وبدأت
القراءة...
الورقة الأولى
كانت حياتنا قبل مرض أبي هادئة كجدولٍ صغير ينساب بين بيوت الفقراء، بسيطة، مطواعة، لا تُفاجئ أحدًا. كان أبي يعمل سائقًا في الميناء، رجلاً لين الملامح، طيب الطبع، يملك من الصبر ما يجعل صوته دائمًا منخفضًا حتى وهو يواجه قسوة الدنيا.
كنتُ ابنته الوحيدة.
طفلة في العاشرة، أعيش في كنف والداي كزهرةٍ لا تعرف من الرياح سوى النسائم، فأنا موضع دلالهما رغم ضيق الحال، وكانا يشيّدان لي في كل يومٍ حلمًا صغيرًا يعوّضني عن كل ما ينقصنا.
لكن الربو الذي لازم أبي سنينًا طويلة بدأ يتحوّل إلى ذئبٍ ينهش أنفاسه نهشًا. لم يعد سعاله عارضًا عابرًا، بل صار يتردّد في صدره كطبول حرب تقرع في ليلٍ بلا نجوم.
ومع تدهور صحته اضطر لترك العمل، او لأقل سرح منه.
حصل بعد جهدٍ مُرهِق على تقاعدٍ هزيل لا يكاد يسد الرمق.
بدأت أمي تُخفي دموعها في المطبخ، وأصبح وجه أبي أكثر انطفاءً، وكأن الهواء الذي يستنشقه لم يعد يكفي لبقائه في هذا العالم.
وحين ضاقت السبل، اضطر أبي إلى استدعاء أخيه.
كان عمي ــ ذلك الرجل الذي لا يأتي إلا إذا احتاج ــ يعمل في سلك الشرطة، ويتاجر في الظلام بكل ما يمكن بيعه أو تهريبه.
جاءنا بزيه الرسمي، مسدّسه يتدلّى عند خاصرته كتهديدٍ صامت، وحضوره يملأ البيت رائحة خوفٍ لم أعرفها من قبل.
سأل أبي عن قدرته على إيصال بعض "الصناديق"، كما فعل في مرةٍ سابقة.
ولم يجد أبي بُدًّا من الموافقة، فالعوز كان شرسًا، ينهش في نبرة صوته ورجولته.
منذ ذلك اليوم صار بيتنا مخزنًا لعلبٍ مبهمة ولفائف غامضة، صناديق مُحكمة الإغلاق لا يجرؤ أحد على السؤال عمّا بداخلها.
كان عمي يكلّف أبي بنقلها وحده، مريضًا كان أم على حافة الإغماء، لا يهمّ.
كان يكلّمه من علٍ، يوزّع كلماته وكأنه يرمي صدقاتٍ على متسوّل.
أما أنا، فكنت أرتجف كلما دخل البيت بحذائه الملطّخ وعينيه الزائغتين؛ كنت أشعر، على صغري، أن حضوره يطفئ شيئًا من نورنا.
زاد عمل أبي مع عمي مرضًا فوق مرض.
صار فراشه ضيقًا عليه، وأنفاسه كخشبٍ يابس يشقّ طريقه نحو الاحتراق.
وحين أخبرنا الطبيب بأن أيامه صارت معدودة، انكمشت أمي كظلّ يُسحب من عنفوان نهاره، بينما لم يكلّف عمي نفسه حتى بالسؤال عنه.
كنتُ أذهب إلى المدرسة بخطواتٍ متردّدة، أختبئ خلف صديقاتي، أستعرِض وجوههن لأتأكد أن أحدًا منهن لا تعرف بصدقات الجيران التي صارت أمي تقبلها مُكرهة. كنت أخجل، بل كنت أشعر بأن العالم كلّه ينظر إليّ بعينٍ تُشفق وتدين في آنٍ واحد، وكنت أبكي سرًا حين أسمع أمي تستقبل زوّارًا يحملون لنا ما يسد رمقنا.
وبعد اشهرٍ قصيرة وثقيلة، رحل أبي.
رحل وكأنه اعتذر عن الحياة، وتركنا معلّقتين في هواءٍ ملتبس لا نعرف كيف نتنفسه.
لم تمضِ أيام حتى أدركنا أن موت أبي لم يكن نهاية العذاب..
بل بدايته.
فقد أصبحنا تحت رحمة العم، ذلك الذي كان ظلّه وحده كفيلًا بأن يصادر الدفء من البيت.
كنت طفلة،
نعم...
لكنّ قلبي كان يرى ما لا تراه أعين الكبار. كنت أعلم، بيقينٍ يشبه حدس الجياع، أن الأيام المقبلة ستختبر قدرتي على البقاء.. وأن الخوف الذي يسكن البيت لن يغادر بسهولة.
الورقة الثانية
لمّا انطفأ وجه أبي إلى الأبد، وبات اسمه يُتلى همسًا في أركان الدار، حلّ عمّي في حياتنا كظلّ ثقيل لا يُرى منه سوى سواد الطمع ونتانة السلطة.
كان يأتي بصفة المعيل،
يحمل في يده ما يشبه الرحمة،
وفي قلبه ما يشبه الخراب.
يزورنا بحجّة السند، بينما كانت نظراته تفصح عن نوايا لا تخفى على من ذاقت الفقد وعرفت مبكرًا ألوان الخديعة.
كنتُ يومها طفلة، لكنّي أحمل في داخلي قدرًا من فطنة مبكرة، تلك التي تمنحها المآسي لأصغر أبنائها. كنتُ أرقب خطواته وهو يدخل غرفة أمّي، يغلق الباب وراءه، ثم يخرج بعد ساعات بنفَس متثاقل، وأمّي تلوذ بجدار المطبخ تنتحب، تشتم حظّها وتدفن وجهها في راحتيها كأنها تحاول إخفاء ما لا يُخفى.
أدركت،
دون أن يخبرني أحد...
أنّه كان يراودها عمّا لا حق له فيه،
وأنه يلوّح بقطع المعونة إن رفضت،
بل...
يتجرّأ على ضربها إن نهضت كرامتها لتقف في وجهه.
ومنذ تلك اللحظة، انفتح في صدري بئرٌ من الكراهية لا قرار له.
كنت أراه نجسًا يمشي على قدمين، وأتحاشاه كما يتحاشى الطاهر كل ما يدنّس روحه. صرت أختبئ في زوايا البيت، خلف ستارة متهالكة، تحت السرير، أو قرب سطح الدار حيث لا يصعد أحد.
لكن عينيه كانتا تلاحقانني أينما حللت، كأن حضوري يوقظ فيه شرًّا آخر.
يسأل أمّي دائمًا عن غيابي، وحين يعلم أنّني في الدار يطلب أن أقدّم له الطعام والشاي، مكرسًا من وجودي خادمة أبدية من حقه المكتسب.
كم كرهتُ تلك اللحظات. يدٌ صغيرة ترتجف وهي تحمل طبقًا أكبر من قدرتها، ونظرات متوحّشة تترصّد كل خطوة. وحدث غير مرة أن انزلقت يدي وسقط الطبق على الأرض، فيستشيط غضبًا، ينهال عليّ ضربًا وشتماً، ثم يعاقبني بعقوبة كانت أشدّ قسوة من الألم ذاته: حرماني من المدرسة، التي كانت نافذتي إلى العالم، ومهربي الصغير من رائحة الخوف في البيت ومن نظراته التي تغتال لحظات الطمأنينة المتلألئة بالامان.
مرّة، وحين تكدّست المرارة في صدري، قلت لأمّي
إنني أريد قتله.
كنت أقولها بصدق طفلة وصلت إلى منتهاها. وضعت أمّي يدها على فمي بسرعة، كمن يخشى أن تستيقظ العواصف، وقالت بصوت مبحوح، هادئ ولكنه حازم:
"لا تكرّري هذا أبدًا، يا حياة..
إن علم بما نويتِ سنُدفن معًا دون أثر.
عليكِ أن تكوني لطيفة معه..
فلا تظهري نفورك".
لكن كيف لطفلةٍ أن تجامل وحشًا؟
قلت لها: إنني أكرهه، ولا أطيق حضوره في بيتنا، ولا أحتمل إهانته لنا.
كنت أقول ذلك وقلبي يخفق بخوف وتمرّد لا يعرف شكلاً ولا مخرجًا.
لكن...
بلغني في المدرسة، همسًا بين الطالبات، أنّ عمّي يريد الزواج من أمّي، وأنه سيصير "والدًا" لي. كانت الفكرة وحدها كفيلة بإصابتي بالغثيان. نفيتُ الأمر..
لا بل رفضته بكل ما أوتيت من قوة الرفض... كأنها نبوءة شرّ لا يجوز أن تتحقق.
لكن اليوم الذي خشيتُه جاء، ولم يكن بإمكاني صده.
جلس عمّي أمامنا، بعينين لا تعرفان الحياء، وقال إن علينا الانتقال إلى بيته لتوفير الإيجار، وإنه ينوي الاقتران بأمّي "سترًا لها... لنا".
يا للسخافته!
كان
يمنّ
علينا
بما
سرقه
من
طمأنينتنا.
اقتاد أمّي إلى أقرب مأذون، وكأنها صفقة يجب إنهاؤها بسرعة.
عادت تلك الليلة صامتة، كأن صوتها نُزع منها.
عيناها تحملان أثر معركة خاسرة.
تم الزواج في يوم واحد، وكأن القدر استعجل الوجع كي يستقرّ في صدورنا.
وفي صباحٍ كالح، حملنا ما تبقّى من متاعنا القليل، وانتقلنا إلى بيت عمّي، تابعين اياه كمقادين لا حول لهم، كخراف تُساق إلى جزار الجديد.
كنت أسير باتجاه الشاحنة التي اقلتنا، وأنا أصر على اسناني وأضغط على يدي حتى تترك أظافري أثرًا في جلدي، كأن ذلك الألم الخفيف يُساعدني على احتمال ألم أكبر.
كنت أحسّ بأن الطفولة تُسلب مني، وأنني أدخل عالمًا غريبًا لا مكان فيه لضحكة، ولا لكتاب، ولا لسماء نظيفة. كل شيء كان ثقيلًا:
الطريق،
الهواء،
نظرة أمّي الشاردة،
وصمتها الذي يشبه استسلامًا مجبَرًا لا قبولًا رضيًا.
ومع ذلك، في داخلي كانت هناك شعلة صغيرة، لا أعرف من أين جاءت، ربما من ذكرى أبي، أو من شيء دفين في روحي، شعلة تقول إنني سأكبر يومًا، وإن هذا الظلم، مهما تمدّد، لن يبتلعني كاملة.
كانت الطفلة في داخلي ترتجف..
نعم، لكنها لن تركع.
وكل خطوة نحو بيت عمّي كانت تُعمّق عزيمتي على أن أحيا بطريقة لا تشبه قسوته، وأن أظلّ، رغم الخوف، حياة:
تلك الصغيرة التي لم يسمح لها القدر أن تكون طفلة،
لكنها أقسمت أن تحفظ ما تبقّى من نورها في قلبها، ولو سرًا.
الورقة الثالثة
منذ اللحظة الأولى لخطونا عتبة بيت عمّي، أدركتُ أنّ البيت ليس بيتًا، بل فخٌّ متقن نصبه القدر، وأُجبرتُ أنا وأمّي على الإقامة فيه كقطعتين زائدتين في معادلة لا ترحم.
خصّص لنا غرفة ضيقة، جدرانها رطبة، لا تُمسك سرًّا ولا تحفظ خصوصية.
وزاد الطين بِلّة أنّه انتزع المفتاح وأخفاه في جيبه، ليقتحمها متى شاء، في أي ساعة، وبلا استئذان، كأنه يختبر مدى ضعفنا حين تُفتح الأبواب قسرًا.
هناك، بدأتُ أتعلم مفردات الخوف المتواصل كما يتعلم الطفل الحروف الأولى.
تسلّل القلق إلى روحي كما تتسلل الرطوبة إلى جدار يتجمع نزيز الماء تحته، لا تُرى في البداية، ثم تُترك ندوبًا لا تُمحى.
كنت أقضم أظافري حتى ينضح الدم، أنتزع شعرات رأسي بعد أن أعقدها بين أصابعي بإلحاح، أجرح ساعدي بأي شيء حادّ يقع تحت يدَي.
لم أكن أفعل ذلك رغبةً، بل استجابة غامضة يفرضها خوف نامٍ في صدري، خوفٌ جعلني أتمنّى، في لحظات يأس مضاء بكراهية، أن أتحوّل في عيني عمّي إلى وحشٍ يخشاه، لا طفلة يستسهل دهسها.
وتعلّقتُ بأمي كتعلّق ظلّ بجسدٍ خائف.
كنت أرافقها أينما ذهبت... في المطبخ، في الفناء، وحتى حين تتهيّأ للنوم.
أعرف أنها لا تستطيع حمـايتي، لكن قربها كان يمنحني شيئًا الطمأنينة والأمان...
بقايا حضنٍ لا يحول دون الشرّ، لكنّه يخفف وخزه، ويبعد عواقبه.
ولهذا كنت أحمل معي دائمًا شيئًا خفيًا:
مسمارًا صغيرًا، حجرًا بحافة حادة، قطعة حديد صدئة، شوكة..
أي شيء يمكن أن يتحوّل في لحظة إلى أداة دفاع أو ربما إلى تميمة تمنحني وهم القوة كالحرز الذي شدته امي على ساعدي في اول يوم ذهبت به الى المدرسة ولازالت احمله.
لم نكن نعرف لمزاجه توقيتًا.
كان يخرج في ساعات مبكرة، ثم يعود فجأة في منتصف النهار، أو يدخل علينا ليلًا بعينين حمراوين تفحان شرّا، كأنّ الليل نفسه يتجسّد في موعد عودته.
وهكذا عشنا في ترقّب دائم، في توترٍ يشدّ الأعصاب كما يشدّ القوس وتره.
ثم بدأت تحرّشاته، واضحة، مقززة، لا يغطّيها حياءٌ ولا تسترها بذرّة رحمة.
كان يسحبني من ذراعي بعنف لأجلس قربه، يتعمّد مراقبة فتحة صدري الصغيرة، يمدّ يده إلى أردافي حين يعلم أنني نائمة، أو يفتح باب الغرفة لحظة تغيير ثيابي استعدادًا للمدرسة.
كانت عيناه تُعلن ما في نفسه قبل يديه. وكنتُ أعرف، بحدس طفلة خُدشت براءتها مبكرًا، أنّه ينتظر اللحظة المناسبة لارتكاب ما هو أفدح من اللمس.
ولم يكن لديّ مخرج. فكرتُ أن أهرب إلى بيت عمّتي، لكنّها كانت نسخة أخرى من أخيها: بخلٌ، وجشعٌ، وخوفٌ أعمى من سطوته، فلا ملاذ هناك.
حاولتُ التفكير بمن يمكن ان يصدقنا من الناس، معارف، اقرباء، جارة عجوز، معلمة في المدرسة، لكنّ الجميع كانوا يتجنبونه كما يُتجنَّب الوباء.
وحتى لو كلمتهم، فلن يصدّقني أحد.
بل ربما يُتهم جسدي الصغير بالعار، ويُلقى بي في أول مكبّ نفايات كما تُرمى الأشياء المكسورة.
كان عمّي يُذكّرنا، كلما سنحت له الفرصة، بأنه "سترنا" من الشارع، وأنّ فضل وجودنا فوق أرض بيته يعود له وحده.
يلوّح بالمهانة دائمًا كما يلوّح الظالم بسيفه، يريدنا ممتنّتين لظلمه، لاهجتين بمعروفه، ومدينتين لقهره حتى آخر العمر.
وحين كنت أدفع يده عني أو أرفض الجلوس قربه، كان يهددني بحرماني من المدرسة، ذلك الملاذ الذي لم يبقَ لي سواه.
يقول إنه سيحبسني في البيت، وإن عليّ أن أطيعه.
وحين تتدخل أمي، راجيةً، يزداد غضبه حتى يكاد يفقد صوابه، ينهال علينا شتمًا وضربًا، كأن وجودنا خطيئة تُستوجب العقاب.
ليالي كثيرة، كان النوم يجافيني خوفًا، فلا يغمض لي جفن إلا بعد أن أسمع وقع خطواته تغادر البيت.
حينها فقط كان جسدي يرضى أن يستسلم للنوم تَعِبًا.
كنت أدعو، بلسان طفلة لا تعرف سوى البكاء والدعاء، أن تحلّ به مصيبة تبعده عنا، أن يضلّ الطريق، فلا يعود أبدًا.
لم تكن أمنية مبطنة بالحقد فقط، بل كانت محاولة للنجاة، محاولة يائسة للبقاء.
كنت أتحيّن كل لحظة كي أتفادى ما قد يحدث، أنسلّ مبتعدة عن طريقه، أخفي جسدي في الظلال، وأتعلم، ما استطعت، أن أغدو أصغر ما يمكن، كأن الوجود يصير عبئًا يجب أن يُخفى. ومع ذلك، كانت هناك شرارة صغيرة في داخلي، لا تزال تقاوم.
الورقة الرابعة
مرّت
الشهور
ثقيلةً
كحجارةٍ تتدحرَج فوق صدري، أتحاشى وجودي في حضرته كما تتحاشى الظلالُ نوراً يحرقها.
كنت أتقن فنّ التواري والاختفاء، أختبئ خلف جدران الصمت وأبواب غرفتي، أحسب أن العزلة قادرة على أن تُعمي عين الشرّ المتربّصة بي.
لكن الشرّ يعرف أين يختبئ الخوف.. ويعرف كيف به يتربص.
حلّ يوم ميلادي الحادي عشر، يومٌ ما كان ينبغي له أن يكون سوى فرح صغير لطفلةٍ تُطفئ شمعة وتسرح بخيالها.
لكن السماء في تموز كانت قاسية، ترسل حرَّها فوق رأسي حتى شعرتُ أن وجهي يحمرّ كخبزٍ خرج تواً من فم التنور.
عدتُ من المدرسة أجرّ قدميّ المتعبتين، وركضت إلى المطبخ لأسكب ماءً يُطفئ جمراً يشتعل في صدري قبل وجهي.
وحين استدرتُ لأصعد إلى غرفتي وأستبدل ملابسي، وجدته يقف في باب المطبخ، يسدُّه بجثته كما يسدّ الغادرُ طريق نجاةٍ أخيرة.
كانت عيناه تنضحان بالدناءة، بريقٌ خبيث فيهما كأنهما ثقبان يقذفان شواظًا اسواداً.
تجمّدتُ مكاني وسألته بصوتٍ مرتعش:
ـ عمي.. أتريد ماء؟
لم يُجب. كان الصمت على لسانه أشدَّ رعباً من أي كلمة.
تقدّم نحوي خطوةً بعد أخرى، كذئبٍ يقترب من فريسته وهو واثقٌ أن لا خلاص لها. صرخت: "ماما!" فارتدّ الصوت عليّ كأنه ضائعٌ في بئر مهجورة.
قال ببرودٍ يُشبه برد المقابر:
ـ أمُّك ليست في البيت.. اهدئي وكوني عاقلة.
كنت أرتجف، لكن، ليس من الماء الذي بللت به يدي ووجهي، بل من شيءٍ أعمق:
من إدراكٍ مفاجئ بأنني وحيدة تماماً. قلت له محاوِلةً أن أستجمع بقايا شجاعتي:
ـ إذن.. اسمح لي أن أمرّ.
ـ سنخرج معاً.
ـ لا.. أريد غرفتي.
كنت قد خططت في داخلي أن أهرب إلى الشارع، إلى أي ضوءٍ يحميني من هذا الظلام الذي يقف أمامي الآن.
لكنّه لم يتركني أفكر طويلاً.
قبض على ساعدي بقوة، يده كانت خشنة كيد جلاّد.
لم أجد سلاحاً سوى كأس الماء إلى جانبي، فرفعتُه وضربتُ يده بكل ما في ذراعي الصغيرة من غضبٍ ويأس.
صرخ، شتمني، رفع يده وصفعني صفعةً أطاحت روحي قبل جسدي.
نهضتُ
كالغريزة،
لا كالقوة.
دفعته بكل ما فيّ من رمق نجاة، ركضت نحو باب البيت، كنت أسمع دقات قلبي أعلى من صراخي.
أصرخ لعلّ الشارع يسمعني، لعلّ العالم يسمع طفلةً تُستباح.
لكنه التقطني من شعري، سحبني كما تُسحب دمية قذرة.
كنت أتلوّى تحت قبضته، مستعدةٌ أن أفقد شعري كله ولا أفقد نفسي.
كان بكائي يثير فيه وحشاً كامناً. فقلت له وأنا أرتجف كعصفور مبتلّ:
ـ عمي.. أرجوك..
أنا حياة، ابنة المرحوم أخيك.
أستحلفك بالأخوّة..
بالدم..
لا تؤذني. أنا ابنتك أيضاً..
أرحمني.
لكن الرحمة لم تكن ضمن معجمه القذر...
رماني، وانا لا زلت اصرخ، في زاوية غرفته كما يُرمى جرمٌ لا قيمة له، ثم أغلق الباب وأخفى المفتاح. التفت إليّ وقال بابتسامةٍ منتهكة للإنسانية:
ـ ومن قال إنك ابنة أخي؟
اسألي أمك عن نطفتك..
أنتنّ بلا أصلٍ ولا نسب، ولولاي أنا، لكانت الشوارع مأواكنّ.
كانت كلماته أغلالاً تُلقى على روحي.
حاولتُ أن أبحث عن شيءٍ أدافع به عن نفسي، حجر، قلم، أي شيء، لكنّه انقضّ عليّ ككلبٍ مسعور.
مزّق ثيابي، يده تهوي عليّ ضرباً، وأنا أضغط أظافري في جلده، وأعض أي جزء منه في متناولي، أردّ الضرب بالضرب، كمن يدافع عن آخر نفسٍ في صدره.
دفعني بقوّة على حافة السرير، اصطدم رأسي بخشبةٍ بارزة منه، ورأيت العالم يُصبح ضباباً.
ظلّه يقترب، يشتم، يربط يديّ بعمود السرير كأنني جارية في زمنٍ مظلم.
وفي تلك اللحظة..
مات شيءٌ كبير في داخلي.
لم تكن مجرد لحظة اغتصاب..
كانت لحظة موت.
وحين انتهى، سحب جسدي كما تُسحب الجثة، ورماني خارج الغرفة.
كنت دماً بلا روح، أنفاساً متقطعة لروحٍ أُنهكت حتى النهاية.
ذلك اليوم..
لم أنتهِ فقط. بل بدأتُ أفهم أنني أصبحت "عاراً" في عينيه، وأن سيف الموت قد ينهال عليّ في أي لحظة بذريعة غسل العار.. فقط لأنني قاومتُ وصرخت.
الورقة الخامسة
لم أعد قادرةً على الحركة، كأن جسدي كله استحال حجراً يابساً طُرِح على أرضٍ باردة. انقطع صوتي عن البكاء، وتيبّست دموعي فوق وجهي كأثرٍ أخير لروحٍ كانت تقاوم ثم خارت.
لم أعد طفلةً في تلك اللحظات، بل شبحاً ينظر إلى الدنيا من وراء زجاجٍ معتم.
وبينما كنت غارقةً في وجعي وخوفي، سمعت صوت المفتاح يلتفّ في الباب كما لو أنه يفتح قبراً.
فتحت أمي الباب. وما إن وقعت عيناها عليّ حتى صرخت كأن شيئاً انتُزع من قلبها.
لم تسأل، لم تحتج إلى سؤال...
كانت الأم تعرف بعينها ما تعجز عنه لغةُ البشر.
هرعت إليّ، تنوح وتولول، تحاول أن تفهم أين يبدأ جرحي وأين ينتهي.
ساعدتني على النهوض، وأنا أثقل من أن تحملني ذراعاها الضعيفتان.
ساقتني إلى الحمّام، وأجلستني تحت الماء.
كانت تغسلني بدموعها قبل الماء، تمرر يديها المرتعشتين على وجهي وكأنها تحاول محو ما لا يُمحى.
كنت أسمع من خلف الباب صراخاً متقطّعاً، شتائمَ كالسهام، صوتَ ارتطامٍ غاضب.
كان عمي، ذلك الوحش الذي يتنفّس بين جدراننا، يهدّدها ويقذفها بالإهانات، يتوعدنا بالطرد والتشريد إن هي فتحت فمها أو حاولت أن تحميني منه.
كان صوته طعنةً أخرى، تُذكّرني بأنني لم أكن ضحية للحظةٍ واحدة، بل ضحية لقدرٍ جائر يحيط بي من كل الجهات.
مكثت أسبوعًا طريحة الفراش.
جسدي لم يعد جسدي، روحي معلّقة في مكانٍ لا أعرفه، لا أرض ولا سماء.
أمي كانت تجلس عند رأسي، تحاول أن تنطق بكلمة مواساة، فأصدّها بنظرةٍ هاربة. لم أرد شيئاً...
لم أعد أريد الحياة نفسها.
كانت فكرة الانتحار تمرّ بخاطري كما تمرّ السحابة بالسماء، لا تلبث أن تغادر، لكنها تُظلّل القلب بظلامها قبل أن تمضي.
كنتُ ضائعة في عالمٍ لا يرحم طفلةً كُسرت قبل أن تفهم معنى الكسر.
توقفت عن الذهاب إلى المدرسة. لم أُعدّ حقيبتي، لم أمسك قلماً، لم أودّع أحداً.
خرجت من عالم الطفولة كما تخرج الروح من الجسد: بلا عودة.
وحين بدأت أستعيد وعيي شيئاً فشيئاً، شعرت بوخزة في ذراعي.
لمست المكان فإذا به “الحرز”، ذاك التميمة التي ربطتها أمي حول ساعدي منذ صغري، وقالت إن فيها بركةً تحفظني من الشرور.
تأملتُه طويلاً، وفي داخلي مرارة لا تشبه أي شيء.
هذا الشيء، الذي كان يُفترض أن يحميني، خانني في اللحظة التي احتجت فيها إليه أكثر من أي وقت.
نزعته بغضبٍ وبكيت، كأنني أقتلع خيبةً عالقة في جلدي.
رمَيتُه بعيداً..
لكن شعوراً غريباً شدّني إليه. كأنه يناديني بصوتٍ خافت:
"صحيح أني خذلتك.. لكني ما زلت قادراً على أن أحفظ أسرارك".
ترددتُ،
ثم
التقطته
ثانيةً.
بوضعٍ ما، كان الحرز الشيء الوحيد الذي لم ينظر إليّ بعين إدانة، لم يجرحني، لم يلوّح بيدٍ قادرة على البطش. كان كصندوق صغيراً.. وفي داخله مكانٌ يصلح أن يحتضن وجعي.
فتحتُه...
كان يحوي بعض الأوراق القديمة الملفوفة.
أخرجتها، طويتها بهدوء ووضعتها في حقيبتي، ثم جلبت أوراقي الشفافة.
شعرتُ بأنني بحاجة إلى أن أُفرغ كل ما يثقل صدري.
أن أرسم جراحي بكلمات، أن أضعها على الورق علها تكفّ عن مطاردتي في الظلام.
لم أكن أبحث عن عزاء، كنت أبحث عن نجاة:
نجاةٍ روحية، خيطٍ رقيقٍ يربطني بما تبقّى مني.
وبدأت
أكتب..
كان قلمي يرتجف كقلبي، لكنّه يكتب.
يكتب ما لم أستطع قوله لأمي، ما لم يسمعه الشارع حين صرخت، ما لم يفهمه أحد.
كلما كتبتُ سطراً، شعرت أن قطعةً مظلمة داخلي تتلاشى وبصيص ضوء واهن يتنفس.
لم يختف الألم، لكنه صار قابلاً لأن يُلمس دون أن أموت مرةً أخرى.
وحين انتهيتُ من أول ورقة، طويتها طيّاً محكماً، وأخفيتها في الحرز، ثم ربطته حول ذراعي من جديد.
كان الربط أشبه بميثاقٍ جديد، كأنني أعيد بناء ذاتي بخيطٍ من الحبر والورق.
لم يكن الحرز هذه المرة تعويذةً ضد الشرّ، بل صندوق الريح الذي يحمل صوتي، سرّي، حكايتي..
التي لن تُدفن بعد اليوم.
ومع كل ورقةٍ أكتبها، كنت أشعر أن "حياة" ـ تلك الطفلة التي ظننت أنها ماتت ـ ما زالت في مكانٍ ما داخلي، تنفض غبار الانكسار، وتتهيأ ببطءٍ شديد للعودة إلى الضوء.
في مكانٍ عميقٍ داخلي، ظلّ جزء صغير من حياة..
يرفض أن يموت.
جزءٌ خافت، صغير جدا، لكنه موجود..
ينتظر يوماً ينهض فيه من بين الركام فينتقم.
الورقة السادسة
مضت
سنتان..
سنتان ثقيلتان كدهرٍ يجرّ أذياله على كتفيّ النحيلين، وأنا أبحث، في صمتٍ عميق يشبه خفوت الأنفاس، عن مخرجٍ آمن من عتمتي، عن نافذةٍ لا تطل على الهاوية.
لم أكن أفكّر بالخلاص بقدر ما كنت أبحث عن معنى أن أظلّ على قيد الحياة.
في داخلي كانت النار تشتعل، ورغم هشاشتي كنت أعي تماماً أن في قدرتي، لو أردت، أن أقتله.
غير أنّ الفكرة نفسها كانت تسقط من قلبي كحجرٍ في بئرٍ بلا قرار.
أيُّ عدالةٍ تلك التي ستُنقذني لو رفعتُ عني حاجز الخوف وطعنته بخيبتي؟
هل سأفلت من العقاب؟
أم سأُلقى في غياهب سجنٍ لا تنتهي لياليه، وتلاحقني لعنات مجتمعٍ يتقن قلب الحقائق؟ مجتمعٍ يرى في الجلاد ضحيةً بيضاء، وفي الضحية مجرمًا يستحق القصاص؟
في بلدٍ تحكمه شريعة الغاب، والعشائر، والأعراف التي تجعل المرأة مذنبة قبل أن تنطق، متهمة قبل أن تُسأل، عاراً يمشي على قدمين..
وإن كانت هي المكسورة الجناح.
كان عمي لا يملّ من التهديد.
صوته يأتيني كل ليلة كصفعةٍ جديدة:
ـ لا تنكشفي..
إن عُرفت الفضيحة فلن يكون لي حلٌّ سوى غسل العار.
كانت كلماته تتردد في داخلي كناقوس موت.
تعلّمتُ معها أن الصمت ليس اختياراً بل نجاة، وأن الرضوخ ليس ضعفاً بل محاولة يائسة لأن أبقى حيّة، ولو على حافةٍ ضيقة من الظلّ.
انطويتُ على نفسي. لم أعد أخرج من البيت، ولا أستقبل أحداً.
اختفت حياة من العالم، وبقيت «حياة» أخرى، ساكنة، تتنفّس في داخلي بشيءٍ يشبه الاحتضار.
غير أنّ السكون كان وهماً؛ فداخلي لم يكن خامداً كما يظنّ من يراني.
كان بركاناً صغيراً، يكتم غليانه في النهار ويستفيق ليلاً.
في النهار كنتُ أتحرك في البيت كأنني خيالٌ مدجَّنٌ، ألبي طلباته، أقوم بشؤون المنزل، أتعمد أن أبدو منحنية، صامتة.
ربما، لو رآني مكسورة يزهد في إيذائي، أو لعلّ انكساري كان درعاً أرتديه لأمضي يومي بحدٍّ أدنى من الألم.
ومع ذلك، كنت أشعر بثِقَل نظراته عليّ، كأنها يدٌ خفية تمسح على ظهري بنصل سكين بارد.
وفي الليل..
كان لي عالم آخر.
عالمٌ ضيق، لكنه العالم الوحيد الذي أتنفس فيه.
أجلس قرب نافذتي الصغيرة، تلك التي لا تكشف إلا قطعةً من السماء، وأرافق أوراقي كما ترافق الروحُ ظلَّها الأخير.
كنت أفتح الحرز، وأخرج أوراقي الشفافة، وأكتب وأمزق، واعود وأكتب بحمى، كأن الكلمات هي الهواء الوحيد الذي أستطيع أن أبتلعه دون أن أختنق.
كنت أكتب عن خوفي، عن قهري، عن البيت الذي يشبه قبراً، عن رجلٍ يعيش تحت سقف واحد معنا ولا يشبه البشر.
أكتب عن أمي التي تذبل كل يوم قليلاً، وتخفي ضعفها بقوةٍ مصطنعة، وعن تلك اللحظة التي تبدلت فيها حياتي إلى ما لن يعود.
وأحياناً..
كنت أكتب عن انتقامي.
لم يكن انتقاماً من لحمٍ ودم، بل انتقاماً من القدر الذي سلمني بيديه لطفولةٍ مُزقت قبل أوانها.
كنت أتخيلني أقف يوماً ما أقوى، أطول، لا يقدر أن يرفع صوته عليّ.
كان المشهد يشبه حلماً يتكرر، أحفظ تفاصيله: أنا واقفة أمامه، لا أرتجف، أقول له كلمة واحدة فقط، كلمة تشبه صفعة... كفى! تلك الكلمة وحدها التي كانت تعني لي القدرة على استعادة نفسي.
مرّت الليالي وأنا أكتب في الظلام، أدفن أوراقي في الحرز كما يُدفن سرّ في صدر الزمن. كنت كلما طويت ورقة شعرت أن جزءاً صغيراً مني يلتئم، وأنني أبني، ببطءٍ مؤلم، جداراً خفياً يحمي ما تبقّى من روحي.
مع كل كلمة، كنت أتعلم أن الخوف لا يُقاوم بالصراخ، بل بالبقاء..
بالبقاء حيّة رغم كل شيء.
لكن شيئاً آخر كان يتشكل داخلي..
شيء يشبه القوة.
قوةٌ لا تشبه العنف ولا الصراخ، بل أشبه بنبتة صغيرة تشقّ الصخر التماسًا للضوء.
لم أعد تلك الطفلة التي ماتت في الورقة الأولى.
كنت الآن الفتاةً التي تعرف عدوّها، تعرف ضعفها، وتعرف
ـ وهذا الأهم
ـ أنها يجب ان لا تبقى طويلاً على هذه الحال.
كان الليل صديقي الوحيد، والكتابة اليد التي تنتشلني من الغرق.
ورغم الصمت الذي يحيطني، كنت أعلم أنه ليس نهاية..
بل بداية لشيء ما يتشكل، ينمو، يكبر، وسيأتي يوم يخرج إلى النور.
الورقة السابعة
كأن البلاد قد انفجرت من داخلها، كجرحٍ ظلّ يخفي نزفه طويلًا ثم انفلت فجأة.
خرج الناس إلى الشوارع يصرخون بالعدالة، يطالبون بإطلاق المسجونين، يهتفون ضد القهر، حتى بدا أن الهواء نفسه صار يحتجّ.
وما هي إلا أيام حتى سقطت جدران النظام مثل غبار تهاوى تحت المطر.
انتشرت الفوضى كحريقٍ يتغذى من اليأس، تتقاذفها عصاباتٌ، وولاءاتٌ جديدة، وكلٌّ يمدّ يده ليقتطع نصيبه من الخراب.
في هذا الانهيار تغيّر عمي..
لا، بل تكشّف.
كانت لحيته التي نبتت فجأة لا تشبه التديّن، بل تشبه ستارًا يُخفي شيئًا أعمق من الدناءة، وأشدّ ظلمة من الخسّة.
صار يتجوّل في الحي وخلفه رجال مسلّحون، يرفعون شعارات الدين على أكتافٍ تلطخت بالغنائم.
يتحدثون عن الشرع، شرع الله، كما يتحدث اللص عن مفاتيحه.
وعندما يعودون إلى البيت، كان المكان يضيق بأنفاسهم، بأصواتهم الثقيلة، بضحكاتهم التي تجرح جدران الليل.
تحوّل بيتنا إلى وكر، لا يكاد يخلو من السلاح والرجال.
أمّي
وأنا
نخدمهم كأننا غبارٌ في طريقهم.
العيون "آه تلك العيون" لم تكن تنظر، بل تنهش.
رغم حجابي، رغم محاولتي الانكماش في ظلٍّ أصغر من جسدي، كانوا يرونني.
يرون اللحم الصغير الذي صار عبئًا عليّ، يرون خوفًا يحلو لهم أن يروه لأن الخائف يسهل امتلاكه.
لم يكن عمّي يومًا رجلًا رحيمًا، لكنّ البلاد حين احترقت، احترقت معه ذرة إنسانيته.
كان قد هتك طفولتي وأنا في العاشرة، سرق براءتي ثم أخفاها كما يُخفى جرمٌ مُحكم الإغلاق.
كنت أظنه يومها ذئبًا واحدًا منفردًا، لا يتكاثر، لكني كَبُرت لأكتشف أن الذئاب تتوالد حين ترى الفوضى وتمعن في الطراد والاغارة، وأن الوحش الذي مزق جسدي في صغري صار اليوم قائدًا لقطيعٍ جائع.
وما عاد يخفي رغبته في بيعي لهم، واحدًا تلو الاخر، باسم "الزواج" و"الشرع"، كفضيلةٍ تُهدى، لا كطفلةٍ تُذبح.
كنت في الرابعة عشرة، لكنني أشعر أن عمري صار ضعف ذلك.
كأن السنوات التي سُرقت مني أثقلت ظهري قبل أن يشتدّ جسدي الذي بدأ يتغير، يتفتح على أنوثةٍ لم أطلبها، ولم تحتملها روحي، بل صارت نذيرًا لما ينتظرني.
وكنت أخشى الليل أكثر من النهار، لأن الليل يحرر وجوههم من الأقنعة.
يضحكون كثيرًا حين يذكرون “التزويج”، يتهامسون عن “الليلة المباركة”، كأن الشرّ حين يُعطى اسمًا دينيًا يصبح نعمة.
في تلك الليالي، حين يدوّي الرصاص في الخارج، كنت أشعر أن الحرب كلها تتواطأ علينا. البيت يهتز، الشوارع تعوي، لكنّ خوفي الحقيقي لم يكن مما يجري للبلاد، بل مما يجري لجسدي، لروحي التي تختنق كلما ورد اسم “الزواج” على لسان عمي.
كنت أعرف أنه لا يقصد بي إلا الصفقة، إلا البيع، إلا أن يُسَلّمني لأول رجل من عصابته يرفع يده.
كنت أعرف أنني سأُعرى من كل شيء، من أمي، من نفسي.
أمّي
كانت ترى وتخاف،
لكنها عاجزة..
مكسورة..
تنظر إليّ أحيانًا وكأنها تعتذر عن الحياة كلها، ثم تخفض عينيها قبل أن يفضحها البكاء.
كنا نغرق معًا، لكنها كانت تخشى أن تسبح، وأنا كنت أخشى أن أموت دون محاولة.
الورقة الثامنة
وفي إحدى الليالي التي انشقّ فيها الظلام عن أصوات اشتباكٍ قريب، عاد عمي متجهمًا، غارقًا برائحة البارود والتعب.
دخل غرفته ثم ناداني بصوتٍ ملغوم.
كان صوته وحده يكفي ليعيد إليّ كل الكوابيس التي سجنتني منذ العاشرة.
ترددت لحظة عند الباب.
تساءلت:
ماذا بقي لي بعد أن سفك طفولتي؟
ماذا يمكن أن يأخذ أكثر؟
دخلت.
كان يجلس في عتمةٍ لا يضيئها إلا خيط من نور متعب.
لم يكن ينظر إليّ كطفلة، بل كشيءٍ يُسوَّق. قال لي بهدوءٍ شرس:
"غدًا.. سيأتي من سيتزوجك.
شرع الله، ولا اعتراض."
شرع الله..
كم من الجرائم تُرتكب حين يتوارى الله ويُترك الشرع بين أيدي الوحوش.
تجمدت.
شعرت كأن الأرض انكمشت حتى غدت حافة هاوية.
وعندما اقترب مني، خطوة بعد خطوة، نهض شيء في داخلي، شيء لم أعرفه من قبل. ربما هو الظل الأخير من إنسانيتي، ربما هو ما تبقى من طفلةٍ لم تمت بعد رغم كل شيء.
تراجعت.
قال غاضبًا:
"لا ترفعي عينيك عليّ هكذا والاّ!"
لكنّني
رفعت
عيني.
ثم صرخت..
صرخة خرجت من عمقٍ لم ألمسه أبدًا من قبل.
وركضت...
وركضت نحو حضن امي...
ركضت كأن الأرض تشتعل تحت قدمي، كأن صرختي كانت أول نسمة حريةٍ عرفتها.
لم أنتصر بعد.
ما زلت في بيتٍ تحكمه البنادق، وتديره الذئاب.
لكني في تلك الليلة أدركت أمرًا واحدًا، يكفي لأن يُبقيني واقفة:
إن الروح، مهما ضُيّقت عليها الجدران، تظل قادرة على أن تتمرد..
وأن تحيا...
الورقة التاسعة
لم تعد الغرفة غرفةً بعد ذلك اليوم؛ صارت كهفًا مظلمًا، وسجنًا بابه يقف على صريرٍ مرعب يمكن أن يُفتح في أي لحظة بيد رجلٍ يظن نفسه “مشتريًا” لجسدي.
كل زاوية فيها..
صارت فخًا، كل ظلّ..
احتمالًا لهجوم، وكل دقيقة..
انتظارًا لطاغٍ جديد يقتحم عالمي الصغير باسم:
الصفقة،
الشرع،
والمال.
كنت أعيش في تلك العتمة كعصفورٍ جريح، لكنه رافضٌ أن يُمدّ له أحدٌ يدًا تُقص جناحيه.
وحين دخل أولهم..
كان يجرّ أذيال رائحةٍ كريهة من التديّن المزيف، يتمتم باسم الله وهو يتنحنح كمن يتهيّأ لخطيئة يريد لها غطاءً من السماء.
لم يخجل من نظراتي، ولم يتردد لحظة.
أنا وحدي التي كنت أتردد بين الهرب والصراخ والقتال.
تجمّدت في زاوية الغرفة، أرتجف غضبًا، لا خوفًا.
قال بصوتٍ خشن:
"لقد دفعت لعمّك.. وسأصلي قبل كل شيء."
كم من الجرائم تبدأ بالصلاة حين يفقد الناس معنى الله!
قلت له، وأنا أشعر بصوتي يتحول إلى سيف:
"لكنني لم أوافق على الصفقة."
اقترب خطوة، وفي عينيه تلك الوقاحة التي تتغذى من الفوضى، وقال ببرود:
"دفعتُ.. وهذا يكفي."
أجبته، واقفةً رغم رجفة ركبتي:
"اخرج الآن.. لن تلمسني إلا على جثّتي."
ابتسم ابتسامة مستترة بالسخرية:
"ليس هناك وقت للجدال.. ولم أكن الوحيد الذي سيدخل هذه الغرفة."
كانت تلك اللحظة شرارة.
اندفعت نحو الباب بكل ما بقي في جسدي من قوة، لكنّه كان أسرع، قبض على ذراعي بقوة ذئب، ثم ضرب ظهري بمقبض رشاشه.
سقطتُ، غير أن القدر وضع بجانبي أحد الكراسي الخشبية.
أمسكت قائمته بكلتا يديّ، وصرخت صرخةً خرجت من أعماق السنوات التي سرقوها مني، ثم هويتُ بالكرسي عليه.
لم يكن يتوقع أن تنهض صبية مكسورة في وجهه.
ترنّح، ثم انقضّ كحيوان يُدرك أن فريسته قاومته.
التقط الكرسي من يدي، رفعه عاليًا ثم هشّمه على كتفي وظهري، تتناثر أجزاؤه في الغرفة كأنها شظايا من حياةٍ تتكسر.
الألم لم يشلّني، بل أشعل شيئًا داخلي.
شيء يشبه صمود شجرةٍ ضربتها العاصفة فلم تنحنِ.
ثارت ثائرته، وراح يضربني بعقب الرشاش على رأسي، مرارًا، وهو يصرخ:
"ستطيعن! غصبًا!"
لم أُطع.
لم أصرخ طلبًا للنجاة، بل صرخت لأردّه عني.
وعندما سقطت إحدى شظايا الكرسي قرب يدي، قبضت عليها، ونهضت مترنّحة، كأنّي أنهض بآخر قطرة كرامة تسري في عروقي.
وباغتّه بضربةٍ على زند ذراعه.
صرخ، ثم استدار وصفعني صفعةً كادت تخلع روحي من جسدي، وأسقطني أرضًا.
انقضّ عليّ بعدها بوحشيةٍ عمياء، يفترسني وكأنه ينتقم لرجولته التي هزمتها فتاةٌ، لم يتوقع مقاومتها.
لم يكن في ضرباته سوى الحقد، ولا في أنفاسه سوى الغلّ.
وحين انتهى من وحشيته، بصق على وجهي..
بصقة كانت أقسى من الضرب.
ثم خرج، يصرخ ويشتم، كأنه هو من تعرّض للظلم.
تركني جثةً ممدودة، نصف واعية، نصف طافية فوق الألم.
كنت أشعر بدمي يسيل على الأرض، بدقات قلبي تتثاقل، وبجسدي كأنه ليس لي.
أضربت عن الطعام والشراب، حتى أمّي..
لم أعد أريد رؤيتها.
ليس لأنها مذنبة، بل لأنها عاجزة، ولأن عينيها حين تلمحانني تحملان ألمًا لا أحتمله.
لم تمرّ سوى ساعات، حتى فُتح الباب مرة أخرى..
صوت ثقيل، خطوات خشنة، ظل رجل آخر يملأ المكان. لم أعد أميّز الوجوه، صرت أرى كل رجل وحشًا بوجهٍ واحد.
حاولت أن أصرخ، لكن الصوت خرج خافتًا، كأن حنجرتي ترفض العودة للحياة.
حاولت أن أزحف بعيدًا، لكن جسدي لم يعد يستجيب. شعرت ببرودة المكان تحاصرني، ثم عتمة ثقيلة طاشت فوق رأسي.
لم أعرف كم اجتمع حولي من الذئاب.
كانوا يتداولون الغرفة كأنها مسرح مُظلم يُعاد فيه المشهد نفسه، وأنا جثةٌ لا تقاوم إلا بعينيّ حين تفتحان لثوانٍ وتحدّقان فيهم بحقدٍ يرفض الموت.
كنت أرى فيهم ذئاب مفترسة، تأكل فتاةً مرمية على حافة الحياة.
لم أصحُ إلا على صوت أمّي وهي تبكي وتصرخ:
"حياة.. حياة! تنزف..
بُنيّتي تنزف! ..
يمكن أنها ماتت!"
لكنني لم أمت.
كنت معلَّقة بين الحياة والموت، لكن شيئًا داخلي ــ ككل مرة ــ رفض أن يستسلم.
كانت روحي، رغم كل ما جرى، تُمسك بي وانا اتدلى من حافة الهاوية وتقول:
اصمدي.. لم يبقَ إلا أنتِ لكِ.
ورغم أن الجسد كان منكسرًا، كانت الإرادة ما تزال، كجمرةٍ صغيرة في عمق الركام، ترفض أن تنطفئ.
الورقة العاشرة والأخيرة
لم تكن الورقة العاشرة شبيهةً بأخواتها.
لم تكن مشغولة بالسطور، ولا ممهورة بجملٍ تفيض وجعًا كما اعتدتُ.
كانت ورقةً مجعدة، متعبة، كأنها جسد حياة نفسها وقد انكمش من فرط ما تحمّل.
لم تُطوَ بعناية كغيرها، ولم تُرتَّب في الحرز بحرص يدٍ تعرف الخوف.
كانت منفلتة،
منفردة،
تتقدم الأوراق وكأنها تريد أن تُرى أولًا، أو تُقرأ أخيرًا.
كانت الورقة خالية من الكلمات..
إلا من بصمة.
بصمة إبهامٍ صغيرة مغموسة بدمٍ لم يجف.
كانت حمراء قاتمة،
منطبعة على الصفحة البيضاء كختمٍ نهائي،
كصرخةٍ لا تحتاج إلى حروف.
وقفتُ أمامها طويلًا..
أحسست أن حياة، حين وضعت إصبعها على الصفحة، لم تكن تسجل حضورًا عابرًا، بل كانت تجمع في تلك اللمسة خلاصة عمرها القصير، تختصر كل ما كُتب قبلها، وتشهد على ما لم تستطع قوله.
كانت الورقة، رغم فراغها، صاخبة كأنّ عليها صدى كل الليالي التي صرخت فيها ولا أحد سمع او استجاب، وكل محاولات المقاومة التي خاضتها بجسدٍ صغير وروحٍ كبيرة، لم تفشل في تؤكيد جراءتها ومقاومتها وعزة نفسها.
ربما لم تعد حياة قادرة على الكتابة في لحظتها الأخيرة.
ربما كانت يداها ترتجفان من النزف، أو ربما كانت عيناها تفقدان الضوء، فجعلت الدم حبرًا أخيرًا لخبر أخير..
وربما..
ربما أرادت أن تقول ما لا تحتمله الكلمات، ولا تستوعبه اللغة.
كانت البصمة،
وحدها كافية..
لتفتح أمامي أبواب المعنى.
أول ما خُيّل إليّ أن حياة لم ترد أن تكون ضحية صامتة تُطوى أوراقها وتُنسى.
كانت تريد أن تترك جزءًا منها، قطعةً من دمها، من لحمها، من حقيقتها، كشاهدٍ لا يُكذّب. ولعلّها أرادت أن تُثبت للعالم أنّ ما جرى لها ليس خيالًا ولا مبالغة.
الدم وحده
لا يكذب.
ثم خطر لي أنها ربما أرادت شيئًا آخر. كأنها تقول:
“أنا هنا.. كنت هنا.. ولن يستطيع أحدٌ محوي.”
كانت تلك البصمة أشبه بصرخة انتصار أخيرة. ليس انتصارًا بمعناه الظاهر، الملموس.
لقد كانت حياة في لحظاتها الأخيرة، منهكة جسدًا وروحًا، لكن انتصارًا من نوع آخر، انتصار الروح التي ترفض الاستسلام حتى وإن انكسرت العظام وتخاذلت العضلات.
كلما حدّقتُ في الورقة، شعرت أن حياة لم تكتب للشفقة، ولا لطلب الرحمة، ولا لتسجيل مصير مأساوي.
كانت رسالتها صلبة، حادة، تشبه حدّ السكين الذي يقطع الظلام.
كانت رسالة لكل فتاةٍ اغتُصبت، ولكل جسدٍ حاول أحدهم أن يدوس عليه، ولكل طفلٍ ظنّ أن العالم بلا سماوات.
كانت تقول:
“ليس الخطأ فيكِ.. ولا الخطيئة لكِ.. ولا العار يسكن جسدكِ، بل يسكن أيدي من اعتدى عليك. قاومي.. ولو لم يبقَ منكِ إلا نفسٌ واحد.”
لم تكن حياة تحلم بالنجاة وحدها. كانت تحلم بالمعنى.
كانت تريد أن تُثبت أن المقاومة ليست حكرًا على الأقوياء، وأن الضعف نفسه يمكن أن يتحول إلى سلاح حين يرفض الانكسار.
عندما كانت تقاوم عمها والرجال الذين اقتحموا غرفتها واحدًا تلو الآخر، لم يكن لديها سلاح سوى جسدٍ مثخن وجدارٍ تتكئ عليه، وامل يتراءى بصيصه في البعيد.
ومع ذلك قاومت، قاومت حتى انفجرت حياتها كالشرارة الأخيرة في ليلٍ طويل.
ولأنها..
لم تستطع أن تكتب جملتها الختامية،
تركت دمها يقولها عنها.
الدم الأكثر صدقًا من الكلمات،
والأكثر قدرةً على البقاء.
الكلام قد يُزوَّر، وقد يُمحى، لكن الدم حين يجف على الورق يبقى أثره لا يُمحى إلا باحتراق الورقة كلها.
ولم تكن حياة، في تلك اللحظة، تفكر بالذين قتلوها، ولا بعمها الذي باعها، ولا بالرجال الذين ظنوا أنهم سيغسلون خطاياهم بالصلاة. كانت تفكر بمن سيأتي بعدها.
بالفتاة التي ستقرأ أوراقها ذات يوم، في غرفةٍ صغيرةٍ مشابهة، ربما مختبئة، ربما جريحة، وربما تحاول أن تفهم لماذا يُعامل العالم الأجساد الضعيفة كغنائم.
كانت حياة تقول لها:
“اكتبي..
قاومي..
اصرخي..
اتركي أثرًا...
لا تبقي سجينة لأحد.”
ولعلّ دمها، حين صبغ الورقة، لم يكن شهادة موت، بل شهادة حياة. كأنها تقول:
"جسدي رحل..
لكن قصتي تبدأ الآن".
أدركت وأنا أتأمل البصمة أن حياة لم تكن تبحث عن الخلاص، بل عن الخلود.
أرادت أن تُخلد لا كنبيه ولا كبطلة،
بل كصوتٍ انكسر ولم ينطفئ،
كجرسٍ خفيفٍ يدق في الظلام ليهدي غيره للطريق.
ولم تكن الورقة العاشرة مجرد نهاية لسردها، بل كانت بداية لرسالة لا تُقال، بل تُفهم.
ورغم أن الكلمات غابت عنها،
بقيت الورقة الأكثر امتلاءً بين كل الأوراق..
لأن الفراغ، حين يُخَتَم بالدم،
يتحول إلى صرخة كاملة.
وها أنا اليوم أقف أمام تلك الورقة الأخيرة، كأنني على تخوم حياتين:
حياةٌ رحلت، وحياةٌ أخرى تُولد من رمادها.
كلما تأملتُ البصمة الممهورة بدمها، شعرت أن حياة، في لحظتها الأخيرة، لم تكن تموت.. بل كانت ترفع إليّ وهجًا أثقل من الروح وأبهى من البقاء.
كانت تُسلّمني وصيتها الأعمق، شيئًا أكبر من جسدها المكسور وأوسع من سنواتها القليلة. كانت تمنح كل فتاةٍ اغتُصبت صوتًا، وكل امرأةٍ قُهرت جناحين، وكل طفلةٍ ارتجفت خلف بابٍ مغلق نافذةً صغيرة على الضوء.
لم تكن حياة تطلب النجدة يوم عانقت الموت، بل كانت تطلب الشهادة، أن يجد ظلمها من يروي تفاصيله، وأن تجد صرختها من يحفظ صداها.
وكانت البصمة وحدها، فوق صفحةٍ فارغة، كافية لأن تُسمِع العالم أجمع ما لم تستطع حروفٌ كثيرة قوله.
حين أطبقتُ أصابعي على الحرز الذي تركته لديّ، انطلقت دموعي بلا إرادة، دموعٌ ساخنة حملت كل ما شهدته في تلك الليالي التي كانت فيها مريضتي، وكل ما عرفته عن قلبها الشجاع الذي كان يخفق رغم الانكسار، وعن ذلك اليقين المرير الذي كان يسكن عينيها كمن يتوقع نهايته ويقرأ الغيب في تضاريس مصيره.
أتذكرها في أواخر أيامها حين همست لي بصوتٍ أرهقه النزف:
"إذا لم أخرج من هنا..
خبري عني
أنّي قاومت".
كانت تعرف..
كانت تستشعر أن النهاية أقرب من أي دواء، وأن يد الموت تمتد لها من خلف الباب، ومع ذلك لم تسأل عن نفسها، بل عن قصتها؛ عن تلك الأوراق العشر التي خبأتها بقلقٍ يليق بالأسرار، كأنها تخشى أن تُسرق حكايتها مرة أخرى كما سُرق منها حقّها في الحياة.
ولم أفهم سرّ إصرارها إلا الآن، لحظة وقوفي أمام وصيتها، لحظة شعوري بأن دمها على الورقة ليس علامة موت، بل توقيع حياةٍ جديدة تُولد من جسدها الغائب.
لوهلةٍ شعرت أن حياة لم تكن تكتب لنفسها، بل لكل من تم تجاهل أنينها وخنق صوتها ودفنت مأساتها في صمت البيوت.
فما حدث لها ليس قصة تُروى للدهشة، ولا مأساة فردية تنتهي بآخر صفحة.
ما جرى لحياة يمكن أن يحدث كل يوم، خلف جدران لا نرى خلفها، في غرفٍ مغلقة لا تسمع العالم، وفي بيوتٍ تُطفأ فيها الأرواح كما تُطفأ المصابيح عند آخر الليل.
حياة ليست استثناءً؛ إنها مرآة لآلاف الأجساد التي تُعذَّب بلا صوت، وعشرات الأرواح التي تُزهق بلا اسم، وأحلامٍ تُقمع بلا جنازة.
ولذلك، حين أكملت العشر ورقات، شعرت أنني لا أغلق قصة، بل أفتح عهدًا.
عهدًا أعقده مع فتاةٍ غابت جسدًا وبقيت أثرًا، أن قصتها لن تُدفن معها؛ أن صمتها لن يُبتلع مرة أخرى.
يا حياة:
أعدك
أنّي سأكتب قصتك كما أردتِ،
صدقًا بلا رتوش،
وعمقًا بلا تزييف،
وقسوةً كما كانت.
سأكتبها لتكون صرخة، لا أنينًا. نارًا، لا دموعًا.
وسأضعها أمام العالم كما هي:
حقيقةً لا خيالًا، قدرًا لا مبالغة، وجعًا يحدث كل يوم ولا يلتفت إليه أحد.
سأكتبكِ...
لأنك تستحقين أن تُكتبين.
وسأنشركِ...
لأن العالم يحتاج أن يرى ما يختبئ خلف أبواب مغلقة، وما يُرتكب في العتمة باسم العيب والخوف والصمت.
وسأخلّدكِ..
لا كمأساة تبكيها العيون ثم تنساها، بل كقوة. كجسدٍ قاوم حتى آخر نفس، كروحٍ رفضت الإنطفاء، كفتاةٍ علمتني أنّ الدم حين يختلط بالحقيقة يصبح شهادة لا تُمحى.
ها أنا، اليوم:
أكتب ..
اكتب، ليست نهاية حياة.
إنها بداية الصرخة التي تركتها خلفها.
بهذه البصمة..
بهذه الورقة الفارغة التي امتلأت بدمها..
بهذه الوصية التي سلّمتني إياها وهي تعبر من عالمٍ إلى آخر..
أعلن أن حياة لن تُنسى.
ولن تُدفن قصتها.
وما دامت كلماتها قد وصلت إليّ، فسأجعلها تصل إلى العالم كله.
سلامٌ لروحك يا حياة.
سلامٌ لدمك الذي صار حبرًا.
سلامٌ لصرختك التي تحولت رسالة.
وليعلم الجميع..
أن حياة...
وإن رحلت،
قد تركت أثرًا لا يزول.
***
سعاد الراعي - المانيا