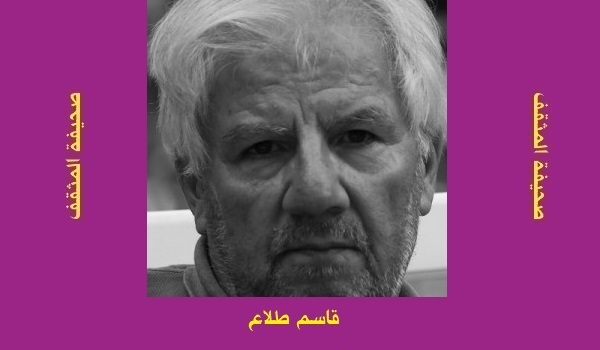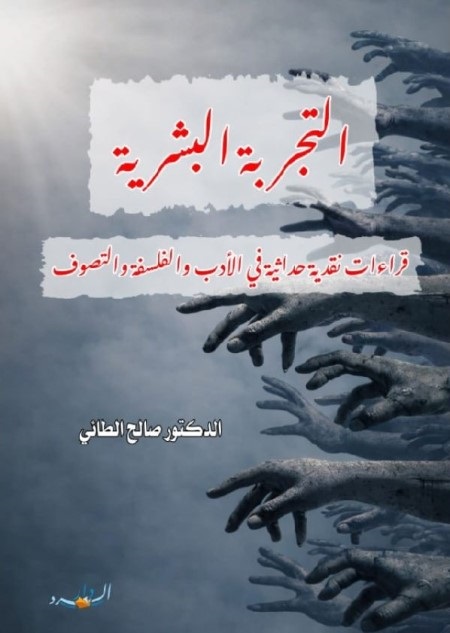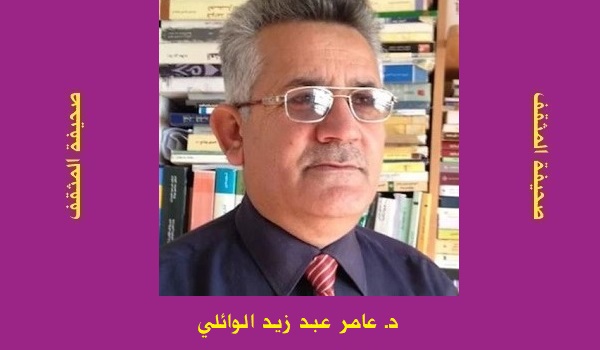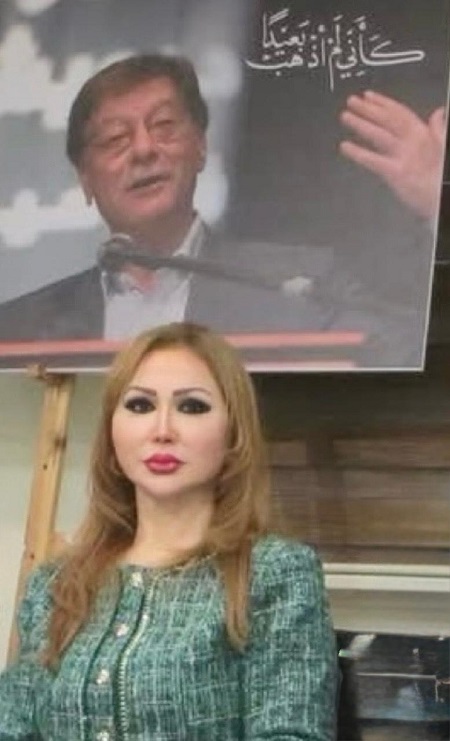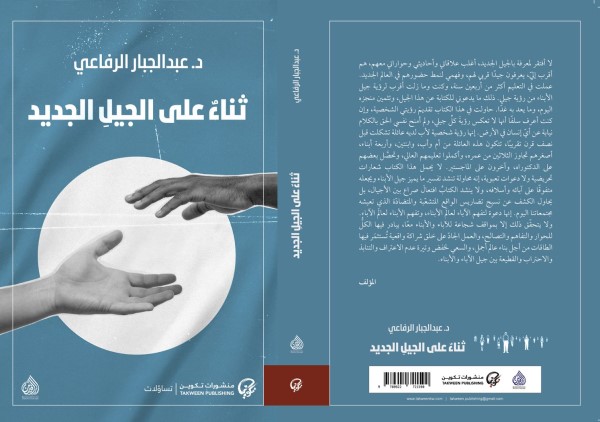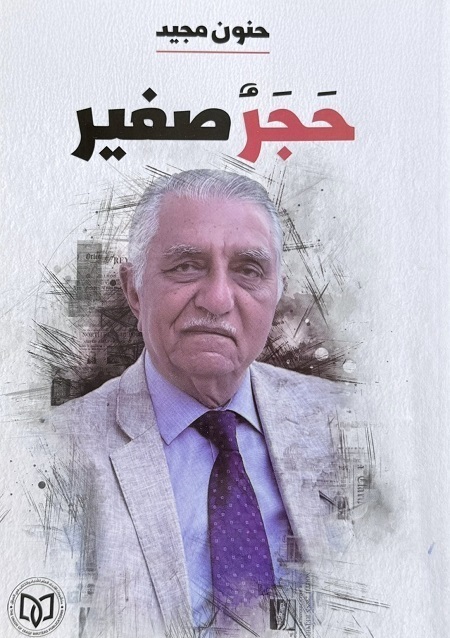للدكتور صابر مولاي أحمد
هذا الكتاب: مساهمة معرفية ومنهجية في الكشف عن علاقة القرآن الكريم بما سبقه من الكتاب وفق رؤيته الداخلية، ملمحا إلى الآفاق الرحبة التي يمكن أن تفتحها هذه العلاقة في الحوار والتواصل بين الأديان المختلفة بهدف تحقيق السلام العالمي والحوار بين الأمم والحضارات، والعيش السلمي المشترك، وإصلاح المجتمعات الإنسانية، فالكتاب يتضمن نقد السردية التوراتية (العهد القديم) التي ربطت موضوع العهد بالأرض وأفرغته من كل مضمون قيمي وأخلاقي، والتي جعلت من الإله إله متحيز لبني إسرائيل على حساب غيرهم من الناس.
مفهوم الهيمنة في القرآن الكريم، بعيد كلّ البعد عن مفهوم التسلط والسيطرة والتَّحكم، وقريب من مفهوم الائتمان والرحمة والاعتراف بالأديان والكتب السابقة.
فكرة الكتاب
صدر للأستاذ الباحث الدكتور صابر مولاي أحمد (من المغرب)، في السنوات الأخيرة كتابا هاما في حقل الدراسات القرآنية بعنوان، منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم: سورة البقرة أنموذجا. الكتاب يتضمن قراءة معرفية للآية 48 من سورة المائدة تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه﴾ (المائدة/48). فالمؤلف يرى: "أن القرآن يتضمن اعترافًا "مصدقا" بما سبقه من الكتاب قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19)﴾ (الأعلى) ولم يتوقف القرآن عند الاعتراف "التصديق" دون أن يربطه بوعي منهجي مفاده، أنه كتاب "مهيمن" على ما سبقه من الكتاب، وأنه خطاب للناس جميعاً ورسالة عالمية وكونية، وليس حكراً على أحد دون آخر. فمصطلح الهيمنة، حاضر ومتداول بشكل كبير في العلوم السياسية، فنقول الهيمنة الأمريكية أو الهيمنة الأوروبية؛ بمعنى سيطرة مجموعة على أخرى، أو سيطرة دولة على مجموعة من الدول. أما مفهوم الهيمنة في القرآن، فبعيد كلّ البعد عن مفهوم التسلط والسيطرة والتَّحكم، وقريب من مفهوم الائتمان والرحمة والاعتراف؛ فالله عـز وجل احتفظ لنفسه بفعل الهيمنة، فلا مهيمن قبله ولا بعده، لكن خص القرآن فقط بهذا الوصف دون غيره من الكتب التي سبقته، وصفة التصديق يشترك فيها القرآن مع ما سبقه من الكتاب".[1]
موضوعات الكتاب
يتكون الكتاب من بابين أساسيين، كما يتكون كل باب من فصلين، ويتكون كل فصل من عدة مباحث، مع تقديم ومقدمة ومدخل يوضح فيه صاحبه موضوعه وهدفه ومنهجه، بالإضافة إلى خاتمة عامة وقائمة بأهم المصادر والمراجع، مع فهرس للموضوعات.
ومن حسنات هذا الكتاب أنه لم يحرمنا من متعة الاتصال المباشر بالنص الديني الأصلي الذي حقق الوصال معه. أما القيمة المضافة في هذا الكتاب فتتمثل أساسا في الكشف عن علاقة الوصل والفصل بين القرآن والنصوص الدينية الأخرى، وتجشم عناء الفحص الداخلي للقرآن بهدف الكشف عن تلك العلاقة. فهل ما قال به أحمد صابر يراعي الإنصاف في طبيعة تلك العلاقة؟ وهل لنا أن «نتحرى محل النزاع»، بينه وبين غيره من الدارسين لهذه العلاقة في هذه القضية تدقيقا وتعيينا وحصرا؟
لقد شاء الباحث في هذا الكتاب، الذي يتأطر في إطار علم مقارنة الأديان، الاشتغال على القرآن الكريم- دون السنة النبوية التي تحتاج إلى بحث مستقل- باعتباره النص التأسيسي الأول الذي لا ينضب معينه للعلماء والنظار والفلاسفة والباحثين، قديما وحديثا، لفهمه وتأويله واستثماره لتحقيق الخلاص والسعادة الإنسانية، خاصة وأن القرآن الكريم حمال أوجه، وصالحا لكل زمان ومكان، وبالتالي يوجب النظر إليه "باعتباره كتابا مفتوحا على الكون والإنسان والتاريخ والمجتمع، ما يجعله في استجابة مستمرة لأسئلة العصر، وقضاياه المعرفية"[2].
وقد شاء الباحث أن يتخذ من مفهومي «التصديق والهيمنة» مفتاحا أساسيا للولوج إلى نسق النص الديني والارتماء في أحضانه، وتذوق روحه، باعتبارهما – أي التصديق والهيمنة- الثابت الذي عليه المتحرك من المفاهيم الأخرى، والمدار الذي تلف حوله في تأثير وتأثر، وانفعال وتفاعل يطبعه التناغم والتناسق والانسجام، مع ضرورة التنبيه إلى أن هذه المفاهيم ليست أرخبيل من جزر متفرقة ومبعثرة ومستقلة عن بعضها البعض، ولكنها تنتظم في سلك المفاهيم القرآنية الأخرى التي تشكل نسقا مفتوحا ومرنا متكاملا و متعاضدا ومتآزرا يشد بعضه أزر البعض الآخر.
ويمكن القول بأن هناك جملة من القضايا التي تلملم شتات النصوص الدينية المقدسة من قبيل: الاجتماع الإنساني وتاريخ الخلق والخليقة والقصص النبوي وسؤال النشأة، وغيرها من القضايا الأخرى التي تشكل القاسم المشترك أو الجامع بينها، بيد أن هذا المشترك لا ينبغي أن يتخذ ذريعة للتضحية أو التشطيب على خصوصيات ومقومات وبنيات كل نص على حدة. ذلك أن القرآن لا يخلو من إحكام وتوثيق ودقة منهجية ونأي عن الاختلاف والتعارض وخصوصيات منهجية ومعرفية مميزة له وتفصله عما عداه. "وبهذا، يكون القرآن محفزا ودافعا لقراءة النصوص المؤسسة قراءة منهجية، بدل إسقاط خصوصيات بعضها على بعضها الآخر"[3]. وإذا كان بعض المستشرقين قد تعاملوا على قدم المساواة مع هذه النصوص المقدسة، فإن هذا التعميم قد نأى بهم عن جادة الحق والصواب، وأوقعهم في بعض المطبات التي يصعب فيها الفصل بين الهدى والنور من جهة والتبديل والتحريف من جهة أخرى. "إذ من التعسف العلمي والمنهجي، أن ينظر إلى القرآن الكريم، وهو يعرض على البشرية وغير ذلك من الموضوعات، دون استحضار أنه كتاب يتصف بخصوصية منهج التصديق والهيمنة على ما قبله من الكتب، وهو منهج قد أخص الله به القرآن دون غيره من الكتب"[4].
وبناء عليه، يمكن اعتبار منهج التصديق والهيمنة شعار هذه الدراسة التي تتغيى الكشف عن طبيعة العلاقة بين القرآن والكتب السابقة عليه التي يقف شاهدا ومؤتمنا عليها حسب جل أو كل المفسرين. ولذلك كان لزاما على الباحث أن يتساءل عن هذا المنهج وأسسه لأنه يمثل العمود الفقري لهذه الدراسة ويمكننا من فهم ما جاء يه القرآن في تداركه ومراجعته النقدية للكتب المقدسة السابقة وتقويم وتصحيح تحريفها وما بدل فيها. فالغاية من هذه المراجعة التصحيحية النقدية التي وقفها القرآن حيال الكتب السابقة فيما يخص مجموعة من القضايا التي تعرضت للتدليس والتزييف تتمثل في الكشف عن المشترك الإنساني العام بدون غلط أو تغليط، "إذ من الأولى أن نعود على هذا المشترك عودة يحضر فيها الحق بدل الباطل والأهواء"[5].
المقاربة المنهجية المعتمدة من لدن المؤلف
يمكن القول بأن مقاربة الباحث لا تخلو من التحليل والمقارنة التي هي أساس الفهم والكشف عن القيمة المضافة في القرآن، واقتناص الدلالة من القرآن نفسه الذي هو المبتدأ والمنتهى في هذا الكتاب الذي حاول فيه صاحبه اقتناص دلالات العديد من المفاهيم من السياق الكلي للنص القرآني توخيا للوحدة النائية وللرؤية الكلية والتوحيدية والمتكاملة، وتلافيا للرؤية التجزيئية. "وعليه، يقتضي المطلب المنهجي التعاطي في فهم القرآن في كليته، بدل أخذ بعض منه، والإعراض عن بعض، علما بأن كل سوره وآياته تشكل وحدة عضوية متماسكة يتوقف أولها على آخرها، وآخرها على أولها"[6]. ولذلك، فأحرص ما يحرص عليه الباحث في هذا الكتاب هو الرؤية الكلية والمتعددة الأبعاد، أو «الرؤية التوحيدية» بتعبير محمد أركون[7]، بدل الرؤية التجزيئية والأحادية والإنعزالية، أو«الرؤية القصيرة النظر» التي «تقتل في المهد إمكانات الفهم والتأمل»، حسب بعض عبارات إدغار موران المكثفة والموجزة.
لقد سعى المؤلف بخطى حثيثة إلى تحديد مجموعة من المفاهيم على ضوء البنائية القرآنية، "وذلك بالحرص على تجلية المعاني الكلية، من خلال تتبع جزئيات المعاني التي تصب وتجتمع فيما هو عام وكلي، وعيا منا بكون القرآن الكريم يشكل وحده حقلا دلاليا مستقلا عن غيره من الحقول الدلالية الأخرى"[8]. وهكذا رمى بنا المؤلف في ثنايا هذا الكتاب في لجة الحقل الدلالي المتميز والمتفرد والفذ للنص القرآني الذي له معان تشكل خاصيات لصيقة به تميزه عن باقي الحقول المعرفية الأخرى، وفي مقدمتها الشعر العربي واللغة العربية التي لم يكن فيها لمجموعة من الكلمات من قبيل: الله، إسلام، إيمان، كافر، كتاب، إلخ، الحظوة والرئاسة والثقل الدلالي الذي أكسبه إياه القرآن الكريم عندما أسبغ عليها معاني ودلالات وحمولات معرفية جديدة كل الجدة. وفي هذا الصدد يميز المؤلف بين ما يسميه بمستوى المعنى الأساسي من جهة أولى، ومستوى المعنى العلاقي من جهة ثانية. "فالأول يكون أساسيا في معنى الكلمة، أما الثاني، أي: العلاقي، فهو المعنى الذي تكتسبه الكلمة داخل الحقل الدلالي القرآني في علاقتها بالكلمات الأخرى"[9]. فالقرآن لا يخلو من نظم لغوي خاص به يستلزم علينا العودة إليه لفهم مصطلحاته من داخله، ويتوقف المؤلف عند جملة من المفردات، نورد منها اسم الكتاب الذي هو جنس تحته أنواع من الكتب المختلفة التي هي القرآن بالنسبة للمسلمين والإنجيل بالنسبة للمسيحيين، والتوراة بالنسبة لليهود، "وتترتب على هذا التمييز، من حيث التسمية خصوصيات تميز كل كتاب عن الآخر من حيث السبق التاريخي، إذ يحتضن الكتاب الموالي الكتاب الذي سبقه"[10].
إن القرآن كتاب مفتوح وعام وكوني وعالمي وجامع وشامل لما قبله من الكتب التي صدق الحق الذي جاء فيها وصحح الباطل الذي تسرب إليها، وميز النور عن الباطل، والهدى عن الضلال، والصحيح من التزييف، والحق عن الأهواء، وفرق الحنطة عن الزؤان، والوردة عن الشوك، والشهد عن إبر النحل، لا يختص بزمان أو مكان أو شعب معين، يشكل الرسالة الخاتمة التي لا رسالة بعدها. وهذا ما يجعله نصا متميزا ومتفردا ووحيد جنسه، وفريد نوعه، "وهذا يعني أن عالمية الخطاب القرآني تقر التعددية الدينية وفقا لمبدأ الحرية[...] فالإنسان هو المخلوق الوحيد، الذي يتصف بالحرية والمسؤولية عن أفعاله"[11].
إن الصورة التي خطها القرآن الكريم للكتب السماوية هي صورة الإيمان بالحق المتضمن بين دفتيها، وتعرية التحريفات التي تسربت إليها، ويحددها المؤلف في الإيمان بها وتصديقها والهيمنة عليها مع الكشف عن التحريفات وفضحها[12]. وهي صورة تشكل في الآن عينه همزة وصل وهمزة قطع بين القرآن وهذه الكتب السماوية. وقد عزز المؤلف هذه الصورة بمجموعة من الآيات القرآنية المركزية لهذه الصورة الواصلة والفاصلة. وإذا كان القرآن قد اعترف بالحق الوارد في الكتب السماوية واشترك معها في هذا الجهر بالحق، فإنه كشف عن التزوير الذي تخللها وانهال عليها بالمراجعة النقدية. وقد أورد المؤلف- اعتمادا على مجموعة من الآيات القرآنية- الآليات والمسالك التي سلكها المبطلون في تحريف كتبهم، "فبالإعراض عن العقل ودوره في القراءة والفهم والتحليل، وبالنسيان والتجاهل للحقائق بإخفائها واستبدالها بغيرها كذبا وزورا، يفقد الكتاب المقصود والغاية والرسالة التي جاء من أجلها، وتحل الأهواء محل الغايات والمقاصد الكبرى"[13].
الدراسات القرآنية في الفكر العربي المعاصر
فما هي علاقة القرآن بالكتب السماوية في الفكر العربي المعاصر؟ لقد اختار المؤلف نماذج دالة ووازنة في الفكر العربي المعاصر، من طينة محمد أركون، ووزن نصر حامد أبو زيد، وحجم محمد عابد الجابري. فلنبدأ بادئ ذي بدء بالمرحوم محمد أركون الذي لم يتردد المؤلف في رجمه بحجارة النقد الخفيفة، بالنظر إلى أن محمد أركون ظل في السماء المجردة والعالية لنطاق الدعوة إلى توظيف المناهج الحديثة دون النزول بها إلى أرض التطبيق والممارسة، كما انهال بالمطرقة – وهذا هو بيت القصيد ومربط الفرس – على وجهة النظر الأركونية لطبيعة العلاقة التي تربط القرآن الكريم بالكتب المقدسة. فأركون "لا ينظر إلى القرآن كونه يتميز عن غيره من الكتب بخاصية التصديق والهيمنة، بل اكتفى أن يعترف له بأنه يهضم ما قبله"[14]. ويردف المؤلف قائلا: "والغريب في الأمر أن أركون يعترف للقرآن بتميز إبداعيته وأصالته، ولكن تميزه هذا، في نظره، لا يشفع له أن يكون مهيمنا ومصدقا لما قبله من الكتاب"[15]. وهكذا يضع أركون الأديان السماوية الثلاثة كلها على قدم المساواة دون تمييز أو تفضيل أو ترجيح، مع الدفاع عن وجود متخيل ديني مشترك في النصوص التأسيسية لهذه الأديان. "وبهذا، لا يعترف محمد أركون للقرآن بخصوصية الاسترجاع النقدي على ما قبله، وليس من الغريب أن نجده ينظر إلى نصوص القرآن الكريم النظرة نفسها، التي ينظر بها إلى النصوص الدينية الأخرى، وهذا، في تقديرنا، فيه قفز وتجاوز للخصوصيات المصاحبة لبنية أي نص ديني، من حيث تاريخ تدوينه، ومن حيث نظامه الداخلي، ومن حيث القضايا والموضوعات التي عالجها، ومن التعسف المنهجي أن نسقط خصوصيات الكتاب المقدس على القرآن الكريم"[16].
كما ينتقل المؤلف إلى الحديث عن الموقف الفكري المنهجي لنصر حامد أبو زيد تجاه القرآن، مبينا أن النص عند هذا المفكر يطلق بالاشتراك المتساوي على النص الإلهي والنص البشري بدون تقديم أو تأخير لأحدهما على الآخر، وبالتالي يصبح من الاستحالة بمكان فهم النص بمعزل عن الملابسات الفكرية التي تبلور فيها أو الحيثيات الثقافية التي تشكل فيها، والاقتصار على بنيته الداخلية فقط. ولذلك يخلص المؤلف صراحة من خلال فحصه لكتابات نصر حامد أبو زيد إلى أن علاقة القرآن بما قبله هي الغائب الأكبر في مؤلفات هذا الرجل، و"وبهذا يكون نصر حامد أبو زيد قد لجم نفسه عن الحديث، والخوض في موضوع الاسترجاع النقدي، الذي قام به القرآن في علاقته بما سبقه من الكتب، مع العلم بأنه استفاض في الحديث حول التفسير، وعن الاتجاه العقلي فيه"[17].
وفي الأخير يصل المؤلف إلى محطة هامة في الفكر العربي المعاصر، عندما يمثل لها بالمفكر المغربي محمد عابد الجابري الذي بذل جهدا جهيدا لتحديد طبيعة العلاقة المنهجية التي يجب أن تجمعنا بالقرآن الكريم الذي يختلف عن التوراة والإنجيل من جوانب جمة، لعل أهمها وبيت القصيد فيها يتعلق باللسان العربي المبين والمعجز، بالرغم من المحتوى والمصدر الواحد لهذه الكتب السماوية، الذي هو اللوح المحفوظ. ورغم إقرار الجابري بخاصية تصديق القرآن لما قبله، فإن خاصية هيمنة القرآن على تلك الكتب تظل الغائب الأكبر في مؤلفات الرجل. "لم يبين لنا الجابري الأبعاد المعرفية والمنهجية لتصديق القرآن ما قبله !![...] ما الفائدة، إذا، من تصديق القرآن ما تضمه تلك الكتب، التي تم تبديل أمر الدين فيها؟ أيعني هذا أن القرآن مصدق لها في كل شيء، أم أن تصديقه هنا يرتقي إلى مستوى هيمنته على تلك الكتب، وهي خاصية تخص القرآن وحده، دون غيره من الكتب؟ هذا هو الأمر المغيب عند الجابري في حديثه عن علاقة القرآن بما قبله من الكتاب"[18]. وهذا ما أو قع الجابري، رغم تميزه عن محمد أركون ونصر حامد أبو زيد، في المقاربة التجزيئية بدل المقاربة الكلية المتكاملة للقرآن الكريم، "والذي جعل الجابري، في تقديرنا، يعرض عن القول بكون القرآن يتصف بالمراجعة النقدية لما قبله من الكتاب، وبأن خاصية التصديق والهيمنة، خاصية تخص القرآن دون غيره من الكتب التي سبقته، هو كونه لم يتعاط مع فهم القرآن من خلال وحدته البنائية، بل رهن نفسه بفهم القرآن بترتيب النزول، ما أسقطه في الفهم ألتجزيئي بدل الكلي لكثير من القضايا المنهجية ، وعلى رأسها إغفال بيان أن القرآن مصدق ومهيمن على ما قبله من الكتاب"[19].
قراءة في سورة البقرة
بيد أن معالم الصورة التي يروم الباحث رسمها لمشروعه الفكري في هذا الكتاب الذي نقوم بفحصه وتمحيصه وتقليب أنظارنا في صفحاته ستظل ناقصة، إذا ما تجاهل الجانب التطبيقي، ولذلك كان لزاما عليه، بعد أن أشبع القول في الجانب النظري، أن يولي بوجهه شطر الجانب التطبيقي، فطول أنفاسه، ليربط ببن النظرية بالتطبيق، ويرد العجز على الصدر، ويحقق غرض الفهم الحقيقي المتكامل بالرغم من وعيه بصعوبة المهمة، إذ بعد أن فرغ المؤلف من الجانب النظري لمنهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم، انتقل إلى الجانب التطبيقي من البحث، منكبا على الموضوعات الأساسية لسورة البقرة التي هي مرآة مجلوة تتلألأ على أديمها أوجه تصديق وهيمنة القرآن على ما قبله من الكتب السماوية السابقة عليه. وهكذا عمل الباحث على التعريف بسورة البقرة، والسياق التاريخي الذي صاحب نزولها، والموضوعات الأساسية التي عالجتها، والتي حازت فيها علاقة بني إسرائيل بالأنبياء والرسل على نصيب الأسد منها. فسورة البقرة جعلت من القوم المفلحين، والقوم الخاسرين، ومهمة الاستخلاف، باعتبارها الغاية من الوجود الإنساني، الموضوعات الأساسية والرئيسية فيها، ناهيك عن الخلافة وتجربة بني إسرائيل، وما عهد الله به لإبراهيم ومن تلاه. يقول المؤلف عن هذه المواضيع: "إن هذه الموضوعات المحورية، التي جئنا على ذكرها، وما تبعها من موضوعات فرعية، قد نظمت من خلال العمود المحوري للسورة، وهو التذكير بموضوع وحقيقة استخلاف آدم وذريته من بعده، فالخلافة لا تكتمل إلا من خلال الوفاء بالعهد الذي عهد الله به لبني آدم بالا يتبعوا خطوات الشيطان، وبأن يلتمسوا الهداية من التوجيه الرباني المتمثل في ما جاء به الأنبياء والرسل عليهم السلام، وخاتمهم محمد (ص)، كما هو مبين في مطلع السورة"[20].
وقد أناط المؤلف بكاهله قراءة موضوعات سورة البقرة على ضوء البنائية القرآنية، بحيث يشكل موضوع الخلافة في الأرض المدار الذي انتظمت من خلاله موضوعات السورة، فاستعرض التصحيحات والمراجعات النقدية التي تضمنتها سورة البقرة للعهد القديم فيما يتعلق بموضوع الخلافة في الأرض، وحقيقة ما عهد الله به لإبراهيم ولذريته من بعده. وقد فرضت عليه القراءة البنائية للقرآن عدم عزل سورة البقرة عن بقية السور القرآنية الأخرى لتقديم صورة دقيقة وأمينة ومتكاملة عن الموضوعات المعالجة من داخل بنية النص القرآني في كليته. ولم يتردد المؤلف في إلقاء اللوم ومؤاخذة مجموعة من المفسرين لقضية استخلاف آدم، وفي مقدمتهم الطبري الذي نقل عنه أغلبهم. "مع الأسف، نجد أن الزمخشري وابن كثير والطاهر بن عاشور، بقدر معين، لم يخرجوا عن الإطار الذي رسمه الطبري للموضوع، متأثرا بما جاء في العهد القديم. وكما أشرنا سالفا، يطرح هذا الأمر أمامنا مشكلة منهجية خطيرة تتعلق بفهم القرآن، إذ من المفترض فهم القرآن من خلال نظمه وسوره وآياته، بدل الاستعانة بما تم تحريفه وتبديله من نصوص العهد القديم (التوراة)، التي جاءت التي جاءت نصوص القرآن لترفع الضرر عما تم تبديله وإخفاؤه في تلك النصوص، وإلا فما الفائدة من منهج التصديق والهيمنة الذي يتصف به القرآن عن غيره؟ !"[21].
وقد وقف المؤلف مليا عند الاسترجاع النقدي الذي مارسه القرآن على العهد القديم فيما يخص موضوع الاستخلاف، وهو بيت القصيد، من خلال عقد مقارنة بين صورتيهما لهذه المسألة، ليخلص إلى "أن القرآن الكريم قد عمد إلى بناء الموضوع من جديد، وذلك بالعمل على تحريره مما لحق به من الزوائد والإضافات، التي ليست من صلبه، فقد أظهر القرآن الكريم ما أخفته نصوص العهد القديم من الحقائق، والغايات، والمقاصد المرتبطة بموضوع استخلاف آدم"[22]. والعمل نفسه قام به المؤلف أيضا بالنسبة لموضوع العهد مع إبراهيم، من خلال عقد مقارنة بين صورتيهما لهذه المسألة، ليخلص إلى "كون القرآن يصدق العهد القديم من حيث عنوان الموضوع الموسوم بعنوان «عهد الله لإبراهيم»، ولكن القرآن الكريم، لا يتوافق بشكل جذري، مع مضامين الموضوع، وحيثياته، وتبعاته، كما هي واردة في العهد القديم، إذ هيمن القرآن على الموضوع، وحرره من كل الزوائد والشوائب التي أدخلت عليه، وأبعدته عن كل ما هو غائي ومقصدي، وله علاقة بالفضائل والقيم والأخلاق الرفيعة التي تفضي إلى البر والخير"[23].
ولم يفت المؤلف إلى أن يتطرق إلى طباع بني إسرائيل في سورة البقرة المتمثلة في نقض العهد، وقداسة التاريخ، وإخفاء الحقيقة، وسفك الدماء في ما بينهم، مع التركيز على المشترك الإنساني، "في الوقت الذي نجد فيه نصوص العهد القديم متحيزة لذرية إبراهيم، ولا سيما نسل إسحاق، على حساب مصالح العباد، وقد جعلت من الخالق – سبحانه – إلها متحيزا لبني إسرائيل دون غيرهم من الناس، نجد نصوص القرآن يطبعها الانفتاح على الناس جميعا، وتحمل أبعادا أخلاقية يتساوى، من خلالها كل الناس، في علاقة بعضهم ببعض، وفي علاقتهم بالأرض وبالخالق"[24].
فسورة البقرة «عينة دالة» لسور القرآن الكريم، وتمثل «الرادار» الأكثر قدرة على التقاط ذبذبات التطبيق، عملا بالآية الكريمة «قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»[25]، ووفاقا مع قول الشاعر:
والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء
وبهذا يتبين لنا، أن حسابات البيدر (الجانب التطبيقي) مطابقة لحسابات الحقل (الجانب النظري).
خاتمة
من خلال ما ذكرنا من مواقف ومجالات، يتبين لنا بأن منهج التصديق والهيمنة له مظهران أو وجه وقفا (كما يقال عن قطعة النقد الواحدة): وجه الهيمنة من جهة، ووجه التصديق الذي نبه إلى سكوت بعض الدراسات المعاصرة عنه من جهة أخرى. فهذا المنهج هو الهاجس الذي استبد بالباحث مولاي صابر أحمد في هذا الكتاب الذي ارتأى "أن يعالج منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم معالجة غير مسبوقة، فهو قد محض الجهد لضرب من الاسترجاع النقدي والتأويلي، داخل التنزيل الحكيم، لعلاقة القرآن بالعهد القديم، فنحا في ذلك منحى لا يجري وراء مسلمة الهيمنة القرآنية، وإنما يرسم تلك العلاقة في أفق المشترك الإنساني الذي يجتهد في بنائه التاريخ، فتبدو سورة البقرة في هذا المنظور المبدع، وكأنما نكتشفها من جديد آية آية، وإنما ينشد القرآن هذا المشترك الإنساني، ولذلك جاء مصدقا...ومهيمنا..."[26].ونحن نعتقد جازمين، بأن فضيلة هذه الدراسة تكمن في الرجوع إلى المصادر والنصوص الدينية التأسيسية الكبرى التي عول عليها الباحث دون وسائط تأوبلية أو تبسيطية، وجعل منها نقطة الانطلاق الإجبارية للحديث عن منهج التصديق والهيمنة، لا من الناحية النظرية فحسب، ولكن أيضا من الناحية التطبيقية والأفق الذي رسمه الباحث لنفسه، إذ "لا يؤخذ الشيء إلا من مصادره" حسب «عجز» بيت شعري للأخطل الصغير بشارة الخوري في رثاء شوقي، و«البحر مستغن عن النيل و دجلة والفرات»، والمثل يعلمنا أنه «لا ينبغي أن نستقي من الساقية إذا أمكننا أن نستقي من النبع». وإذا كان الباحث قد آخذ بعض الدراسات المعاصرة في تناول علاقة القرآن بالكتب السابقة من خلال الوقوف فقط عند عتبة الهضم والتميز والأصالة عند محمد أركون، وسقف التفسير والاتجاه العقلي عند نصر حامد أبو زيد، ومرتبة التصديق الذي كان حضوره لافتا عند محمد عابد الجابري دون الكشف عن الهيمنة، وهو ما غيب أي أثر لهيمنة القرآن على الكتب السابقة لدى هؤلاء!
فإننا نعتقد بأن ذلك يعود بالأساس إلى اختلاف فهم المفاهيم والمنطلقات والبدايات والاختيارات والخلفيات والمناهج والتخصصات بين الباحثين. ولا شك أن أجناس القول قد تختلف وتفعل فعلها بين الباحثين المعاصرين. وكما يقال: «شعراء ولكل واحد منهم بحر»، و«بلغاء ولكل واحد منهم أسلوب»، و«علماء ولكل واحد منهم مذهب»، رغم أن «أهل كل صنعة هم أخلق بالكلام عنها»، كما قال ابن رشيق. "وجملة القول إن علاقة الإسلام بالديانات السماوية في صورتها المنظورة علاقة تصديق لما بقي من أجزائها الأصلية، وتصحيح لما طرأ عليها من البدع، والإضافات الغريبة عنها، [...]فهذا هو موقف الإسلام من الديانات الأخرى من الوجهة النظرية، [...] إن الإسلام لا يكف لحظة واحدة عن مد يده لمصافحة أتباع كل ملة ونحلة في سبيل التعاون على إقامة العدل، ونشر الأمن، وصيانة الدماء أن تسفك، وحماية الحرمات أن تنتهك، ولو على شروط يبدو فيها بعض الإجحاف، [...] هذا هو مبدأ التعاون العالمي على السلام... يقرره نبي الإسلام...ورسول السلام"[27].
وتبعا لذلك يمكن اعتبار كتاب منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم للدكتور مولاي صابر أحمد عمدة في الدراسات الإسلامية ولاسيما في علم مقارنة الأديان، بعد أن جعل الباحث من جناحي التصديق والهيمنة كبير المفاهيم ومفتاحها في فك مغالق العلاقة معدن القائمة بين القرآن والنصوص السابقة، أو العلاقة بين المحمدية وبين الموسوية والمسيحية، وموقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها، ملمحا إلى الآفاق الرحبة التي يمكن أن تفتحها هذه الدراسة في الحوار والتواصل بين الأديان المختلفة التي لا تخلو من العام والخاص في علاقة بعضها ببعض لتحقيق السلام العالمي والحوار بين الأمم والحضارات، والعيش السلمي المشترك، وإصلاح المجتمعات الإنسانية، وتحقيق سعادة الجماعة البشرية. وهنا تكمن ثمرة الأديان وفوائدها الظاهرة للفرد وللجماعة، كما نبه على ذلك فلاسفتنا القدماء ناهيك عن رواد عصر النهضة المتنورين، وفي طليعتهم الثائر جمال الدين الأفغاني في رسالة الرد على الدهريين!" فالباحث مولاي أحمد صابر يتصف بالقدرة على التتبع والقراءة، وعلى نظم المفردات والبناء عليها، وعلى النقد والمراجعة، وعلى الامتداد بالوعي وبالمدركات في مجالات المعرفة الفسيحة.. مما يجعله مبدعا مجددا باستمرار"[28]. وبناء عليه، يمكن اعتبار هذا الكتاب الذي هو مأدبة علمية يجتمع حولها كل راغب في معرفة علاقة القرآن بالكتب السماوية السابقة عليه.
***
الدكتور محمد أيت حمو
شعبة الفلسفة، كلية الآداب، ظهر المهراز بفاس/المغرب
....................
[1]- لقاء حواري مع د. مولاي أحمد صابر في كتابه: "القرآن ومطلب القراءة الداخلية؛ سورة التوبة نموذجا" حاوره د. حسام الدين درويش، موقع مؤمنون بلا حدود، بتاريخ: 11 أكتوبر 2024م https://www.mominoun.com/
[2]- مولاي صابر أحمد، منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم: سورة البقرة أنموذجا، (الناشر: مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2017)، ص 117.
[3]- مولاي صابر أحمد، منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم: سورة البقرة أنموذجا، (الناشر: مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2017)، ص 93.
[4]- المرجع نفسه، ص 31.
[5]- المرجع نفسه، ص 116.
[6]- المرجع نفسه، ص58.
[7]- يحذرنا محمد أركون من الانفصال عن «الرؤية التوحيدية للفكر» بالانغلاق داخل اختصاص واحد. فعلم الكلام مثلا ليس معزولا عن علوم أخرى مجاورة له، و يتصدرها علم أصول الفقه. "و بالتالي فكيف يمكن أن ندرس علم الكلام و نفصله عن كل هذه العلوم المجاورة له والمتداخلة أثناء العصور الوسطى؟"، محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني: كيف نفهم الإسلام اليوم؟، ترجمة و تعليق هاشم صالح، دار الطليعة للطباعة و النشر، الطبعة الأولى، نيسان (أبريل) 1988، ص. 106.
[8]- مولاي صابر أحمد، منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم: سورة البقرة أنموذجا، سبق ذكره، ص. 49.
[9]- المرجع نفسه، ص 50.
[10]- المرجع نفسه، ص 56.
[11]- المرجع نفسه، ص 139 – 140.
[12]- المرجع نفسه، ص 173- 174.
[13]- المرجع نفسه، ص 189.
[14]- المرجع نفسه، ص 192.
[15]- المرجع نفسه، ص 192.
[16]- المرجع نفسه، ص 192 – 193.
[17]- المرجع نفسه، ص 196.
[18]- المرجع نفسه، ص 198.
[19]- المرجع نفسه، ص 199.
[20]- المرجع نفسه، ص 217.
[21]- المرجع نفسه، ص 242 – 243.
[22]- المرجع نفسه، ص 267 – 268.
[23]- المرجع نفسه، ص 309.
[24]- المرجع نفسه، ص 318.
[25] ـ سورة البقرة، الآية: 111.
[26]- محمد محجوب، غلاف كتاب، منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم: سورة البقرة أنموذجا، تأليف مولاي صابر أحمد، سبق ذكره.
[27]- محمد عبد الله دراز، الدين: بحوث ممهدة لدراسة الأديان، دار القلم للنشر والتوزيع، كويت، الطبعة الثانية 1428ه – 2007، ص. 243 – 244 – 246.
[28]- سعيد شبار، تقديم لكتاب، منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم: سورة البقرة أنموذجا، تأليف مولاي صابر أحمد، سبق ذكره، ص. 17.