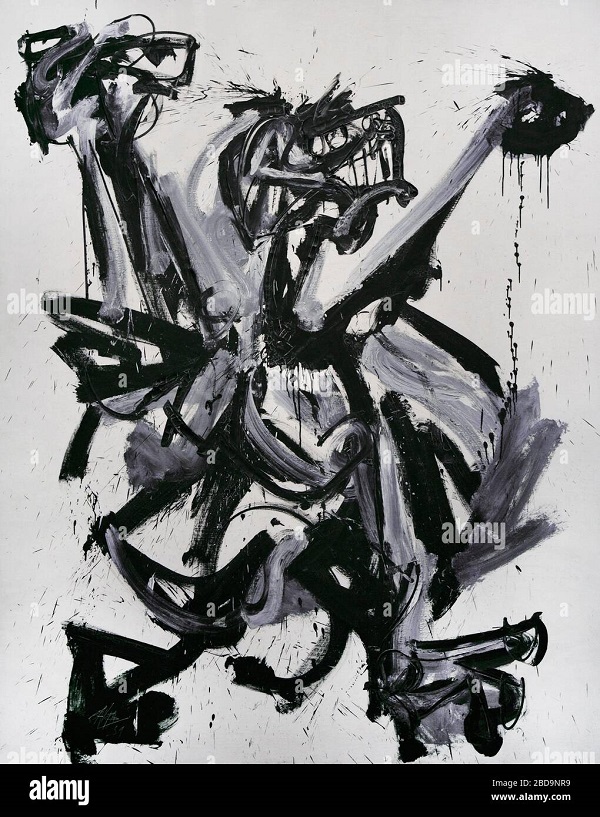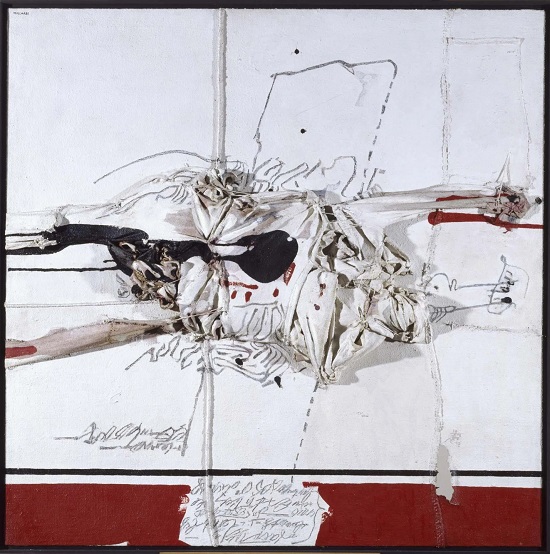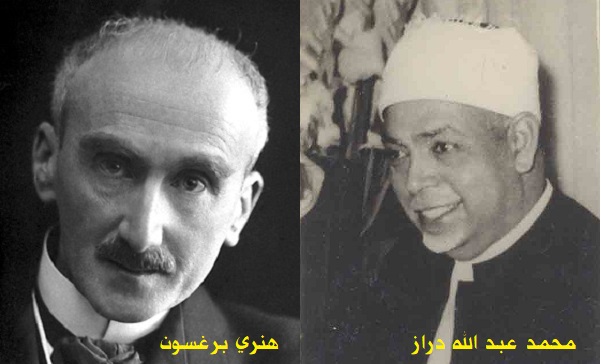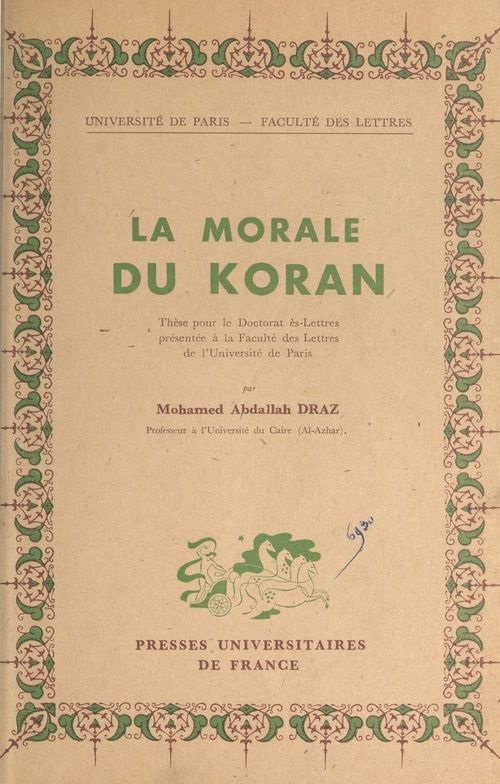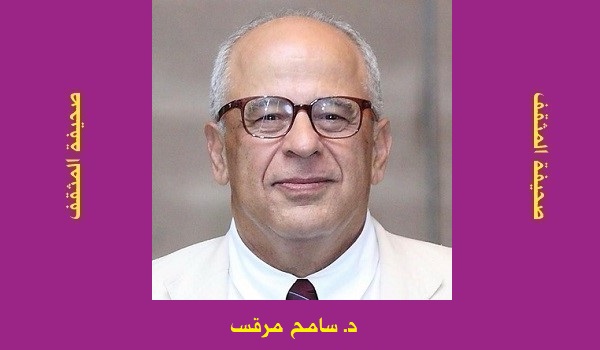العنف المعاصر بوصفه وظيفة في الاقتصاد السياسي العالمي: قراءة نقدية في مؤشر السلام العالمي 2025
مقدمة: في نقد الحياد التقني
لا يقدّم مؤشر السلام العالمي 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، نفسه بوصفه بيانًا أيديولوجيًا، بل كأداة قياس "محايدة" لمستويات السلم والعنف في 163 دولة تمثل 99.7% من سكان العالم. تتوزع مؤشراته الـ23 على ثلاثة محاور: الأمن والسلامة المجتمعية، النزاعات الداخلية والخارجية، ومستوى العسكرة. لكن ما تكشفه أرقامه، حين تُقرأ خارج اللغة التقنية الباردة وداخل سياقها البنيوي، هو حقيقة أشد قسوة وأكثر جدلية:
العالم لا ينزلق إلى العنف لأنه فشل في إدارة اقتصاده، بل لأنه يدير اقتصاده - بدقة وكفاءة - كما ينبغي له أن يُدار في ظل الرأسمالية المتأخرة.
فالتراجع المتواصل في مستويات السلم العالمي - للعام الـ13 خلال 17 عامًا، والسادس على التوالي بنسبة 0.36% - ليس حادثًا عابرًا ولا نتاج أزمات طارئة. إنه نتيجة منطقية لنمط إنتاج كوني استبدل التنمية بالعسكرة (106 دول تدهورت في مجال العسكرة خلال عامين)، والعدالة الاجتماعية بإدارة القسر، والإصلاح البنيوي بتدوير النزاع وتصديره جغرافيًا.
الأطروحة الأولى: العنف ليس خللًا في النظام... بل نمطه الإنتاجي الأكثر ربحية
حين يقدّر المؤشر الكلفة الاقتصادية للعنف بنحو 19.97 تريليون دولار (بالقوة الشرائية المتعادلة PPP) - أي 11.6% من الناتج العالمي الإجمالي، أو 2,455 دولارًا لكل إنسان على هذا الكوكب - فهو لا يصف عبئًا خارج النظام الاقتصادي، بل يصف حجمه الحقيقي وبنيته الفعلية.
أكثر من 73% من هذه "الكلفة" ناتجة عن:
- الإنفاق العسكري والأمن الداخلي: تمثل 73% من الإجمالي
- الإنفاق العسكري وحده: 9 تريليونات دولار (45% من الإجمالي)، بزيادة 6% عن العام السابق
- خسائر الناتج المحلي من النزاعات: ارتفعت 44% في عام واحد
جدلية التسمية: كلفة أم استثمار؟
هنا تكمن المفارقة اللغوية الكاشفة. حين نسمي هذا الرقم "كلفة اقتصادية للعنف"، فإننا نفترض ضمنيًا أن العنف عبء يثقل كاهل الاقتصاد. لكن الحقيقة الأكثر إزعاجًا هي أن هذا الرقم يمثل قطاعات إنتاجية كاملة:
- شركات أسلحة عملاقة حققت أرباحًا قياسية
- صناعات أمنية وتقنيات مراقبة متقدمة
- قطاع "إدارة الأزمات" والاستشارات الأمنية
- اقتصاد إعادة الإعمار المُمَوَّل بقروض دولية
بعبارة أدق: العنف ليس ما يدفعه النظام ثمنًا، بل ما يستثمر فيه بوصفه آلية تراكم.
الأرقام تتكلم: تصاعد منهجي لا عشوائي
- 59 نزاعًا مسلحًا نشطًا قائمًا على الدولة (الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، بزيادة 3 عن العام السابق)
- 152,000 قتيل في نزاعات مسلحة عام 2024
- 17 دولة سجلت أكثر من 1,000 قتيل داخلي في عام 2024 (الأعلى منذ 1999)
- 18 دولة إضافية سجلت أكثر من 100 قتيل
- 78 دولة منخرطة في نزاعات خارج حدودها في 2024 (مقابل 59 في 2008)
- 98 دولة كانت متورطة جزئيًا على الأقل في شكل من أشكال النزاعات الخارجية خلال السنوات الخمس الماضية
- 122 مليون شخص نازح قسريًا (زيادة 185% منذ 2008)
- 17 دولة فيها أكثر من 5% من السكان إما لاجئون أو نازحون داخليًا
هذه ليست أزمة طارئة، بل دورة إنتاج منتظمة.
الأطروحة الثانية: "التفتت العظيم" - العسكرة كبديل بنيوي عن التنمية
حين تصبح الدبابة أسهل من المدرسة
في عالم يعاني من:
- تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي (3.3% في 2024)
- ديون عامة تبلغ 97 تريليون دولار (وتتصاعد)
- الدول النامية تنفق 42% من إيراداتها على خدمة الديون (لا على التعليم أو الصحة)
- انسداد أفق الرفاه الاجتماعي
تتحوّل العسكرة إلى الحلّ السياسي الأسهل:
- تحفّز الصناعات الثقيلة دون إعادة توزيع حقيقية للثروة
- تخلق وظائف مشروطة بالخوف والطوارئ الدائمة
- تؤجّل الانفجارات الاجتماعية عبر "أعداء خارجيين"
- تُبرَّر باسم "الأمن القومي" و"التهديدات الوجودية"
الإنفاق العسكري: رقم قياسي بامتياز
- 2.7 تريليون دولار إنفاق عسكري عالمي في 2024 (زيادة 9% عن 2023 - رقم قياسي)
- 84 دولة زادت إنفاقها العسكري كنسبة من الناتج المحلي
- 50 دولة فقط خفّضت إنفاقها
- 106 دول تدهورت في مجال العسكرة خلال العامين الماضيين
- 24 دولة أوروبية زادت إنفاقها العسكري استجابة لحرب أوكرانيا
المفارقة الأوروبية: حين تتضاعف الميزانية دون تضاعف القدرة
يكشف التقرير مفارقة ساخرة ومأساوية:
- أوروبا تنفق 4 أضعاف ما تنفقه روسيا عسكريًا
- لكن قدرتها العسكرية المشتركة تفوق روسيا بثلث فقط
السبب؟ الافتقار إلى التكامل. 33 جيشًا وطنيًا، بأنظمة قيادة منفصلة، ومشتريات غير منسقة، وثقافات عسكرية متباينة. النتيجة: هدر فلكي في الإنفاق دون تحقيق فعالية حقيقية.
ما لا يقوله الخطاب الرسمي: كل دولار يُضخ في السلاح، يُسحب مباشرة من:
- التعليم (الذي يحتاج إصلاحًا جذريًا)
- الصحة (التي تواجه أزمات بنيوية)
- الإسكان (الذي بات حلمًا لجيل كامل)
- الضمان الاجتماعي (الذي يتآكل تدريجيًا)
وهنا يصبح "الأمن" نقيضًا للسلم، لا شرطًا له.
الأطروحة الثالثة: العدالة الاجتماعية تُستبدل بـ "إدارة القسر الذكية"
أرقام الخنق المالي
يشير المؤشر إلى معطى صادم لكنه غير مفاجئ:
- الدول النامية تنفق في المتوسط 42% من إيراداتها العامة على خدمة الدين
- الصين هي الدائن الأكبر ( ليس البنك الدولي أو صندوق النقد تقليديًا)
- الديون العامة نمت ضعف سرعة نموها في الدول المتقدمة منذ 2010
هذا الرقم وحده كافٍ لفهم لماذا:
- تتآكل الدولة الاجتماعية وتُستبدل بالدولة البوليسية
- ينهار العقد الاجتماعي ويُستبدل بـ"عقد أمني"
- يُعاد تعريف الدولة بوصفها جهاز ضبط لا رعاية
اللغة السياسية البديلة
في هذا السياق، لا يظهر العنف من فراغ. إنه لغة سياسية بديلة حين:
- تُغلق لغة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- يُختزل الإنسان في عبء مالي (عاطل، مهاجر، فقير)
- أو في خطر أمني (إرهابي محتمل، متظاهر، معارض)
المعادلة البسيطة والوحشية:
- لا مال للمستشفيات → لكن هناك دائمًا مال للدبابات
- لا موارد للجامعات → لكن هناك دائمًا موارد للسجون
- لا ميزانية للإسكان الاجتماعي → لكن هناك دائمًا ميزانية لأنظمة المراقبة
الأطروحة الرابعة: "التفتت الجيوسياسي" - اللامساواة تُعاد إنتاجها عبر تصدير النزاع
جغرافيا العنف: المركز يُنتِج، الأطراف تستهلك
واحدة من أكثر مفارقات التقرير فجاجة:
- 8 من أكبر 10 مصدّري أسلحة للفرد هم ديمقراطيات غربية: فرنسا، السويد، إيطاليا، هولندا، ألمانيا، النرويج
- بينما ساحات الموت الفعلية هي: أفغانستان، اليمن، جنوب السودان، الكونغو، السودان، سوريا
العنف هنا ليس صدفة جغرافية، بل آلية توزيع كوني منظمة:
- يُنتَج في مصانع برلين وستوكهولم وباريس
- يُصدَّر إلى الساحل الأفريقي، الشرق الأوسط، جنوب آسيا
- يُستهلك بشريًا في مناطق لا تملك حق النقض في مجلس الأمن
"التفتت العظيم": من نظام ثنائي إلى فوضى متعددة الأقطاب
يقدم التقرير مفهومًا جديدًا: "The Great Fragmentation" - التفتت العظيم:
- 34 دولة تملك نفوذًا كبيرًا في دول أخرى اليوم (مقابل 13 في السبعينيات، و6 في الحرب الباردة)
- التجارة العالمية توقفت عند 60% من الناتج العالمي طوال العقد الأخير (بعد نمو سريع بعد 1990)
- القيود التجارية تضاعفت ثلاث مرات: أكثر من 3,000 إجراء تقييدي في 2023 (مقابل حوالي 1,000 في 2019)
- الحروب بالوكالة تتصاعد: النزاعات الداخلية بمشاركة أطراف خارجية (الحروب الأهلية الممولة دوليًا) ارتفعت 175% منذ 2010
- 92 دولة كانت متورطة في نزاعات خارج حدودها في تقرير 2024 (الرقم القياسي حتى الآن)
النتيجة: عالم لا يتجه نحو نظام عالمي جديد، بل نحو فوضى إقليمية منظمة، حيث تتنافس قوى متوسطة (تركيا، الإمارات، فيتنام، جنوب أفريقيا، البرازيل، إندونيسيا) على مناطق نفوذ، مدعومة بأسلحة من القوى الكبرى.
حالة دراسية: الصراع في الساحل الأفريقي
- بوركينا فاسو: أعلى معدل إرهاب في العالم
- 6 من أصل 10 دول ذات أعلى تأثير إرهابي في أفريقيا جنوب الصحراء
- تدخلات متعددة: روسيا، فرنسا، الولايات المتحدة، الصين، جميعها منخرطة
- الموارد الطبيعية (الذهب، اليورانيوم، النفط) في قلب الصراع
- السكان المحليون: ضحايا صامتون لحرب بالوكالة
الأطروحة الخامسة: حقوق الإنسان - الضحية البنيوية لا الخطابية
حين يصبح الحق رفاهية غير قابلة للتحقيق
في هذا المشهد البنيوي، لا يمكن التعامل مع حقوق الإنسان بوصفها إطارًا أخلاقيًا محايدًا أو "قيمًا كونية". حقوق الإنسان هي أول ما يُضحّى به حين يختار النظام الاقتصادي-السياسي:
- العسكرة (2.7 تريليون دولار) بدل التنمية
- القسر بدل العدالة التوزيعية
- الأمن (بمفهومه الضيق) بدل الكرامة الإنسانية
الأرقام الصادمة لانتهاك الحقوق الأساسية
- 122 مليون نازح قسريًا (زيادة 185% منذ 2008)
- 17 دولة فيها أكثر من 5% من السكان إما لاجئون أو نازحون داخليًا
- معدلات البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 24.5% (أعلى بـ10 نقاط من المتوسط العالمي)
- عمليات حفظ السلام والبناء: 47.2 مليار دولار فقط (0.52% من الإنفاق العسكري) - انخفضت بنسبة 26% منذ 2008
التناقض الفاضح
حين تُفرَّغ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من مضمونها، يصبح:
- القمع "ضرورة أمنية" مشروعة
- التجويع "أثرًا جانبيًا" لسياسات اقتصادية "ضرورية"
- النزوح "أزمة إنسانية" بلا مسؤول محدد
- الحصار والعقوبات "أدوات ضغط" (رغم أنها تستهدف المدنيين أساسًا)
الأرقام الإضافية المرعبة:
- عمليات حفظ السلام: انخفض عدد قوات حفظ السلام بنسبة 42% خلال العقد الماضي (بينما زاد عدد النزاعات)
- الإنفاق على بناء السلام: 47.2 مليار دولار فقط (0.52% من الإنفاق العسكري) - انخفض بنسبة 26% بالقيمة الحقيقية منذ 2008 (كان 64 مليار دولار)
حالة دراسية: فلسطين وتحديد قيمة الحياة
- أكثر من 63,750 قتيلًا في غزة (تقديرات رسمية محافظة، وبعض التقديرات تشير لأعداد أعلى بكثير)
- حصار كامل للمساعدات الإنسانية منذ مارس 2025
- التغطية الإعلامية: الوفيات المدنية في الدول ذات الدخل المرتفع تحظى بتغطية إعلامية أكبر 100 مرة من عدد مماثل من الوفيات في الدول منخفضة الدخل (حسب تقرير 2025)
- النزاعات الأهلية أقل تغطية: تحصل على اهتمام إعلامي أقل من النزاعات بين الدول، حتى عندما تكون أعداد الضحايا أعلى بكثير
السؤال الجدلي: هل حقوق الإنسان كونية، أم أن لها سعر صرف يختلف حسب الجغرافيا والجيوبوليتيك؟
الأطروحة السادسة: "السلام الإيجابي" - خطاب أنيق على ركام منظم
المفهوم والواقع
يقدم المعهد مفهوم "السلام الإيجابي" (Positive Peace) بوصفه: "المواقف والمؤسسات والهياكل التي تخلق وتحافظ على مجتمعات سلمية". لكن أرقام التقرير نفسه تكشف انهيار هذا المفهوم:
- مستويات السلام الإيجابي تحسّنت حتى 2019
- منذ 2019 تتراجع باستمرار - حتى في أمريكا الشمالية وأوروبا
التناقض البنيوي
كيف يمكن الحديث عن "سلام إيجابي" في عالم:
- نسبة حل النزاعات بالسلام انخفضت من 23% إلى 4% (من السبعينيات إلى العقد الثاني من القرن الـ21)
- نسبة النزاعات التي تنتهي بانتصار حاسم انخفضت من 49% إلى 9%
- النتيجة: نزاعات مزمنة لا تنتهي، بل تُدار وتُمَوَّل وتُصدَّر
تدفق المعلومات: ديمقراطية الوصول، دكتاتورية المحتوى
يشير التقرير إلى مفارقة مثيرة:
- الوصول إلى الاتصالات تحسّن بشكل كبير (أكثر مؤشر تحسنًا في السلام الإيجابي)
- لكن حرية الصحافة وجودة المعلومات شهدت أكبر تراجع
الاستنتاج: لدينا وصول غير مسبوق إلى المعلومات، لكنها معلومات منخفضة الجودة، متحيزة، أو مُصممة لإثارة الانقسام.
الأطروحة السابعة: عوامل التصعيد - لماذا تصبح النزاعات غير قابلة للحل؟
تسع عوامل تحوّل الصراع إلى جحيم مستدام
حدد المعهد 9 عوامل رئيسية تزيد احتمالية تصعيد النزاعات:
1. الدعم العسكري الخارجي
2. الإقصاء العرقي المنهجي
3. توفر اللوجستيات والأسلحة
4. الأنظمة السلطوية الصارمة
5. "أدلجة الصراع" (تحويله لقضية وجودية)
6. غياب الوساطة الفعالة
7. الموارد الطبيعية القابلة للنهب
8. الذاكرة التاريخية للعنف
9. انهيار البنى المؤسسية
النزاعات المرشحة للتصعيد الكارثي
بناءً على هذه العوامل، حدد التقرير 4 نزاعات ذات خطر تصعيد هائل:
1. جنوب السودان: 7 من 9 عوامل موجودة
2. إثيوبيا/إريتريا: 6 من 9 عوامل
3. الكونغو الديمقراطية: 8 من 9 عوامل
4. سوريا: 7 من 9 عوامل (مع حكومة انتقالية هشة)
حالة دراسية: كشمير - ساعة موقوتة نووية
- هجوم إرهابي في أبريل 2025 (خارج فترة التقرير)
- 25 سائحًا هنديًا قُتلوا
- توقف الحوار فورًا
- دولتان نوويتان (الهند وباكستان) على حافة حرب مفتوحة
- المنطقة الأكثر عسكرة في العالم
السؤال الوجودي: إذا كان كل الأطراف يعرفون عوامل التصعيد، لماذا لا يُمنع؟ الجواب: لأن التصعيد نفسه مُربح لأطراف عديدة.
الأطروحة الثامنة: التدهور التراكمي - 17 عامًا من الانحدار المنهجي
أرقام الانحدار طويل المدى
منذ إطلاق المؤشر في 2008:
- متوسط درجات الدول تدهور بنسبة 5.4%
- 94 دولة أصبحت أقل سلمية (مقابل 66 تحسنت، و3 بقيت كما هي)
- 17 من أصل 23 مؤشرًا تدهورت
- الفجوة بين الأكثر والأقل سلمية اتسعت بنسبة 11.7%
الدول الأكثر سلمية (أيسلندا ووهم الاستقرار)
1. أيسلندا (1.095) - الأكثر سلمية منذ 2008 (17 عامًا متواصلة)
2. إيرلندا (1.260)
3. نيوزيلندا (1.282)
4. النمسا (1.294)
5. سويسرا (1.294)
الملاحظة الجدلية:
- 8 من أصل 10 دول الأكثر سلمية في أوروبا الغربية والوسطى
- 12 دولة فقط في فئة "سلام مرتفع جدًا"
- كل هذه الدول مستفيدة من نظام اقتصادي عالمي غير عادل
- أيسلندا نفسها: لا جيش لديها، لكنها عضو في الناتو (تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية)
الدول الأقل سلمية (جغرافيا الجحيم)
163. روسيا (3.441) - الأقل سلمية لأول مرة
164. أوكرانيا (3.434)
165. السودان (3.323)
166. الكونغو الديمقراطية (3.292)
167. اليمن (3.262)
الملاحظة: 4 من أصل 5 دول في أفريقيا أو الشرق الأوسط.
الأطروحة التاسعة: بنغلاديش - حالة دراسية في انهيار العقد الاجتماعي
السقوط الحر
- أكبر تدهور في 2025: انخفاض 13.2% (33 مرتبة في التصنيف)
- من المرتبة 90 إلى 123 في عام واحد
- 436 قتيلًا في نزاعات داخلية في 2024 (مقابل 12 في 2023)
- زيادة 3,533% في وفيات النزاعات الداخلية
- أكثر من 1,000 قتيل في المواجهات مع قوات الأمن (حسب وزارة الصحة)
- 1,400 قتيل حسب تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
التسلسل الكارثي
1. احتجاجات طلابية ضد نظام الحصص الوظيفية
2. قمع وحشي من الحكومة (1,400 قتيل حسب الأمم المتحدة)
3. هروب رئيسة الوزراء شيخة حسينة
4. حكومة انتقالية هشة بقيادة محمد يونس (الحائز على نوبل)
5. اقتصاد في أزمة: نقص العملة الأجنبية، تضخم غذائي
6. 2,010 هجومًا على الأقليات في أغسطس 2024 وحده
الدرس الجدلي
بنغلاديش ليست "حالة فاشلة"، بل نموذج مصغّر للنموذج العالمي:
- اقتصاد نيوليبرالي "ناجح" (نمو مرتفع لعقود)
- قمع منهجي للحقوق
- خنق الفضاء العام
- انفجار حتمي حين لا يعود القمع كافيًا
خاتمة جدلية: نحو مؤشر للصدق لا السلام
ما لا يقوله المؤشر
مؤشر السلام العالمي - بكل رصانته المنهجية - يقيس الأعراض لا الأسباب البنيوية. يعدّ النزاعات، لكنه لا يسأل: لمن يُربح استمرارها؟
العالم لا يحتاج إلى مزيد من مؤشرات السلام بلغتها التقنية المطمئنة، بل إلى مؤشر واحد صريح يقول الحقيقة بلا تلطيف ولا مواربة:
العنف ليس انهيار النظام العالمي، بل علامته الحيوية الأخيرة. إنه ليس خللًا في الآلة، بل الآلة نفسها وهي تعمل بكفاءة.
الأسئلة التي يجب طرحها
1. لماذا تنتج الديمقراطيات الغربية 80% من الأسلحة المُصدَّرة للعالم؟
2. لماذا تنخفض ميزانيات حفظ السلام (26- %) بينما ترتفع ميزانيات التسليح (9+%)؟
3. لماذا يُقاس "النجاح الاقتصادي" بمؤشرات تستثني 19.97 تريليون دولار عنف؟
4. لماذا تُحل 4% فقط من النزاعات بالسلام (مقابل 23% في السبعينيات)؟
5. لماذا تحظى حياة إنسان في دولة غنية بتغطية إعلامية أكبر 100 مرة من حياة إنسان في دولة فقيرة؟
الحقيقة القاسية
ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي:
- منطق إدارة الأزمات بالقوة (78 دولة في نزاعات خارجية)
- منطق تأجيل العدالة بالسلاح (2.7 تريليون دولار سنويًا)
- منطق تصدير العنف جغرافيًا (المركز يُنتِج، الأطراف تموت)
- منطق استبدال الحقوق بالأمن (42% من إيرادات الدول النامية لخدمة الديون)
فإن الحديث عن السلم وحقوق الإنسان سيبقى لغة أنيقة تُلقى فوق ركامٍ مُدار بعناية فائقة.
الخلاصات الرئيسية: عشر حقائق جدلية
1. العنف ليس أزمة بل صناعة: 19.97 تريليون دولار قطاع إنتاجي كامل (11.6% من الناتج العالمي)
2. العسكرة تتسارع بشكل غير مسبوق: 106 دول تدهورت عسكريًا في عامين، 2.7 تريليون دولار إنفاق عسكري (رقم قياسي)
3. الديون أداة قمع منهجية: 42% من إيرادات الدول النامية لخدمة الديون (ضعف سرعة نمو الديون مقارنة بالدول المتقدمة)
4. التفتت الجيوسياسي منظم ومتعمد: من 13 إلى 34 دولة نافذة عالميًا (تضاعف ثلاث مرات منذ الحرب الباردة)
5. جغرافيا العنف طبقية: 8 من أكبر 10 مصدري أسلحة ديمقراطيات غربية، والجنوب يستهلكها بشريًا
6. حل النزاعات سلميًا أصبح شبه مستحيل: من 23% إلى 4% في 50 عامًا (الانتصارات الحاسمة من 49% إلى 9%)
7. النزوح القسري يتفاقم: 122 مليون نازح (185+% منذ 2008)، 17 دولة فيها أكثر من 5% من السكان نازحون
8. الإعلام يُسعِّر الحياة جغرافيًا: تغطية الوفاة في الغرب = 100 ضعف تغطيتها في الجنوب
9. السلام الإيجابي ينهار حتى في المركز: تراجع مستمر منذ 2019 حتى في أوروبا وأمريكا الشمالية
10. أوروبا: هدر هائل بلا كفاءة: تنفق 4 أضعاف روسيا لكن قدرتها أقل من الضعف (مشكلة التكامل لا الميزانية)
توصية نهائية: من قراءة المؤشر إلى فهم البنية
مؤشر السلام العالمي 2025 وثيقة قيمة، لكنه - ككل أدوات القياس - محايد أخلاقيًا بشكل مخادع. يقدم لنا أرقامًا دقيقة لعالم يحترق، لكنه لا يسأل: من أشعل النار؟ ومن يبيع الوقود؟ ومن يستثمر في إعادة الإعمار؟
القراءة النقدية تتطلب:
- تجاوز الأرقام إلى البنى السياسية-الاقتصادية
- تجاوز "الكلفة" إلى الاستثمار والربح
- تجاوز "الأزمات" إلى الأنماط البنيوية
- تجاوز "النزاعات المحلية" إلى الاقتصاد السياسي الكوني
العالم ليس أقل سلمًا لأنه فشل في إدارة نفسه.
العالم أقل سلمًا لأنه ينجح - بكفاءة مرعبة - في إدارة نفسه وفق منطق الربح والهيمنة.
والسؤال الأخير، الأكثر جدلية وإزعاجًا:
ماذا لو كان هذا المستوى من العنف هو بالضبط ما يحتاجه النظام الحالي ليستمر؟
***
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الإنسان
.......................
المصادر:
- Institute for Economics & Peace. Global Peace Index 2025: Measuring Peace in a Complex World, Sydney, June 2025
- جميع الأرقام والإحصاءات مأخوذة من التقرير الكامل (163 صفحة)
- التحليل الجدلي والنقدي من إعداد الكاتب