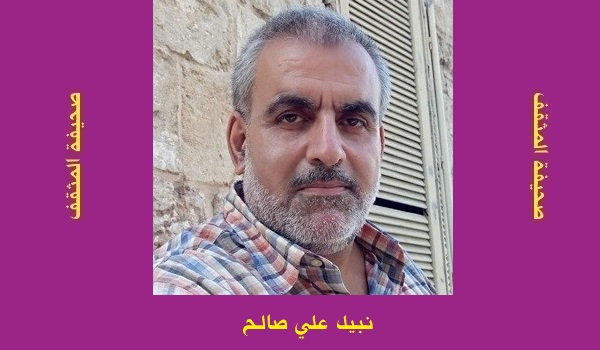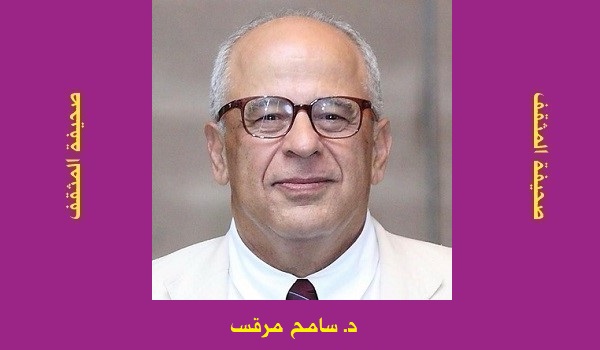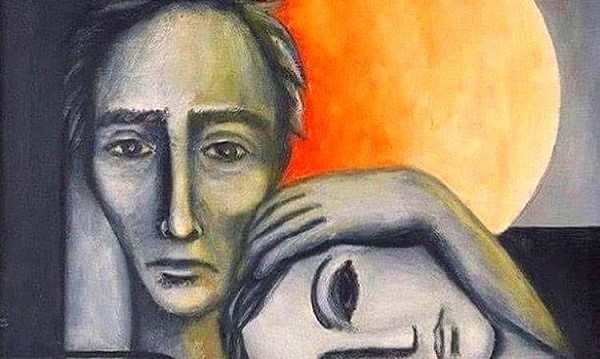نحو فهم بنيوي وإرادة تجاوز
مفتتح: تعيش المجتمعات العربية اليوم واقعًا حضاريًا متناقضًا؛ فبينما تشهد الثورة التكنولوجية والمعلوماتية تحولات هائلة في أنماط الحياة والفكر، تبقى الثقافة العربية حبيسة نمط إعادة الإنتاج للأفكار القديمة، وتعطيل الجدل الخلاق الذي يُفترض أن يكون محركًا للحضارة. إن الجمود الثقافي ليس حالةً عارضة تمرّ مع الزمن، بل هو بنية متجددة تستعيد نفسها كلما أعادت المؤسسات والذهنيات الجماعية إنتاج آليات التقليد، وتعطيل النقد، وتقديس الموروث خارج سياقاته التاريخية. والسؤال المركزي الذي يستحق التأمل العميق: لماذا يستمر هذا الجمود رغم تعاقب مشاريع الإصلاح والنهضة، ورغم ضغط العولمة والتحولات الرقمية التي تفرض منطقًا جديدًا على الفكر والسلوك؟1 وهل يمكن تفسير المفارقة الصارخة بين كثافة الخطاب النهضوي العربي وبين ضعف أثره الفعلي في تحويل الثقافة إلى قوة إنتاج للمعنى والحرية والتنمية المستدامة؟
الأزمة هنا ليست سوء فهم أو تراجع مؤقت، بل استمرار نسقي في تعطيل آليات التفكير النقدي، الذي يُعتبر العصب الأساسي لأي حضارة حية ومتطورة. فالجمود الثقافي لا ينبثق من "نقص المعرفة" وحسب، بل من نمط عميق في إنتاج المعرفة وتداولها: نمط يفضّل النقل على النقد، والامتثال على الابتكار، ويستبدل الأسئلة المؤسِّسة بإجابات جاهزة تُستعمل لضبط المجال الاجتماعي والرمزي.2 كما يفترض أن مواجهة الجمود تتطلب تفكيك شروطه: المؤسسية، والتربوية، والقيمية، والاقتصادية، لا الاكتفاء بوعظه أخلاقيًا أو نقده على المستوى النظري المجرد.
الإشكالية وتحديد المفاهيم
ينبغي أن نبدأ بتوضيح الإطار المفهومي: الجمود الثقافي لا يساوي المحافظة أو التمسك بالتراث، بل هو تعطيل نسقي لمنطق المراجعة والنقد. فحين تتحول الثقافة إلى "سلطة تفسير" مغلقة بدلاً من أن تبقى "مادة فهم" قابلة للتجدد، حين يصير التراث نصًا مقدسًا لا يخضع للتساؤل، لا حوار، يحدث الجمود.3 والفرق جوهري: المحافظ الحكيم يُعيد قراءة الموروث في ضوء الحاضر ويستخلص دروسه للمستقبل؛ بينما المتجمد يكرّر الصيغ بآلية، يستقيمها من منطق "كان هكذا، إذن يجب أن يبقى هكذا".
الجمود الثقافي تطبيقياً: هو حالة بنيوية تتسم بضعف القدرة على إنتاج أفكار جديدة وتحديث الأدوات المعرفية والمنهجية، مع الميل الثابت إلى تكرار صيغ تفسيرية قديمة بوصفها حلولاً نهائية لمشاكل حاضرة ومختلفة4 . وهو ليس مرادفًا للتقليد البريء بقدر ما هو إغلاق مقصود—أو غير مقصود لكنّه منتظم—لمسار السؤال والفحص النقدي. إنه يعني أن المثقفين والمؤسسات والقيادات تُفضّل نقل الأجوبة على إعادة صياغة الأسئلة، وتختار الراحة الفكرية على المشقة المنتجة للمعرفة.
مقاربة الأزمة:
يتجدد الجمود الثقافي عبر أربع آليات رئيسية متداخلة:
أولاً: تعطيل العقل النقدي في مؤسسات التربية
حين تُبنى المناهج التعليمية على الحفظ والتلقين، لاعلى الاستقصاء والتفكير، يتراجع التفكير التحليلي لصالح إعادة إنتاج المألوف المعروف5 . يتشكل المتعلم داخل منطق "الإجابة النموذجية" التي لا تناقش ولا تُسائل، بل تُستقبل وتُحفظ وتُكرر. وعبر سنوات الدراسة الطويلة (من التعليم الابتدائي حتى الجامعي) يتعود الطالب على أن الحقيقة موجودة في الكتاب أو المعلم، لا في الفضول الفكري والبحث المستقل. وهكذا ينشأ جيل "يحترم المعلومة" لكنه يخاف التفكير بها، يكرر الحكمة القديمة لكنه عاجز عن تكييفها مع واقع جديد. العقل الذي لم يتدرب على السؤال والنقاش في مراحل تكوينه الأولى، سيجد صعوبة بالغة لاحقًا في التحرر من السلطة (سلطة النص، النص الديني، الرأي الجماعي، الزعيم، الأيديولوجية).
ثانيًا: جدليات الخطاب والممارسة
كثير من الخطابات الثقافية والسياسية الرسمية تتحدث بلغة الحداثة والتقدم (الدولة، الحقوق، العلم، المساواة، العدالة)، لكنها تعمل ذهنيًا وسلوكيًا بمنطق ما قبل الحداثة (العصبية، المحسوبية، القبلية، تقديس الأب/الزعيم، الولاء الأعمى للرموز)6، هذه القطيعة الحادة بين المفاهيم والممارسة تُنتج شخصيات مشتتة، تقول شيئًا وتفعل الضد، وتُعلّم أطفالها الديمقراطية في الفصل بينما تمارس الاستبداد في البيت والمؤسسات. وهكذا، يبقى التراث الحي (السلوك الفعلي، المؤسسات، الممارسات اليومية) محافظًا جدًا، قاسيًا جدًا، غير متسامح، بينما الخطاب (الكلمات، الشعارات، الوعود) يبدو حداثويًا منفتحًا. هذه الازدواجية تُعطّل أي تراكم فكري حقيقي و تخلق جدلاً ينمي الأزمة.
ثالثًا: أدلجة الثقافة
حين تصبح الثقافة تابعة لمنازعات السلطة والاستقطاب الأيديولوجي والصراع السياسي، تتحول من ساحة معرفة وإنتاج معنى إلى ساحة تعبئة وصراع هوياتي.7 يُستبدل الحوار الحر بالتخوين الرمزي، والنقاش بالمواقف المسبقة. يصير المثقف ليس باحثًا بل "جندي" في معركة إيديولوجية. والفكرة التي لا تخدم "قضية" معينة أو "صف" معين تُعتبر خائنة، بلا قيمة. هكذا تفقد الثقافة استقلاليتها، وتفقد معها القدرة على الإنتاج الحر والمستقل للمعاني والأفكار.
رابعًا: هواجس ضغط العولمة
بدلاً من تحويل الانفتاح على العالم إلى فرصة للتثاقف الخلاق (الحوار مع الآخر دون فقدان الذات)، قد يحدث رد فعل دفاعي يخلط بين حماية الهوية ورفض النقد كليًا.8 يشتد الجمود بصفته "حصنًا" ضد الغزو الثقافي الخارجي، فتُقدّس القوالب الجاهزة، تُرفع أسوار ضد التأثيرات الخارجية، وبدلاً من أن تتعلم الثقافة الدفاع الذكي (قوة فكرية أصيلة) تختار الدفاع الأعمى (الرفض الشامل). وهنا تفقد الثقافة أيضًا قوتها، لأن الثقافة الحية لا تخاف التحدي، بل تستقطبه.
مالك بن نبي وسؤال القابلية للاستعمار
من المهم هنا أن نستحضر أطروحة الفيلسوف الجزائري مالك بن نبي حول "القابلية للاستعمار"9 (Colonizability) لم يركز بن نبي على العامل الخارجي وحده (الاستعمار كقوة عسكرية واقتصادية)، بل انصبّ تركيزه على البنية الداخلية للمجتمع التي تجعله "قابلاً للاستعمار". وفي هذا السياق الفكري، يمكن القول إن الجمود الثقافي ليس نتيجة "الحصار الخارجي" وحده، بل هو نتاج ضعف "الوعي الذاتي" الذي يمنح المجتمع مناعة ثقافية ويمنع الانصهار التابع داخل الآخر.10
الثقافة المتجمدة هي ثقافة فقدت ثقتها بقدرتها على الإنتاج والتطوير، فاستسلمت للتقليد الأعمى. وفي هذا السياق، تصبح الثقافة العربية "قابلة للتبعية الرمزية والفكرية" (soft colonialism)؛ إذ تستورد أفكارًا دون فحص، تتقبل مفاهيم دون مراجعة، تُقلّد نماذج دون تكييف. وهنا يكمن الخطر الفعلي: ليس في الغزو العسكري أو الاقتصادي الذي يمكن مقاومته بالقوة، بل في الغزو الثقافي الذي ينفذ عبر استسلام الذات لمنطق الآخر.
من ثقافة الجمود إلى ثقافة الفعل
تجاوز الجمود لا يتحقق بشعار "التجديد" الحماسي وحده، بل بترتيبات معرفية ومؤسسية وقيمية عميقة وتدريجية:
إعادة بناء التعليم على أساس مهارات التفكير النقدي
لا بد من ثورة تربوية حقيقية تنقل المناهج من الحفظ إلى الفهم، من التلقي السلبي إلى البحث النشط. يجب تعليم الشباب الأسئلة قبل الأجوبة، تعليمهم أن لا سؤال سخيف، وأن أفضل الإجابات هي التي تنبثق من فضول حقيقي وبحث عميق. مهارات التفكير التحليلي والنقدي والكتابة الحجاجية وأخلاقيات الاستدلال يجب أن تكون محور العملية التعليمية، لا ملحقات هامشية11
فتح المجال العمومي للحوار والاختلاف
على المستوى المؤسسي والسياسي، يجب تقليل منسوب الاستقطاب الهوياتي والأيديولوجي الذي يُحول الثقافة إلى ساحة صراع. لا يعني هذا التنازل عن الآراء أو المواقف، بل السماح بتعددية حقيقية وحماية النقد والاختلاف. المؤسسات الثقافية والإعلامية والأكاديمية يجب أن تُؤمّن فضاءً آمنًا للحوار، حيث الفكرة تُناقش وتُفحص على أساس قوتها المنطقية والعلمية، لا على أساس الموالاة أو المعاداة السياسية.
تجديد المناعة الثقافية
الأمن الثقافي (Cultural Security)—الذي أصبح مفهومًا حاسمًا في ظل العولمة—لا يعني الانغلاق والرفض، بل بناء وعي أصيل قوي بالذات، باللغة، بالمرجعيات.12 أعني ثقافة حية تعرف من هي، تفهم جذورها، لكنها لا تخاف الحوار مع الآخر. هي التي تستقطب التأثيرات الخارجية وتُحولها إلى أسمدة لنموها، لا إلى سموم تُذيبها. إن بناء المناعة الثقافية يتطلب تعزيز الوعي الذاتي التاريخي والحضاري، والتعليم الراقي بأهمية اللغة الأم ودورها في بناء الهوية والتفكير، والحوار الجاد مع التراث الحي للتعلم منه دون الانسجام الأعمى به.
مستخلص: نحو مشروع نهضة ثقافية حقيقية
الجمود الثقافي العربي ليس "قدرًا" محتومًا، بل هو حالة يمكن تجاوزها بإرادة منظمة ومشاريع معرفية جادة. لكن هذا التجاوز لن يأتي من الخطابات الحماسية أو الشعارات النبيلة، بل من تفكيك واقعي لشروط الجمود وإعادة بناء نسق ثقافي جديد على أساس:
أولاً: ثقافة تُولّد أسئلة بدلاً من أن تكرر أجوبة جاهزة. ثقافة تُعلّم الناس أن يفكروا معها، لا أن يفكروا كما تريد.
ثانيًا: ثقافة لا تخاف من النقد الداخلي، بل تستقطبه كوسيلة تنقية ونمو. ثقافة تفصل بين الفكرة والشخص، بين الموقف والولاء.
ثالثًا: ثقافة تُرسّخ الحوار الحقيقي مع الآخر، لا الحوار الشكلي. حوار ينطلق من قوة فكرية أصيلة، لا من موقف دفاعي منهزم.
رابعًا: مؤسسات تُنتج المعرفة وليس التكرار. جامعات حقيقية، مجلات فكرية جادة، قنوات إعلامية تحترم الذكاء والتفكير، كل هذا يحتاج إلى موارد وحماية حقيقية من التدخل الإيديولوجي والسياسي.
وعليه الأزمة الثقافية العربية ليست أزمة أفراد بل أزمة نظام فكري وتربوي وإعلامي بات عقيمًا. والحل لا يأتي بين ليلة وضحاها، بل يتطلب تراكم جهود على مدى أجيال. لكن البدء يجب أن يكون الآن، من غرفة الدراسة، من الجامعة، من المؤسسة الثقافية، من كل مكان يُمكن أن ينجب فكرًا نقديًا جديدًا. فقط هكذا، من خلال حوار حقيقي مع التراث ومع الحاضر، يمكن للثقافة العربية أن تتحرر من الجمود وتستعيد دورها الحقيقي كمُحرّك للحضارة والإنسانية.
***
مراد غريبي
.......................
الهوامش
1- علي أسعد وطفة، الجمود والتجديد في العقلية العربية: مكاشفات نقدية، (دمشق: دار الفكر، 2010)، ص 127.
2- محمد عابد الجابري، نقد العقل العربي (الجزء الأول: تكوين العقل العربي)، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1986)، ص 156.
3- فتحي المسكيني، الفلسفة والنوستالجيا: بحث في البنية الفلسفية للحنين الحضاري، (تونس: الدار التونسية للنشر، 2009)، ص 89.
4- محمد عابد الجابري، نقد العقل العربي (الجزء الأول: تكوين العقل العربي)، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1986)، ص 176.
5- علي أسعد وطفة، الجمود والتجديد في العقلية العربية: مكاشفات نقدية، (دمشق: دار الفكر، 2010)، ص 134.
6- عبد الله العروي، الأيديولوجية العربية المعاصرة، (بيروت: دار الحقيقة، 1979)، ص 98.
7- فؤاد زكريا، الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة، (القاهرة: دار الفكر، 1987)، ص 156.
8- محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ترجمة: هاشم صالح، (بيروت: مركز الإنماء القومي، 1996)، ص 203.
9- مالك بن نبي، قضايا الحضارة مالك بن نبي، شروط النهضة، (القاهرة: دار الفكر، 1986)، ص 71.
10- مالك بن نبي، قضايا الحضارة، (الجزائر: المكتبة العربية، 1978)، ص 156.
11- حسام كصاي، أزمة الفكر العربي المعاصر، (دجلة ناشرون، 2016)، ص 178.
12- علي أسعد وطفة، الأمن الثقافي والتربية، (الكويت: دار القلم، 2005)، ص 89.
قائمة المصادر:
العروي، عبد الله. الأيديولوجية العربية المعاصرة. بيروت: دار الحقيقة، 1979.
الجابري، محمد عابد. تكوين العقل العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1989.
نقد العقل العربي (الجزء الأول: تكوين العقل العربي). بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1986.
كصاي، حسام. أزمة الفكر العربي المعاصر. بغداد: دار دجلة ناشرون، 2016.
أركون، محمد. تاريخية الفكر العربي الإسلامي. ترجمة: هاشم صالح. بيروت: مركز الإنماء القومي، 1996.
العالم، محمود أمين. في الثقافة والاستقلال الوطني. القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، 1974.
المسكيني، فتحي. الفلسفة والنوستالجيا: بحث في البنية الفلسفية للحنين الحضاري. تونس: الدار التونسية للنشر، 2009.
بن نبي، مالك. شروط النهضة. القاهرة: دار الفكر، 1986.
بن نبي، مالك. قضايا الحضارة. الجزائر: المكتبة العربية، 1978.
وطفة، علي أسعد. الجمود والتجديد في العقلية العربية: مكاشفات نقدية. دمشق: دار الفكر، 2010.
وطفة، علي أسعد. الأمن الثقافي والتربية. الكويت: دار القلم، 2005.
زكريا، فؤاد. الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة. القاهرة: دار الفكر، 1987.