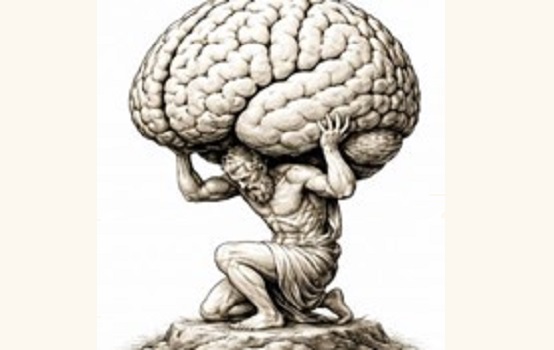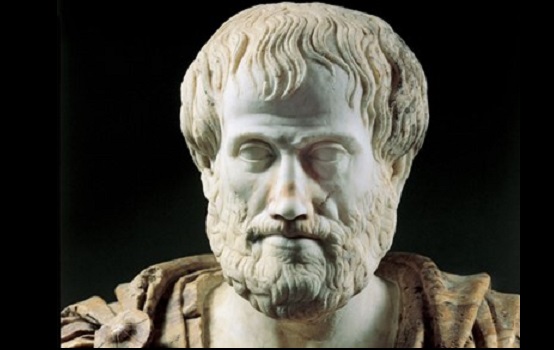درج العراقيون أبناء وادي الرافدين في وسط وجنوب العراق على دمج أكثر من كلمة لسهولة النطق ولأن غاية اللغة في نهاية المطاف هي إيصال المعنى المطلوب بشكل مباشر.
إن هذه الوسيلة منتشرة بشكل كبير ومتعدد الأشكال في اللغة العراقية في حين إن هذا الأمر غير ممكن في العربية الفصحى إلا بحدود قليلة جدا وغير مرغوبة ومقحم أحيانا في حين أن التداول المحكي سلس وتلقائي ويأتي في السياق تماما.
سنحاول تقسيم الموضوع لعدة أجزاء حسب طبيعة الدمج وكالتالي:
1.دمج حروف الجر مع الاسم المجرور
أ. حرف الجر على
- دمج حرف الجر على وهذا الدمج انتقائي أي باختيار المتكلم فنقول
عالرف وعلى الرف
عالبال وعلى البال
عالماشي وعلى الماشي
- وهناك دمج خاص للحرف (على) مع الاسم الموصول الذي (على الذي) لتصبح الكلمة (علّي) كقولنا (العتب علّي خربط الشغلة).
- وهناك دمج خاص بالحرف (على) مع (من) (على من) لتصبح (عَلَمنْ) لتحور إلى عْليمَنْ وعَليمَنْ المستخدمة بكثرة في اللغة العراقية ويقول الشاعر ويغني المغني
عليمن يا ﮔلب تعتب عليمن
هويت وجربت وأمنت بيمن
- وهناك دمج خاص للحرف (على) مع (ما) (على ما) لتصبح الكلمة الجديدة (عَلْما) وهي زمنية قريبة من (لمّا) و(حتى) الفصيحتين كقولنا
انتظر علما أجي
علما اجيت لكيت كلشي خلصان
وهناك استعمال آخر مختلف ل (علما) في اللسان العراقي لتصبح أداة نفي كقولنا
يتعارك عاليسوه وعلما يسوه
- دمج حرف الجر (على) مع الأفعال والمعروف أن على لا تدخل مطلقا في الفصحى على فعل لأنها مختصة بالدخول على الأسماء لكننا نقول في بلساننا
الأمر ينطبق عاليدري والما يدري ونقول العتب عاليحرس البيت
- تدمج على مع الاسم (أبو) لتصبح (عَلَبو) ويتحول معناها بالكامل إلى (على أساس) أو (بحجة) مثل قولنا
ما قِبل أبويا نروح للسينما علبو الفلم مو لعمرنا
- يستخدم العراقيون (عَلَوّا) كثيرا بمعنى (يا ليت) ولابد أن أصلها هو دمج على مع كلمة أخرى جرى حذف جزء منها مع طول الاستعمال وأظن أنها كانت (على واهس) ونحتت مع الزمن إلى (علوّا)
- يستخدم العراقيون (علمود) بمعنى لأجل وأن أصلها هو دمج (على) مع كلمة مود الآرامية التي تعني شأن، كيف (1)
- يستخدم العراقيون عالبرّة وعالجوّة وكلاهما أي برّة وجوّة آراميتان للتعبير عن الاتجاه إلى الخارج أو إلى الداخل ومن الواضح أنهما دمج (على) مع الكلمتين فنقول كرّادة عالجوّة وكرّادة عالبرّة.
- ينتشر دمج (على) بالكلمات في اللغة العراقية عند تأليف الأبوذية
لأنها تعطي معنى مضافا يحتاجه الشاعر للوصول للمعاني الثلاثة
المطلوبة لكلمة واحدة والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها
علامك تحمس بروحي عليمر (على جمر)
أهيم وصار مشروبي علي مر (عليَّ مرّاً)
يوم إنساك مضعونك على مَر (مرَّ عليَّ)
غدت شمس الضحى ظلمة عليّه
ب. حرف الجر (من)
- تدمج (من) مع أين فنقول (منين)
- تدمج (من) مع ضمير الغائب (هو) لتصبح كلمة جديدة شهيرة بعد حذف الهاء هي (منو)
- تدمج هنا وهناك بحرف الجر من (من هنا ومن هناك) لتشكل الكلمتين العراقيتين (منّا ومنّاك) ولأننا نستخدم (هنانه) فقد جرى إلصاق (من (بها لتصبح (منّانه)
فنقول روح منا مو منّاك ونقول إجينه منّانه
ج. حرف الجر إلى: من الواضح أن حرف الجر (إلى) اختفى تماما من الإستخدام كحرف جر منفصل وجرى دمجه على النحو التالي:
- مع الضمائر المتصلة والمنفصلة فنقول الي وإله وإلك وإلكم وإلنا وإلهم وإلهن
- تلصق مع (مَن (لتكوّن (إلمن) لتحل محل (لمن) الفصيحة
د. حرف الجر(الباء): ينتشر دمج حرف الجر (الباء) مع ما بعده
- بهداي: أي بهدوء
- بالراض أو براضة محورة من بالرضا ومنها الأغنية الشهيرة بالراض امش بالراض ﮔتلك دريض والأغنية الأخرى براضة امشي براضه براضة امشي براضة
- بسكوت: أي بسكوت وهدوء
- بلابوش: محرفة عن بلا بوشي أي بلا ستر أو غطاء أو بمعنى بلا حياء من دمج حرف الباء مع لا مع بوش المحرفة عن بوشي.
- بلاهوش: أي بلا وعي أو إدراك والفعل من هاش يهوش
- بساع: أي بسرعة وهي دمج الباء مع ما هو مقتطع من كلمة ساعة.
- بطرﮒ: أي بدون أي شيء عدا شيء واحد مثل إجا بطرﮒ الدشداشة
وغير ذلك كثير
2.دمج ظروف الزمان والمكان
- جرى تحوير استعمال ظرف الزمان (كيف) ليستعمل كاسم يدل على الحالة فنقول
كيفك
شلون كيفك
شلون كيفكم
كما نربطه بحرف الجر الباء لنقول بكيفك وبكيفي وبكيفنا وبكيفهن أي كما تشاء وكذلك تضاف له (أل) التعريف فنقول بالكيف أي حسب الاختيار
- جرى في اللغة العراقية جمع ظرف المكان (بين) إلى (بينات) ونستخدمه في اللسان العراقي بالقول ﮔاعد بيناتنه أو خلّيها بيناتنه بدلا عن الفصيح بيني وبينك بيننا. ونقول بيناتهم وبيناتنا وبيناتهن.
- جرى دمج ظرفي المكان (جوّه) و(برّه) الآراميين مع حرف الجر (على) لتقرأ عالجوّه وعالبرّه.
- نضيف (لي) إلى ظروف المكان مثل (ﻟﻳﮕدام) و(ليوره) و(ليفوﮒ) و(ليجوه) والأصل لام حرف الجر
3. دمج الأفعال:
ينتشر دمج وإدخال أل التعريف على الأفعال بشكل متأصل في جسم اللغة مما يوضح مدى استقلالية اللغة العراقية عن العربية الفصحى واعتبار الاسم الجديد بمثابة اسم فاعل مثل اليدري واليعرف والينام وكأنك تقول الداري والعارف والنائم ويحلل البعض هذه الأل بأنها ليست أل التعريف وإنما هو دمج اسم الموصول الذي مع الأفعال أي أن (الذي) نحتت إلى (اللي) ثم إلى (إل) التعريف (كقولنا الذي يدري ونحتناها إلى اليدري) والأمر سيان لأن الأمرين لا يجوزان في الفصحى.ثم أدخلنا أداة النفي(ما) ودمجنا الكل فقلنا (المايدري والمايعرف)
إن هذا الإستخدام يأتي بأشكال متنوعة أهمها:
- في بداية الجملة: اليدري يدري والمايدري ﮔضبة عدس أو
اليثرد يدري والياكل ما يدري
- في وسط الجملة: راحوا اليقرون وظلوا اليخرون أو
الشاطر اليعبي بالسلة ركي
- في آخر الجملة: خوفك من اليغافلك
مع ملاحظة أن بعض مناطق العراق الوسطى والجنوبية تلفظ (اللي) منفصلة عن الفعل فنقول اللي يسوكه مرضعة سوك العصا ما ينفعه
- إضافة الجار والمجرور إلى آخر الفعل المضارع والأمر والماضي:
يقرالي ويقرالكم ويقرالنا ويقرالجن ويقرالهن
إشتريلي وإشتريلنا وإشتريلهن
بقالي وبقالك وبقالنا وبقالهن وبقالهم وبقالجن
دمج (ما) مع الأفعال وتأتي بأكثر من شكل
- مباشر مثل
مندل دلوني
متروح إلا وآنه وياك
ميخالف
- مدمجة مع إل فنقول إنت تعرف اليصير والما يصير
- مدمجة مع (إش) التي هي أصلا تعني أي شيء فنقول شمدريني والتي تتجزأ إلى
(إش ما أدري أنا)
- مدمجة مع (على) المنحوتة إلى (عل) فنقول (علما توصل لهنا الله كريم)
دمج (دا) مع الأفعال المضارعة لتفيد الاستمرارية
دتتشاقه ، دنتعارك
دمج حرف الدال(د) مع أفعال الأمر
فنقول دروح أو دولّي وربما هي آرامية
4. إش المنحوتة من (أي شيئ) ثم إلى (أيش) ثم إلى إش
ينتشر في اللغة العراقية بشكل واسع منقطع النظير دمج (إش) مع الأسماء والأفعال وإليكم الأمثلة الشهيرة فقط وهناك عشرات غيرها:
- لصق (إش) إلى أول الكلمات:
الأصل إشلون للسؤال عن الصحة فنقول اشلونك واشلونج واشلونكم واشلونجن
- نضيف (إش) إلى راح لتكوّن (اشراح) للاستفسار عما ستعمل
- نضيف(إش) إلى (ﮔد) المنحوتة أصلاً من (قدر) لتصبح (إﺷﮔد) للسؤال عن القيمة أو الكمية و(إﺷﮔد) تختصر جملة أي شيئ قدر بكلمة واحدة ومثلها كلمة (إشكثر)
- ندمج (إش) مع مالك لتكون (إشمالك) بمعنى ماذا حصل لك
- ندمج (إش) مع (ﭽان) أي كان لتقرأ (إﺷﭽان) لتعبر عن جملة (أي شيء كان)
- نربط (إش)مع عِدّه وعدي وعدك وعدنا وعدهم وعدهن للاستفسار بمعنى ماذا لديه مثل اشعده واشعدهم مع ملاحظة حذف النون لأن الأصل هو عند
- نضيف (إش) للأفعال فنقول اشسويت
- دمج (إش) في نهايات الكلمات
- ليش بمعنى لماذا متألفة من حرف الجر اللام وأي شيئ
- ندمج (بِكَمْ) للاستفسار عن سعر الحاجة مع أيش فنسأل بيش؟
- ندغم (على إي شيء) فنسأل عليش؟
- ندغم (من أي شيء) فنسأل منّيش؟
- ندغم (بلا أي شيء) فنقول بلاش تعبيرا عن كون الشيء لا قيمة له ونقول بلاش ما ينحاش
ندغم (ما من شيئ) فنقول مامش ويقول الشاعر:
يا مامش بمامش وترخص وأغلّيك وأحبك
5. دمج حرف الشين إلى الأفعال والأسماء
ينتشر في اللسان العراقي بشكل واسع منقطع النظير دمج حرف الشين مع الأفعال والأسماء مثل شجابك وشجاك
(بلاش)
ناجمة عن دمج أربع كلمات هي حرف الجر(الباء)وحرف النفي (لا) و(أي) و (شيء) وهي (بلا أي شيء)
م.هناك كلمات كثيرة في اللغة العراقية تكونت نتيجة دمج كلمتين وإليكم بعضاً منها
شكرلمه، حامضحلو، داوركيسة، قارشوارش، شكرلي، عجيربحاس
ﭽمدوب، خردهفروش، قدمكاع، سفرطاس، طخماخ، بيعار
هستوه هستوني هستوهم هستوهن هستونا من دمج هسّه مع
توه والحقيقة أنه دمج ثلاثي لأن هسّه أصلاً ناتجة عن
جمع هذه+الساعة وبهذا فإن هستوّه ناتجة من دمج
هذه+الساعة+تواً الفصيحات
6. دمج الجمل الكاملة وأشباه الجمل بكلمة واحدة:
يتداول العراقيون الكثير من الجمل الكاملة وأشبه الجمل مدغمة بكلمة واحدة لأسباب كثيرة أهمها
أولا: استجابة التركيب لفكر العراقيين أبناء الحضارة الرافدينية العراقية التي تمتلك خزينا لغويا هائلاً خصوصا وأن عملية الإدغام والدمج تتضمن بشكل واضح فكرة اللصق أي لصق كلمة أو ضمير أو حرف جر بكلمة أخرى كما مبين في عشرات بل مئات الأمثلة التي تعج بها اللغة العراقية والتي بينا جزء يسيرا منها أعلاه، علما أن السومرية لغة لاصقة وليت لغة متصرفة. إن ذلك يعني ضمن ما يعني أن اللغة العراقية الجنوبية كانت ولازالت وستبقى الجسر الخالد المتطور بين لغات العراق القديم (السومرية- الأكدية- الآرامية) والعربية الوافدة من شبه الجزيرة.
ثانيا: الاختلاف الواضح لآيدولوجية اللغات العراقية القديمة وهي لغة المدن أساساً، تطورت ونمت واكتملت في جو المدن والأراضي الخضراء الخصبة اللين المنفتح وبين فكر العربية الفصحى الصحراوي المتزمت المقيد بالقوانين الصارمة التي سيجت اللغة فصبغتها بالصبغة القاسية المعروفة الواضحة المعالم التي يستعصي فيها التغيير والتطوير والتعديل وبالتالي الدمج والإدغام واللصق الخ من الأساليب التي تتصف بها اللغة العراقية وحين أصبحت الفصحى اللغة المقدسة للعرب بنزول القرآن تسيجت بسياج القداسة الأبدي الذي يصعب تماما تجاوزه.
ثالثا: تبقى النقطة الثالثة التي تناولناها مراراً وهي أن الإدغام والدمج واللصق في اللغة العراقية يحقق أعلى قدر ممكن من التعمية والإبهام ويجعل اللغة مستغلقة على الفهم لغير أبناء وسط وجنوب العراق.
وإذا أردنا تعداد وحصر الجمل وأشباه الجمل التي اختصرها العراقيون بكلمة واحدة فلربما نحتاج لتعداد الكثير منها ولهذا سنأتي بنماذج فقط:
عالبالسيارة: على الذي في السيارة
المايمشي: الذي لا يمشي
عليش: على أي شيئ
هنيالك: هنيئاً لك
المايعرف: الذي لا يعرف
إشمدريني: ما أدراني
بالليصرفله: بالذي يروق له
خيعونك: الله يعينك يا أخي
دروح: والدال من أصل آرامي
***
فهيم عيسى السليم
.......................
المصادر
1. معجم المفردات المندائية في العامية العراقية للدكتور قيس مغشغش ص 330 تحت باب مود.
New