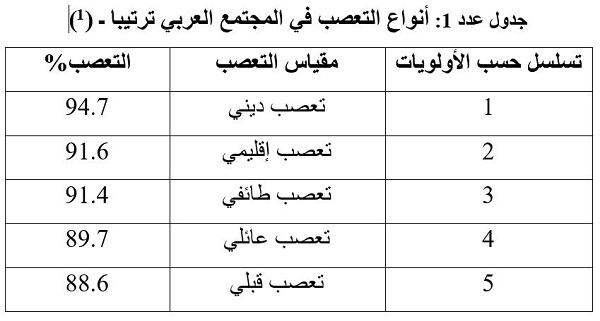دراسة سوسيو- نفسية (للأقليات) في المجتمع السوري
مقدمة البحث: يُعرِّف علم النفس الاجتماعي (Psychosocial) الشخصية الأقلوية لا بصفتها عدداً حسابياً صغيراً، بل بصفتها بنية سيكولوجية تتشكل تحت ضغط الشعور بالتهديد، يحكمها الخوف من الذوبان أو الاضطهاد، وتتسم بنرجسية دفاعية تهدف إلى حماية خصوصيتها الرمزية والمادية أمام ضغط المجموع الأكبر، والحاجة المستمرة للدفاع عن الهوية في مواجهة (الأكثرية)"
تُعد إشكالية "الشخصية (الأقلوية)" من أكثر القضايا تعقيداً في علم الاجتماع السياسي، خاصة في السياق السوري الذي يشهد تداخلاً حاداً بين الهويات الدينية والإثنية والسياسية. ينطلق هذا البحث من فرضية مركزية مفادها أن العداء الكامن لدى بعض "الجماعات ا(الأقلوية)" تجاه الأكثرية ليس انعكاساً مباشراً للظلم المادي فحسب، بل هو نتاج بنيةٍ سيميائيةٍ معقدة تتجلى في "عقلية الحصار" وتُترجم إلى استجابات دفاعية نفسية واجتماعية. يهدف البحث إلى تحليل جذور هذه الديناميكيات، وتفكيك آليات التعويض النفسي والاجتماعي، واستكشاف الأبعاد السيميولوجية التي تشكل وعي (الأقلية) بذاتها وبالآخر ضمن المجتمع التعددي السوري.
الإطار المفاهيمي وضبط المصطلحات
لضمان الدقة الأكاديمية والتحليل الموضوعي، يعتمد البحث مجموعة من المصطلحات المركزية:
- عقلية الحصار (Siege Mentality): حالة ذهنية جماعية يشعر فيها أفراد (الأقلية) أنهم محاطون ببيئةٍ خارجيةٍ معادية، أو تحمل نيّاتٍ عدوانيةً، ما يدفعهم إلى الاستنفار الدائم وتفعيل آليات الدفاع النفسي والاجتماعي على مستوى الجماعة [1].
- النرجسية الجماعية (Collective Narcissism): آلية دفاعية نفسية تتجلّى في المبالغة بتقدير عظمة الجماعة، وإضفاء قيمةٍ مفرطةٍ على خصوصيتها، كتعويضٍ عن الهامشية السياسية أو الاجتماعية، والحاجة المستمرة للاعتراف الخارجي [2].
- الإغلاق الاجتماعي (Social Closure): استراتيجيةٌ واعية أو غير واعية، تلجأ إليها الجماعات المهدَّدة لترسيم حدودها الثقافية والاجتماعية، ومنع الذوبان في المحيط الأكبر؛ وغالباً ما يتمّ ذلك عبر توظيف المقدَّس أو اللغة (أو اللهجة المحلّيّة) كحواجز رمزيةٍ [3].
أنثروبولوجيا البقاء والمقدّس الطائفي
في المجتمعات التعددية، لا سيّما في الحالة السورية، تظهر العزلة الطائفية كآلية بقاءٍ قصوى تفرضها التحديات البنيوية والتاريخية. تتجلى هذه الديناميكية في بعدين رئيسيين:
- تسييس المقدس: يتحوّل الحفاظ على الجماعة (الدينية، أو الطائفية) إلى فعلٍ تعبّدي، حيث يغدو الدفاع عن الكيان الاجتماعي بمثابة دفاعٍ عن "الحقيقة المطلقة" التي تحتكرها الجماعة، مما يبرّر العداء الرمزيَّ للأكثرية التي تُتَصوَّر سيميائياً كتهديدٍ للمقدّس. يندمج البقاء المادي بالجذور الدينية أو الطقسية، فتُشَرْعَن العزلة وتُضفَى القداسةُ على حدود الجماعة [4].
- ديناميكية التعويض الوظيفي: تلجأ الأقليات، تاريخياً، إلى التميّز النوعيّ في قطاعاتٍ محدّدةٍ كالتجارة، السلك العسكري، أو المهن العلمية، لخلق حالة من "التبعية العكسية"؛ بحيث تعتمد الأكثرية على خبرات (الأقلية)، فيتحوّل "الضعف العدديّ" إلى "قوةٍ وظيفيةٍ" تفرض نفسها على بنية المجتمع [5].
التحليل السيميولوجي والسيكولوجي للعلامة ا(الأقلوية)
تُقارب هذه الدراسة "الفرد االأقلوي" كـ "مستقبلٍ للعلامات"، إذ أن القراءة السيميائية للواقع تكشف عن صراعٍ رمزيٍّ عميق:
- تشفير العلامات: يرى الفرد ا(الأقلويّ) رموز الدولة (كالعلم الوطني، اللغة الرسمية، العمارة العامة) كأدوات هيمنةٍ وإقصاءٍ سيميائي، لا كرموزٍ جامعة. يؤدّي ذلك إلى حالةٍ من الاغتراب السيميائي، حيث يُعادُ تفسيرُ الواقع بوصفه شبكةٌ من "علامات الهيمنة" [6].
- اللغة واللهجة: تتحوّل اللغة الأم أو اللهجة الخاصة إلى "قلعةٍ لغوية" تحمي الهوية من الذوبان في الأكثرية، بينما يُضفى على المكان (القرية، الحي، المعبد) قداسةٌ سيميائيةٌ، تجعله نقيضاً لفضاء الأكثرية.
التحليل السيكولوجي: يعاني الفرد (الأقلّوي) من "التهديد الرمزي"، حيث يشعر بالاغتراب النفسي عندما لا يجد قيمه ورموزه ممثلةً في الفضاء العام. تظهر الاستجابة الدفاعية في تقوية الروابط الداخلية مع الجماعة، (والجماعات الأقلوية الأخرى)، وتفسير تصرفات الأكثرية—حتى العادلة منها—كإشاراتٍ عدائيةٍ مبطنة.
- التعويض النفسي (نظرية أدلر): يتم قلب "الدونية العددية" إلى "فوقية أخلاقية" أو معرفية، ما يفسّر الانجذاب أحياناً إلى سلطةٍ ديكتاتورية تضمن الحماية وتكسر "طغيان العدد" [5]. تتجلى ديناميكيات التعويض (الأقلوي) في مستويين مترابطين:
1. التعويض التاريخي: عندما تُحرم (الأقلية) من السلطة السياسية على مدى زمني طويل، تلجأ إلى التفوق الوظيفي في مجالات التعليم العالي، التجارة، أو الفنون، لخلق علاقة "تبعية عكسية" تجعل استمرار الأكثرية مرهوناً بخبرات (الأقلية).
2. التعويض السلطوي: يدعم بعض أفراد (الأقلية) الأنظمة السلطوية أو الديكتاتورية إذا ضمنت لهم موقعاً مميزاً في هرم السلطة، حيث يتم التعويض عن النقص العددي بـ"فائض القوة" الممنوح من النظام، ما يخلق وعياً زائفاً بالأمان الوجودي.
تحولات الذات الأقلوية بين المركزية السلطوية وانكسار السيادة
تتوزع ديناميكيات (الأقلوي) في ظل "سلطة الطائفة" على مرحلتين متعاقبتين:
1. المرحلة الأولى: (الشخصية الحصينة)
- تحوّل السلطة إلى "كيان وجودي": عند "الشخصيات الأقلوية" لا يعود النظام مجرد جهاز إداري، بل يصبح "الرحم" الذي يحمي الأقلية. هنا، يصبح نقد السلطة بالنسبة ل(الأقلوي) هو تهديدٌ مباشرٌ لحياته الشخصية.
- النرجسية الدفاعية (Defensive Narcissism): تبدأ الشخصية بادّعاء تفوق "نوعي" (نحن الأكثر علمانية، نحن حماة الدولة، نحن الأكثر كفاءة). هذا الادعاء يهدف لشرعنة حكم الأقلية للأكثرية وتسكين الشعور بـ "عدم الشرعية العددية".
- تضخيم "فوبيا الآخر": يتم شحن الشخصية بصور نمطية عن الأكثرية (أنهم إرهابيون، حاقدون، انتقاميون). هذا الخوف هو "اللاصق السيكولوجي" الذي يربط (الأقلوي) بالنظام، حتى لو كان معارضاً لممارساته؛ فهو يرى في النظام "شراً لا بد منه" للحماية من "شرٍّ مطلق" (الأكثرية).
2. المرحلة الثانية: بعد انهيار السلطة: صدمة الاقتلاع والقلق الوجودي
- قلق الانتقام (Retaliation Anxiety): تسيطر على الشخصية حالة من الرعب الجماعي. بما أنه تماهى مع السلطة سابقاً، فإنه يفترض أن الأكثرية ستعامله كـ "جزء من آلة القمع"، فيسقط في فخ "التعميم المتبادل".
- الحداد الهوياتي: يشعر بفقدان "الأنا المتضخمة" التي كانت تمنحها له السلطة. فجأةً، يعود ليصبح "عدداً صغيراً" في مجتمعٍ كبير، مما يولّد شعوراً بالانكسار والدونية المفاجئة.
تنقسم الشخصية هنا إلى مسارين: الانكفاء التام: العودة للعزلة المكانية أو الطائفية الصلبة (عقلية الحصار المتجددة). والتحول البراغماتي: محاولة الاندماج السريع عبر تبني لغة الأكثرية الجديدة (التظاهر بالتماهي) كآلية بقاء، لكنها تظل مغلَّفةً بحذرٍ شديد.
بالمحصلة: إن الشخصية (الأقلوية) التي ارتبطت بالسلطة تعيش مأزقاً سيميائياً؛ فهي قد فقدت "الدرع المادي" (السلطة) ولم تكتسب بعد "الأمان الرمزي" في ظل الأكثرية. ولإخراج هذه الشخصية من دوامة الخوف، يحتاج المجتمع إلى "تفكيك الارتباط بين الجريمة والطائفة". إذا لم يشعر (الأقلوي) أن القانون سيحمي "براءته الفردية" بعيداً عن "مسؤولية طائفته الجماعية"، فإنه سيظل حبيس "عقلية الحصار"، وهو ما يهدّد السلم الأهلي على المدى الطويل.
سيكولوجية الأقلوي النخبوي (المعارض الأبدي):
لماذا يتمايز المعارض (النخبوي) عن المعارضة الشعبية (الأكثرية) أثناء النضال الثوري لتغيير السلطة؟ ولماذا تعادي المعارضة النخبوية الأكثرية بعد نجاح ثورتها؟
سيكولوجية الانفصال النخبوي عن الحاضنة الشعبية: يشعر المعارض النخبوي أنه متميز بمعرفته وأدواته التحليلية، ويضع شروطاً ثقافية للنضال، ويرفض الذوبان في الحشود. يعاني من "النرجسية القيادية" ويتوقع أن الأكثرية ستنصّبه قائداً بمجرد سقوط المستبد، ويصاب بخيبة أمل إذا لم يحدث ذلك.
النخبوي يقدّس "فردانيته" وتميزه الشخصي؛ والنضال مع الأكثرية يتطلب "ذوبان الذات" في الكتلة، وهو ما يرفضه النخبوي سيكولوجياً لأنه يخشى فقدان بريقه الخاص. فينسحب من المسارات الميدانية إذا أصبحت شعبيةً أكثر من اللازم، ويبحث عن مساراتٍ نخبوية تعمّق الفجوة بين "المثقف" و"الشارع".
بعد نجاح الثورة، قد يشيطن السلطة الجديدة إذا لم تأتِ به كحاكمٍ مطلق، وقد يجد نفسه يفضّل "ديكتاتوراً مثقفاً" (يشبهه في اللغة والنمط) على "ديمقراطي شعبي" (يشبه الأكثرية في القيم والتدين)، وهذا هو قمّة الانفصال السيكولوجي عن أهداف الثورة الأصلية.
يعدّ التمايز بين "المعارض النخبوي" (الذي ينتمي لأقلية ثقافية عابرة للطوائف والأعراق) و"المعارضة الشعبية" (الأكثرية) من أعقد معضلات الثورات. هذا الشرخ ليس سياسياً فحسب، بل هو شرخ سيكولوجي وأنثروبولوجي عميق يتعلق بكيفية تعريف "الوطن" و"العدالة".
أولاً: التمايز أثناء النضال الثوري - صراع "الخلاص" و"التغيير":
1. اختلاف الدوافع (القيم مقابل الحاجات):
المعارض النخبوي: يناضل من أجل مفاهيم تجريدية (دولة القانون، العلمانية، الحريات الفردية، التعددية). هو يرى الثورة أداةً لتحديث المجتمع قسراً. بينما المعارضة الشعبية (الأكثرية): تناضل من أجل الكرامة، العدالة الاجتماعية، وإزالة القهر. الثورة بالنسبة للأكثرية هي فعل "تحرر" لاستعادة سيادة الهوية المغيبة.
2. اختلاف أدوات المقاومة: المعارض النخبوي يميل إلى "النضال الرمزي" (البيانات، الصالونات السياسية، الضغط الدولي). بينما الأكثرية تميل إلى "النضال الميداني" (التظاهر، العصيان، المواجهة المباشرة). هذا الاختلاف يجعل النخبوي يخشى من "راديكالية" الشارع التي قد تخرج عن سيطرته الفكرية.
ثانياً: عداء ما بعد انتصار الثورة (صدمة الديمقراطية):
بمجرّد سقوط النظام القديم، يكتشف المعارض النخبوي أن "حليف الأمس" (الأكثرية) أصبح هو "الخطر اليوم".
أسباب هذا العداء:
- متلازمة "الوصاية الثقافية": يعتقد المعارض النخبوي أنه "المصمّم" الحقيقي للثورة. عندما تستخدم الأكثرية حقها وتختار قياداتٍ أو رموزاً لا تشبه النخبة (محافظة أو دينية)، يشعر النخبوي بـ "الغبن التاريخي". هو لا يقبل أن يكون صوته مساوياً لصوت "العامي".
- الخوف من "تغوّل الهوية": يرى المعارض النخبوي أن استبداد النظام البائد كان "عقلانياً" أو "متوقعاً"، بينما يخشى مما يسمّيه "استبداد الغالبية" الذي قد يهمّش نمط حياته. هو يتوجّس من أنّ الأكثرية ستحوّل الدولة إلى نسخةٍ من هويتها الخاصة، مما قد يهمّش نمط حياته "المغاير".
- الارتقاء الطبقي والرمزي: يخشى النخبوي أنّ العدالة الاجتماعية التي تطالب بها الأكثرية (وينظّر هو لها) ستمسّ بمكانته الاجتماعية أو الاقتصادية، ويفضّل "ديمقراطية شكلية" تحافظ على امتيازاته، ويرفض "الديمقراطية الجوهرية" التي تعيد توزيع القوة، والهيمنة الثقافية.
ثالثاً: سيكولوجية "اليتم المزدوج":
الأقلّي النخبوي يجد نفسه في حالة يتم سيكولوجي فريدة: هو مغتربٌ عن السلطة القديمة (لأنه ناهض استبدادها). وهو خائفٌ من السلطة الجديدة (لأنه لا يثق في ثقافة الأكثرية).
هذا "الارتياب الوجودي" يدفع النخبة أحياناً للتحالف (سرّاً أو علناً) مع بقايا النظام القديم (الدولة العميقة) لعرقلة السلطة الجديدة، تحت ذريعة "حماية مدنية الدولة" أو "منع الفوضى"
سيكولوجية "الأكثرية المقهورة"، ووعي المظلومية:
عندما تتعرض الأكثرية لاضطهاد من سلطة تُحسب (رمزياً أو فعلياً) على أقليات، يتولّد لديها وعيٌ جمعيٌّ يرى أن "الوضع الطبيعي" (سيادة الأكثرية) قد سُلب منها غصباً. في الحالة السورية، ومنذ ما ينوف عن نصف قرن، اختبرت الأكثرية التهميش السياسي الممنهج، ما خلق لديها سيكولوجيةً فريدةً سندعوها ب "الأكثرية ذات الجرح الوجودي".
المركزية الجريحة:
تشعر الأكثرية أن هويتها، التي من المفترض أن تكون المتّصل الوطني، قد اغتُصبت، وتمّ استبدالها بهوياتٍ فئوية، فتلجأ إلى سلوكيات وردّات فعل سيكولوجية، لا تساعد على بناء السلم الأهلي الذي تدعو إليه:
التعميم السيكولوجي: قد تميل الأكثرية، في لحظات الغضب، إلى تحميل الأقليات، ككتلةٍ واحدة، مسؤولية أفعال السلطة، وترى في استعانة السلطة بالأقليات نوعاً من التحالف ضد المجتمع.
وهم السيادة المهددة: تميل الأكثرية الخارجة من الاضطهاد إلى تبنّي خطاب "الدولة للأكثرية"، أو "من يحرّر يقرّر" كنوعٍ من جبر الضرر التاريخي الذي لحق بها.
سيكولوجية "الخوف المعاكس" في ظل الانتقال: هنا نصل إلى لبّ المشكلة: لماذا تخاف الأكثرية من مطالب (الأقلية) حتى بعد التغيير؟
الخوف من استمرار "الاستثناء": تخشى الأكثرية أن تؤدي حقوق الأقليات إلى "تفتيت" الدولة أو إبقاء الأقليات في مراكز قوةٍ غير متناسبةٍ مع حجمها العددي، كما كان يحدث في عهد السلطة (الأقلوية).
تفسير المطالب كـ "امتيازات": سيكولوجيّاً، أي مطلب ذي خصوصيةٍ هوياتيةٍ للأقلية قد يُفهم من قبل الأكثرية الجريحة كطلب لـ "امتياز جديد" وليس كحقٍّ طبيعي.
هندسة الخطاب وآليات السلطة في إزالة مخاوف الأقليات:
لإزالة المخاوف والهواجس المتبادلة، بين أكثرية جريحة، انتصرت ثورتها حديثاً، وأقليات تنتابها مخاوف من الأكثرية، يحتاج الخطاب إلى آليات محددة:
- خطاب المواطنة السيادية: التأكيد أن الدولة ملكٌ للجميع بالحقّ القانوني، وليس بمنحةٍ من أحد، ما يطمئن الأكثرية بأن سيادتها الوطنية مضمونةٌ، ويطمئن الأقلية بأنّ وجودها ليس منوطاً برضا السلطة.
- فصل السلطة عن الجماعة: ضرورة وجود خطابٍ إعلاميٍّ وتربويٍّ يفصل بين "أفعال النظام البائد" و"الجماعات (الأقلوية)" كمكوناتٍ اجتماعية.
- الضمانات القانونية التبادلية: التأكيد على أنّ حماية حقوق الأقلية هي الضمانة الوحيدة لعدم عودة الاستبداد مرةً أخرى، لأن التغوّل على أي فئةٍ هو تمهيدٌ للتغوّل على الجميع.
الخلاصة والتوصيات
مما سبق توصلنا إلى أن المجتمع السوري يعاني من قلق على المستوى الاجتماعي، ناجمٍ عن عدم توازن نفسي؛ فالأكثرية، المنتصرة بعد صراعٍ مرير، وتضحياتٍ جمّة، في مراحل مختلفة من نصف القرن الأخير، تسلّمت السلطة بالشرعية القانونية للمنتصر، وجدت نفسها تحمل جراحاً نفسية، ليس من السهل تجاوزها، يزيدها إيلاماً تبجّح بعض الأقلويين الذين فقدوا سلطةً كانت تحقق لهم امتيازات لا يمكن لهم تحقيقها بمقياس الكفاءة الذاتية، وأقلية نخبوية، سجينة أقفاص أيديولوجية، أو نرجسيات مريضة، ترى أن سلطة الأكثرية رجعية، وغير شرعية، وأنهم، كمناضلين مثقفين، أولى بقيادة المجتمع، نحو الحداثة والتطور. ولتطمين أفراد المجتمع، بأقلياته وأكثريته، ولأم الجراح، لا بدّ من بعض الإجراءات الضرورية:
1. المسار القانوني: تفعيل هيئة العد الة الانتقالية بأسرع وقت، لتشعر الأكثرية الجريحة ببعض العزاء عن تضحياتها، ولتطمين الأشخاص من الأقليات غير المتورطين بالجرائم، بأن العقوبة تلحق المجرم فقط، بغض النظر عن طائفته أو إثنيته.
ودسترة التنوع السيميائي والاعتراف بالحقوق الثقافية والرمزية للأقليات، وتحويلها إلى قوانين تحمي ممارسة الهوية في الفضاء العام، ما ينهي "عقلية الحصار" ويستبدلها بشعور "المواطنة المحمية".
2. المسار الفلسفي الوجودي: إعادة تعريف الهوية الوطنية كهوية مركبة تسمح بالسيولة الهوياتية، وتعزيز الحوار الذي يرى في "الآخر" شريكاً في الوجود، مما يقلل من ديناميكية التعويض الاستعلائية.
3. المسار التربوي: إعادة صياغة الذاكرة الجمعية الوطنية في المناهج الدراسية لتشمل رموز الجميع، وبناء جيل يمتلك مناعة سيميائية ضد التعصب ويرى في تنوع الرموز إثراء لهويته الشخصية.
4. التعليم التعددي: إدماج السير الذاتية والتاريخ الثقافي (للأقليات) في المناهج الوطنية لكسر "الغربة السيميائية" وتعزيز شعور الانتماء المشترك.
5. اللامركزية الإدارية: تشجيع الإدارة المحلية وتمكين الأقليات (الإقليمية) من إدارة شؤونها الخاصة، مما يخفف من حدة العداء تجاه المركز ويدعم الاستقرار.
الخاتمة
تؤكد نتائج البحث أن "الشخصية (الأقلوية)" ليست قدراً بيولوجياً، بل هي استجابةٌ سيكولوجية وسوسيولوجية لبيئةٍ تفتقر للأمان الرمزي والمادي. إن محاولات صهر الأقليات القسري في بوتقة الأكثرية غالباً ما تؤدّي إلى تعميق "عقلية الحصار" وزيادة التوترات البنيوية، في حين أن الاعتراف بالخصوصية الثقافية و(الهوياتية) هو المسار الأكثر فاعليةً لبناء الثقة وتحقيق الاندماج الحقيقي.
يبقى الربط بين الجماعة والمقدّس الحصن الأخير ضد الذوبان، مما يتطلب معالجة حذرة تحترم هذا الربط ولا تصطدم معه مباشرةً. إنّ العدالة العددية وحدها لا تضمن إنهاء مخاوف الأقليات ما لم يرافقها اعتراف سيميائي عميق، وتوسيع مفهوم المواطنة ليشمل الجميع على قاعدة الحقوق المتساوية.
***
بقلم: منذر فالح الغزالي
فاحتبيرغ،23.01.2026
.......................
المراجع المعتمدة
1. Bar-Tal, Daniel. Group Beliefs: A Ideology, Orientation, and Maintenance. Springer-Verlag, 1990. (الصفحات: 125-140) - حول مفهوم "عقلية الحصار".
2. Golec de Zavala, Agnieszka. Collective Narcissism and Its Social Consequences. Journal of Personality and Social Psychology, 2009. (الصفحات: 1074–1091).
3. Weber, Max. Economy and Society. University of California Press, 1978. (الصفحة: 342) - حول مفهوم "الإغلاق الاجتماعي".
4. ليبهارت، أريند. الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد. معهد الدراسات الاستراتيجية، 2006. (الصفحات: 45-60) - حول إدارة الانقسامات الطائفية.
5. Adler, Alfred. Understanding Human Nature. Greenwich, CT: Fawcett, 1927. (الصفحات: 68-85) - حول ديناميكيات التعويض وعقدة النقص.
6. بارت، رولان. سيميولوجيا الحياة اليومية. (ترجمة عربية)، دار نينوى. (الصفحات: 30-55) - حول كيفية قراءة الرموز كأدوات هيمنة.